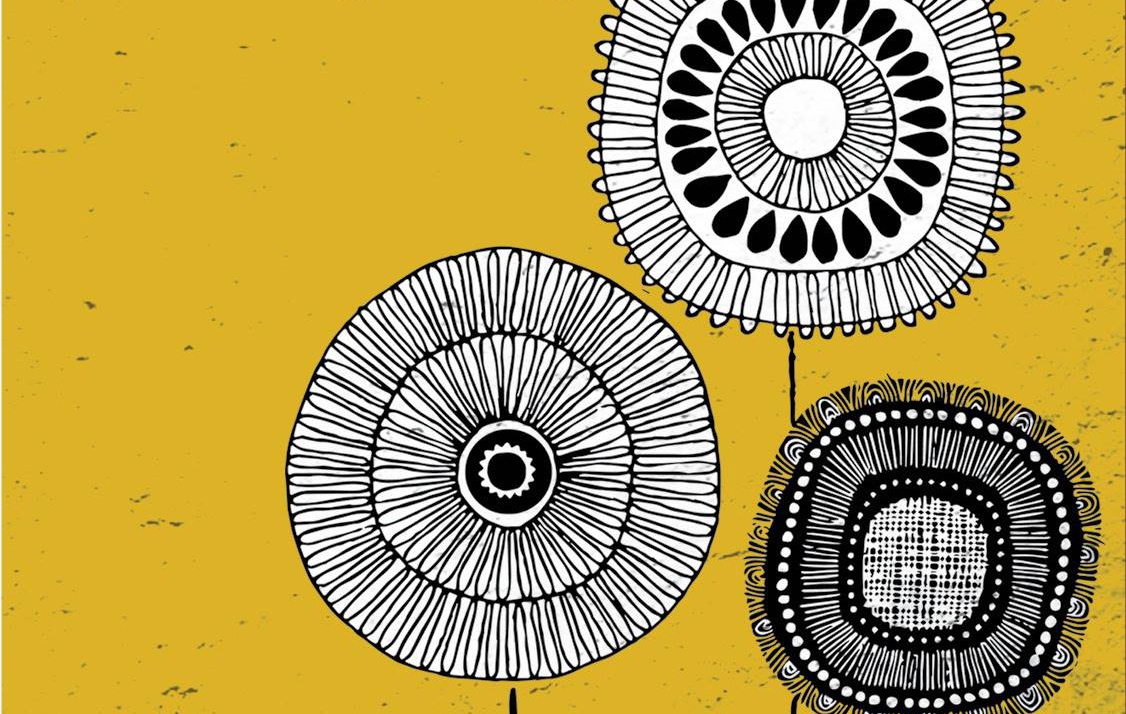إذاً، المدينة هي الناصرة، والقصّة هي قصّة عائلة بورجوازية تفقد امتيازاتها. الجدّة، ماري، تحمل معاني القسوة والجمال والقليل من الشرّ. الأمّ، عايدة، تبدو في وضع إنكاريّ لما آلت إليه أوضاع العائلة، تصرّ على الماكياج الكامل وعلى وضع خواتم زواجها كمن يتمسّك بماضي أبناء الذوات. الأخت، سوسن، مصابة بالجنون، وقابعة في دار للرعاية النفسية. الأخت الثانية، جانيت، مهاجرة إلى كندا. الأخت الثالثة، مي، انتحرت. الأخ، إميل، أصيب بالإيدز ومات. أمّا الابن الأصغر، كميل، فيبدو وكأنّه وإميل شخص واحد (الفارق حرف واحد بين الاسمين)، وقد امتزجت الشخصيّتان باسم “يولا” الذي يشكّل وأخواته عنوان الرواية. هذا المزج بين الشخصيّتين يظهر أيضاً بطريقة أقلّ حدّة بين الأمّ وابنتها سوسن. فحين توقّع عايدة على الموافقة على بيع ممتلكات العائلة بالمزاد العلني، ينتبه كميل أنها تحمل قلمَيْن، وحين تستخدم أحدهما، يظهر توقيعها بالعبرية: “سوسن”. فهل عايدة هي سوسن نفسها، لكنّ كلاً منهما اختارت طريقتها للتعايش مع الواقع الجديد، إمّا عبر الإنكار، وإمّا عبر الجنون؟
ليست التحوّلات السياسية والاجتماعية وحدها ما أفقد العائلة حضورها التاريخي. فبعد وفاة الأب، اكتشف الجميع ضرائب متراكمة لم يسدّدها قبل وفاته. ومن هذه المعلومة البسيطة، يحدّد راجي بطحيش مصدرَيْن للعنف الذي تصطدم به شخصياته: الأب والدولة. السلطة الأبوية والسلطة الإسرائيلية. كما يعترف الراوي، في فصل آخر، أنّه كذب على الأخصّائي النفسي قبل ثلاثين عاماً، فلم يجرؤ على إخباره عن تضايقه من سرقة الغزاة لثمار شجرة اللوز، ومن إجباره على حضور صف الرياضة مع الصبيان بدلاً من التطريز مع البنات.
يكمن سحر الرواية في العدد القليل من الصفحات التي تمكّنت بأسلوبها المكثّف من الدخول إلى العوالم العميقة للشخصيات وللمدينة وللعنف المحيط بها، وذلك عبر لغة تمتزج فيها السخرية بالميلانكوليا والكتابة الكويريّة التي تعتمد الألفاظ الجنسيّة الصريحة والعلاقات المثليّة المحرِرة، في محاولة لتحقيق أكثر من غاية واحدة: تدمير الصورة الرومانسية التي تطبع الكثير من الأعمال الأدبية الفلسطينية، الابتعاد عن اختزال صورة الفلسطيني بالضحية، تفكيك الوحدة المصطنعة للإنسان الفلسطيني، السخرية من العادات الاجتماعية للطبقة الوسطى الناصرية، وإدانة آليات العنف العسكري والاجتماعي.
“خرج إميل كعادته كلّ صباح إلى الشارع الرئيس في ديانا، ليستعرض أوراق الموتى”.
يبدأ أحد مقاطع الرواية بهذه الجملة، كأنّه من العاديّ أن تكون لإميل عادة كهذه. لكنّنا لا نلبث أن نعرف أنّ إميل ليس وحده مَن يعتمد هذا الروتين الصباحي في قراءة أوراق النعي. فالرجال المشاركون في الجنازات وهم يضعون نظارات سميكة “يبدون وكأنهم ينهضون من النوم فقط لحضور الجنازات، حيث يعودون من بعدها للرقاد الطويل حتى المرة التالية”. ولا يفوّت الكاتب فرصة وصف ثياب المجنّزين حيث “يرتدي الجميع قمصاناً بيضاء كمراويل أطباء الأسنان”، و“تدخل جميع هذه القمصان في البناطيل”، قبل الإعلان بأنّ “لا بناطيل جينز في جنازات هذه المدينة”.
إضافة لما تحمله هذه العبارة الأخيرة من سخرية من العادات الاجتماعية، فإنّ صياغتها على هذا النحو تتضمّن من دون شكّ إحالة إلى رواية خالد خليفه «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة». وقد سبق لبطحيش أن أشاد في إحدى مقابلاته بسرد هذه الرواية السلس لمواقف مثليّة. لكنّ التواطؤ بين الروايتين يتجاوز وصف العلاقات الجنسية المثلية. فكلتاهما يتحدّث أيضاً عن تفكّك عائلة وحُطام مدينة في ظلّ علاقات العنف السائدة، بلسان راوٍ هو الأخ الأصغر. ولا تبدو الصدفة وحدها هي التي منحت اسم “سوسن” لشخصية رئيسية في الروايتين. وكأنّ سوسن، الفتاة المقبلة على الحياة والتي تنتقل من خيبة إلى خيبة وتنتهي مهاجرةً عند خليفة، يختار لها بطحيش نهايةً مختلفة: الجنون. ففي «يولا وأخواته»، يتقاطع عند سوسن بالذات حُطام الناصرة بالخراب الذي يسود المنطقة، بدءاً من الحرب الأهلية اللبنانية ثمّ مجزرة صبرا وشاتيلا، وإن كان بطحيش لا يلجأ إلى إجابات سهلة بشأن ما الذي أصاب سوسن بالجنون، ويترك العلاقات السببية غير واضحة.
وإذا كانت مجزرة صبرا وشاتيلا قد بدأ معها “عصر جديد فيما يتعلّق بعلاقة الجمال بلبنان”، فإنّ رثاء الراوي لأمّه وهو ينظر إلى مفرش الطاولة الدمشقي بعبارة “لا أمّي بقيت، ولا الشام سلمت”، يقفل الباب على الحنين إلى زمن وأشياء لم تكن. فكما يكتشف الراوي، “لا مكان اسمه “الشام” على الخريطة أصلاً، وأنّه مجرّد اختراع للرومانسيين”. ولا تسلم تلك الرومانسية من السخرية حين يصف الراوي صورة الشام في ذهن أبيه: “أما الماء، فطعمها مسك، والقهوة طعمها زنبق، والحليب رائحته ياسمين، والليمون يقطر عسلاً.. والجبنة البلدية تفيض حناناً”، ليتّضح له لاحقاً أنّ أباه لم يزُر الشام يوماً.
وبالسخرية السوداء نفسها، يرسم بطحيش مشهد جنون سوسن في ذلك اليوم من العام ١٩٨٢ حين اقتحمت طقوس العزاء بضحايا صبرا وشاتيلا في الجمعية النسائية الخيرية، وانقضّت على جدّتها، فتطايرت صينية المغلي الذي استقرّ محتواه “داخل كعكة الشعر على رأس الريسة رفقا حيث بدا رأسها كأنه عشّ يمتلئ بالقيء”. في هذه الجملة الواحدة، تتكثّف نظرة الكاتب إلى تسريحات الشّعر لدى نساء هذه الطبقة، والإصرار على صناعة هذا النوع من الحلويات رغم إصابتهنّ بالسكري غير الوراثيّ، ومشهد المغلي الذي يشبه القيء الذي أرادت سوسن أن تُخرجه من بطنها إلى الخارج.
هذا النوع من التكثيف الساخر والميلانكولي في الآن معاً يذكّر بمشاهد من أفلام إيليا سليمان، ابن الناصرة هو الآخر. الاقتصاد في الكلام وفي حركة الكاميرا اللذان يطبعان أفلام سليمان يوازيهما هنا الاقتصاد في الحوارات والأحداث والسرد الوصفيّ. وكما عند سليمان، تردم السخرية السوداء الهوّة بين الواقع والخيال، فيصف الراوي آنسات الحيّ ومعذّباته وهنّ يجلسن على شرفات متآكلة ينتظرنَ المسيح وهو عائد من عمله.
فلا مقدّسات دينيّة أو وطنية تضع حدوداً لهذه السخرية. ورغم الدور الذي تحتلّه مجزرة صبرا وشاتيلا في الرواية، لا يتوانى الراوي عن ملاحظة أنّ هاتين الكلمتين ستصبحان “مثل ريا وسكينة أو مريم ومرني”. وخلال تخطيط جانيت لرحلتها إلى معسكرات الإبادة في بولونيا، تغريها الموظّفة في شركة السياحة بوجود محال “الآوتلت” حيث يمكنها القيام بمشتريات شخصية، إلى جانب زيارة المعسكرات. حتّى قسوة الاحتلال وهيمنته، فلا يُشار إليهما إلا بسخرية قاسية. فحين تزور جانيت أضرحة شخصيات يهودية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، يقول الراوي إنّ جانيت كانت تعتقد أنّها مجرّد أسماء لشوارع في حيفا وتل أبيب.
السخرية نفسها يستخدمها بطحيش في مواجهة الرموز والكليشيهات الثقافية. فيصف رائحة الكعك بسمسم في زمن الطفولة بـ“كأنها تبكي على “العرب المتدحرجين من الأندلس””، في محاكاة هزلية لقصيدة “الكمنجات” لمحمود درويش التي تبكي على “العرب الخارجين من الأندلس”. وفي ما يبدو أيضاً محاكاة لقصيدة “أمّي” لدرويش نفسه، يصف الراوي صدر أمّه الذي “يلامس هضاب الطحين التي ستصبح بعد قليل عجيناً، لا يحلو صنعه إلا في الفجر”. لكنّه لا يلبث أن يستدرك: “ولكنّ أمّي كانت ابنة طبقة متوسطة، وهي لم تستيقظ مرّة في الفجر، لتعارك العجين”. ففي مقابلة له مع الباحثة سونيلا موباي، يقول بطحيش إنّ “جيلنا مصاب بالعقدة الدرويشية أو متّهم بذلك على الأقلّ، فلقد حاول كلّ واحد منّا بطريقته الخاصّة أن يهرب منها قدر الإمكان إلى أماكن أخرى”. لكنّ همّ بطحيش ليس التخلّص من عقدة أبويّة وحسب، بل التخلّص من تحكّم الأيديولوجيا بالأدب الفلسطيني. لذلك، يعلن عن امتنانه للقفزة التي حقّقها درويش منذ إصداره ديوان “لماذا تركت الحصان وحيداً” الذي شكّل تحوّلاً في مسيرة الشاعر الفلسطيني، وهو تحوّل سهّل مهمّة الجيل اللاحق. وإذ يعلن بطحيش في شهادة له عن الأدب الفلسطيني الجديد، أنّ “الأيديولوجيا أفسدت قليلاً «عائد إلى حيفا»”، فإنّه يبدو واثقاً من أنّ “غسان كنفاني كان في طريقه لهجر الأيديولوجيا البنيوية في السرد في سبيل الفن”. هكذا يبدو بطحيش وكأنّه يقدّم نفسه لا كمتمرّد على تجربة درويش أو كنفاني، بل كامتداد للمرحلة الأخيرة منها.
“أنت… أي إميل، مصدر لحظتك المثيرة، وأنت من يُنتجها”.
بهذه الكلمات خاطب إميل نفسه بعد علاقة جنسيّة عابرة تكلّلت بالفشل. لكن، رغم الفشل الجنسيّ، يشعر إميل بـ”الفخر بجسمه” الذي لا يزال قادراً أن يختار شركاءه ويلفظهم متى شاء ذلك. لكنّ هذا الشعور بالفخر مرتبط أيضاً بما سبق هذه المغامرة الجنسية وما تلاها. فتحضيراً لاستقبال عامر في البيت، يسارع إميل إلى إفراغ غرفته من كراكيب العائلة ليجهّز ساحة الاغتصاب الطوعيّ الذي وعده به عامر، فيرى أغراباً يعبثون بمقتنيات العائلة في الخارج ويمزّقون ألبوم الصور، لكنّه يقرّر ببساطة ألا يثير مشكلة معهم كي لا يُفسِد لقاءه الجنسيّ المنتظَر.
لكنّ فخر إميل بجسده لا يتزامن مع تخلّصه من سطوة الإرث العائلي وحسب، بل مع تحرّره أيضاً من السلطة الثقافية. فحين لوّح عامر باستخدام كتب المثقّفين خلال العملية الجنسية، “صار إميل يتخيّل كتب ادوارد سعيد ودريدا المغبّرة محشوّةً داخله… فلم تعجبه الفكرة”. لكن، ما أن يغادر شريكه الشقّة، حتّى يلجأ إميل إلى كتاب “الجهل” لميلان كونديرا. فتماماً كما يكنّ بطحيش الاحترام لدرويش وكنفاني ويعلن في الوقت نفسه تجاوزهما، لا يستسيغ إميل استهزاء عامر بسعيد ودريدا، لكنّه ما عاد يجد الراحة في أسئلتهما وأجوبتهما النظرية، فلجأ إلى عالم الأدب عند كونديرا حيث لا عودة ممكنة إلى الوطن، وحيث لعنة الاغتراب لا تزال تلاحق إميل منذ قراره العودة إلى الناصرة من دراسته الجامعية.
ومثلما ارتبط الخلاص الذي أنشدته سوسن عبر الجنون بتحطيم المشهد السياسي الرسميّ وطقوس عزائه، ارتبط الخلاص الذي بحث عنه إميل عبر الجنس بالتحرّر أيضاً من صورة “الفلسطيني” الواحد الذي صنعته الرواية السياسية الرسمية. ففي مسكن الطلبة الجامعي في حيفا، كانت نظرة إكزوتيكية تحكم علاقة إميل المسيحيّ بزملائه المسلمين. وحين كان إميل يتحدّث إلى أمّه بالفرنسية، كان الجميع يظنّون أنّهما يخطّطان لرحلة تزلّج إلى سويسرا أو رحلة شوبينغ في لندن، لكنهما كانا في الواقع “ينصتان معاً لصراخ سوسن بصمت”. ولم يتمكّن إميل من الخروج من عزلته كـ”مسيحيّ دلّوع” إلا من خلال إقامة علاقة بينه وبين سمير المُسلم، ممّا حوّله إلى “دمية الشقّة المدلّلة التي استطاعت اختراق النواة الصلبة للوجود الريفي الإسلامي لمساكن الطلبة”.
تتكرّر محاولات كسر صورة “الفلسطيني” الواحد في الرواية، فتصبح الوجوه المتعدّدة مرادفاً لتعدّد المصائر. فبعد مجزرة صبرا وشاتيلا، يدور الحوار الآتي بين الجدّة ماري وابنها:
“أبوك ترجّاني نْهجّ علبنان مع العالم اللي هجّت من حيفا مع دار خالك، كان إسا كانوا مدبّحينّا.
يمّا ما انت عارفة انهن أعطوا المسيحية جنسيات… عن شو بتحكي؟”
ليست صورة الفلسطيني الواحد هي وحدها ما تحاول الرواية كسره، بل كذلك صورة الإسرائيلي الواحد. فحين تقرّر جانيت أخيراً تحقيق حلمها بزيارة معسكرات الإبادة في بولونيا، تبلغها موظفة شركة السياحة: “يوجد رحلات للعلمانيين، ورحلات للمتديّنين، ورحلات للحريديم المتشدّدين الذين يهمّهم زيارة أضرحة الأولياء والفقهاء أكثر من المعسكرات”. تبلغها أيضاً أنّ هناك جماعات التديّن الصهيوني، وأنّ هناك نوعَيْن من الجماعات العلمانية: من يقيمون تقاليد السبت ومن لا يقيمونه.
لكنّ بطحيش لا يُعنى بكسر الصورة الموحّدة وحسب، بل كذلك الصورة الدونيّة للفلسطيني كضحية دائمة. فحلم جانيت بزيارة معسكرات الإبادة لم ينبع من شعارات حقوق-إنسانية، ولا من تعلّقها بصورة الضحية التي تحوّلت جلاداً للفلسطينيّين. لقد ذهبت إلى هناك لترصد “عملية التدهْوُر” أو “كيف يمكن لجماعات بشرية، تعيش بفردوس من الحياة الاجتماعية والثقافية والجماليات والأناقة والأمان أن تتحوّل مجرّد أكوام من الهياكل العظمية المفتّتة”. إن كان هناك من تماهٍ تبحث عنه جانيت، فهو في هذا “التدهْوُر”. وحين أقامت خلال رحلتها علاقة مع نفتالي، لم تقِس الأمر كضحية فلسطينية وجلاد إسرائيلي، بل كفلسطينية مسيحيّة من طبقة لطالما نظرت بفوقيّة إلى الرجال السلافيّين. ويبدو بطحيش هنا واعياً تماماً لاستخدامه امتياز الانتماء الطبقي كسلاح في مواجهة صورة الضحية. فمن كلّ أفراد العائلة، وحدها المساعدة الآسيوية للأمّ “مسكونة بشعور دائم، بأنها ضحية شيء ما”. وهذه هي بالضبط الصورة التي يودّ بطحيش لو يَخرج الأدب الفلسطينيّ من أسرها.
“ماما، حبيبتي، اسمعيني جيّداً، لم يتبقّ أحد، بقيتُ أنا وأنت فقط وسط كلّ هذا الخواء”.
تخترق فصول الرواية نصوص أوتوبيوغرافية يعود بعضها لسنوات قبل كتابة الرواية. لكنّها تصطفّ إلى جانب الفصول الأخرى في وحدة ميلانكوليّة معنيّة بإزالة الحواجز بين أساليب السرد، وزيادة الالتباسات بين الواقع والخيال، بين يولا وكميل، بين سوسن وعايدة، وبين الناصرة والناصرة التي يستعيد المسنّون “أيّام العزّ” فيها. فيتحدّثون عن البيوت التي خلت من ساكنيها وبيعَتْ للأغراب، وعن ”المصانع التي أصبحت مغاسل للسيارات، والحوانيت الأنيقة التي أصبحت مرتعاً للحشّاشين والبلطجية وغسيل الأموات”، وعن الرحلات إلى الشاطئ شبه الخاص بالعائلة على بحيرة طبرية “قبل أن تحتلّها رائحة الخراء” وقبل الأسلاك الشائكة التي نحست الشاطئ و”جفّفت الماء فيه، ولَعَنت أسماكه، وأسكنت الديدان في أحشائها جاعلةً إيّاها تفتك بكلّ من يتجرّأ على أكلها”.

لعلّ هذا هو الغياب الذي يتحدّث عنه يولا بعد موت أبيه، حين اختار من البيت شيئاً واحداً فقط هو قفص العصافير الخشبي: “سأعبّئ في القفص هذا الغياب كلّه”. وهو نفسه غياب أفلام الأبيض والأسود المولع بها. غير أنّه إحساس بالغياب ممزوج بشعور بالذنب تختصره لازمة فيلم «ثرثرة فوق النيل»: “الفلاحة ماتت، ولازم نسلّم نفسنا”. فتنفق عمرك تنتظر عقاباً على جرم “قد لا تظنّ أنّك ارتكبتَه مرّة”.
هكذا يختلط كافكا بكونديرا، ويختلط الاحتلال بتدهوُر العائلة وبالتحوّلات التي طرأت على المدينة. لقد بقي مفرش الطاولة الدمشقي، لكنّ الطاولة باتت من عند “أيكيا”. حتّى الجنس لا يصل إلى نهاياته لدى الشخصيات الغارقة بفانتازماتها إلا عندما تغادر أسوار المدينة التي يتحسّر إميل عليها بعبارة وودي آلنيّة: “تنظيم حفل جنس جماعي في أيامنا هذه أصعب وأعقد من تنظيم جنازة أو أربعين حتّى”.
لكن، رغم كلّ هذه الجنازات، تنتهي الرواية بمشهد مليء بالأمل. سوسن تقف أعلى الصخرة تنتظر طائراً كبيراً يحلّق بها، والراوي يقفز في المحيط حيث ينتظره قارب يركبه شخص غريب. اختفت مفردات القرف والغبار والقاذورات والجثث المشطورة، وانتصرت اللغة الكويريّة التي يقول بطحيش إنّه يريد أن يحتلّ الاحتلال بها.