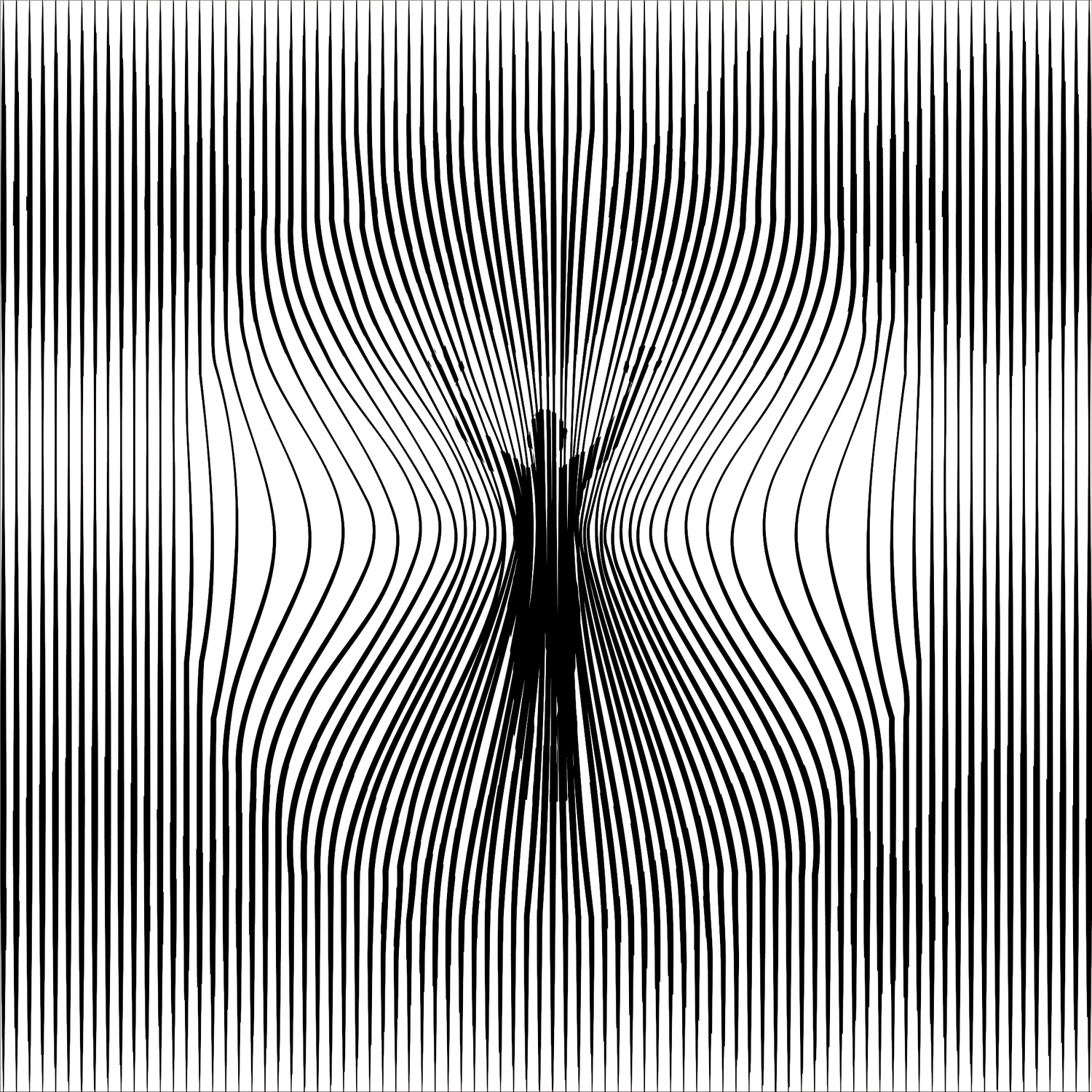يبدو أن النمط الشعري، والكتابي السوري عمومًا، الذي انطلق مع بداية انتفاضات الربيع العربي عام 2011، مسنودًا بقيم الأحداث التي عاشتها دول هذا الربيع. قد شارف على الانتهاء، إن لم ينتهِ فعلًا. يدفعُنا التمعّنُ في المتغيرات التي رافقت الكتابة، أو رافقتها الكتابةُ خلال السنوات السبع الماضية، إلى هذا الاعتقاد. ذلك أنّ النمطَ الذي فرضتهُ أحداث تلك المرحلة، لم يعد يتناسبُ مع ما يجري اليوم، ولم يعد متسقًا مع المشاعرِ التي يعيشُها الكاتبُ نفسه.
فوجئ السوريون، مع بدايات الانتفاضات، بمجالٍ باتَ مفتوحًا للقول، والتعبير، مكتوبًا كانَ أم غير مكتوب. كُسرَ احتكارُ السلطةِ للتعبير المباشر، البعيدِ عن المجازِ والترميز (بتوحّشهِ وفظاظتِهِ أحيانًا)، بانكسارِ قدرةِ السلطةِ نفسها على احتكار الفضاء العام. وانتزعَ السوريون إمكانيّةَ القولِ من فمِ الأسد، بعد أن كانوا قد فقدوها لعقود. انعكس هذا الانتصار المهم على مشاعر الناس، ومن بينهم الكتّاب والشعراء، الذين التقطوا لحظته بكاملِ مفرداتها وتعابيرها، فأنتجوا نصوصًا تشبهُ هذه المشاعر، وتماثلُها في الاتجاه والقوّة. ارتفعَ النّبْرُ، وكانت قيمةُ الحريّة هي الناظم والمعيار للكتّاب، الذين علا صوتُهم أيضًا، واستغنوا، بعدَ أن انتزعوا حقّ القول، عن المجازات والتهويمات اللغوية غير المفهومة، حيث انسحبت هذه الأخيرة مع انسحابِ الخوف من النفوس شيئًا فشيئًا، لصالح الوضوح، الذي وصلَ في كثير من الأحيان إلى المباشرة، الأمرُ الذي يسّرَ الطريق إلى معترك الكتابة لأصواتٍ كثيرة، قررت التجريبَ مسنودةً بوهم سهولة الكتابة وبساطتها، ظانّةً، مثل أصواتٍ أكثر خبرةً أيضًا، أنّ الحاملَ (الذي هو ثورة الحريّات والحال هذه) قد يكفي لرفعِ هذه النصوص، وليقيها من السقوط في شراكِ التهافت.
سنواتُ الكتابة خلال الثورةِ، التي أجيزُ لنفسي هنا تسميتَها بسنواتِ الصوتِ المرتفعِ، بدأت بالتلاشي شيئًا فشيئًا، تبعًا لما تغيّرَ من معطياتٍ (سياسية لا أدبية) على الأرض. فما كانَ ثورةً باتَ حربًا مفتوحة دمّرت المكانَ وقتلت البشرَ، وأسهمت، إلى حدٍ بعيدٍ، في تدميرٍ نفسيّ لمن لم يمت، وشُرّعَت الطريقُ أمام المأساة. خفتت الأصوات، هدأ الاحتفالُ، وانتهى الكرنفالُ إلى خرابٍ عميم. فماذا نكتبُ الآن؟!
ترافقَ انتهاءُ الكرنفال مع وصولِ عددٍ لا بأس بهِ من الكتّاب السوريين إلى منافٍ بعيدة عن صخبِ الحدث، كان بإمكانِها أن تعطي هؤلاء الكتّاب، لو لم يكونوا مقسورين على التواجد فيها، فرصةً للتمعّنِ فيما يكتبون، أو ينوون كتابته، بل وكانت لتعطيهم فرصة، والحال تلك، إلى التفكّرِ في الكتابةِ بعينِها، في أسئلتها الصعبة، بدءًا من السؤال الضروريّ: لماذا نكتب؟!
لكنّ المنفى كان جزءًا من المأساة التي ساهمت بانخفاضِ الصّوتِ وهدوء النبرْ، سيّما وأنّ أحدَ ركائزِ الكتابةِ الثلاث، المتلقّي (الأوروبي هنا)، لم تعد لديه القدرة، أو الرّغبة ذاتها، بتلقّي نصوصٍ مشحونةٍ بالألم نفسه الذي عايشهُ في إنتاجات الكتّاب منذُ الـ2011. المتلقّي يبحثُ عن آلامٍ كثيرة عادةً، لا عن ألم وحيد طوال حياته! ونظرتُهُ إلى أناسٍ ثائرينَ أخذت شكلًا آخرَ، إن لم نقل إنها تبدّلت كليًا، فالشعبُ الذي كان ضحيّة الديكتاتورية، باتَ يعيشُ وإيّاهُ على الأرضِ ذاتِها، ومعيارُ التعاملِ معهُ باتَ مقتصرًا، أو يكاد، على إقراره الضريبيّ نهاية العام.
ساهمَ كلّ هذا في عزلةِ الكتّابِ المنفيين، وانقطاعِ النفس الاحتفاليّ، والثوريّ في نصوصهم. وباتَت الكتابةُ أقربَ إلى فعلٍ نوستالجيّ، أو ذي مؤدّىً نوستالجيّ على وجه الدقّة.
مرحلةٌ جديدةٌ في الكتابةِ السوريّة الحديثة، قد يجيزُ لنا وصولنا إلى العام 2018 أن نسمّيها مرحلةَ الهزيمة، إذ نحنُ على أعتابِ الذكرى السابعة على انطلاقةِ الانتفاضة السوريّة. تبدّلت الأحوال والأماكنُ والزمنُ، ولم يتبدّل سالبُ الفضاء العام ومُحتكِرُ القول. لم يتبدّلِ الموتُ أيضًا. وإذا اتخذتِ الكتابةُ طابعًا جديدًا، ربما، هدأَ هياجُها وانفعالُها خلالها، ونحت منحىً جديدًا بالرجوعِ إلى المشاعرِ الأصيلة، والرغباتِ والاحتياجات الأولى في النفس البشرية، أعادت الكتّابَ إلى الجوهر، بعيدًا عن المكتسب والطارئ، فإنما بسببِ تلك الهزيمة.
والهزيمةُ شعورٌ مريرٌ حتمًا، لكنّهُ شعورٌ بنّاء. حيثُ يجدُ المرءُ نفسهُ وحيدًا، عاريًا من الأسمال، أعزل. مجرّدًا من سلاحٍ ساهمَ فرحُ الكرنفالِ وصدمتُهُ بوضعهِ موضعَ الأصيل. الهزيمةُ جعلت الكتّاب مجرّدينَ مما هو وهميٌ، وأكّدت لهم أنّ السرابَ ليسَ ماءً، وأنّ الصحراء أكبر من الامتداد المرئيّ للرمال، وليس من سبيلٍ للنجاةِ سوى التفكّرِ في اللحظة، في عطشِها، وإمكانيّةِ النجاةِ منها، والمضيّ إلى لحظةٍ أخرى. وإذا كان من موتٍ، فلا يُكلّفُ الأمرُ، إذا اشتدّ الكربُ، سوى وصيّة صغيرة، بأن يُدفنَ المرءُ في بلادهِ إذا رغب.
يبقى أنّ المكسبَ الأكبر للكتابِ السوريين بعد الـ 2011، وهو ما قد يميّزهم، إن أحسنوا استثمارهُ، أنّ القيم التي باتت أرضيّةً يستطيعونَ بناء كلّ إنتاجاتهم على أساسها، هي الحريّة والعدالة والمساواة. إضافةً للتعبير المباشرِ الخالي من التهويمات والعبث اللغويّ والترميزِ الذي لم يكن يفهمه في مرّاتٍ كثيرةٍ سوى كاتبهُ نفسهُ، إنْ فعل!
هُزمت الثورة، وهُزمَ الإنسانُ السوريّ سواءٌ كان كاتبًا أم لم يكن. غيرَ أنّهُ باتَ قادرًا على قولِ ذلك بوضوح، وقادرًا على التعبير عن ألمهِ وهزيمته، بعد عقودٍ طويلةٍ حقّرت الديكتاتورياتُ خلالها الألم الفردي إزاءَ آلامِ الأمّة، امتدادًا لسياقٍ طويلٍ جدًا خبرهُ الكتّابُ العرب، لم يبتدئ ربّما بـ لا «صوت يعلو فوق صوت المعركة»، ولكنّ نهايتَهُ باتت ضروريّةً أكثر من أيّ وقت، وقد بدأت تباشيرُها بالظهور.