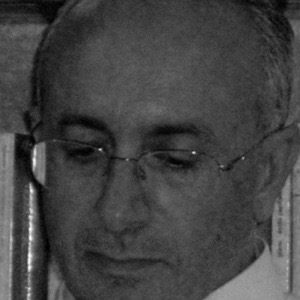كالفيلسوف الفرنسي “ميشيل فوكو”، لن نقوم هنا بالبحث عن “المعنى” الكامن وراء التعبير السياسي الذي يُعبّر عنه البيان والشعار السياسي وإنما سنقومُ بالبحثِ عن شروط إنتاج وتَشكُلِ هذا التعبير التقريري المُؤكِد والمُقررُ لموقفٍ ما (statement) أو المُعلِنُ عن (énoncé) هذا الموقف أو ذاك أو هذا “الفعل” أو ذاك. وقائع النكبة والاقتلاع والتهجير التي صاحبت قيام “دولة إسرائيل” على أنقاض فلسطين كانت بمثابة الشروط التي أُنتِجَت من خلالها شعارات التحرير والعودة كشعارات برامجية لحركة تحرر وتحرير وطني. وهذه الوقائع وقبل أن تُتَرجم سياسياً وعسكرياً، كانت تُعبّر عن مُعاش انثروبولوجي جمعي من المعاناة والألم وسيادة مشاعر الضياع والفقد والغربة. التسييس اللاحق لهذه الخبرات الجماعية الصادمة للوعي الفردي والجماعي كان محاولةً للتسامي عن آثار “ما-بعد الصدمة” للارتقاءِ نحو مصافٍ تجاوزي لها بهدف “الصمود” أمام أهوالها. هنا، كان شعار “التحرير” وشعار “العودة” مفاتيح الصمود وإذكاء الفعل المقاوم وعدم التسليم بالهزيمة أو ما يمكن أن نسميه بلغة علم النفس بفعلٍ هادِف لتجاوز آثار الصدمة” كمقدمة للنهوض من جديد (resilience).
تشكيل المنظمات الفدائية المُبَكِر كـ”شباب الثأر” و”أبطال العودة” و”فتح” لاحقاً اندرجَ في شروط “النكبة” ومُستتبعاتها وهذه الشروط لم تُنتج خطاباً حول “الدولة”. منظمة “فتح” ورغم رفعها مُبكراً لشعارات “الكيانية الفلسطينية” لم ترفع شعاراً نضالياً نحو “الدولة” ولم تغادر بذلك دورها كـ”حركة تحرير وطني فلسطيني” منذ خمسينات القرن العشرين وصولاً لـ”برنامج النقاط العشر” لعام 1974.
تحول “فتح” اللاحق في بحثها عن “الدولة” بأي ثمن، كان بداية الانزلاق نحو “حل الدولتين” التصفوي للقضية الوطنية وخروجاً من دورها التاريخي كقائدةٍ لحركة تحرير وطني فلسطيني.
الدولة الديمقراطية والعلمانية
برزت قضية الدولة الفلسطينية الديمقراطية والعلمانية قبل قيام دولة إسرائيل وقبل النكبة وقد حضرَ الطرح العلماني في فلسطين كحل للصراع الفلسطيني الصهيوني منذ الثلاثينات والأربعينات من القرن المنصرم عندما قدمت “عصبة التحرر الوطني” الفلسطينية شعار الدولة الديمقراطية العلمانية كبديل للمشروع الصهيوني الداعي إلى قيام دولة يهودية خالصة على كامل التراب الفلسطيني.
ولقد أُعيدَ التأكيد على هذا الشعار في السبعينات من القرن الماضي كهدف مركزي النضال الفلسطيني وصولاً لعام ١٩٧٤ حيث افتتحَ “برنامج النقاط العشر” سابق الذكر حقبة جديدة في التاريخ الفلسطيني، حقبةً انحرف فيها النضال الفلسطيني عن أهدافه الوطنية محط الإجماع الفلسطيني العام، ممهداً الطريق بذلك لتبني “حل الدولتين” اللاحق وللانخراط في “اتفاقيات أوسلو” والمفاوضات المارثونية والعبثية التي أعقبتها، والتي تواصلت منذ ١٩٩٣ حتى “صفقة القرن” الترامبية.
سلسلة هذه التطورات الدراماتيكية في مسيرة النضال الفلسطيني أدت الى تشويه الوعي الوطني الفلسطيني وبدايةً لخلق تعارضات ما بين مصالح المكونات المركزية للشعب الفلسطيني وذلك بفصل فلسطينيي الضفة وغزة عن جموع اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن إضافة الى التخلي العلني عن فلسطينيي ١٩٤٨ واعتبارهم خارج الدائرة الفلسطينية تمهيداً للمزيد من ترسيخ أسرلتهم.
التخلي العملي عن المطالبة بحق العودة والاعتراف بشرعية الدولة الصهيونية وبصحة روايتها كان من شأنه دق أولى المسامير في نعش القضية الوطنية المعاصرة ولم تكن سياسات “ترامب” سوى كشفٍ عن المستور من سياسات التراجع لحركة التحرر الوطني الفلسطيني وتعلقها بأوهام الحل عبر التفاوض المؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على ٢٢% من فلسطين التاريخية.
انكشاف حقيقة الأوهام بخصوص “حل الدولتين” وما خلفه من توسيع للاستيطان والى المزيد من اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أدى الى عودة قوية للطرح الديمقراطي والعلماني على المشهد الفلسطيني ولم يكن بروز العديد من التيارات والتجمعات الملتفة حول شعار “الدولة الديمقراطية الواحدة” إلا التعبير الأوفى عن عودة الروح الى الطرح الديمقراطي والعلماني الأصيل والمتأصل في الفكر السياسي الفلسطيني والذي واكب في الماضي الما-قبل-أوسلو لحركة وطنية نابضة بالحياة ورافضة للاستسلام أو للتخلي عن أهداف العودة والتحرير.
بالطبع، تنوعت هذه التيارات وتراوحت طروحاتها ما بين “دولة ديمقراطية واحدة” و”دولة ديمقراطية علمانية واحدة” إضافة الى منوعات أخرى كـ”دولتين لشعبين في فضاء واحد” وصولاً لطروحات هامشية لِدولة “كونفدرالية فلسطينية-إسرائيلية” و”دولة واحدة ثنائية القومية”… إلخ.
ما يمكن أن نلاحظه في هذا السياق هو أن هناك قاسماً مشتركاً أعظم يجمع ما بين هذه الطروحات المتنوعة ألا وهو البروز الحاد لشعار “الدولة” وكأنه ولعٌ وتعلقٌ استحواذي يزيح ما عداه من القضايا التي تراجعت إلى الظل بسبب طغيان هذا المعطى “الدولتي” المبالغٌ بأهميته. التركيز على قضية “الدولة” لم يولِ أي أهمية لتعميق البحث والتحليل لتركيبتها السياسية ولنظامها الديمقراطي ولبرامجها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعلاقاتها بقضايا الحداثة والعلمانية. الاكتفاء بإطلاق شعار “الدولة الواحدة” دون مواكبة هذا الطرح ببطارية ثقيلة من الفكر السياسي والتحليل النقدي المتبصر لمعرفة ماهية هذه الدولة وجوهر أنساقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية كان يحملُ تقصيراً ونقصا فادحاً، فنعم للدولة الواحدة، ولكن ما هي هذه الدولة بالضبط؟ سؤال لا يزال معلقاً ولم يلقَ إجابات شافية.
“الدولة” كولع استحواذي
إطلاق مقولة “الدولة الواحدة” كفكرة عامة وتعميمية (generic) بغياب عمل فكري دؤوب حول القضايا السياسية وحول الأبعاد الفكرية وحول الاستحقاقات الاجتماعية المترتبة على تبنيها، يلغي موضوعياً دورها التعبوي كشعار سياسي ويفقدها قدرة التحفيز للنقاش النقدي البنّاء كرادف للفكر وللممارسة السياسية. هذا الغياب للنقاش المعمق بخصوص الدولة الواحدة المستقبلية يجعل من هذا الشعار معطىً رخواً وهلامياً وضعيف الدلالة السياسية والفكرية والاجتماعية فالمعنى “السائب”، “العمومي” غير مضبوط المعنى والدلالة لن يكون فقط ضعيف المردودية السياسية بل وثغرةً تسمح للقوى المحافظة بنقضه وتشويه معانيه وتحميلها ما لا يحتمل.
في الواقع، قد يكون غياب التناول التفصيلي لأبعاد الدولة الواحدة مرتبطاً أيضاً بشكل مقصود “بغاية في نفس يعقوب” من قِبَلِ بعض دعاة هذا التيار إما لِمحافظة عميقة كامنة لديهم وذلك لكيلا نضطر لنقاشٍ قد يُؤرق “مقدسات” اجتماعية محافظة في أعماق وعيهم و/أو تلبيةً لانتهازية سياسية تقوم على مبدأ “التقية” لكيلا “تُثارٌ قضاياً خلافية جانبية” قد تُعكرَ صفو الالتفاف على شعار الدولة الواحدة.
وهكذا، أعادت تيارات “الدولة الواحدة” فكرة “الدولة” كفكرة ثابتة ومقدسة لدرجة تطفح فيها على ما عداها من عناصر ووقائع ملموسة شديدة الارتباط بها لكي تُلغِيها وقد سبق وأن شاهدنا هذه الظاهرة الاستحواذيه في “حل الدولتين” إذ كان هاجس “الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس” بمثابة فكرة تسلطت على الوعي السياسي بقوة جاعلةً منه في حالة انشغالٍ وعمىً عن رؤية الحقائق الأخرى وخصوصاً تلك التغيرات التي أحدثها الاستعمار الاستيطاني الإحلالي على أرض الواقع مُقلصا نسبة الـ22% المُخصصة نظرياً لقيام الدولة إلى مالا يزيد عن حوالي 10% .
هنا، وكي لا تقع تيارات الدولة الواحدة في مطب الولع “المرضي” بـ”الدولة الواحدة” كقدس الأقداس، وكي لا تكرر سقوط النظام السياسي الرسمي الفلسطيني في وحل تقديس “الدولة” والذي فرضَ تضحيةً بالقضية وبالشعب وبالأرض، لا بد من إيلاء براديغمات موازية لقضية “الدولة” أهميتها ومركزيتها هي الأخرى وذلك للحيلولة دون السقوط في هوس الاستغراق بقضية واحدة على حساب نقاش القضايا الرديفة بل وبالأحرى واجبة النقاش السابق وليس اللاحق لنقاش “الدولة”.
هيمنة نقاش “الدولة” وخفوت نقاش “التحرير” أو “وضع الحصان خلف العربة”
قبل الخوض في النقاش الضروري والمعمق لماهية نظام الدولة الديمقراطية وأشكاله ومنوعاته وأصنافه (تمثيلي-برلماني -نيابي، مباشر، شبه مباشر، ليبرالي، اشتراكي، تشاركي John Dewy، الخ) وقبل الخوض في إشكالات واشتراطات علمانية النظم الديمقراطية بتمفصلهما الوثيق إذ ليس هناك من ديمقراطية حقة دون أن يواكبها نظام اجتماعي وقانوني علماني وضعي. هناك عددٌ من القضايا السياسية الواجب نقاشها بهدف صياغة فكر سياسي ونظرية سياسية حول الدولة المنشودة. أولى هذه القضايا وأكثرها أهمية هو تغييبٍ مُتعمّد لمبدأ “التحرير”، تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني كمقدمةٍ ضرورية لتحقيق “حق العودة” إذ بدا هذا الهدف الشرعي “العتيق”، ورغم طابعه التأسيسي للوعي الفلسطيني الجمعي المعاصر حجر عثرة للحديث عن الدولة الواحدة. كيف تحولَ هذا الشعار التأسيسي إلى شعار ماضوي عفا عليه الدهر ولم يعد صالحاً كما كان عليه الحال في حقب ماضية؟ لماذا نخجلُ من طرحه كضرورة سابقة لقيام الدولة الواحدة؟ وكيف تحول إلى رديفٍ للسذاجة أحياناً وللتحجر “الأيديولوجي” أحياناً أخرى وكأن شعارات الماضي هي شعارات بدائية، بمعنى “التخلف” المرافق للوصف بالبدائية كما علمتنا إياه مدارس الاستشراق الغربية.
هل يستدعي هذا الشعار مخاوف انفضاض العدد الضئيل من أنصارنا اليهود ممن تخلص من الطرح الصهيوني بدرجات متفاوتة؟ فبدلاً من تعميق النقاش حول الطابع الأخلاقي الرفيع لدولة واحدة علمانية وديمقراطية تحفظ حقوق التجمع اليهودي في فلسطين المستقبل بعد تفكيك الكيان الصهيوني العنصري، نقوم بالاستبعاد 'الإرادي” لشعار فلسطيني أصيل ومشروع كي لا نثير مخاوف هذه الأقلية الشجاعة من اليهود اللاصهاينة.
ياسر عرفات هو أول من ضحى بشعار التحرير بعد إعلانه دون استشارة شعبه عن إلغاء “الميثاق الوطني” الفلسطيني المتضمن مبدأ تحرير فلسطين وذلك رضوخاً للموقف الأميركي-الأوروبي-الرسمي العربي وخضوعاً طوعياً لهذا الابتزاز الوقح، فهل يقوم أنصار الدولة الواحدة باستبعاد مبدأ التحرير لكيلا يسببون خدوشاً معنوية لأنصار يهود حديثي العهد لما-بعد الصهيونية؟ عرفات، ضحّى بمبدأ التحرير أملاً بثمن بخس: إقناع الدولة الصهيونية العميقة بقبول “حل الدولتين” فهل يتكرر هذا الخطأ التاريخي هذه المرة باسم حل “الدولة الواحدة”؟
“عرفات” صرح بالفرنسية وبكلمة واحدة (يبدو أنه حفظها عن ظهر قلب) بأن “الميثاق الوطني” Caduque، مُنقضي، مُتساقط، عفى عليه الزمن ولكنه لم يحصل على دويلته القزمة التي ضحى بفلسطين وبقضيتها وبشعبها كثمن للحصول عليها لولعه الهاجسي الاستحواذي القديم ببناء “دولة”. إلغاء المادة 21 من الميثاق الوطني الفلسطيني (1968) والمادة 12 من “الميثاق القومي الفلسطيني”(1964) لم يخضع لاستفتاء شعبي فلسطيني. لقد جرى إسقاط قضية تحرير فلسطين كخطوة نحو تفكيك الكيان العنصري الصهيوني من خلف الأبواب المُغلقة لمفاوضات سرية لم يطلع عليها إلا الحاشية المُقربة من مركز القرار العرفاتي.
ضمن هذا السياق، إعادة الاعتبار إلى براديغم التحرير كنموذج لشعار توحيدي للكل الفلسطيني لارتباطه المباشر بتطبيق حق العودة اللاحقة للتحرير وتفكيك الدولة الصهيونية، هو مهمة عاجلة تقع على عاتق دُعاة “الدولة الواحدة”، مهمةٌ متمايزة بحق عن دُعاة “حل الدولتين” واللذين أسقطوا هذا الشعار من جداول أعمالهم.
تحرير فلسطين وتحرير الفلسطيني من تشرده في بقاع الأرض دون هوية وإتاحة المجال له للعودة إلى أرضه وأرض أجداده لكي يعيش بسلام ومساواة مع من سلبه حقوقه وشرده من دياره هو جوهر العيش المشترك في ظل دولة ديمقراطية علمانية. دولة تُحِقّ الحقوق بإعادتها للجموع اللاجئة ولأجيالها اللاحقة إلى قراها ومدنها وتعويضها عما خسرته مادياً وتعويضها عن حجم المعاناة التي تعرضت لها هي وأبناؤها منذ النكبة.
وهكذا، لا بد من ترتيب بديهيات الخطاب الفلسطيني في “الدولة الواحدة” وذلك بإبراز أولوية تحرير فلسطين وتفكيك الدولة الصهيونية كهدف استراتيجي للنضال وذلك لكي نضع الحصان أمام العربة لا خلفها.