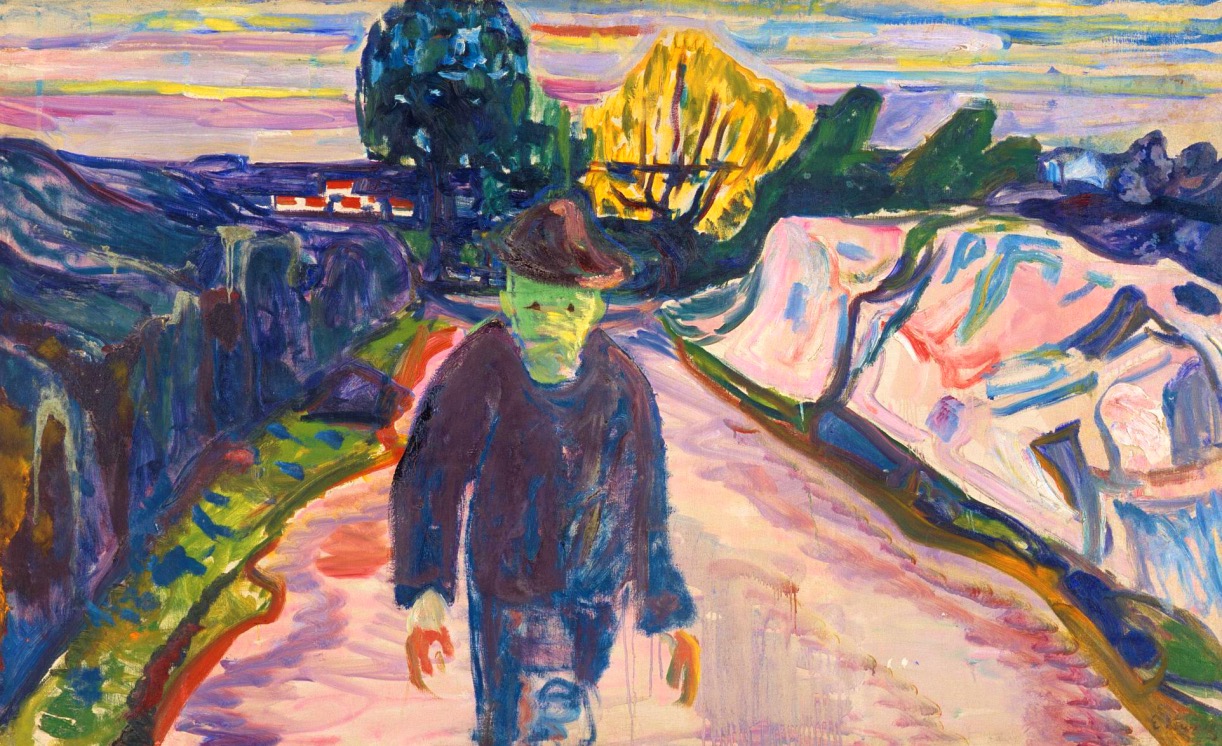يحاول هذا المقال الإجابة عن سؤال “لماذا الإجرام؟” من وجهة نظر سايكولوجية مُستوحاة من رسالة “لماذا الحرب؟” للمحلّل النّفسي سيغموند فرويد. وبالنّظر إلى الوضع الخاص في الدّاخل الفلسطيني (أراضي ٤٨) أُخِذَ بعين الاعتبار العوامل النّفسية والاجتماعية التي ساهمت في خلق حالة مقلقة من السّلوك الانحرافي الّذي “عجزت” عنه مؤسّسات الحكومة.
في رسالة فرويد الجوابية إلى آينشتاين “لماذا الحرب؟” (١٩٣٣) يسهب بدايّةً بشرح متعاقب عن علاقة القانون والعنف وتاريخ توالدهما الطّبيعي منذ النّشأة البدائية للفرد والجماعة نهايّة بالحضارة. ثم يتطرّق بعدها إلى الدّوافع الغرائزية التي تتحكّم بالفرد وتُفضي إلى معادلة تبرّر فيها نزوعه -الطّبيعي- إلى الحرب. فهو يقسّم الدوّافع الغريزية إلى فئتين حصرًا: الغرائز الإيروسية وهي دوافع الحياة، والغرائز العدوانية وهي دوافع الموت. ويؤكد معلّلا أن كِلا الدّافعين ضروريّان، بل ولا يمكن لدافع واحد أن يتحقق دون الآخر، فالدّافع الغريزي نحو الحياة يحتاج قدرا من العدوانية ليضمنه. ويُكمل من هنا اهتمامه بالدافع العدواني؛ وهو التّدميري أيضًا، ويؤكّد أنّ تحوّل هذا الدّافع نحو الخارج to the object، أي أن يكون مُنصبًّا نحو موضوع ما، يجعل حاجة الكائن الحيّ في الحفاظ على حياته الخاصّة مرهونة بتدمير حياة الغير. كأنّما يبدو أن للإنسان عذرا بيولوجيا يبرّر انحرافاته الخطِرة. إلّا أنّ هذه الميتولوجيا لا تعطي شرعيةً بقدر ما تبيّن حقيقة استحالة اجتثاث نوازع العدوان عند البشر. (1)
أمّا الإجرام في تعريفه فهو فعل ينتهك القانون، ويمثّل تهديدًا للمجتمع والنّظام الاجتماعي.(2) يحوي الإجرام أنواعًا مختلفة من السّلوكيات المنحرفة، ولكّن الجرائم الأكثر خطورة تحوي العنف والعدوان، وبغض النّظر عن أسباب وعوامل انخراط الفرد في الجريمة، إلّا أنّ الأفعال الإجرامية تصبّ في مصالح المجرم، وإنّ هذه المصالح مدفوعة من غرائزه الطبيعية أوّلًا وآخرًا، فما العمل إذًا؟
يرى فرويد أن لا جدوى، ولا يمكن اقتلاع دوافع العدوان وإنّما يجدر السّعي نحو تغيّير مسارها بحيث لا تكون موجّهة نحو الدّمار والحرب، وإنما أن نحاول توجيهها نحو الحبّ، وهو الدّافع المناقض للعدوان. ويوضّح فرويد شكلين من تحقيق هذا الدّافع، أوّلهما بالحبّ كما معناه المجرّد دون أن يكون بالضّرورة ذا هدف جنسي. والآخر بالتّماهي (Identification) الذي يوثق روابط الجماعة ويساهم بشكل أساسي في بناء المجتمع الإنساني. ويضيف أيضًا الحاجة إلى تنشأة قادة حقيقيين من نُخب المجتمع الذين يتمتّعون بتفكير مستقل، يناضلون من أجل الحقيقة ولا يخضعون للتّرهيب، أولئك تكمن الحاجة إلى حضورهم التّمثيلي لإرادة الشّعب أمام إرادات القوى السيّاسيّة التي تستغل السلطة.
بالإضافة إلى الحلول الطوباوية كما أسماها (خياليّة)، يقترح فرويد تقبّل الحرب كواحدة من ضروريّات الحياة المؤلمة. مكرّرا بذلك نزوعها الطّبيعي واستحالة نزعها. بالطّبع تبدو هذه الواقعة ذات تفارق أمام قدرة البشر على التّقدّم في السّلاح وآليات الحرب مقارنةً بتخلّفهم عن أيّ اتّفاق جماعي لحظرها.
ينهي فرويد رسالته بأمل طوباوي أخير يأمل فيه أن يصير باقي الناس مسالمين، هؤلاء الذين يشكّلون رمزًا من رموز التّقدم الحضاري الذي آل إلى حياة أفضل بفضل تطوّرات سيروراته جميعها من أفضلها إلى أسوأها. كذلك كانت التّعديلات النّفسية مصاحبة لهذا المسار التّطوري، فأصبح الإنسان الحضاري قادرًا على إعمال عقله مقابل غرائزه وردّ نازعه العدواني داخلا. لذلك تكون الحرب وضعًا مناقضًا منبوذًا لِما وصلنا إليه اليوم من تعديلات نفسيّة فرضتها السيرورة الثقافية، فلا يمكن للمسالمين إلّا أن يسخطوا على حالة الحرب ويمقتوها. وعلى الرّغم من أنّه ما من سبيل لضمان أمن المستقبل، إلّا إنّ كل ما يمكن أن يدعم تطوّر الثقافة ينقض الحرب.
وهل هناك ما ينقض الإجرام؟
في العلاقة التي يشرح فيها فرويد عن علاقة القانون بالعنف، يغيب عنه السّؤال عن علاقة غياب القانون بالعنف؟ فإذا نشأ القانون عن حاجة الجماعة لمنع عنف الفرد، فكيّف يعلّل سطوة الجريمة في ظّل وجود القانون؟ إنّ وجود قانون عاجز عن تطبيق قانونه هو حقيقة غيابه، أو هو حضوره الغائب، أيّ عدم تطبيق القانون، أو تطبيقه جزئيا وفق المصالح السياسية. والواقع الإسرائيلي حافل بتاريخه المنحطّ في تعامله مع قضايا الإجرام في المجتمع العربي. في حين أنّ الجميع يعلم هويّة الفاعلين، إلّا أن هنالك جهة واحدة فقط لا تعرف من هو المجرم ولا تقبض عليه، وللمفارقة، هي الجهة الوحيدة القادرة والمخوّلة على فعل ذلك. إنّ الجهود المبذولة والتي ستُبذل لمكافحة الجريمة هي وحدها شعارات مبتذلة ومواساة رديئة تشبه خيال الشّعارات الانتخابية في رداءتها فلا تُساهم في أيّ حلّ والحال أنّها تضفي شعورًا بالعجز والانهزام يُبَث عميقًا في صدور المواطنين ضاربة آمالهم عرض الحائط.
لقد حثّ فرويد على السّعي إلى تغيير مسار الدّافع التّدميري نحو مسار الدّافع الإيروسي. والحال أنّ الدّافع التّدميري عند الإنسان المجرم في المجتمع العربي في الدّاخل ينكص باستمرار نحو مساره العدواني. بل إنّ أيّ تغيّير عن هذا المسار يُقابَل بالصدّ أو يصل إلى طُرق مسدودة تعيده أدراجه. فمثلا في حالة المجرم، نرى أنّه لا ينال عقابه الحقّ، بل ويسهل النّفاذ من العقاب فترى مجرما يُخَفّف عنه بعدد السنوات أو يعاقب على جريمة بدل الأخرى كالتسبّب بالقتل بدل القتل. وإنّ وجود المجرم بالسّجن لا يغيّر واقعًا، إنّه قد يخرج من السجن مع رأس مال اجتماعي في عالم الإجرام ويعود للانخراط في هذا العالم.. وفي حالة المواطن، يصعب عليه التّعامل مع صعوبات الحياة في الدّولة من متطلّبات وغلاء معيشة وصعوبة في الزواج والحصول على ترخيص أو العمل بشهادته وغيره. فيصبح الانزلاق إلى عالم الجريمة أهون ما يكون.
إنّ أيّ مواطن عادي في الدّاخل الفلسطيني معرّضٌ لأحد الأمرين: الانزلاق إلى عالم الجريمة أو الأذيّة منّه. وفي حال استطاع المواطن العادي أن ينجو ويتقدم في حياته ومشاريعه، فإن لم تلاحقه الدّولة لاحقته مجدّدا رصاصة السوق السّوداء. يعيش المواطن العربي مُحتَلّا من الدّولة وخاضعا لحكومتها، ومحتَلّا من الإجرام، ومستَعبَدًا من ضغوطات الحياة، وفارًّا من كل هذا إلى الاستهلاك.
في كتاب “تحليل المشكلات الاجتماعية” (٢٠٢٠)، يصنّف مانيس المشكلات إلى فئات تعاقبيّة، فهوّ يركّز على أهميّة فهم المشكلة الأوليّة التي تؤدي إلى المشكلة الثانوية والثالثة. يوضّح أنّنا عادّة ما نسلّط الضّوء على المشكلة المطروحة كونها مشكلة أساسية دون العودة إلى منبعها، يعني محاولة تفكيكها، إذ إنّ تحليل المشكلة هو الجزء الأكبر من حلّها. إنّ مشكلةً كالفقر تؤدّي إلى ولادة مشكلات الأحياء المتخلّفة، والتهميش وسوء التّغذية، وكلّ مشكلة من تلك تؤدي أيضًا إلى مشكلات كالجناية والتعّاطي، والتّخلف العقلي، واللامبالاة، وغيرهم. كذلك مشكلة العنصريّة تؤدي إلى كلّ من العزل العرقي والتميّيز العنصري والصراع، وبدورهم يؤدّون إلى الاغتراب وكذلك العمل في مهن أدنى، البطالة، السّرقة الخوف وجرائم العنف. ولا ننسى مشكلة الحرب التي تؤدي إلى حالات الموت والأضرار المختلفة، وكل واحدة تقود بالضّرورة إلى فقد في الموارد البشرية وانخفاض في الإنتاجيّة وازدياد الاستهلاكية وغلاء العيش.(3)
والمجتمع العربي في الدّاخل الفلسطيني يعاني من تراكمات هائلة من المشكلات الأوّلية والثّانويّة والثالثة، تؤدّي هذه التّراكمات إلى التّغلغل في الواقع دون حلّ لها، فلا نلبث نستيقظ حتّى نجد أنفسنا منصاعين عاجزين أمام واقع الجريمة زائد النفوذ والنّفاذ. فالإجرام ليس مشكلة أوّلية، بل إنّه نِتاج مشكلات متعاقبة آل تواترها إلى الشّكل الفظيع من هذا الفعل الشنيع. وإنّ دوافع العدوان ليست بمشكلة، ولكنّ انحرافها الحادّ وحضورها الطّاغي في صورتها الجماعية على شكل جريمة منظّمة يشكّل تهديدًا وخطرًا على حياة النّاس، وهذه مشكلة حقيقية تُحتّم الدّعوة الطّارئة لإيجاد حلّ أو طريقة لفهم ما يحدث.
إنّ الدّوافع التّدميرية في حالة فلسطينيي الدّاخل مشحونة بعوامّل خارجيّة أساسيّة كالسّياسيّة والاجتماعيّة، وإنّها بالطّبع موجّهة نحو أبناء المجتمع الواحد، فنرى مثلا حالات الشّجار على مصفّ السيارات، قطعة أرض، متر عن سور الجار واختناق في شقق السّكن واكتظاظ في المدن والقرى بسبب عدم وجود تراخيص بناء أو غلاء سعر الأراضي وسواها من الأزمات التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الفجوات المهولة مقارنةً مع المواطن اليهودي. إنّ ما يزرعه الواقع الظّالم من أذى يجّند عند الفرد العربي آليات دفاعية بدائية تزيد من تفاقم أزماته وأزمات مجتمعه.
من المهمّ الإشارة أنّ كل واحدة من المشكلات المختلفة، فرديًة كانت أم جماعيّة، تنصّب جميعها في القالب النّفسي وتولّد كمًّا من الأزمات والمشاعر السّلبية. بذلك يتعزّز شعور الفرد بالوحدّة أمام مؤسسات الدّولة وعنصريّتها بالطّبع، والعجز من الحصول على أيّة تسويّة عادلة. فلا يستبعد المواطن ملاذه الأخير في الّلجوء إلى استخدام العنف وحتّى القتل أو وهم الاستعانة “برحمة” عالم الإجرام. كأنّ الواقع العربي إمّا يقود إلى العنف أو الجريمة أو الاغتراب. إنّ هذا الواقع ليس نتاج دوافع تدميريّة عند مجموعة من الأفراد وحدّها، وإنّما عوامل بيئية ساهمت في خلق حالة الاضطّراب داخل الأفراد والجماعة معًا. وهذا لا يعطي شرعيّة لتفشّي العنف والجريمة وغيرها من السّلوكيات الانحرافية، ولكن يحتّم علينا التّروّي لفهم عُمق الدّافع التّدميري وصعوبة ترويضه في هذه المرحلّة بالذّات.
في حال عدم إدراك الفرد تأثُّر كُلٍّ من موقعه النّفسي والاجتماعي والسّياسي والجغرافي على تشكيل هويّته وصراعاته، فسيستمر بتفعيل آليات الدّفاع النّفسية ظانّا منه أنّه يساعد نفسه وذويه على التّعايش مع واقعه. فيتماهى العربي مع المُستَعمِر في كونه أدنى ولا يستحق الرّفاه في حياته، ويتماهى مع المجرم في كونه عاجزًا ومعرضًا للخطر في كلّ حين فيحتمي به منه، ثمَّ يتقهقر المجتمع وتتحوّل أنماط وسلوكيات الحياة عنده نحو المأوى والمَأكل والسّفر والصّور؛ فيصبح أكثر أبناء المجتمع العربي مجرّد أرقام في التّعداد السّكّاني ومستهلكين دائمين حتى وإن وصلوا إلى مناصب عُليا ومرَتَّبات قديرة.
بالنّسبة إلى إسرائيل، فإنَّ دولة قائمة في بُنيتها على الاستعمار، ليس في نظامها خطّة لحلّ الأزمات الأخرى التي لا تخدم مصالحها. لا منفعة تُجنى من مجتمع لا تفسده الجريمة، فالجريمة تهدم نظام المجتمع وتزعزع روابطه، فيتماهى أبناء المجتمع مع خوفهم ويرتدّون على أعقابهم. فبالطّبع الجريمة تمنع من بناء المجتمع والثقافة التي تبني الوعي وتسعى إلى تغيير النّظام وتحقيق العدّالة، وهذا لا يصبّ في مصلحة الدّولة. وكذلك كُلٌّ من غياب الديموقراطية وحضور العنّصرية وهيمنة الاستعمار، وتوالد البّنى النفّسية المُركّبة والمُتصادمة في تركيبها، يؤدي إلى خلق مجتمع عربي مقهور ومقموع ولامبالٍ ويائس وقليل حيلة ومصاحب لمشاعر الدّونية والعجز والإحباط. من المهمّ الذّكر أنَّ شعبًا يحمل في ماضيه أثر النّكبة ويعتاش على رحمة الاستعمار والإجرام لهو شعب يعيش داخل صدمة مستمرّة، يصعب على مجتمع كهذا أن ينشل نفسه بنفسه، بل إنّ تجنيد دوافع العدوان ستكون هي ملاذه الموهوم.
أمّا بالنّسبة إلى الحلول الطوباوية -الفرويديانيّة- في حالة الفلسطيني، فبالإضافة إلى ما اقترحه فرويد من تقبّل الدّوافع العدوانية، ثمّ محاولة تغيّير مسارها نحو الدافع الإيروسي عن طريق الحبّ والتمّاهي مع المجموعة. وأيضا، العمل على تربية القادة الحقيقيين وهنا يقصد العمل السّياسي، نهايةً بالعمل الجادّ على التّطوير الثّقافي الذي قد يكون في مقاليده مفاتيح النّجاة. نضيف: على الفلسطيني أن يحاول التّعرّف على دافع الحياة لديه، فإنّ سنوات الظّلم التي سادت منذ قيام إسرائيل تكاد تُلغي معرفتنا لذواتنا ودوافعنا. وعليه تجب معرفتنا لدوافعنا ومصدرها وفهم روايتنا وأثَرَها. إنّ تطبيق هذه الضّرورة تقع على عاتق الفرد ومجتمعه ومؤسساته الاجتماعية. وعلى الجانب الآخر يقف واجب الدّولة وضرورة فرضها للقانون والنّظام العادل. هناك حاجة طارئة لتدّخل جهاز الأمن والشّرطة وتجنيد المصادر المطلوبة للقضاء على الجريمة مثلما كان في حالات كثيرة، ونجحت فيها بسبب وجود جديّة في فعل ذلك. وعلى الدّولة أن تلتزم بتخصيص المساعدات والمساهمات في تطوير الخدمات الصّحيّة كالمراكز النّفسية ومؤسسات الإصلاح والرّعاية، وتخصيص ميزانيات لمشاريع توعويّة وتحصينيّة في المؤسسات الحكوميّة خاصّة التّعليميّة للتّعامل مع موضوع العنف والجريمة. من نافل القول، أنّ ما ذُكر أعلاه لن يُقدم لأحدٍ على طبقٍ من ذهب، لا سيّما وأنّنا أمام معادلة مُستعمِر ومُستعمَر، لكن لا مناص من خوضها.
هوامش:
-
جيروم مانيس، تحليل المشكلات الاجتماعيّة. (القاهرة: دار رؤية، ترجمة فتحي أبو العينين، 2020).
-
سيغموند فرويد، رسالة إلى أينشتاين لماذا الحرب؟ (1933).
-
Finckenauer, James O. “Problems of definition: what is organized crime?.” Trends in organized crime 8, no. 3 (2005): 63-83.