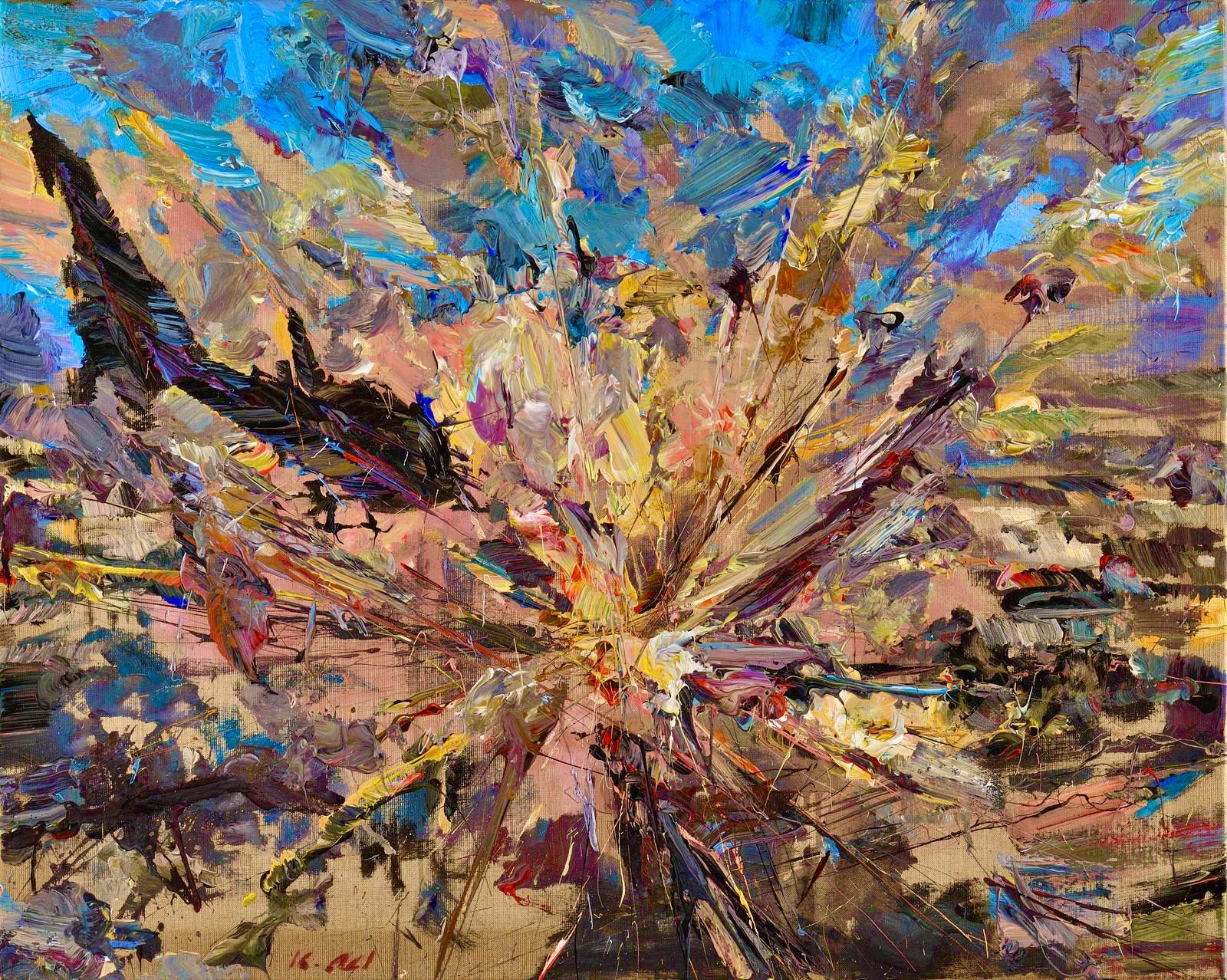يأتي الموت بفجاعته مباغتًا، مهما تحضّرنا له في اللاوعي واختبرنا حيواتنا كل يوم بما هي فقط اقتراب للموت، ولا شيء غير ذلك. يأتي خبر استشهاد نصر الله فاجعًا لنا جميعًا، وهو – نصر الله – الذي لطالما قدّم لنا نفسه شهيدًا ينتظر دوره، واردًا لما سبقه إليه ابنه، هادي، والمئات من شباب المجاهدين في الحزب معه.
لم تكن حياة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بسيطة أو مفهومة ضمنًا، لنتمكن من فهم موته -الآن- بيد إسرائيل، الدولة المذعورة والمهووسة بالحرب والقتل والحصار، وكأنه حدث حربي/ مواجهاتي فحسب. وليس ذلك لأن الموت والحياة بؤرٌ لمعنى الوجود الإنساني ككل فحسب، إنما لأن مسار وجود نصر الله ومسيرته بين هاتين البؤرتين كان انعكاسًا لتحوّلات هذه المنطقة من العالم وسكانها ومنظوماتهم القيمية، في هذا الزمان/ التاريخ والمكان/ الجغرافيا، الفارقين.
كيف نحدّق بالموت الفادح حولنا، وكل موت في هذه الحرب؟ سؤال لا يقلّ وطأة عن سؤال التحديقة بفداحة الإصرار على الحياة، وكل حياة في هذه الحرب! ولعلّ التحديقتين هما بالشيء نفسه، وخاصة إذا ما انطلقت التحديقة من غزة، التي أعادت تعريف جغرافيّاتنا وأشكال وجودنا جميعًا. ولو كان لنا أن نستفيض أكثر، لقلنا أن ما يمرّ به العالم الآن، وانطلاقًا من هذه الجغرافيّة، لهو مرحلة فاصلة في تكوين معارفنا وخبراتنا وتواريخنا وذواتنا، وأوّلها أشكال الوجود بين الحياة والموت.
ولنبدأ تمريننا في التحديقة بالموت، موت نصر الله، باعتباره موتًا لشيءٍ ما فينا جميعًا، ولتكن المقاربة جغرافيّة في بدايتها.
يأتي اغتيال نصر الله في لحظة فارقة من حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة -منذ النكبة وما قبلها- تجاه كل ما هو فلسطيني، وتحديدًا في غزة؛ فهو قائد جبهة الإسناد الشمالية للمقاومة الغزية، تلك الجبهة التي نجحت في إخلاء مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل من المستوطنين مدة 11 شهرًا حتى الآن، وهو ما لم تفعله جيوش العرب مجتمعة. وهو الأمر الذي عُدّ ضغطًا استراتيجيًا وحربيًا وسياسيًا قويًا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها، والأهم بنيتها التحتية وشبكة العلاقات الاجتماعية في المنظومة الاستعمارية.
وإذا ما وسّعنا العدسة الجغرافيّة قليلًا، لوجدنا أن موقع حزب الله الجغرافي في المواجهة على الحدود الشمالية يعمل بشكل تركيبي مع جبهة المقاومة العراقية، إلى الشرق، ما يعني مدًّا لخطوط المواجهة من الشمال إلى الشمال الشرقي، وإلى جهة الشرق، في جبهة تعيد لتعبير “دول الطوق” جزءًا من فاعليته النضالية (بعد ما أخرسته كامب ديفيد وأخواتها). وهو ما عدّته مراكز دراسات استراتيجية امتحانًا أساسيًا للبنية الدفاعية الإسرائيلية. إضافة إلى الأمر الأهم، وهو أنه يكشف شبكة التعاونات التطبيعية اللوجيستية في منطقة طبريا، وتحديدًا المجال الجوي.
يأتي هذا التعاضد بين الجبهة العراقية واللبنانية في لحظة استعمارية (وليست ما بعد استعمارية، كما قد يخالها البعض!) حداثية فارقة بشأن تكوينات حداثية أساسية ورثتها المنطقة ودولها من الدول الاستعمارية، من غير أن تمرّ بعملية نزع للكولونيالية كما يُفترض، ولا انتقال إلى “ما بعد”ها. لنجد مؤسسات الحداثة الدولانية الأساسية، مثل الجيوش القومية التي خلّفتها الدول الاستعمارية بعد تأسيس بنيتها، تؤدي دورًا استعماريًا متواطئ ضدّ شعوبها، لإدامة وضعها في شرط استعماري جديد (كما هو الحال في مصر)، أو لتمرّر تنازلات عن أجزاء من الإقليم القومي (كما هو الحال مع جزيرتي تيران وصنافير المصريتين)، أو أن تقتل شعبها بوسائل ذات تاريخ استعماري (كما هو الحال مع الجيش السوري)، أو أن تقوم بحروب بالوكالة، كما هو الحال في التدخلات في اليمن وليبيا والسودان. تلك كلها شواهد استعمارٍ لم يتوقّف يومًا.
هذا الموقع المقاوم لحزب الله على الجبهة الشمالية، الذي نجح في إخلاء مستوطنات الشمال في فلسطين المحتلة أشهرًا طويلة، وساهم في مراكمة الضغط على حكومة الاحتلال وقياداته الحربية، إسنادًا لغزة، إنما هو أمر ممتد من/ في النسيج الاجتماعي الأهلي المجتمعي اللبناني، إذ بدأ الحزب من خلال خدمات الطبابة والتعليم وحلقات التعلّم الديني وغيرها، بما لا ينفي عن تلك البنية الخدمية كونها جزءًا من مشروع إيراني يمتد في المنطقة، لنا أن نعارضه أو أن نتفق معه، لكن لا معنى لمواقفنا منه ومن غيره ما لم يكن لدينا، نحن العرب، مشروع خاص بنا، يبدأ بدوره من الاجتماعي والأهلي، أو اليومي المعيش. ولعلّ أولى عتبات تلك البداية هو المواطنة والديمقراطية، وهو ما يقود إلى مقاربتنا الثانية.
الجغرافيا الاجتماعية المتحركة
ارتفعت أصوات التشفّي من البعض تجاه اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلّا أن ذلك التشفّي هو تمثيل جليّ لبنية العلاقات والمواقع الاجتماعية وأزماتها، حتى مع كونه نابع من ألم الفقد والقتل والخيانة، ولتلك النوابع التقدير والاحترام. وخاصة أن دعم الحزب في مواجهة الاحتلال في هذه الحرب وما سبقها، لا علاقة له باختلاف سياسي وقيمي واضح في مواقف الحزب ونصر الله شخصيًا من الداخل اللبناني والأحداث في سورية، إذ اختار أن يصطفّ إلى جانب الدكتاتور وبراميله وجيشه! إلّا أن اختيار التشفّي والفرح باغتياله لا ينفصل عن مديح القاتل والقبول بإضعاف جبهة إسناد لغزة، ما يعني القبول بمزيد من الإيغال الإسرائيلي والأميركي والغربي في الدم الغزيّ، مقابل عاطفة تؤكّد موقعنا في منظومة القوى.
التشفّي هو سلوك دونيّ (بالمعنى الموقعي وليس الأخلاقي)، يصدر في الأغلب الأعمّ من الطرف الأضعف، أو الطرف المستثنى منزوع الفاعلية والمستَلَب من عمليات القوى والتغيير والتأثير في المجتمع. وهو الأمر المفهوم ضمنًا في حالة شعب يرزح تحت أعنف الأنظمة العربية وأكثرها توحّشًا ودموية؛ نظام بشار الأسد. والتشفّي، على العكس من السخرية التي تملك طاقة استعارية وخطابية قادرة على إنتاج فضاء أو ممارسة هيتروتوبية تخلخل المسافة بين يوتوبيا الأنظمة الدعائية، وديستوبيا الواقع الدوني المهزوم.
غير أن للتشفّي وجه آخر، لا يظهر إلّا إذا نظرنا بعدسة الثورات وقيمها إليه؛ فالتشفّي في موت الخصم، وبالذات بيد إسرائيل في حرب الإبادة هذه، هو ممارسة مضادة لكل قيمة سعت إليها الثورة السورية من انتصار على ادّعاء الممانعة والمقاومة، واشتباك واندغام مع راهن الشعوب العربية لحظة 2011؛ تلك الشعوب الواعية للترابط بين الأنظمة القمعية والشرط الاستعماري الإسرائيلي. وهي لحظة 2011 التي يقول عنها نتنياهو إنها كانت من الأخطر على دولته (من منّا ينسى تنادي جماهير الشباب الثوريّ للتوجّه إلى حدود دولة الاحتلال في عام 2012، من دول الطوق كلها: الأردن، وسورية، ولبنان، ومصر؟).
يتضادّ التشفّي مع قِيَم المواطنة وحرية التعبير والحقوق المواطنية الدولانية الديمقراطية التي طالبت بها شعوبنا العربية منذ عام 2011، وقوبلت بكل قباحات الدنيا. فالمتشفّي يقرّ بأن موت غريمه هو اقتصاص رمزي له هو، وعدالة تأتي من السماء، حين فشلت عدالات الأرض التي قد تأتي بها مؤسسات اجتماعية ومواطنية سعى إليها ذات يوم، وبذل في ذلك الغالي والنفيس.
التشفّي في موت نصر الله، لا ينفصل عن تراث طويل ممتد في الذاكرة العربية لخطابات الساداتية المصرية بشأن جدوى المقاومة، وكون “أوراق اللعبة كلها في يد أميركا”، كما كان يتخيّل السادات. التشفّي في موت نصر الله لا ينفصل عن تراث من الطائفية وخطابها السام الذي أسست له دول بعينها منذ سبعينيات القرن الماضي، مع طفرة البترول فيها، إذ حاربت فينا كل جميل قد يحويه الدين، وحوّلت الدين إلى قيود ومهاترات طقوسية لا معنى لها سوى إغلاق جميع النوافذ على الحياة ومعانيها.
كما أن التشفّي في موت نصر لله بيد إسرائيل لدى بعض متثاقفي اليمين القُطري والليبرالي في بعض الدول، مثل الأردن ومصر والسعودية (ليست مصادفة أن يكون لتلك الدول دور واضح تجاه أي خطاب مقاوم!)، إنما هو ممارسة مجبولة بإعادة إنتاج الخطاب الطائفي والاستعماري والطبقي والجندري، في أكثر استعاراته فجاجة. فنجد خطابًا يتغنّى بسجون الأمير الشاب، ويهاجم فلسطينيي الداخل متّهمًا إياهم بالخيانة (تلك إحدى أقدم أدبيات النظام الساداتي)، أو أن يستبطن خطابًا غزا الأكاديميا العربية الحكومية في العلوم السياسية بعد كامب ديفيد ووادي عربة، مفاده أن الفلسطينيين أينما حلّوا، إنما سعوا إلى القلائل والحروب في مجتمعاتهم المضيفة. كما نرى مجموعات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي (تنشأ في يوم وليلة بآلاف الأعضاء الوهميين)، تنادي باعتقال من يهتف لحزب الله أو لجبهة المقاومة في غزة ولبنان، باعتبار أنها تناصر من يسبّ الرسول وصحابته، وأنها استدعاء لحزب الله جديد في الأردن أو غيره، أو أنهم -الآن فقط- أصبحوا غيارى على حرمات السوريين وآلامهم، وهم نفسهم من نادى بإغلاق الحدود في وجه اللاجئين منذ سنوات، وما فتئوا يهاجمون اللجوء السوري في بلدانهم!
ولو وسّعنا الخريطة قليلًا، لنتأمل جغرافيا الحركة السورية في اللجوء، لوجدنا أن اللجوء السوري كان أحد أهم أسباب فضح خطاب الغرب وتعريته في مجال الحريات والحقوق والقيم والأخلاق، حتى قبل السابع من أكتوبر؛ فالدول التي تهاجم اللاجئين في عرض البحر لإغراقهم قبل احتجازهم في مراكز التحقيق، والدول التي تبرر لنفسها فصل الطفل عن والديه بحجة حمايته ممن عبروا به بحارًا ومحيطات ليحموه من المقتلة وبراميل الدكتاتور، ليسوا أهلًا للحديث عن الحرية والفضيلة والتقدّم، مهما كانت منابرهم مرتفعة!
لذا، فإن التغنّي والتبريك بعدالة الجيش الإسرائيلي في القصاص لضحايا نصر الله في سورية، إنما هو خيانة لقيم الثورة السورية كلها، تلك القيم التي فضحت تواطؤ العالم كله. وبالحديث عن العدالة والقصاص، فإن هذا التشفّي والفرح إنما يعكس جهالة تاريخية للبعض بالمنطقة وتاريخها، حتى على المدى القريب؛ إذ شتان بين العدالة والقصاص، فحينما أعدم الاحتلال الأميركي صدام حسين، لم يحقق ذلك العدالة لضحاياه الذين استُكمل تجويعهم وقتلهم وإبادتهم وإفقارهم ونهب مواردهم.
لا عدالة ولا قصاص يأتي من الغرب، أو كما أشار علينا مالك بن نبي: الغرب لا يحمل قيمه معه إلينا! يومًا ما سنقتصّ منهم جميعًا، حينها نكون نحن من وجب أن نكون.