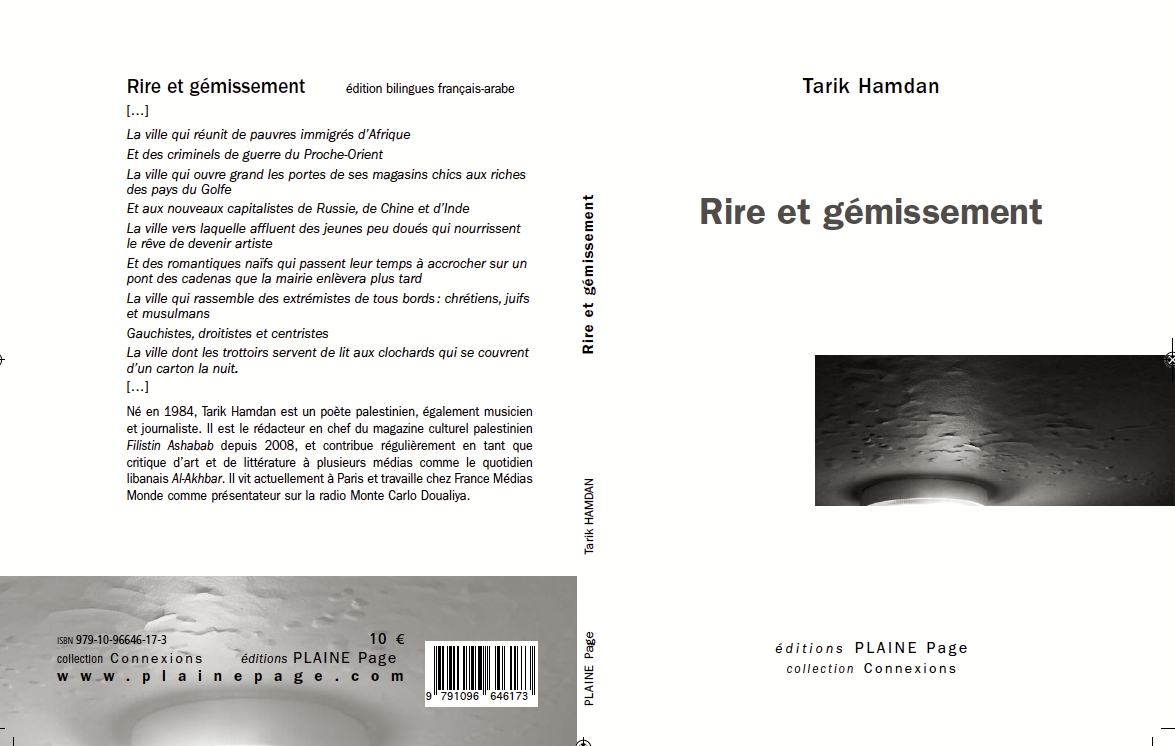يؤكّد الشاعر والإعلامي الفلسطيني طارق حمدان أنّ “العالم بأسره اليوم يعيش أدبياً في وقت الرواية”، وبالرغم من ذلك لا يتوانى عن شغفه بالشِعر بوصفه المعادل الوحيد للوجود. في رصيد ضيفنا، حتى الآن، مجموعتان شِعريتان، هما: “حين كنت حيواناً منوياً” (2011)، و”ضحك ونشيج” (2018)، عدا عن عشرات المقالات الأدبيّة والنقدية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات العربيّة.
يعمل طارق حمدان كمعد ومقدم برامج في إذاعة مونت كارلو الدوليّة، بالإضافة إلى عمله كمحرّر لمجلة “فلسطين الشباب” الثقافيّة الشِهريّة.
بالتزامن مع صدور مجموعته الشِعرية الجديدة، هنا حوارنا معه:
صدرت لك مؤخراً مجموعة شِعريّة جديدة حملت عنوان “ضحك ونشيج”، وقد أقمت حفل توقيعها في سوق الشِعر بباريس، كيف تنظر إلى واقع الشِعر عمومًا، وهل لاقت مجموعتك الحفاوة المرجوّة؟
واقع الشعر كواقع الحياة عماد، ما دامت موجودة فالشعر موجود، نجد الشعر أحياناً في الأماكن غير المعتادة، ومرات كثيرة نعثر عليه عند أناس لم يحترفوا كتابته، نجده في سوق الخضار، عند نادل بار أو مقهى، في جلسة عابرة مع أناس غرباء… الشعر هو انعكاس للوجود. أما إن أردت إجابة عن واقع الشعر المكتوب، ربما نجد في أوروبا اهتماماً أكثر بالأدب والإنتاج الثقافي بشكل عام، وهذا لا يعود لكون الأوروبيين خلقوا كذلك بالفطرة، بل بسبب عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى واجتماعية تتعلق بنوعية الحياة. أما عن الحفاوة التي استقبلت فيها مجموعتي الجديدة، بصراحة لا أعرف ما المقصود بالحفاوة، لست مشهوراً وهذا أمر جيد. أصدقاء أثق بآرائهم أحبوا المجموعة، وآخرون كتبوا عنها، ومجموعة من المهرجانات اهتمت بها. وهذا أكثر من كاف بالنسبة لي.
تعتبر باريس إحدى أهم العواصم الثقافيّة في العالم، كيف تنظر إلى حركة الثقافة العربيّة هناك، وتحديداً بعد موجة النزوح الأخيرة من بلدان عربيّة إلى أوروبا؟
باريس مدينة مفتوحة على العديد من الثقافات والاتجاهات، هذا التنوع هو ما صنع المجد الثقافي لهذه المدينة منذ قرن تقريباً، الكثير من الكتاب والموسيقيين والفنانين جاؤوا إلى باريس وساهموا في خلق الألق الثقافي الذي بلغ ذروته منتصف القرن الماضي، لتنحسر هذه الهالة الثقافية شيئا فشيئا، وتبرز مدن عالمية أخرى تؤدي الآن نفس الدور الذي قامت به باريس في الماضي، كبرلين مثلاً، هذا لم يمنع أن تظل باريس حتى الآن إحدى أهم مدن الثقافة في العالم. بخصوص “الحركة الثقافية” ليس هناك حركة ثقافية عربية في باريس، وأعني هنا حركة تخلق متابعين وتثير الرأي العام والإعلام… إلخ، هناك نشاط ثقافي عربي وأغلبه فردي، وإن قارنا هذا النشاط بنشاط ثقافات أخرى كاللاتينية أو الصينية، فسنجد أنه نشاط متواضع.
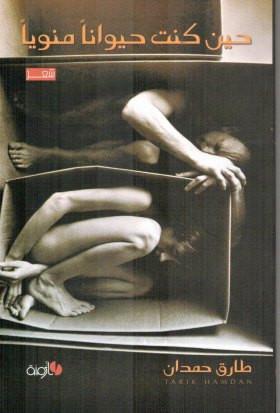
سبع سنوات بين مجموعتك الجديدة “ضحك ونشيج” (2018) ومجموعتك الأوّلى “حين كنت حيواناً منوياً” (2011)، لماذا كل هذا الزمن بين الإصدارين، هل بسبب رداءة التعامل من قبل الناشر العربي مع الكتب الشِعريّة أم هناك أسباب أخرى؟
خلال السنوات الماضية ومنها التي فصلت ما بين المجموعتين، عشت في ما لا يقل عن ست أو سبع مدن، ربما عدم الاستقرار الذي تمثل بتنقلي وسفري الدائم كان سبباً، من ناحية أخرى فإن حركة النشر في العالم العربي متخلفة بسبب الكثير من العوامل، على سبيل المثال، أرفض دفع مبلغ مالي لناشر مقابل إصدار كتاب أو مجموعة شعرية، وأعتبر هذا الأمر بمثابة إهانة للكاتب، أُفضل أن لا أنشر اطلاقاً على أن تنشر لي مجموعة شعرية مقابل مال! هذا من بين الأسباب طبعاً، بالإضافة إلى اهتمامات أخرى غير الشعر. بغياب القراء وخصوصاً القارئ العربي، ليس لدي هاجس نشر ولا أعتقد حتى بضرورته، كل ما يهمني امتلاك الأدوات المطلوبة للقول والتعبير سواء بالشعر أو بغيره.
في مجموعتك الجديدة تكتب قصيدة التفاصيل اليوميّة، القريبة من عالم المهمّشين، وهي برأي امتداد لتجربة القصيدة الشفويّة.
سؤالك يدفعني إلى التساؤل، ما هو عالم المهمشين؟ أخشى أن الأغلبية الساحقة لهذه المعمورة هي مهمشة، نحن في عالم يسحقه الحديد ورأس المال من ناحية، ويتأثر بمؤخرة كيم كاردشيان على “الانستغرام” أكثر من تأثره بأي كاتب أو مفكر يخطر ببالك. أكتب بدون خطط أو نية لكتابة نوع شعري معين، كل نص أكتبه ينطلق من تجربتي وتصوراتي الخاصة، أحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الموضة الشعرية التي قد تلقى صداً وترحاباً من جهات تعنى بهذه الموضة، وخصوصا شعر المآسي والنكبات التي تحيط بعالمنا العربي. لا أكتب كضحية بل كند لهذا العالم.
قصائد مجموعتك الجديدة تأتي في أقل من 40 صفحة، لماذا كل هذا “التقشّف”؟
النصوص التي نشرت في مجموعة “ضحك ونشيج” هي مختارات من مجموعة كبيرة من النصوص، اخترتها لأنها تغرف من نفس الإناء تقريبا، ولكونها تبدو متماسكة عند جمعها بين ضفتي كتاب، أنشر حسب الفرصة والمزاج، دار النشر أو المنبر، طبعاً هذه المجموعة الأولى التي تظهر باللغة الفرنسية، وهنا أشكر الصديق المترجم أنطوان جوكي الذي اهتم اهتماماً بالغاً بترجمة النصوص.

يرى بعضهم أن المبدع ناقد بالضرورة، انطلاقاً من نصّه مرورًا إلى نصوص الآخرين، كيف تنظر إلى هذه الظاهرة، خاصة وأنك كتبت ونشرت العديد من المقالات في هذا المجال؟
الشعر هو نقد بشكل من الأشكال، أنظر إلى النقد كعنصر أساسي لا يكتمل الإبداع بدونه أيا كان نوعه، وهنا لا أتكلم فقط عن الشعر، بل في المقال ومعظم الأعمال التي أقوم بها، أستعين دائما بعين الناقد، حتى خارج النطاق الإبداعي، في اختيار حبات التفاح، في الطبخ، في اختيار قميص أو في اختيار الأصدقاء… إلخ. النقد هو نمط حياة.
ثمّة ظاهرة لافتة في الوسط الإبداعي، وهي تحوّل العديد من الشعراء إلى عالم الرواية، كشاعر كيف تنظر إلى هذه الظاهرة، وما هي الأسباب التي تدفع الشاعر تحديدًا إلى كتابة الرواية؟
هناك عوامل كثيرة، في البداية يجب أن نعترف بأن العالم بأسره اليوم يعيش أدبياً في وقت الرواية، التي يقف بجانبها السوق طبعاً، الشعر لا يبيع، بعكس الرواية. عربياً ومنذ أكثر من عشر سنوات انطلقت الجوائز الخليجية، وساهمت بشكل كبير في الدفع نحو محاولة كتابة الرواية والظفر بالدولارات، أتفهم ذلك طبعاً، ولكن هذا خلق بحراً من الروايات المتوسطة والرديئة. عودة إلى السؤال عن الأسباب التي تدفع الشاعر إلى كتابة رواية، هل من المهم فعلاً أن نفكر في هذا السؤال؟ قد يكون هناك عشرات الأسباب المختلفة لكل كاتب، لكن بتقديري السبب الرئيسي يبقى أن الشاعر لديه رغبة لكتابة رواية، وهذا بنظري يكفي. سؤالك كنت سألته لشاعر لا أشك بإبداعه ووعيه الفني، أجابني يومها بأن الرواية لديها مساحة أكبر للقول والإيضاح.

إلى جانب عملك محررًا لمجلة “فلسطين الشباب”، تكتب المقال الصحفي، وكذلك تعمل كمعد ومقدّم برامج في راديو مونت كارلو. برأيك العمل في الصحافة والإعلام ماذا يقدّم للمبدع، هل يضعف إبداعه أم يجعله أكثر غنى؟
بصراحة، أعمل في الصحافة كي أعيش، لو كنت مقتدراً لاكتفيت بكتابة الشعر وربما التركيز على مشروع موسيقي مجمد حتى الآن بسبب ضيق الوقت، أما فيما يتعلق بالصحافة والإبداع، فربما الصحافة هي المهنة الأقرب إلى الكاتب، وبالتأكيد تساعد، وخصوصاً الصحافة الثقافية التي أعمل فيها، والتي تبقيني على اطلاع دائم بالإنتاجات الثقافية في العالم العربي والعالم بأسره. كتابة الشعر لا تحتاج إلى تفرغ كامل كحال الموسيقى مثلاً، الشعر حاضر في حياتنا اليومية، ويحيط بكل التفاصيل من حولنا، وبالإمكان العثور عليه في كل لحظة ومشهد. عندما تخطر الأفكار الشعرية ندونها على قصاصة، نسجلها على الموبايل، أو نحفظها في الذاكرة، وعندما تحين الفرصة نجلس أمام ورقة أو لاب توب لتكوينها فتصبح نصاً. بالطبع، الصحافة هي حقل ديناميكي وهام للمعرفة، والإبداع لا يستوي بدون معرفة.
كيف تقرأ المشهد الإبداعي والثقافي في العالم العربي اليوم، في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية المتلاحقة التي طالته في السنوات الأخيرة؟
هذا سؤال كبير يحتاج إلى صفحات كثيرة لا يتسع لها حوارنا. باختصار شديد، لا أريد أن أفصل المشهد الثقافي عن الواقع الاجتماعي في عالمنا العربي، وأي فصل بينهما يبقى قراءة سطحية للصورة. في العالم العربي نعيش في مرحلة انحطاط سياسي واقتصادي وفكري هذا واضح على الأقل بالنسبة لي. المشهد الابداعي والثقافي يرتبط في جزء كبير منه بالمصالح والحسابات أيضاً، يثير السخرية والحزن في آن معاً، سؤالك يذكرني بالأزمة الخليجية العام الماضي، والأقلام التي انفجرت وتكشّفت للدفاع والتبرير لهذا الطرف أو ذاك، يذكرني بفيلم فلسطيني مثّل دولة “الاحتلال” في إحدى المهرجانات الكبيرة، يذكرني بالشرخ السوري الذي قسّمنا بصورة مقززة إلى أبيض وأسود، موال ومعارض. نجد فئة مرتبطة بالأنظمة والحكومات العربية المهترئة، وأخرى تلهث للعزف بنغمات تطرب لها الأذن الغربية كوسيلة سريعة للانتشار والشهرة، نجد الفنانين الـ”كوول” الذين يلعبون “الفن للفن” بمعزل عن أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية… إلخ. لكننا لسنا في صحراء، هناك تجارب مشعة ومشجعة، هناك أفراد كثر يعملون وينتجون، يمتلكون الوعي والأدوات الكافية. لكن السؤال الأهم من هذا كله؟ أين الواقع الاجتماعي عن الثقافة والإبداع؟ من سيقرأ هذا الحوار؟ من سيقرأ الروايات والمجموعات الشعرية، من سيشاهد الأفلام التي نصنعها، من سيستمع إلى الموسيقى الحقة، من سيذهب إلى معرض للإطلاع على تجربة فنان؟ هناك خلل بنيوي كبير يتعلق بالمجتمع والثقافة في البلاد العربية، وذلك يعود إلى أسباب كثيرة، الإبداع منفصل عن الشعوب، وأخشى أن المبدعين باتوا ينتجون للخارج… أهلاً “بالعالمية”.
هل من عمل جديد يصدر لك قريباً؟
مجموعة “ضحك ونشيج” صدرت منذ مدة قصيرة، حالياً أخوض تجربة بعيدة عن عالم الثقافة والإبداع، هي سباق الدراجات النارية، تلك الرياضة التي جعلتني أتنفس بشكل أفضل، وأنا ممتن لها. آمل أن يحالفني الحظ للإشتراك في بطولة فرنسا لسباق الدراجات النارية العام المقبل!
ما الذي تود أن تضيفه في نهاية حوارنا معك؟
أتطلع إلى اليوم الذي أجلس فيه على شاطئ حيفا بدون أن أرى وجه محتل… إلى اليوم الذي أجلس فيه في إحدى مقاهي المرجة في دمشق، إلى اليوم الذي تعود فيه الكتب إلى شارع الفجالة والمسارح إلى عماد الدين في القاهرة، إلى اليوم الذي تجف فيه بحور النفط، تلك التي كانت بمثابة نكبة ثقافية وحضارية وفكرية علينا وعلى ثقافتنا وحضارتنا العربية. وأحلم بجبهة مضادة؛ تقف ببأس وجأش في وجه كل هذا القبح الذي يلتف حولنا.