يقول حسين البرغوثي: “في المتاهة الأسطورية الشهيرة كان لا بد من خيط مربوط بخارج المتاهة يتشبث به الداخل فيها كي يستطيع العودة بالخيط. وهذا الخيط الإدراكي هو “المألوف” و”المتذكر” و”المعروف” والمفارقة أنني كنت أبحث عن المألوف في اللامألوف، عن الذاكرة القديمة في الجديدة عن المعروف في المجهول. أعني بأن التعرف على المتاهة نوع من أنواع “الاستئلاف” وليس “الألفة”(1).
المتاهة هي ما لا نعرفه، والخيط هو ما نظننا نعرفه، هكذا يخبرنا حسين!
من دون عظيم جهد، يعلم جميعنا أن المتاهة التي قصدها حسين، هي تلك المركزية في مخيالنا الإنساني الحديث/الحداثي، والآتية من مركزية يونانية. هي المتاهة التي بناها ديدالوس لملك كريت، والتي حبس فيها الأخير الميناطور المتوحش؛ النصف بشر، النصف ثور، ابن الثور الأبيض الذي أتى به بوسيدون لملك كريت، ليكون أضحية للآلهة، ولكن زوجته الملكة هامت به، وأقامت علاقة جنسية معه، ليكون الميناطور.
خرج تيسيوس من المتاهة -نفسها، قد تكون!- منتصرًا بعد أن أعطته أريانا لفة خيوطٍ حمراء، دلته على طريق الخروج.
بيد أن المتاهة متاهة، وما من شيء سواها يشبه من قريب دماغ الإنسان: ومهما بدا الأمر هي خيط ملتف ينطلق من مركزٍ ما ونحوه، إلى جوهر ما، هل منها خروج، وهل لها خيط، أم أن حسين اقترح الاستئلاف كممارسة دماغية.
ديدالوس الذي بنى المتاهة هو من سلم الخيط لأريانا لقهر المتاهة، والميناطور فيها. والميناطور على عكس كل مناهج الأنثروبولوجيا والتاريخ والأكاديميا الابستمولوجية “الدوغمائية” (كما يصفها ميشيل مافيزولي)؛ هو حالة التباس تكسر الفصل المدعى بوجاهة بين المتوحش والمستأنس أو المدجن. ولنقس عليه أشكالًا أخرى من “الفصولات” (محاولة لنحت جمع لكلمة “فصل”، لا علاقة له بعملية الفصل ذاتها، لعل الالتباس هنا يطال الموضوع واللغة التي تتناوله!)، الميناطور هو التباس الطبيعي والاجتماعي/الثقافي، الأليف والمتوحش، لعل هذا ما عناه حسين حين فصل بين الاستئلاف كعملية، والألفة كموضوع، ما فعله حسين هنا -أو هناك- هو أنه عكس لغويًا محاولات فك الالتباس عن مضمون المتاهة – الميناطور.
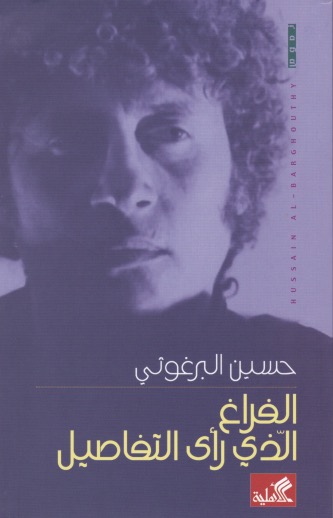
لكن لنعد للميناطور، أو بالأصح لديدالوس، باني المتاهة، ومالك مفتاحها. “وجب اعتبار ديدالوس ميكانيكيًا ومعماريًا صانع آلات أوتوماتيكية ودمى متحركة، ناهيك بالمدن وبالمباني: بطل جوال انتمى لشملٍ من صناع ومفسري ألغاز كانوا محط أنظار الملوك”(2). بل هو قاهر الملوك أغامينوني وأغاميمنون ومينوس وكوكالوس، حتى أنه قد فرضت عليهم الحماية منه، إلى أن طالهم وتفنن في قتلهم، وجدير بالذكر أن مينوس هو من منع ديدالوس حريته، في النهاية، لأن مالك المتاهة، يمكنه أن يحكم على أي شخص بالتيه!
أيمكننا القول أن ديدالوس هو العقل بمركزيته الحداثية، الذي بنى لنا المدن واللغات وألعابنا الحداثية، وأن الميناطور هو التباسها من داخلها ومن داخل بدنها المادي، الذي سيؤدي إلى هدمها وتفكيكها، وانتقالها إلى “ما بعد”؟ وهل استشرافات حسين البرغوثي هي محاولات لاستئلاف ما لا يؤتلف، أو استئلاف “كل ما هو صلب يتحول إلى أثير”.(3)
هو العقل الذي لم يعد يستحق شفقة أحد؟ هنا ثلاثة شخصيات مركزية عندما نتحدث عن الشفقة:
الميناطور – الالتباس بين كل المعرّفات، وفشل النحت أمام المنحوت، أو “اللامسمى” بالمنطق البرغوثي.
ديدالوس – مستحوذ التيه وباني المتاهة، الذي يدور في دوائر هو أيضًا بين امتلاك المعضلة (المتاهة) ومفاتيحها معًا، كإله حبيس القدرة والاستطاعة.
“مهما يكن، كان خيط ديدالوس يربط ويحل كباطن قوقعة وتعاريج كهوف وممرات خفية، تبين عن سراديب مدينة معادية. العبقرية البنائية الحقيقية تتطور بعملٍ شمولي مغاير مفككًا الكبير والصغير بالتقنية نفسها المطواعة والمبهمة والذكية في اتجاه مسارب الخروج المحتملة، لأن المخترع الذي يهلك نفسه بيديه لا يستحق شفقة أحد”.(4)
الخيط هو البحث عن المألوف في اللامألوف، عن الذاكرة القديمة في الجديدة، عن المعروف في المجهول، التعرف على المتاهة نوع من الاستئلاف، وليس الألفة.
يقدم لنا عبد الرحيم الشيخ متاهة البرغوثي بالقول أن لها أشكالًا متنوعة، “فمتاهة البداية تنشأ نتيجة الغموض المفرط أو الوضوح المفرط (…) وأمّا الوضوح، فيسببه سوء تفاهم استيهامي بين “الأنا” ومحيطها، سواءً في إنتاج نص يشبه المتاهة، كالخط المستقيم الذي تُخطط استنادًا إليه مدينة متعددة الميادين؛ أو في إعطاء تفسير له بغية إنتاج معنى يصير متاهة جديدة. فالمتاهة إذن؛ “حالة ذهنية” ناشئة عن ظروف تحيط بواقع “الأنا الواعية” الذي تعيشه، وتحول دون بلوغ اليقين”.(5) متاهة البرغوثي هي العودة الدائمة إلى ما درجنا على فهمه مألوفًا، يقينيًا.
المتاهة في نص البرغوثي، هي حالة الالتباس التي مثلها الميناطور، والتي لا تحتويها الكتب ولا هندسة ديدالوس، الذي اتفقنا أنه لا يستحق! هي حالة العودة إلى الشيء نفسه بلا جدوى.
لنا هنا أن نتأمل أكثر من نموذج لاستئلاف ما لا نظنه أليفًا، ولم نألفه حتى، في موضوعيته، إنما فعلنا بطقس عابر طقوسي، لم نمتلك فيه الحق في المعنى والخيال.
“إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ* قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا”. (القرآن)
….
“وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ” (القرآن)
يوسف لم يقل أنه يريد بل رأى فحسب، لم يعانده أحد بالقول أنها رغبته، لكن في النص التوراتي، تنبه يعقوب إلى مافي بال ابنه: “ولما قصهُ على أبيه وإخوته انتهره أبوه وقال له: “ما هذا الحلم الذي رأيته؟ أنجيء أنا وأمك وإخوتك فنسجد لك إلى الأرض؟”(6)
لم يصرح يوسف بشهوة السلطة، ترك الأمر ملتباسًا “متائهيًا” (محاولة ملتبسة أخرى للنحت اللغوي، لمواجهة التباس الفكرة والمتاهة). ننظر نحن الآن إلى القصة من خارجها، أي من خارج متاهة الالتباس، لكن حينها في بدن/جسد النص/القصة – المتاهة لم يكن الأمر إلا ملتبسًا. في البئر لا جهات، كان البئر ثمنًا لطمع يوسف في ما لا يحق إلا للآلهة، البئر متاهة يوسف، التي وصفها حسين. هي وهمه الذهني، وأن الأنا نقطة الثبات والمركز الذي يجب العودة إليه دائمًا، لكن بتأويل يفتح باب “الاستئلاف”:
“رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ” (القرآن)
بمعنى آخر لحظة البئر هي لحظة المتاهة والخيط معًا، البئر متاهة يوسف العارف برؤياه، وكلاهما حوادث لغوية.
هنا يمكننا تتبع ألعاب حسين باللغة.
يصبح استئلاف ما لا يستألف أمرًا لازمًا، والألفة محض خديعة (شكرًا حسين!).
لا مانع لدينا أن نقبل حلم يوسف حين طلب من مظاهر الألوهة ما لا يحق له، فنحن نألفه ونستألفه معًأ، حتى وإن كان الأمر متعارضًا مع صريح الألوهة. ولكننا نرفض إبليس الذي أظهر إيمانًا وحدانيًا حاسمًا حين طُلب منه أن يسجد لغير الله، ولا نستألف ما ألفناه منه في الصورة النمطية عن المعصية!
تلك حالة “اللامسمى” المتاهية، وراء حدود الوعي وأشيائه.
هنا يكون المخرج من المتاهة، بعودة الإدراك إلى الأنا المتعرفة، هنا لنا أن نستوعب التباسنا بين يوسف وإبليس، لكن بين ذاكرتين توحيديتين، يسميها حسين ال Déjà-vu، بين كليهما معًا.
إبليس له في المتاهة نصيب؛ حكاية السجدة، وهو الخارج من متاهة الالتباس الرباني الآمر بالسجود إلى الحسم التوحيدي (مؤمن-كافر، جنة-نار، طاعة-معصية، وغيرها!)، إبليس أدخله الإله بئرًا متاهةً وحرمه الخيط التأويلي اللغوي الذي منحه ليوسف قبله، بئر إبليس هو انحباسه في ظلنا، نحن نسل آدم.
إبليس على عكس يوسف، خاطر بالإفصاح أمام الإله عمّا في باله حين رفض السجود، الانحباس في المتاهة: “قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ” (القرآن)، طُرد إبليس لصراحته، وفض الالتباس بخروج عن ثنائيات فرضت عليه. فخاف الإله من تلك الحقيقة، فمنع آدم عن شجرة المعرفة في الجنة، وتحايل في الأسباب، كان أقرب ما يكون حينها لديدالوس، الذي طمس فكرة الميناطور في ما بعد.
يرفض إبليس استئلاف ما لا يؤتلف بالنسبة له: “قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ” (القرآن)، تقول الأفعى في العهد القديم: “لن تموتا، لكن الله يعرف أنكما يوم تأكلان من ثمر تلك الشجرة تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله تعرفان الخير والشر”. إبليس والأفعى كانا خيط ديدالوس بيد ديدالوس – الله.
يقول حسين أن في الجنة أربع ذوات كلها عاقلة واعية لنفسها: الرب وآدم وحواء والأفعى، آدم يعرف بأنه ليس الرب، ولا الأقعى ولا حواء، إنه آدم. وكذلك الرب والأفعى وحواء، كلها “ذوات” تعرف نفسها بالطريقة المنطقية ذاتها، فهي ليست كذا وكذا، الاختلاف يأتي من التعين.
هم إذن لم يكونوا في المتاهة، بقدر ما لم يكونوا خارجها.
الميناطور في متاهة ديدالوس، هل يتعين ليختلف، أم اختلف بتعيينه؟ ومن هو آخره؟
ليس الأمر بهذا الحسم، يا حسين!
عوقب آدم بالطرد، لأنه أكل من شجرة باعثة على/للـ الفهم، كانت تلك محاولته للاستئلاف، فنحن لا نستألف ما لا نعرفه تمامًا ولا نعرف ما لا نستألفه تمامًا. فهم آدم بمسارات في الاستئلاف أن الحقيقة العارية خطر عليه، “أدرك أن الجنة التي كان فيها مثل الموت، حيث للآخرين أن يرونه عاريًا تمامًا”.
يرشدنا حسين إلى تأمل “المعاد إدراكه”(7)، “فما نراه ليس غريبًا ولكنه يتغرب، يفقد خرائطه المألوفة، أعني سيداتي سادتي، بأن المألوف يشبه منديلًأ شفافًا جدًا ملقى على وجه الأشياء، وعند لحظة معينة في المتاهة يسقط المنديل، فيبدو وجه الأشياء غريبًا تمامًا، لم نره من قبل”(8).
الموت
للفن التشكيلي القدرة على إضاءة ما نريد من المتاهة هاهنا، أو ما نظننا نألفه دون أي استئلاف.
الموت، ثانيةً، وموت حسين نموذجًا!
ذلك الأكيد الغريب بيننا.
يرسم كلود مونيه زوجته كاميل وهي تحتضر، يستألف مونيه الموت هنا، داخل متاهة الحياة، فيقف وزوجته على حدود غير المعرّف، المتكرر بتكرار الحياة، بين ذاكرتين، حية وميته، أو طرفي خيط – متاهة. هو يجسد مبدأ النقص الذي يخبرنا به موريس بلانشو؛ “ففي داخل كل كائن يوجد هناك عدم كفاية”(10) لا يسعى للاكتمال إنما يكتفي بنقصانه، بتعيين ما ينقصه، على غير سعي للاكتمال. ما يحدث هنا هو فكاك من ثنائيات الحداثة، وخيوطها وآلهتها، وديدالوسييها (نحت آخر!).
اختلاف لا يأتي بتعين الذات وحدها، لكن بتعيين الفقد والنقص كمتاهة، والكمال دون علاقة اعتباطية بينهما، هنا خيط آخر للمكوث في المتاهة لا الخروج منها، ما يقوله حسين: “لا أكتب المتاهات، بل “حكمة المتاهات”، وكتابي نفسي. مثلما قلت في “ما قالته الغجرية”: من علمك الرقص؟ ثالت: متاهة”(11)، من دون (الـ) الـ….”تعريف”.
نسأل الميناطور عن هويته، أي منهما؛ لا يدري، ولا مونيه.

بقدر ما يستحضر الاستئلاف المعرفة، أو يفضي إليها، والمعرفة لها سلطتها، إلا أنه يتضمن أيضًا ترويضًا للخوف، دون تعريفه لازمًا. والخوف كموضوع من مفاتيح فهمنا لذواتنا. “أنا أفعل، آكل، أشرب، أتنفس، أعمل” كلا الجسد يأكل، يشرب، يتنفس، يتذكر (…) أنا أستطيع تشريح أفكاري وكأنها ضفدع. ولذا، فإن بوسعي أن أرتبط بنفسي كما ترتبط ذات بموضوع، وعي الذات هو عملية الربط هذه بعينها”.(12)
يمنحنا حسين مسشترفًا موقعية (نحت آخر، ملتبس برسم ملتبس، عن فكرة غير ملتبسة!) مختلفة، في مقاربة ثنائية الذات والموضوع، والخوف كما الحب والجنس والرغبة والهيام والألم، تجارب معرفية وموضوعية، لأنها ذاتية.
يسجل فريدناند فيكتور إيغون ديلاكروا، في النسخ الستة المكررة من لوحته “المسيح على بحيرة طبريا”، مشاعر الخوف، من الماء، والماء صنو الآلهة ومنه الحياة ومتخيلات الألوهة، والمسيح نصف إله نصف بشري، تمامًا كجلجامش، وكائن من أنصاف غير متمازجة كالميناطور.
المسيح يشكو ضعفه، في موج متلاطم، وجلجامش يُشكى من جبروته إلى الآلهة ثمة خوفان متراكبان هنا في هذا التناص بين أنصاف الآلهة هنا، كلاهما في المتاهة، بخيطيهما: الضعف وقلة الحيلة، والبطش والتجبر، وكلاهما خاصتين تنتصر لنصف منهما على الآخر، ولا تليق لا بإله على التمام، ولا إنسي على التمام؛ البطش على الإله، والضعف على الإنسان. هما المسيح وجلجامش؛ مونولوج الميناطور في المتاهة، هما سؤاله لنفسه عن نفسه، أيحق له الكلام، أتخرج المتاهة عن حكمة ديدالوس الإله؟



تلك هي حكمة المتاهة التي أنبأنا بها حسين، وعلمت الغجرية الرقص، متاهة في لوحات فيرناند لها ملهاة تتجذر رأسيًا في تكرارات العمل الفني، وكأن البحر هو المتاهة.
المتاهة التي ساوت بين جلجامش والمسيح، في اختلافهما عن بعضهما. تلك هي المتاهة التي جعلت دراسة نماذج تكرارية من الأعمال الفنية والتشكيلية، شكل من أشكال تفكيك هيمنة وسلطة نظريات تاريخ الفن، بكل هفواتها وأخطائها. وأن تلك التكرارية إنما شكل مقاوم، ومحدد لسيرورة التاريخ التعبيري للفنون (جورج كوبلر)، دون أن تكون الحاجة لتوثيق التغيرات أمرًا مشروطًا في دراسة التكرارات في المتاهة.
تضيء المتاهة البرغوثية هنا على منطق “الاختلاف والتكرار”، الدولوزية (نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز) كشكل من أشكال الاستئلاف. وأن الهوية مهما ائتلفنا معها كإجابة هي مصطنعة، نتجت بوصفها أثرًا بصريًا عن لعبة أعمق، هي لعبة الاختلاف والتكرار، غير البادية عيانًا. ذلك التكرار في الانكشاف على الذات والموضوع، الذي يستلزمه استئلاف كل ما هو مختلف، مهما كانت درجة تطابقه، هو ما يخلف الاستئلاف ويمتحن الألفة.
بقي أن نقول أن الترحال داخل المتاهة المونولوج، واستئلاف كل ماهو من الذاكرة والهوية واللغة ومقولاتها والمخيال وتحيزاته، أمر دافع للتأمل والدرس، كما للرقص، تمامًا كما كان يفعل بيكاسو مع أعماله الفنية.
يخبرنا البرغوثي أن المكان فكرة في عقل أحدهم، ولأن نصوص حسين هي أمكنته ومتاهاته، كانت الحاجة إلى شعرية التجريب، والتشريح، والإتاحة، والتشتيت (13)، بحثًا عن صوت الآخر في كل الأصوات التي فينا ومعنا ولنا، في متاهاته، وبيدنا خيطه.
الهوامش:






