إلا أننا في «مرايا سائلة» نتلمس مدخلاً جديدة في عوالم هذه التجربة، مدخلاً موارباً ربمّا ندخل فيه من الباب الخلفي إلى ما أنتجه حسين البرغوثي، مختلفاً عن الأبواب الأمامية الوجاهية الواضحة التي كان أراد حسين أن يُشرعها أمام القرّاء في ثلاثية كتب السيرة الذاتية، وهي الكتب الأكثر صيتاً وانتشاراً له.
" في أسطورةٍ قديمة، أحضروا لرجلٍ إناءين من الماء؛ ليحدَّق فيهما في طقوسٍ سحريّة، وبدل أن تسمي الأسطورة هذين بـ "إناءين من ماء" تقول أتوا له بـ "مرآتين سائلتين" هذا شعر. النظرُ في الماء هو أول مرآة في التاريخ. هذا هو: الشعر ماء-مرآة تتهشم باستمرار، مرايا سائلة."
بهذه الطريقة يُعيد حسين البرغوثي تعرّيف الشِعر في مجموعتهِ الشعريّة الأخيرة "مرايا سائلة" والتي صدرت في العام ٢٠٠٠ أي قبل وفاته بعامين فقط، بعدَ أن اكتملت إلى حد بعيد تجربته الثرية والموسوعيّة الدؤوبة والذاهبة في عمق الذات والتي حافظت أيضاً على تماسها مع الخارج، الشِعر مرايا سائلة متعرّجة دائمة التكسر والانحناء، كما هو النظر إلى وجه البحيرة، ثمة ما يتعرّج ويتموّج دائماً، ولا يمكن أن يكونَ هناك ثبات، إنه الماء الذي كُلّما أصابه الشاعر، اكتشفَ أنه سراب، وأبصر فيه ذاته المتكسرة أو لنقل بقايا تهشيماً لهذه الذات، ولذا فإنه تبعاً لذلك فكرة في مخيلة أحدهم كما يشير البرغوثي نفسه إلى المكان فيقول إنه "فكرة في عقل أحدهم"، إلا أنها فكرة بعيدة المنال، دائم التفلّت من بين يدي الشاعر، وهو في رحلة البحث الطويلة هذه، عليه أن يكونَ صبوراً لحوحاً في استجداء هذا المكوّن الغرائي العجيب ذو الندرة الفائقة، يبدو تعريفاً منسجماً مع سياق بناء الكتاب في كليته الّذي يعمدُ الكاتب إلى جعلهِ مساحةً مفتوحة على فكرة التجنيس الأدبي النقدي الكلاسيكي الصارم، والّذي يضع شرطاً فنياً لما هو شعر وشرطاً فنياً آخراً إلى ما هو نثر، وممهداً في ذات الوقت إلى نتاج «حجر الورد» الصادة 2002 وهو، كما يُصنفه النُقاد، نص ما بعد حداثي مفتوح تماماً على كافة الأجناس الأدبيّة.
مُنحازاً إلى المعنى وجارياً مع سيولته يدوّر حسين البرغوثي دائرة الإنتاج التي خلقت كتاب «مرايا سائلة» في حالة من حالات التجريب والصناعة الشعريّة والأدبية التي كانت نتاج برنامج للكتابة الإبداعية الّذي التحق به حسين البرغوثي في جامعة آيوا. فهو بمنظور النقد الأدبي المدرسي ليس شعراً خالصاً، كما أنه ليس سرداً فقط، لكنه مزيج هائل من المركبات الشعرية والميثولوجية والكلاسيكية والمعاصرة والسينمائية والمنولوجية والروائية والقصصية كذلك. يشير حسين البرغوثي نفسه إلى هذا التجرّيب في صناعة «مرايا سائلة» في مقالة غير منشورة يقدم أجزاء منها عبد الرحيم الشيخ في دراسة أُجريت حول الكتاب مشيراً إلى التقنية ما بعد الحداثية فيقول: "أول فكرة كانت مستلهمة من التأمل العميق، الحدسي، للوحة تشكيلة ما، بعد عدة قصائد من هذا النوع، خطر في بالي فكرة أكثر إثارة، لماذا لا أكتب معها أو فيها كل ما أفكر فيه"
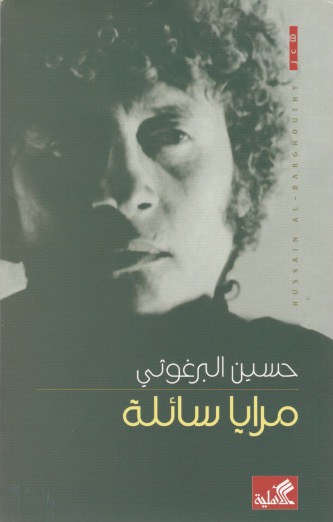
إذن فهي فضاء مزدحم غاية الازدحام بخلاصة تجربته المعرفيّة المتفرّدة والخاصة والسابقة لعمره البيولوجي المقصوف بفعلِ السرطان الّذي جاء في الوقت الغلط كما يشيرُ إلى ذلك في واحدة من المقابلات التي أُجريت معه وهو على فراش المرض.
يعرض حسين البرغوثي في «مرايا سائلة» (صدر بطبعة جديدة عن الدار الأهلية في عمّان، ٢٠١٨) إطاراً دارمياً متخيلاً ثم يسكب فيه خلاصات معرفيّة وشعريّة دقيقة، حيث يتمركز في بناء العمل شخصيتان: الأولى لمونتير يعمل في موقع تصوير والثانية لمخرجة سينمائية تعمل معه في ذات الموقع، فيما تحدث علاقة بين الشخصيتين، تطلب بواسطتها المخرجة السينمائية من المونتير أن يكتب لها قصيدة شعرية كالتي في ذهنها، نصاً شعرياً يوافق تماماً ما هو موجود في ذهنها عن ماهية الشعر، وتتتابع محاولات المونتير في مسارٍ من البحث الطويل عن هذه القصيدة التي في مخيلتها، محاولات تنمو هرمياً ثم سرعان ما تتداعي كما تتداعي الأهرام المصنوعة من أوراقِ اللعب عند أقل محك أو حركة، وفي هذه الدائرة المُفرغة من الهدم والبناء، ثمة تعريفات جديدة، واستدلالات تسعى في مدار معاني جديدة ومركبات تستعدى فعلاً خاصاً من التأمل.
وكل هذه المحاولات مرايا مُتهشمة يقدمُ من خلالها حسين في كل مرآة من مرايا المجموعة معنى من الممكن الحصول عليه أو إعادة تفكيكه أو البناء فيه، وصولاً إلى الشِعر أو ما يشبه الشِعر إن صحَّ التعبير، بنفس الطريقة التي يستخدمها المونتير في قص الشريط وقطع الأحداث عن سيرورتها الطبيعية ثم إعادة تركيبها في دائرة إنتاج جديدة، هي ترجمة لما يريد المخرج رؤيته. يفعلُ الشعر ذلك، يقومُ بخلع الأشياء من سياقاتِها معترضاً ربمّا على شكلِ اصطفافها في مصفوفتِها الكونيّة كما أراد اللهُ لها أن تصطف وتكون، لصالح رؤيتهِ الخاصة التي ترغب في إعادة بناء وتركيب الأشياء وفقاً لزاويةِ نظرٍ مختلفة، وهو بذلك ينزع الفعل من مسار نموه الطبيعي، ليُنتج تشوهاً خاصاً يتناغم مع ما تريده ذائقته، وذائقة غيره، ثم يتتبع إيقاع هذا التغير بالكثير من الإصغاء والتقدير، إنها إذن عملية خلق موازنة، لكنها في الوقت ذاته لا تستعدي شيئاً من العدم، بل تعيد ترتيب الموجودات في أطرٍ جديدة ومغايرة، يقول حسين البرغوثي في «مرايا سائلة» مشيراً إلى هذه الرغبة الأصيلة: "كل فنان خالق عند نتشه، ماهية الإنسان، جوهره، حاجته الأصل، ليست الشهوة، ولا السيطرة، ولا الاستهلاك، ولا أن يحمل أعباء الوطن، أو الألوهة، أو العائلة، أو الفن، بل الخلق. نعم الخلق."
إلا أن هذا الخلق، مهمة مضنية بعيدة المنال، إذ أن المونتير في مساعيه المستمرة يصطدم دائماً بفكرة اصطياد هذا المركز الّذي يمكن من خلاله أن ينفذ إلى ذهنها، أي إلى القصيدة التي في ذهنها، حيثُ في الوقت الّذي يفكر فيه المونتير بمفاتيح الدخول إلى دهاليز هذا الذهن، ينسى أن المدخل من الممكن أن يكون ذهنه هو، والذهنان ربّما يكوّنا الذهن البشري كلّه من حيث كونه في الأصل واحد، ومن هنا ينمو استخلاص معرفي جديد في رحلة البحث هذه، فالقصيدة التي في ذهنها هي قصيدة الكون التي تبقى عصية على الاكتمال والاستحواذ، طالما أن هذا الكون في حركةٍ دائمة وصاخبة، يشير حسين البرغوثي إلى هذا الاستدلال في كتابه فيقول: "القصيدة التي في ذهنها بركة ينعكس فيها ظل القصيدة العظمي للكون، والتي لن تكتمل إلا في نهاية التاريخ، الشاعر بركة، مرآة سائلة، تعكس جزءاً من هذه القصيدة، كما تعكس بركة قصر الحمراء جزءاً من القصر".
وبهذا الشكل تبقى الدائرة مُفرعة، وتبقى كل قصائد الشعر التي كُتب منذ أن بدأت الصناعة الشعريّة، محاولات لإدراك الشعر الذي في الحقيقة لا يمكن إدراكه، تماماً كما لا يُمكن إدراك الإنسان بصورة نهائية يمكن أن نضع بعدها نقطة، ليكن لدينا جملة مكتملة المعنى ويحسن السكوت عندها، ثمة فواصل دائمة والكثير من الكلام الّذي من الممكن أن يُضاف بعد كلمة إنسان. وهكذا الشعر، لا يمكن إدراكه، حيث تمر محاولات إدراكه بنفس تلك المحاولات التي بذلها جلجامش لإدراك الخلود إلى أن ينتهي إلى أن الموت هو الحقيقة الوحيدة المُدركة، وعليه الاستماع بما هو متاح له في الحياة، كما هو موجود في كتاب فراس سواح «ملحمة جلجامش»: الآلهة هم الخالدون في مرتع شمس، أما البشر فأيامهم معدودات وقبض الريح كل ما يفعلون".
ولذلك فإن من أدق تعريفات الشعر وفقاً لهذا المعنى، التعريف الذي يقدمه الشاعر الإنجليزي جون كيتس، حينَ يقول: "إذا لم يجئ الشعر طبيعياً كما تنمو الأشجار على الأشجار، فخير له أن لا يجيء"، لكن كيف يمكن لنا الفكاك من هذه الورطة، يجيب حسين البرغوثي عن هذا السؤال في ذات المقالة غير المنشورة الموجودة في دراسة عبد الرحيم الشيخ عن «مرايا سائلة» فيقول: "وعثرت على فكرة أن كل ما أفكر فيه وأنا أكتب قصيدة هو القصيدة نفسها، حتى ولو كانت تافهة".
مستوى صوفي يأخذ من اللغة وسيلة وغاية
القارئ لنتاج حسين البرغوثي بسردهِ وشعره، يُمكنهُ أن يلحظ بجلاء ذلك المستوى الصوفي المُترسب في قيعان لغتهِ الشعريّة والسرديّة على حدٍ سواء، وهذا ينسجم مع رحلة حسين البرغوثي الطويلة في البحثِ عن الذات، الذات التي فقدها مراراً وأنكرها وتشكك فيها، ثم أعلاها وقدسها، ثم استحالة إلى السكون والموت، والقارئ لثلاثية السير الذاتية («الضوء الأزرق»، «الفراغ الّذي رأى التفاصيل»، «سأكون بين اللوز») يمكنه أن يلحظ هذا المستوى الصوفي الممتد في تكوين تجاربه الذاتية في رحلةِ البحث عن الذات وهي بمعنى آخر رحلة المُتصوّف في البحث عن ذاته في مراحل الترقي بين مقامات البقاء والفناء، ولهذا المعنى يشير المتصوفة إلى فكرة الترحال، "سيحوا تستريحوا" والسياحة المقصودة هنا ليست تجوالاً في الأمكنة فقط، لكنها تجوالاً داخل الذات أيضاً لا يتحقق إلا في التجوال في المكان على اعتبار أن المكان ينطوي في الذات، كما يشير الإمام علي إلى هذا المعنى حين يقول: وتحسب أنك جرمٌ صغير وفيك انطوى العالمُ الأمر"وبالعودة إلى تجربة حسين البرغوثي الذاتية نجد هذا الترحال والاغتراب الذي بدأ في هنغاريا في بودابست التي كانت تشكل له كما يقول متاهة ثم تبلغ ذروتها في سياتل التي مكث فيها عاماً كاملاً منكفئاً على ذاته لا يكلّم أحداً كما يشير إلى ذلك في «الضوء الأزرق»، إلى أن تبدأ علاقته ببري الصوفي المتشرّد من قونيا ومن أتباع مولانا جلال الدين الرومي، وفي «مرايا سائلة» تقفز اللغة الصوفية في الكثير من المناطق في جسد النص سواء بواسطة مفردات لغوية تعبر بجلاء عن البعد الصوفي، حينَ يقول: "عيناك مقامان للأولياء، مقامٌ يُزار وفاءً للنذور ويشغل فيه السراج، بزيت الطقوس، وآخر يطفو على الماء في حلمي، ويضيء لي الأشياء، يذهلني الحب في الحالتين: حين يزور وحينَ يُزار".
فالعينان هما بوصلتان تدلان على الطريق كلّما اشتبكت الدروب في رحلة البحث عن الذات، تماماً كما هي المقامات والمزارات لدى المتصوّفة نقاط للاستراحة والاسترخاء ومحاولة لملمة شتات الذات التي بعثرتها رحلة البحث الطويلة والمجهدة، وفي «سأكون بين اللوز» يعود حسين بعد هذا الطواف إلى الجمال الّذي سبق وأن خانه، إلى الدير الجواني، إلى نقطة تجميع الذات التي أنهكها المسير في دروب البحث والتيه.
والحقيقة أن تناول أي نتاج لحسين البرغوثي من مجمل نتاجاته التي تنوّعت ما بين السيرة والنص والشعر والمسرح والفلكلور والأغنية والنقد والسينما، يستدعي النتاجات الأخرى بالضرورة، يعود ذلك إلى أنها وإن اختلفت تجلياتها وأشكالها تُترجم بدقة لرحلة حسين البرغوثي القصيرة زمنياً، الطويلة في مجالاتِ التجرّيب والبحث والإبحار في الذات وخارجها، كأنها تماماً نصاً ملحمياً طويلاً، متصلاً بهذه الحالة الخاصة التي تشبه تماماً صاحبها، والتي ربمّا لم تحظَ بما يليق بها من الاحتفاء والاهتمام والدراسة، لأسبابٍ كبيرة يختصرها حسين البرغوثي حين يقول: "أنا كاتب على الهامش الكبير من الحياة".
إلا أننا في «مرايا سائلة» نتلمس مدخلاً جديدة في عوالم هذه التجربة، مدخلاً موارباً ربمّا ندخل فيه من الباب الخلفي إلى ما أنتجه حسين البرغوثي، مختلفاً عن الأبواب الأمامية الوجاهية الواضحة التي كان أراد حسين أن يُشرعها أمام القرّاء في ثلاثية كتب السيرة الذاتية، وهي الكتب الأكثر صيتاً وانتشاراً له.





















