يشدد الكاتب على مقارنة اليابان بالولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، حيث كانت اليابان في تلك الفترة أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يعود برأي الكاتب إلى عاصفة الإنارة التي اجتاحت البلاد،
يقارن جينشيرو تانيزاكي في كتابه «في مديح الظل»، ما بين حب الغربيين للضوء واليابانيين للظل. ولد جينشيرو تانازاكي عام 1886 في طوكيو لعائلة من طبقة التجار، وكتب في سيرته الذاتية عن طفولته الرغيدة، والتي استمرت حتى دمر زلزال طوكيو الكبير عام 1894 منزله، بعدها بدأ حال عائلته المادية يتدهور، حتى أضطر إلى السكن مع عائلة أخرى عندما نضج، والعمل كمدرس لديهم. التحق جينشيرو بكلية الأدب في جامعة طوكيو، إلا أنه اضطر لترك مقعده الدراسي، لعدم قدرته على دفع رسوم الجامعة. وبقي جينشيرو في حيز مدينة طوكيو، حتى دُمر منزله للمرة الثانية في زلزال كانتو الكبير عام 1923. وقد أثار، خسارة العديد من المباني والأحياء التاريخية بمدينة طوكيو في هذا الزلزال، تغيراً في حماسته تجاه الثقافة الغربية والحداثة، ووجد في نفسه اهتماما متجددا بتاريخ اليابان وجمالياتها الثقافية، وهو الموضوع الذي طغى على مؤلفاته بعد انتقاله إلى كيوتو.
هل هناك ثقافة للظل؟
يجاوب جينشيرو بنعم في هذا الكتاب الذي هو في الحقيقة عبارة عن مقال كتبه عام 1933، ونشر من قبل إحدى المجلات الثقافية المرموقة في تلك الفترة. يناقش في المقال تلاشي الظل الذي كان حائماً في اليابان وحولها. فقد حدث تحول هائل في المجتمع الياباني، بعد إصلاحات الإمبراطور ميجي عام 1868، فقد قررت اليابان دخول السباق الصناعي الذي حولها من مجتمع زراعي إلى دولة رائدة في التحديث، مما طور قدراتها الصناعية في غضون جيل، ولإنجاح هذا المجهود، استقبلت اليابان التقنيات والابتكارات الغربية، والتي غيرت من شكل الحياة بدورها.

ومعها دخلت أفكار أجنبية عن الجمال، واللباس والفنون. ولم يكتب جينشيرو هذا المقال بلهجة اتهام للغرب، ولا كوسيلة لبيان التفوق الثقافي عندهم. بل كإنسان قلق على مقدرته في التعبير عن نفسه، وعن المكان الذي ينحدر منه بشكل كامل كما يتجلى في الثقافة اليابانية، وذلك في وجه التقليد الثقافي للغرب الذي قامت به اليابان ذلك الوقت. فيشكل جينشيرو صفحة بيضاء كالتي يجدها القارئ ما بين فصول كتاب، ليقف شاهدا على ما تبقى من الماضي الحي، ويظل متطلعا نحو مستقبل جديد.
المضحك أن جينشيرو يشير إلى نفسه كرجل عجوز في الكتاب، وقد يتفق معه القارئ، وهو في صدد القراءة، ولكن الحقيقة أنه كان في الأربعة والأربعين من عمره، عندما نشر المقال. وسيخطئ القارئ مرة أخرى إذا فكر أن جينشيرو إنسان محافظ ومتزمت تجاه الحداثة التي تمر بها اليابان، فقد كون سمعة بين جمهور قرائه، لكتابته روايات تتطرق إلى مواضيع جنسية صادمة، وتناقش السلوكيات المؤذية للذات. فقد انتقد مجتمعه قبل أن ينتقد الأخر.
مقال أو كتاب، هما في الحقيقة صفتان لا تنطبقان على هذا النص، فهو تيارات وعي الكاتب التي تتدفق بشكل عفوي على الصفحة، فيتحرك الكاتب من موضوع جدي إلى آخر مرح بلا إنذار، وبلحظة يقفز من الحديث عن الحمامات اليابانية إلى إعداد الطعام، ومن ثم إلى ورنيش الأوعية التقليدية. فالمقال إذا أردنا تسميته كذلك، مكتوب بأقدم وأكثر الأساليب ترسخاً في الأدب الياباني، والذي يعتبر التركيبات النصية الدائمة الوضوح، والتسلسل وسيلة لتزييف تأملات القلب، فهناك اعتقاد أن أفضل طريقة للتعبير عن تقلبات المشاعر الإنسانية والإدراكات التي تعبر الذهن مسرعة، هو أسلوب القلم الحر الذي باستطاعته نقل الشكوك التي ترافق العملية الفكرية.
الصفة التي نسميها الجمال... يجب أن تنمو من الحياة الواقعية"... جينشيرو تانيزاكي
يتطرق جينشيرو إلى كيفية وصول الظل إلى قمة تراتبية الجمال في الثقافة اليابانية. بالإشارة إلى تفاصيل المعمار التقليدي. ويبدأ بالسطح الذي شيد لكي تتدلى حوافه حول المنزل كوسيلة حماية من الرياح القوية والأمطار والشمس، وهذه التقنية في البناء أدت إلى حجب معظم الضوء الذي قد يدخل إلى المنزل. ويعتبر جينشيرو أن هذه التقنية تسببت في نمو قيمة الظل الثقافية عند اليابانيين، فصممت أدوات الطعام ومستلزمات الحياة بطريقة تكون فيها أخاذة تحت الإضاءة الخافتة، فهي تزداد جمالاً في الأماكن المظلمة.
ويأتي جينشيرو بالعديد من الأمثلة أبرزها الأوعية اليابانية المصبوغة بالورنيش الأسود والمزخرفة بماء الذهب، والذي برأي جينشيرو تفقد جمالها عندما تعرض في أحد المطاعم التي قررت أن تركب الإضاءة الحديثة، فتظهر الزخرفة الذهبية كشيء مبهرج وصارخ في البيئة الجديدة، ولكن عندما يعرض الوعاء في ظل الإضاءة الخافتة لأحد المنازل أو المطاعم التقليدية، يبرز اللون الذهبي ويلفت الانتباه لجمالية الزخرفة وحرفية الفنان الذي رسمها.
ومنها يطوف على ملابس الرهبان في المعابد، ومن ثم المسارح التقليدية مثل النُو والكابوكي التي تطورت في ظل الإضاءة الخافتة، والتي يعتبرها جينشيرو مناسبة أكثر مع البشرة اليابانية، والتي قتلتها الهوس بالإضاءة الحديثة في اعتقاده، والذي لم يترك للمتلقي مجالا لكي يملأ بخياله الفراغات الموجودة عمداً في الأداء، فتحت تلك الأضواء الساطعة تخسر الأقنعة والأزياء سحرها، وينفضح زيفها أمام الجمهور، فبالنسبة إلى جينشيرو الظل هو مكان يولّد فيه الجمال.
ويتساءل ماذا لو تطورت العلوم التي أدت إلى الثورة الصناعية عند الغرب في الشرق؟ هل كنا نجد الأن فرشاة كتابة يابانية عصرية، وأوراق كتابة ترافقها؟ يذكر جينشيرو الصعوبات التي واجهها في بناء منزله، حيث كان يأمل بالرغم من المستلزمات التي تتطلبها الحياة العصرية بأنه يستطيع بناء منزله بالطريقة التقليدية، فيتبين لجينشيرو سريعاً عدم انسجام هذه الإرادة مع الأدوات والأجهزة العصرية الأتية أغلبها من الغرب، فكلما فكر أنه وجد حلا لمشكلة معينة تمكنه أن يحافظ على الطابع التقليدي للمنزل، تظهر أخرى لتعيده إلى نقطة البداية، كأنما يحاول حل أحجية بقطع لا تتوافق مع بعضها، بل لم تخلق لكي تتوافق. هنا يتطرق جينشيرو إلى عدم ملائمة المستلزمات المنزلية الغربية مع الذائقة الثقافية لليابان.
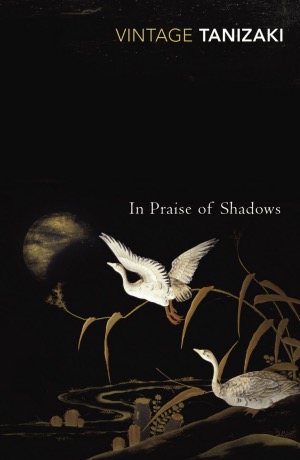
حيث يضرب مثالا لصعوبة إيجاد بديل للإروري، وهو موقد تقليدي ياباني محفور في الأرض، يستخدم لطهي الطعام، وتدفئة المنزل أيضا، فبالنسبة له لا يوجد فرن حديث يمكن أن يستبدل الإروري في المنزل، وذلك من حيث تناغمه السهل مع بقية المعمار، وكونه المكان الذي تجتمع حوله العائلة. هنا أجد نفسي اتعاطف بشكل كبير مع الكاتب، وأعتقد أن العديد من القراء يمكن أن يتشاركون مشاعر جينشيرو. ففي مسيرة تطور المعمار العربي نجد هناك وقفة تاريخية، ولو لم تكن كاملة. فإننا نجد عندما ننظر إلى أفق المدينة أو عندما نلاحظ محيطنا داخل المنزل أو داخل أي معمار قد نعبره، افتقاره لسماتنا الثقافية في التصميم والوظيفية. ففي صدد مواكبة التطور الصناعي الجاري، حدثت حركة استيراد ضخمة لعلوم الهندسة المعمارية الغربية، بدون فلترتها وتطويعها لكي تتناسب مع البيئة والثقافة الموجودة في المنطقة العربية، فنجد تلاشي لحلول التهوية الشائعة قديماً، واختفاء الجلسات العربية داخل معظم المنازل واضمحلال الظل بين المنازل وفي المنزل ذاته.
"بهجة فسيولوجية"
"بهجة فسيولوجية"، هو ما قاله ناتسومي سوسيكي؛ وهو يعتبر أحد أكبر الأدباء اليابانيين، عن رحلته إلى الحمام في كل صباح. فيتطرق جينشيرو حتى إلى الحمامات حينما يقارن الحمام التقليدي الياباني بالحمام الغربي المزود بالبلاط والمرحاض الحديث. هنا يلتمس جونشيرو الفروقات الثقافية التي تعطي ضروريات الحياة معنى مختلف، فبالنسبة إلى الغربيين قضاء الحاجة أمر بيولوجي يجب أن يتم بأسرع ما يمكن وفي بيئة ناصعة تفضح أقل الأوساخ، فيما يضيف اليابانيون إلى حماماتهم التقليدية، والتي في العادة تكون مستقلة عن المبنى الأساسي ومبنية من الخشب، وظيفة تأملية، وتعتبره مكانا للراحة الروحية والاسترخاء، حتى انه يشك أن العديد من شعراء الهايكو عبر العصور راودتهم أفضل أفكارهم في هذا المكان. ويعترف جينشيرو أن في عناصر الأناقة هذه مقدارا من انعدام النظافة والصحة، فهناك حب عند اليابانيين للأشياء التي اكتسبت الزنجار بمرور الوقت، وخصوصاً المواعين المصنوعة من النحاس واليشم الذي يخفت بريقه بمرور الوقت أيضا.
يشدد الكاتب على مقارنة اليابان بالولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، حيث كانت اليابان في تلك الفترة أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يعود برأي الكاتب إلى عاصفة الإنارة التي اجتاحت البلاد، فأصبح من الضروري على الذين يريدون الاستمتاع بظل المساء الهادئ، السفر خارج طوكيو أو أي مدينة رئيسية بالبلاد.
لم يستطع الكاتب فهم ملئ المطاعم والمتاجر بالإضاءة الساطعة حتى في موسم الصيف. حيث تقتل الأضواء النسيم البارد وتخنق رواد المكان. وهنا يستعين بأروبا كمثال على الاعتدال الضوئي، فهناك لازال استخدام مصابيح الغاز في إنارة المدن أمرا شائعا في ذلك الوقت. ويذكر في الكتاب تعليق أحد الروائيين اليابانيين: أن مدن اليابان أكثر إضاءة من أي مدن أوروبية وأكثر سطوعاً ايضاً. فلم أستطع وأنا في صدد قراءة الكتاب إلا التفكير في رحلتي إلى اليابان ومدينة طوكيو. ومن الأشياء التي لفتت نظري حتى قبل هبوط الطائرة، هي المدينة المشعة التي رأيتها من النافذة. بانت كمحيط ضوئي ممتدة إلى أبعد مما يمكن أن تراه عيناي، وفي المساء كانت تصرخ أضواء النيون للعلامات التجارية بوجهي من كل زاوية، الإضاءة في اليابان من وجهة نظري تمثل النجاح الاقتصادي الذي استطاعت أن تحققه البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، والذي وصل ذروته في ثمانينات القرن الماضي. فكان هناك نهوض للصناعة اليابانية التي عرفت بجودتها، وانتشار واسع للأجهزة الإلكترونية اليابانية محلياً وحول العالم. التسويق ولفت النظر لكل هذا، وسع انتشار تلك الأضواء التي أصبحت معلما مهما للمدينة، ومصدرا لجذب السواح.
يتساءل جينشيرو عن مكانة بعض الفنون التقليدية التي أبقيت حية لحد وقتنا الحاضر في المجتمع الياباني، فبالنسبة له قد تلاشت البيئة التي ازدهرت فيها تلك الفنون، ولم تعد أكثر من عملية تظاهر ثقافي، ففي اعتقاده أن الفنون يجب أن تعيش كجزء فاعل في حياتنا، وإذا كان الأمر خلاف ذلك فالجدير بنا هو تركها، ودراستها كظاهرة ثقافية، باعتبار أن كان لها دور مؤثر داخل الثقافة يوماً ما. هنا نلاحظ تغيرا في نبرة تمجيد جماليات الماضي عند جينشيرو، فبالرغم من انتقاده للمجتمع، إلا أنه في أكثر من موقع في الكتاب يعترف بأهمية العملية التطويرية التي تمر بها اليابان، وضرورية التطلع إلى المستقبل.
ويذكر بصفحات الكتاب تساؤلات مهمة عن كيفية فهم الأخر، وترجمة إنجازاته بطريقة تضيف إلى الثقافة، وهو ليس بالأمر السهل بالنسبة إلى اليابان ولنا، وفي الواقع أن عملية الإضافة الثقافية عمل مؤسساتي يتطلب مجهود قطاعات واسعة من المجتمع، كل ما يطرحه جينشيرو هنا هو إثارة التفكير في كيفية التغيير، وإعطائه نفس مقدار الطاقة الذي سنعطيه لأحداثه. وبالرغم من أني وجدت أن بعض آراءه عنصرية، وبها نظرة من الممكن أن تفهم على أنها دونية تجاه المرأة. إلا أنني اعتقد أن هذا العمل يحمل تساؤلات ضرورية عن عملية التحديث والتغير الثقافي، فهو في اعتقادي من أهم الإنتاجات الثقافية لليابان الحديثة.
ترجم هذا الكتاب إلى العربية مديح السالمي ونشر من قبل دار معالم. ولكن من الضروري ذكر أني راجعت هذا الكتاب اعتماداً على الترجمة الإنكليزية التي أصدرتها دار "Vintage Classics".





















