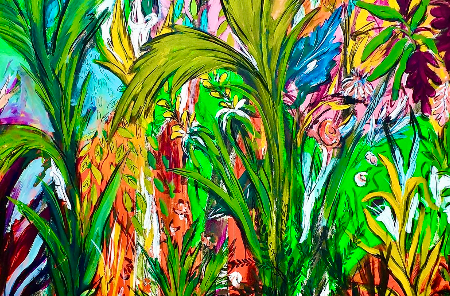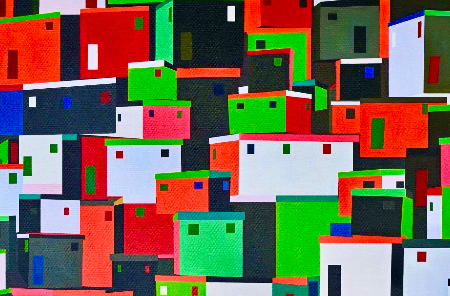وإذا ما عرجنا إلى التاريخ الإسرائيلي الذي يتقاطع مع أدبه، كوْن الرواية هي جزء منه، فإنه لا بدّ من الالتفات إلى الحقيقة. خاصة وأنَّ التاريخ ربما يكون الحقيقة الوحيدة، وأنَّ استقاء التاريخ من الأدب والعكس عندَ الصهيونية، يشكلّ معضلة جوهرية حول السؤال عن الحقيقة.
عندما قابل الكاتب الإسرائيليّ عاموس عوز، الكاتب العراقيّ علي بدر في سنة 2005، قال عوز بأنَّ "هنالك أكثر من مئة رواية إسرائيلية مكتوبة باللغة العبرية عن القدس، من دون أي رواية عربية يقابلها"، ما طفِقَ ببدر إلى كتابة روايته: مصابيح أورشليم: رواية عن إدوارد سعيد. كردة فعل على السرديات الإسرائيلية التي جعلت في رواياتها الأدبية ليس كاستدلال جغرافي، مكانيّ فقط وتاريخيّ بل أيضًا آني ومستقبلي، ينحو إلى مماهاة هوية الأرض مع الهوية الدينية للأفراد الذين يقطنون هذه المدينة وبالقوة على حدّ تعبير علي بدر. لنكون إزاء أدب: يلغي، يمحي ويزيّف، وينشأ هاسكالا (تنوير) جديد قائم على بعث الأدب العبري كأدب عنيف ودعاويّ ولاغٍ وصهيونيّ. ويضيف الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني في هذا السياق إنَّ الصهيونية قاتلت ولا تزال على جبهة اللغة، وبالتالي على جبهة الحقيقة نفسها، عن طريق إخفائها، أو اختلاقها في الأدب، في السياسة، في التاريخ أو عن طريق الإبادة. وأقصد بالإبادة هنا قتل الحقيقة وطمسها أو إنكارها وتكذيبها، ولعلَّ ما جاء على لسان ميريك إحدى شخصيات ميلان كونديرا بأنَّ "نضال الإنسان ضد السلطة هو نضال الذاكرة ضد النسيان" يوضحّ قليلًا ما يجري في فلسطين وفي هذا الفضاء المُستعمَر.
وإذا ما عرجنا إلى التاريخ الإسرائيلي الذي يتقاطع مع أدبه، كوْن الرواية هي جزء منه، فإنه لا بدّ من الالتفات إلى الحقيقة. خاصة وأنَّ التاريخ ربما يكون الحقيقة الوحيدة، وأنَّ استقاء التاريخ من الأدب والعكس عندَ الصهيونية، يشكلّ معضلة جوهرية حول السؤال عن الحقيقة.
كيف يتعامل المُستعمر مع الحقيقة؟
تختلف الحالة الفلسطينية في الطرح، ذلكَ أنَّ المُستعمر الإسرائيليّ الذي يحاول الترويج للكذبة الأولى بـ “نشر الحضارة"، لا يلبث أن يقع في معضلة الحضارة الفلسطينية السابقة التي كانت بمكنوناتها الكاملة تشكلّ تاريخ شعب واضح، بنى مُدنه وهيكلَ هويته العمرانية (التي ذكرها الكثير من المؤرخين منهم إيلان بابيه حيثُ وصف أنَّ الأساليب المعمارية الفلسطينية كانت على طراز الـ Bauhaus، وهو طراز ألمانيّ الأصل)، والثقافية والاجتماعية والسياسية وبنىً تحتية تتماشى مع ما يمكن تسميته بعجلة الحضارات الأخرى. نحنُ هنا إزاء طمس حضارة لشعب كامل، وليس نشر حضارة في مناطق تعيش فيها جماعات "بدائية" و"غير متحضرة" كالشعوب الأصلية في أمريكا إذ ما قارنّاها بمعايير المركزية الأوروبية. ونحن هنا إزاء إخفاء حضارة كاملة بعبارة "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض".
هذه الحقيقة- أي حقيقة وجود هيكلية فلسطينية كاملة قبل النكبة-، تجسدت في الأدب الفلسطيني السابق، وفي التاريخ المكتوب الذي أخفته إسرائيل أو دمرته، وفي التاريخ الشفوي، الذي أصبحَ أحد أشكال التوثيق في منتصف القرن العشرين، وأحد أدوات النضال الفلسطيني، لمواجهة المحو والمحاولات المُمنهجة لإسكات صوت الذاكرة. إذ إنَّ الحالة الفلسطينية تستدعي النبش في حياة الأشخاص العاديين لأهمية تجربتهم ولأرشفتها كوثائق تاريخية مهمّة مع غياب الوثائق الأخرى. وإذا ما عرجنا قليلًا إلى الأدب الفلسطينيّ لاستقاء بعضًا من الحقائق والوقائع فإنَّ المُذكرات على سبيل المثال لعبت دورًا مهمًّا في التأريخ الاجتماعي بدلًا من كونها فقط سيَر ذاتية خاصّة. كمذكرات هالة السكاكيني التي تروي فيها حياتها في عهد الانتداب البريطانيّ وفي مدرستها وفي حيّها التي سكنت فيه. وتذكر السكاكيني الوجبات التي كانت تعدّها أمها من المسخّن والمقلوبة، وتصف مدينة القدس ونمط الحياة فيها لتظهر العاصمة وكأنها الزخم الرئيسي في مذكرات السكاكيني، ولتكون القدس هُنا تكثيفا للذاكرة الفلسطينية التي لا يمكن إلّا وأن تكون أداة للتعبئة السياسية المقابلة للحقيقة التي تفرضها إسرائيل بكافة الوسائل.
فالحقيقة عندَ المُستعمر، هي حقيقة مستمدَّة من القوّة، تتجسد في تاريخ واحد رسميّ، تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين خاصة وأنَّ من عادة المُستعمر الهيمنة على كافة وسائل إنتاج الأبستمولوجيا، تماشيا مع خطابه وقوة سلطته التي تصبح جزءا لا يتجزأ من الهيكلية الاجتماعية والثقافية. لذلك نجد أنه في حالة المُستعمر الإسرائيلي، للتاريخ الأحاديّ جوانب عدّة: تاريخ كتبه الأقوياء، وتاريخ بناه الأدباء الصهاينة في سرد الروايات عن طريق المخيال الأدبي، الذي لا ينفصل عن المخيال السياسي وعن طريق الأبستمولوجيا التي تسيطر عليها الأجهزة الإسرائيلية بكافة وسائلها التعليمية والثقافية والفنية. وكذلك تاريخ بُنيَ على إخفاء كافّة الأرشيفات التي سرقتها العصابات الصهيونية في النكبة الفلسطينية، من المنازل والمكاتب والمكتبات الفلسطينية، وعلى إخفاء مذكرات ومراسلات من شاركوا في المجازر وفي القتل والنهب. وهذا ما ظهرَ حقيقة في الروايات والكتب التي صدرت فيما بعد من قِبَل المؤرخين الإسرائيليين الجدد، حينَ سمحت الحكومة الإسرائيلية بالاطلاع على بعض الأرشيفات الإسرائيلية التي أخفتها على مدار سنوات طوال. وأيضًا عن طريق التدمير العمرانيّ المُمنهج، للعودة إلى مقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" واستخدامها في الخطابات السياسية لجعل الآخر، الدخيل، غير مؤهل لأن يكون حضاريًا، ولتبقى كحجة لمقاتلة "الحيوانات البشرية" في حال، قامت هذه الأخيرة برفع صوتها.
ماذا يعني العودة إلى التاريخ في الحالة الفلسطينية؟
يذكرُ المؤرخ الإسرائيليّ إيلان بابيه في كتابه "فكرة إسرائيل.. تاريخ السلطة والمعرفة"، أنَّ في إحدى ليالي تمّوز الحارّة لعام 1994، وفي الوقت الذي كانَ هناك مباراة مهمة تجري في الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم في أمريكا، اعتقدَ بعض منظمي مناظرة حول "المعرفة والقوة في إسرائيل" بمدينة تل أبيب أنَّ عددا قليلا من الأشخاص سيأتي ليشارك، لكن ما أذهلهم حقَّا العدد الذي فاق الـ 700 شخصا، أتوا للاستماع إلى المناظرة التي قال عنها بابيه أنها لم تكن حوارا كما وصفها الإعلان، بل كانت نقاشات حادّة، ما حذا به السؤال عن: هل كانت الأكاديميا في إسرائيل أداة أيديولوجية في يد الصهيونية أم كانت منارة لحرية الرأي والتفكير والتعبير؟ وعطفًا على هذا السؤال، فإنّه لا بدّ من الخوض فيما أوردته حنّا أرنت حين قالت أنَّ "حكم الفكرة" الذي تتميز به السلطة، خاضعة لفكرة أحادية أكبر، تتوجّها الأيديولوجيا وتكون أداة دعاية عظيمة إذ تجعل "الهابيتوس" (الذي تكلم عنه بيير بورديو كثيرا) سياسة تتبعها. وعودة قليلا إلى الوراء فإنَّ التاريخ الإسرائيلي باعتقاد القادة الصهاينة هو "التمظهر الحتمي الناجع لتاريخ الأفكار الأوروبية" على حدّ قول بابيه، وتُعتبر إسرائيل إحدى أفكار هذا التحول، أو أنَّ أفكارها هي إحدى العناصر التحويلية للوصول إلى "التنوير" ونقل المجتمع من الظلمات إلى النور على غرار مجتمعات القرون الوسطى والتحول إلى نور النهضة، ولا بدَّ من ذكر ما قاله نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في حربه الدائرة اليوم على غزّة: إنها حرب النور على الظلام. يعني أنَّ نتنياهو اليوم، يجسد قول القادة السابقين في وضع الحضارة بمسارها الصحيح.
يقول إيلان بابيه إنَّ قادة الحركة الصهيونية أولوا اهتمامًا كبيرًا بالعمل التأريخي الأكاديمي، وخصصوا جوائز كبيرة لهذا المجال، ذلك لإعادة كتابة التاريخ الفلسطينيّ بطريقة ترضي وتتوافق وأقوالهم الداعية بأنَّ لإسرائيل الحقّ في "الأرض الخالية". لذلك كانَ من الصادم في هذه المناظرة (أعلاه) التي كان بابيه جزءاً منها وضع مجموعة كبيرة من الإسرائيليين "الواقع الأخلاقي" لدولتهم المنشودة في محل شكّ صارخ! وبالتالي فإنَّ العودة إلى أرشيفات هذه "الدولة" يعني النبش في الحقيقة مرة أخرى، وهذه المرّة حقيقة التاريخ الذي أخفته إسرائيل حينَ سوّقت لفكرة الصهيونية "كسلعة"، بهدف إقناع العالم بحقيقتها. وحينَ استخدمت البُعد الأسطوري إذ صحّ القول، لفكرتها بهدف تعبئة الذاكرة، والتي استفادت منها لممارسة نفوذها واستعمارها.
كيف ينتزع المُستعمر الحقيقة من الواقع؟
في ربيع نيسان 1996، وفي الحرب التي سُمّيت بـ عناقيد الغضب، على لبنان، قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مجمّع الكتيبة التابعة لقوة الأمم المتحدة في قانا- الجليل المحاذية للحدود الفلسطينية، أدّى ذلك إلى وقوع أكثر من 100 قتيل وأكثر من 100 جريح لبنانيّ، بعدَ أن احتمى فيها أكثر من 800 مدنيّ، هربوا من منازلهم إلى "أمكنة آمنة". وشهدت هذه المنطقة أفظع المجازر المُرتكبة بعدَ أن تناثرت الأجساد والأشلاء والأبنية على رؤوس من فرّوا ذاعرين إليها. لما العودة إلى هذه الحادثة؟ لأنَّ التاريخ عندَ المُستعمَر، يتكرر مرة على شاكلة مأساة وأخرى على شاكلة مأساة أيضًا إلى حدّ المهزلة. خاصّة وأنَّ ذات المُستعمِر في فضاءٍ مكانيّ مختلفٍ، ومنذ مدّة زمنية ليست بالبعيدة، تحديدًا في مدينة غزّة ارتكب أيضًا مجزرة في مستشفى المعمداني، راحَ ضحيتها حواليّ الـ 500 قتيل ومئات الجرحى.
حاولت إسرائيل بكلتيّ المجزرتين التشكيك في الواقع، وإبعاد الحقيقة عن الساحة، ذلك لأجل تبرئة نفسها أمامَ الرأي العام العالمي، والدوليّ. وإذا كان مصطلح "ما بعد الحقيقة" الذي يعني التشكيك في الحقائق الواقعية والموضوعية قدّ ظهرَ في عام 2016، عقب الانتخابات الأمريكية وما صاحبه من الظاهرة الترامبية، فإنَّ هذا لا يعني أنه لم يوجد قبل. يمكن القول أنّه امتداد لتاريخ الكذب الذي تطرقت إليه حنّا أرندت حينَ تكلمت عن المخاطر التي تنشأ من التلاعب الحديث بالحقائق. ذلك أنَّ فنّ الكذب القديم لهُ حدود معينة، يمكن للمؤرخين والباحثين كشفه عبر الثغرات أو التناقضات، أمّا الحديث منه فهو يجعل صانعيه حتّى، يصدقونه!