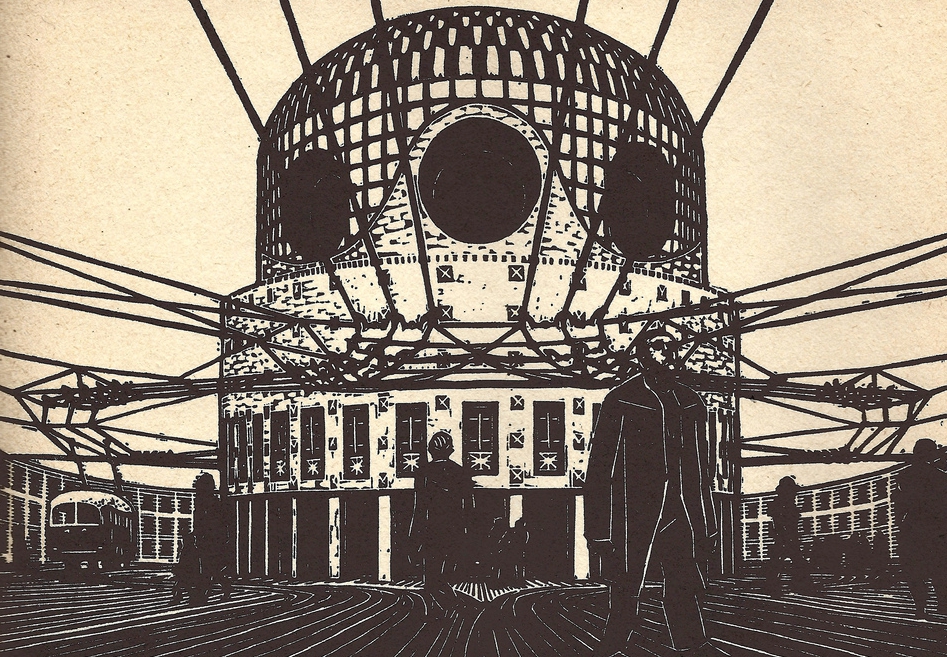طلبتُ اللجوء في ماشتا، أواخر ٢٠٠٨.
– هل لديك عنوان؟ لا.
كان لدي ولكنني لا أريد أن أكون ثقيلا على أحد، أنا شخص فخورٌ بنفسه، ولا أرغبُ أنْ أُحرجَ أي صديقٍ، قضيتُ ليلتين في مركز اللجوء إلى أنْ أصبحَ العدد كافياً لنقلنا، جمعونا في باص وأرسلونا إلى يافلي شمالا، هناك بقيتُ ما يقارب الخمسة أيامٍ أنتظرُ المدينة التي سيتم فرزي إليها، في صباح اليوم الخامس قالت لي الموظفة أنه قد تم فرزي إلى شيليفتيو، وأشارت إلى المدينة بإصبعها على خريطة السويد المعلقة على الحائط، كانتْ المدينة في شمال السويد لدرجة أنَّ الموظفةَ اضطرتْ أنْ تقفَ على أطرافِ أصابعها لتصلَ بإصبعها إلى المدينة وتقول لي: هنا.
– لن أذهب هناك، إنه القطب الشمالي، قلتُ.
كنتُ أشعرُ بقهرٍ ثقيلٍ يجثم على صدري، يشعرُ به كل مَنْ لا يستطيعُ أنْ يعترض.
– لا تستطيعُ أنْ تختارَ ولا أنْ تُبدل، قالت بحزم وأضافت:
– أنت محظوظ.
جلبتْ الكرسي وصعدتْ إليه حتى استطاعت أن تصل بإصبعها إلى نقطةٍ في أعلى الخارطة المعلقة على الحائط:
– أترى هذه المدينة، إنها كيرونا، كثير من الواصلين هنا قد تم فرزهم إلى كيرونا، أنت محظوظ لأنك فرزت إلى شيليفتيو، يجب أنْ تكون شاكراً لأنك لن تكون في كيرونا.
حرارتي مرتفعة، بدأتُ بالهذيان، توقفَ سائق الباص الذي يقلنا إلى شيليفتيو على حافة الطريق، وجاء إلى مقعدي، وضع يده على جبهتي، ذهب ثم عاد حاملا حبة أليفيدون، قال لي هذا قد يخفض الحرارة إلى أن نصل إلى شيليفتيو، في الصباح بعد توقف الباص في شيليفتيو لفترة قصيرة، تبيّن أنهم سيرسلونا إلى بلدة تدعى بوليدن، تبعد ما يقارب الثلاثين كليومترا عن شيليفتيو داخل الغابات، وصلنا صباحاً وكانت حرارتي لا تزال مرتفعة، تفرق اللاجئون كل إلى سكنهِ الذي كان معداً سلفاً له، أخذني شخص ما بعد أنْ تأكدَ أنني الشخص المطلوب إلى بيت من طابقين، كانت الساعة تقارب السابعة صباحاً على ما أذكر، طرقَ على الباب رغم أنه يحمل مفتاحاً، بعد طول انتظار فتح شاب في العشرين الباب، كان البيت عبارة عن صالون ومطبخ وتواليت في الطابق الأرضي، وغرفتي نوم وحمام في الطابق العلوي، قال لي موظف الهجرة، كل إثنان في غرفة، صعدت إلى الطابق الثاني حيث سريري، رميت حقائبي وخرجت كي أتفقد المكان الذي وصلت إليه.
لاحقاً، لم يتعامل معي سكان البيت خلال الـ ٤٥ يوما التي قضيتها في بوليدن، كانوا يأملون بأنِّي سوف أيأس وأطلب من دائرة الهجرة نقلي إلى منزل آخر، كانوا يأملون أن يكون سكان المنزل من الصومال فقط، لم يكونوا يسلمون علي، ولا يردون السلام حين أبادر، فلم أعد أبادر بالسلام، وحين غادرت المنزل باتجاه ستوكهولم كانوا نائمين، خمسة شباب من الصومال، عشت معهم ٤٥ يوما دون أن أعرف أسماءهم، دون أن يسألوني من أين جئت.
يا الله ما أصعب أن تفقد كل شيء في يوم واحد، مدينتك، أهلك، أصدقاءك، حبيبتك، رائحة الشوارع التي اعتدت عليها، دمشق التي قست عليك، الشوارع التي سرت فيها، ذكرياتك….
أن تجد نفسك في بلد جديد، لا تعرف عنه شيئاً، مرميا في بلدة شبه مهجورة، لا يوجد من تكلمه، لا يوجد من يكلمك، لا يوجد من يفهمك، ولا يوجد من لا يفهمك أيضاً، ببساطة، لا يوجد أحد.
كنت أذهب إلى سوبرماركت إيكا أكثر من عشر مرات في اليوم، دون أنْ أشتري شيئاً.
– أنا لستُ لصاً، أرجوك لا تتبعني، صدقني، أنا لست لصاً.
حاولتُ أنْ أشرحَ للشاب الذي يعمل في السوبرماركت، حاولت أن أبدو متزناً وأنا أؤكد له أنَّ كل ما في الأمر أنني أريدُ أنْ أرى الناس، إنَّ المكان الوحيد الذي يتواجدُ به بشرٌ في بوليدن هو سوبرماركت إيكا.
كنت أسير في البلدة، أبحث عن أي أمل بالحياة، أتأمل البيوت، لقد كان أمراً خارجا عن المألوف أن تكون جميع النوافذ في جميع الغرف في جميع المنازل في هذه القرية مضاءة، وأنت تحاول جاهدا لمدة خمس وأربعين يوماً من البحث المتواصل، أنْ تلمحَ شخصاً واحداً، ولكنْ عبثاً، كانت مدينة أشباحٍ بكل معنى الكلمة، بعض المنازل كنتُ أدورُ حولها من جميع الجهات، أستطيعُ أنْ أراها مضاءةً من جميع الغرف، ولكنْ لا أحد، أين الناس، من هم أصحابُ هذه البيوت، من الذي يشعلُ الأضواء ويضعُ الشموع خلف النوافذ؟ ولمن يضيؤون الشموع؟ كنتُ أبحثُ عن أيِّ أثر للحياة في بوليدن كما تبحث ناسا عن أي أثر للحياة في المريخ، الفرق بيننا أنْ ناسا لديها أملٌ باكتشاف الحياة على المريخ.
أقسم بالله أنني مرة كنتُ سائراً، فرأيتُ دراجةً هوائية ساقطة على الرصيف، قررت أنْ أرفعها، وحين هممتُ بذلك صرختْ فتاةٌ وجاءتْ نحوي، أخذت الدراجة من يدي بقوة.
كانتْ تظنُ أنني أقومُ بسرقة الدراجة.
لم أعرف ماذا أقول، ولكنني في تلك اللحظة أدركتُ أنَّ القرية مليئةٌ بالناس، وأنني وإنْ كنتُ لا أراهم، فهم يرونني.
بالمناسبة، لقد كانتْ تلك الفتاة أول فتاة أراها في بوليدن.
ذهبت إلى شيليفتيو لشراء يو إس بي لكي أتصل بالإنترنت، دخلتُ أول متجر للاتصالات:
– أرغبُ بشراء يو إس بي مودم للإنترنت.
– لدينا واحدة تكلف ٢٠٠ كرون شهريا، بعقد لمدة ٢٤ شهراً.
– جيد، سوف آخذها.
– رقمك الوطني لو سمحت؟
– أوه، ليس لدي رقم وطني.
– آسف جداً، ولكن لا تستطيع شراءها بدون رقم وطني، فنحن يجب أنْ نسحبَ من حسابك البنكي ٢٠٠ كرون شهرياً ولا نستطيع أنْ نفعلَ ذلك دون أنْ تكون مقيما ولديك رقم وطني.
– لا مشكلة، عقد لمدة ٢٤ شهراً، بكلفة ٢٠٠ كرون في الشهر، هذا يساوي ٤٨٠٠ كرون سويدي، تفضل، هذه ٤٨٠٠ كرون سويدي نقدا وبدفعة واحدة.
– أسف لا تستطيع، يجب أن تدفع ٢٠٠ كرون شهريا.
– أوكيه، أنا أقوم بذلك الآن، أنا أدفع لك ٢٠٠ كرون شهريا، وأعطيك الـ ٢٤ شهرا دفعة واحدة. أنا من سيخسر في أسوأ الحالات.
– آسف، لا يجوز، يجب أن يكون لديك رقم وطني.
– ولكن أنا لن أهربْ دون أنْ أدفع، على العكس، أنا أدفع سلفاً، أنا من سيكون في موقف ضعف إنْ أنا غادرت البلد مثلاً، فستكونون قد حصلتم على مال مجاني.
– آسف، لا يجوز، يجب أن يكون لديك رقم وطني.
– ولكن…
– آسف، لا يجوز، يجب أن يكون لديك رقم وطني.
– أنا
– آسف، لا يجوز، يجب أن يكون لديك رقم وطني.
….
– آسف، لا يجوز، يجب أن يكون لديك رقم وطني.
كان صيد السمك هو الشيء الوحيد الذي أنقذني، فقدت كنت في بوليدن معزولا عن التواصل المباشر مع الناس، وغير قادر على التواصل عبر الانترنت لأنك تحتاج أن تكون سويديا لكي تحصل عليه، كان صيد السمك ينتشلني من الوحدة القاتلة، كان الشيء الوحيد الذي يضعني على تواصل مباشر مع شيءٍ حي، ففي اللحظة التي تأكل سمكة الطعم وتعلق بالسنارة، يتحول خيط السنارة إلى شريان يصل ما بين يدي والسمكة، اتصال سلكي مع شيء حي، في وسط هذا الكوكب المهجور، في إحدى المرات وقفت بجانبي عجوز سويدية لطيفة، سألتني عن نوع السمك الذي أصطاد، وسألتني من أي بلادٍ جئت.
– من دمشق.
– في أفريقيا؟
– لا إنها تقع في سوريا، أسيا.
– آها. هل هناك مجاعة في سوريا؟
أوه، لا، لا يوجد مجاعة في سوريا.
– حقاً، لا يوجد مجاعة في سوريا؟
– آه، نعم، ١٠٠٪، لا يوجد مجاعة.
تلك العجوز العنيدة لم تقتنع بإجابتي، وظلت تكرر أسئلتها إلى أن وصلت إلى السؤال الحقيقي الوحيد في دزينة الأسئلة الفارغة التي رمتها علي:
– هل يوجد بطاطا في سوريا؟
وحين قلت لها نعم، تنفست الصعداء واقتنعت أنه لا يوجد مجاعة في سوريا.
جلبتْ الكرسي وصعدتْ إليه حتى استطاعت أن تصل بإصبعها إلى نقطةٍ في أعلى الخارطة المعلقة على الحائط: أترى هذه المدينة، إنها كيرونا، كثير من الواصلين هنا قد تم فرزهم إلى كيرونا، أنت محظوظ لأنك فرزت إلى شيليفتيو، يجب أنْ تكون شاكراً لأنك لن تكون في كيرونا.
في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٨، في منتصف الخريف، كانت البحيرة في بوليدن متجمدة تماماً، وتستطيع أن تسير فوقها، لقد كنت الفلسطيني الثاني عبر التاريخ الذي مشى على الماء.
في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٨ تجمدت البحيرة الصغيرة، عرفت أنها مسألة وقت قبل أن تتجمد البحيرات الكبيرة أيضاً، لا صيد سمك بعد الآن، قررت الرحيل.
كان معي ٦٠٠ كرون، كان سعر تذكرة القطار إلى ستوكهولم ٨٥٠ كرون في ذلك اليوم، ذهبت إلى مطعم البيتزا، خلعت ساعة يدي، وضعتها على الطاولة قلتُ للرجل الكردي الذي يكاد يعرفني:
– اسمع، أريد ٢٥٠ كرون وسوف أضع ساعة يدي كرهن إلى أنْ أرسل لك النقود بالبريد.
ضغظ بإصبعه فانفتح درج الحاسبة، قال لي:
– خذ ساعتك والمبلغ الذي تحتاج وأرسله لي حين تستطيع.
استرجعت ساعة يدي، مددت يدي بثقة إلى الدرج، أخذت ٢٥٠ كرون، طلب مني أن آخذ أكثر، رفضت وشكرته وخرجت.
قلت لسائق الباص السويدي إنني لا أملك نقوداً، وأنني أريد أن أذهب للقرية المجاورة لكي أركب القطار إلى ستوكهولم، ابتسم وقال لي تفضل.
قالت لي الفتاة التي تجلس بجانبي في القطار بعد أن تحدثنا:
– هل أنت حقاً ذاهب ستوكهولم وليس لديك مكان لتعيش فيه؟
– أجل.
شعرت أنها لم تصدق ما قلتُ لها، فساد بيننا الصمت.
بعد أكثر من ١٣ ساعة وصلنا في الساعة السابعة صباحاً إلى ستوكهولم، جلستُ على مقعدٍ خارج المحطة، أدخن وأنظر إلى الساعة، السابعة والنصف صباحا، أدخن وأنظر إلى الساعة، الثامنة، أدخن وأنظر إلى الساعة، الثامنة والنصف، أدخن وأنظر إلى الساعة، التاسعة، أدخن وأنظر إلى الساعة، التاسعة والنصف، في تمام العاشرة أجريت اتصالاً:
– من غياث؟
– التقيت بك في بوليدن قبل أن تهرب إلى ستوكهولم.
– …
– أريد أن أضع حقائبي في منزلك.
– أين ستنام؟
– عند بعض الأصدقاء.
– هل تعرف هوسبي؟ إنها على خط المترو الأزرق، هل لديك كرت مواصلات؟ اتصل بي حين تصل إلى هناك.
– نعم أعرف هوسبي، ولدي كرت مواصلات، قلتُ.
لم أكن أعرف أين تقع هوسبي، وليس لدي كرت مواصلات ولا نقود، سألتُ، والذي يسألُ لا يتوه، وصلتُ إلى هوسبي، جاء محمود وأخذني إلى حيث يعيش مع خمسة شباب آخرين، حين وصلنا المنزل كان الشباب قد حضّروا إفطارا ملكياً بانتظارنا، أكثر من عشرة أطباق، يعرف منها السويديون الحمص والباباغنوج، وكان هناك خبز عربي، ٤٥ يوما في بوليدن لم أتذوق فيها الخبز العربي، أكلت وشربت شايا فلسطينيا بالميرمية ونمت.
في المساء قال لي:
– غياث، لو كان لديك أصدقاء في ستوكهولم لما احتجت أن تضع حقائبك في منزلي، تستطيع أن تبقى هنا لعدة أيام إلى أن نجد لك مكاناً.
في مساء ذلك اليوم، كانت أول مرة يحدث في تاريخ السويد المعاصر أن تجد منزلاً منذ أول يوم من البحث، كما أكد لي محمود ضاحكاً، لقد وجد لي سكناً مع خمسة شباب في روغزفيد، بقيت هناك لسبعة أشهر، كان الشيء الوحيد الخاص هناك، فرشاة الأسنان.
منذ تلك اللحظة قبل سبع سنوات وإلى اليوم، لايزال محمد بلا تصريح إقامة.
بعد وصولي إلى بوليدن في سبتمبر ٢٠٠٨، قالت لي إحدى موظفات دائرة الهجرة ذات الأصول غير السويدية مازحة، إن هناك شيئين لا يمكن أن تثق بهما في السويد، الطقس والرجال.
لقد كان تعميماً سخيفاً، مجرد كليشيهات وانطبعات مسبقة تضع جميع الرجال في قالبٍ واحد.
وقد تبين لي مع مرور الأيام أنها كانت مخطئة تماماً، وأنكم ببساطة تستطيعون أن تثقوا بالطقس في السويد.
نُشر هذا النص في مجلة بروڤينس الأدبية السويدية التي طلبت مني كتابته في نهاية العام ٢٠١٥، وهو مقتطفات من ذاكرتي عن طلبي للجوء في السويد في خريف سنة ٢٠٠٨، تغيرت الظروف في السويد بعد صعود اليمين المتطرف في الغرب وتغيرت الظروف في سوريا أيضاً، البلد الذي غادرته شبه هارب في سنة ٢٠٠٨، بالإمكان توقع أنَّ ظروف اللجوء اليوم أسوأ بعشرات المرات مما كانت عليه قبل ثماني سنوات، لكن لاتزال الحرية تستحق أن نتبعها أين ما حلت، حتى وإن هجرنا أوطاننا.
وكما قال جدِّي الشنفرى:
وفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَرِيـمِ عَنِ الأَذَى
وَفِيهَا لِمَنْ خَافَ القِلَـى مُتَعَـزَّلُ.