يؤكد السوري فوّاز حدّاد (1947)، أن الكتابة مسؤولية أخلاقية، وأنه لم ينشر رواية إلا وهو راض عنها، إنسانياً وفكرياً وأدبياً وأخلاقياً وجمالياً وسياسياً. وأنه لم يكن يوماً في المعارضة، ولا في أي حزب سياسي، كما لم يتعامل مع “دولة البعث”، ولا هو انتسب لاتحاد الكتّاب العرب بدمشق. كاشفاً في حوارنا معه حول سيرته ومسيرته الأدبية، فحياته تتسلل إلى رواياته رغماً عنه، وكل رواية من رواياته لا تخلو من شيء منه، من تجربته أو من حياته الشخصية.. هنا تفاصيل كثيرة عن صاحب «السوريون الاعداء» الإنسان والروائي المنتمي لثورة شعبه ضد الظلم والطغيان والاستبداد..
«الشاعر وجامع الهوامش» (“دار رياض الريّس”، 2017)، رواية كتبتها في أتون المحرقة السورية، عن الحرب والناس، الثقافة والدين، الطائفية والحب والجريمة، كيف تقدمها لقراء “رمان”؟ وما الذي تمثله ضمن مشروعك الروائي؟
لا تُقدم الروايات، إلا على سبيل التعريف بها، وبشكل موجز جداً، اذ أن أي تلخيص للرواية مسخ لها. وربما في بعض الإشارات دلالة عنها. إنها عن سورية في ظل تحولات تجري تحت القصف، الحدث في العام الخامس من الثورة التي أصبحت حرباً شاملة؛ الخوف المهيمن، تخندق الناس، انحطاط الثقافة، تكريس الطائفية، جرائم القتل والخطف والاغتصاب، تهتك الأواصر، اختلاق أديان جديدة… ومساءلات الضمير. العناوين كبيرة، لكن الحدث هائل أيضاً، وانعكاساته الكارثية ستدوم عقوداً.
كنت أظنها تجربة تكتب والحرائق تشتعل، رواية آنية تجري ملاصقة لما يجري آنياً، غير أنها تشعبت، وأظهرت ألا مواعيد محددة للكتابة، ومن الممكن الكتابة في طريق مسدود ومن دون أوهام، بلا مجاملة، أو حسابات تراعي أحد.
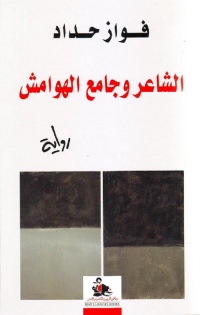
هذه الرواية هي الثانية بعد «السوريون الاعداء» (2014) عن الثورة السورية، سؤالي: لماذا كانت الثورة في سوريا من وجهة نظرك؟
ببساطة لم يعد الناس يتحملون كل هذا الطغيان والفساد من أجل ممانعة كاذبة ومقاومة زائفة. طالبت الثورة بالكرامة والحرية، ضد الاستبداد والنهب. حتى الموالون يعرفون هذا ولا ينكرونه، ليس أكثر من الوضع السوري كان مكشوفاً، الفساد شامل، والمخابرات أجهزة مراقبة وقمع وكتم أنفاس، كأنما هناك صك ملكية، يبيح لهم التحكم بمصائر سورية والسوريين، هذا الحال كان مرشحاً للاستمرار، النظام حدد مدة بقائه، وكانت إلى الأبد. التوريث أصبح قانوناً سارياً، كوفئ به كل من تواطأ مع النظام، وشملت امتيازاته أولادهم وأحفادهم. أما الشعب فمن الإرث، ولهم حرية التصرف به كيفما يشاؤون يتناقلونه ويتوازعونه ويتقاسمونه، يحق لهم معاقبته وتأديبه وسجنه وتعذيبه وقتله وحرقه والتمثيل به… وتسميمه بالكيماوي.
تتعرض رواية «الشاعر وجامع الهوامش» إلى المثقفين الذين في الداخل من خلال شاعر ومثقف، وفي الكثير من كتاباتك تنتقد “صمت المثقفين” وسلبيتهم. ما الذي يتوجب على المثقفين فعله، خاصَّة من بقي منهم في الداخل، ونحن نعلم ما يعانونه من تضييق أمني واعتقالات وتعذيب وقتل؟
انتقدت المثقفين الموالين للنظام والمدافعين عنه، بعضهم كانوا من اليساريين الأقحاح، وبعضهم أيضاً من المعارضين المزمنين، هؤلاء وغيرهم أوجدوا الدوافع الخيّرة للاستبداد، دافعوا عنه وبالغوا في انكار جرائمه. هناك طغمة منهم تتميز بالانتهازية أدانت الثورة على أنها إرهابية، وباركوا إرهاب الدولة، وصمتوا عن جرائمه، وكرسوا أقلامهم للتنكيل بالمعارضين.
أما صمت المثقفين الذين اضطروا، أو آثروا البقاء في الداخل، فقد كتبت مراراً عنهم، ووصفت صمتهم بالمقدس. لا أحد يرغب في أن يكونوا ضحايا مجانيين لنظام مجرم. إنهم يقفون في الخندق المعارض للنظام، يعانون ويدفعون الثمن مضاعفاً.
«السوريون الاعداء» رواية رأى النقاد أنها “أشبه بـ«البيان رقم واحد» الذي يريد شنّ انقلاب عسكري عن طريق… رواية!”. ما هي مسؤولية الكاتب/الروائي في إيصال رسائل تُعنى بكل أبعاد الواقع المُعاش؟ وهل يمكن الفصل بين الثقافي والسياسي؟
لم تكن بيان رقم واحد، ولا انقلاب. إنها رواية تحاول أن تجد جواباً على سؤال لماذا لم يكن هناك بديل عن الثورة؟ فالثورة كانت ضرورية، ولذلك كان الذهاب إلى سجن تدمر، وإلى قصر العدالة، وأن نشهد مجزرة حماة، ونتجول في القصر الجمهوري وأقبية المخابرات. من خلال تتبع مسيرة ضابط صعد إلى القمة. وكان الصعود في ظل هكذا نظام يعني ألا روادع، وكان الانتقال من مرحلة إلى أخرى يحتاج إلى مؤهلات خيانية والاستعانة بالوشاية، والتدريب على القتل. هذه الكفاءات هي ما جعله صالحاً للتقدم المستمر في مجاهيل دولة الفساد والمخابرات إلى حد أنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه التركيبة، وإلى الدفاع عن النظام حتى ضد النظام نفسه.
هل الكاتب معنيٌ بنقل هذه الحقائق؟ طبعاً وهي مسؤولية أخلاقية، قبل أن تكون مسألة رواية أو لا راوية. من هنا تأتي أهمية عدم إمكانية الفصل بين الثقافي والسياسي. الروايات الكبرى في العالم شددت على التواشج والانسجام بينهما، حتى روايات د.ه.لورانس كانت نقداً لتزمت العصر الفيكتوري. هل يدعى هذا نقداً للعرش البريطاني حصراً، أم للمنظومة السياسية والاجتماعية التي شملت ذاك العصر؟

لاقت «السوريون الاعداء» نقداً لاذعاً من بعض النقاد، إذ ذهب أحدهم للقول إن “الحضور الروائي كرّس خفوته لصالح الصراخ السياسي. كاسراً المسافة بين المقالة والرواية، بحيث يكاد القارئ لا يفرّق في معظم صفحات الرواية إن كان يقرأ كتاباً سياسياً أم عملاً أدبياً.. وترسّخ الحضور الفج للمواقف السياسية وتصفية الحسابات”. ما هو تعليقك؟
هذا النوع من النقد يمثل مقولات متداولة عندما يراد إسقاط رواية بدعوى أنها كتاب في السياسة لا عملاً روائياً. هذا ما يتذرع به ببغاوات النقد، أضف إليه الشطح في الكذب. الذين انتقدوني كانوا من المثقفين الموالين، بالتالي تقييمهم للرواية كان ضدي لأنهم مع النظام، والاتهام كان المساهمة في نزيف الدم السوري. أما الذين يدّعون المعارضة بينما هم على علاقة طيبة بالنظام، فاتهموني بالطائفية، وبأنني من الإخوان المسلمين. المتاجرة بهذه الاتهامات أصبحت مقولات نقدية ضد الرواية. هذا لمجرد أنني تعرضت لمقدمات الحدث السوري الهائل بوضوح وشمولية.
هناك آلاف من القراء اطلعوا على الرواية، وقرأت تعليقاتهم على الفيسبوك، إضافة إلى النقاد، الذين اعتبروا أنها رواية كانت عن سورية والثورة، لا تمالئ ولا تحابي، حاولت رسم صورة بانورامية عن الحدث في مفاصله الكبرى.
أما الانتقادات التي طرحت حول أنها في معظم صفحاتها كتاب في السياسة، فهذا كذب فاضح، فإذا ورد حديث في السياسة لا يتجاوز صفحة أو أقل في رواية من خمسمائة صفحة، تدور حول حدث له طابع سياسي يتصل بالعدالة، فما المستغرَب؟ هل في عذابات السوريين حضور فج للمواقف السياسية؟ لا ريب أن في تجنبها وإلغائها إرضاء لأمزجتهم الرؤوفة… ماذا عن معاناتهم أمام مشاهد الشقاء الإنساني، لمجرد أنه تقع في دول أخرى؟ أما شقاؤنا، فيحتاج إلى موافقة من جهاز المخابرات بالذات. ينكرون سجن تدمر، ويدّعون أن المراجع المعتمدة في روايتي هي ما كتبه الإخوان المسلمون، وكأن سلطات السجن ستطلعني على سجلات موثقة عما ارتكبوه من تعذيب ومشانق. يكفي القول إن هؤلاء المثقفين يعتبرون المساجين الإسلاميين يستحقون الشنق والسحل.
وإذا ادعوا المعارضة، فانتقاداتهم محدودة ببعض أفراد أجهزة الأمن الذين يتجاوزون صلاحياتهم لا أكثر. ومنهم من يتباهى بأنهم ضد النظام والمعارضة دفعة واحدة، ومواقفهم تتعدى الإثنين معاً، فهم يحلقون في العالي في سماوات الإنسانية الرحبة، فأي تبجح هذا الذي بلا خجل!! إنهم بكل جلاء من عدة النظام الثقافية العلنية والمستورة. ما دام أنهم بهذه الاستقلالية والجرأة، لماذا لا يشيرون إلى المجرم الذي يطالعنا بجرائمه صباحاً ومساءً؟
أما عن تصفية الحسابات، فأنا لم أكن يوماً شيئاً في المعارضة، ولا في أي حزب سياسي، ولم أتعامل مع دولة البعث، ولا انتسبت لاتحاد الكتّاب العرب، كان هذا خطي منذ بدأت بنشر أول رواية لي وحتى الآن، كاتب روائي، انتهج خطاً لم يزح عنه، منذ وقت مبكر تحولت إلى النشر في بيروت لأستطيع الكتابة بحرية. وإذا كنت قد كتبت عن الحدث السوري، فلأنني أشعر ككاتب بالمسؤولية تجاه البشر. فلماذا لا أشعر بالمسؤولية تجاه شعبي؟ هل الإنسانية شيء غائم جداً بحيث لا تشمل السوريين؟
أخيراً، الرواية بمتناول القراء على الإنترنت، وليقولوا لنا هل هو كتاب في السياسة، أم أنه رواية موضوعها البشر والسياسة والحياة.
إلى أي مدى يمكن أن يساهم الالتزام السياسي بفكر أو قضية ما على الناحية الجمالية أو الفنية للعمل الإبداعي، خاصة وأن هناك نقاداً يتهمون “النص السوري” اليوم بأنه نص مباشر وانفعالي؟
أعتقد أن موضوع الالتزام السياسي وتأثيره على الناحية الفنية للعمل الإبداعي، قضية باتت مختلقة، أولاً، ليس هناك كاتب غير ملتزم، كلنا ملتزمون، لكن بماذا؟ أي كل منا ملتزم على نحو ما. ودائماً هناك قضايا كبيرة أو صغيرة تستهوي الكاتب، ويشعر أنه مسؤول حيالها، ومن السخف تسفيه هذه أو تلك، وبمقدار قناعة الكاتب بها يمنحها المشروعية.
عادة، لا ينكر الكتّاب التزامهم بالإنسان. لكن الذي لم يخطر ببال، هو نشوء أنواع من الالتزام في عصر العقل مضادة للعقل، ليس الزمن ببعيد عندما طأطأت شعوب بحالها للدول الشمولية، وظنت أنها سائرة على طريق اليوتوبيا. تجد دولة اشتهرت بكبار الفلاسفة والموسيقين، نادت بنقاء العرق الآري، واليوم نشهد في بلادنا التزاماً بالديكتاتوريات، وبتأييد من دول الغرب.
المثير أن هناك من يتكلم دائماً عن الناحية الفنية في العمل الإبداعي، والمثال الحاضر اليوم هو “النص السوري” لماذا ينفعل الأدباء السوريون في كتاباتهم؟ السؤال الأصح هو لماذا لا ينفعلون؟ أي ما المبرر لكي لا ينفعلون؟ طوال ست سنوات لم يتوقف القتل والقمع والتهجير والنهب. ثم تبرز قصة القيم الجمالية!! المؤسف أن الذين يلحون دائماً على هذه الناحية فلتسفيه ما يكتب. علينا أن ندرك أن الكتابة تختلق جمالياتها، ليس هناك وصفة محددة لجمال لا يتغير، أو جمال موحد. الجمالية المطلوبة في هذه الأعمال هي القدرة على التعبير بحيث يدُخل القارئ في حالة مغايرة، ربما يجعله يبكي أو يتألم، أو يتعرف إلى شيء لا يعرفه. أي أن تخترق الكتابة عقولنا وأفئدتنا، وربما تعلمنا شيئاً لا يجوز اغفاله ولا نسيانه. ولنتذكر رواية «الساعة الخامسة والعشرون» لكونستانتان جورجيو، و«قلب الظلام» لجوزيف كونراد. اذا استطعت أن أقايض الجمال بالصدق، فأنا أقبل الصدق. إنه جمالية تضرب في الأعماق، عندما يغوص الصدق في الحقيقة.
والأجدى بالدرجة الأولى، النظر إلى العمل الأدبي، هل هو رواية؟ إذ لا رواية من دون فن روائي.
«الشاعر وجامع الهوامش» هي الرواية الثالث عشرة، هل كتبت روايتك التي تريد؟
أتجرأ وأقول، لقد كتبت روايتي التي أريد، كما حدث مراراً مع كل رواية لي. لم أنشر رواية إلا وأنا راض عنها، إنسانياً وفكرياً وأدبياً وأخلاقياً وجمالياً وسياسياً.
اعتبرت على الدوام، أن أي رواية هي فرصة لن تتكرر، وأنه أتيح لي المجال والوقت، ولن أهدرهما، بل استنفدتهما بالكامل، لهذا أستنفر كل ما هو صحيح وحقيقي في داخلي، وأكتب حسب قدراتي، وربما بما يتجاوزها.
بالنسبة لروايتي الأخيرة، كان ضمن تصوراتي التي لم أشأ إغفالها، نوعية المثقفين في الداخل، سورية مدينة لصمودهم، وأخص هؤلاء الذين كانوا دائماً على سوية ثقافتهم الرفيعة وضميرهم الأخلاقي، لا المثقفين المحتالين اللاعبين على الحبال ولديهم في كل موقع مكان.
كيف تتعامل مع رقيبك الداخلي أثناء الكتابة؟ هل تمتلك موهبة التحايل على الرقيب في بلد الرقابة فيه كانت ولا تزال مشدّدة؟
بالنسبة لأجهزة الدولة الرقابية، اخترت بعد روايتين النشر خارج سورية في بيروت، فأنا لم أجد ما يبرر إضافة مهمة أخرى إلى الكتابة هي التحايل على الرقابة. طبيعة كتاباتي لا تأتلف مع اللف والدوران، فأنا أسمي الدولة والمدينة ولا اخترع لها أسماء أخرى، وأحدد الزمن بالضبط. وأشير إلى وقائع محددة، جهدي ينصرف إلى تخليق أكبر مساحة من الواقع والخيال يسمحان لي بالذهاب بعيداً إلى حقيقة ليست جاهزة، أسعى إلى التعرف إليها، غالباً تمنحني إياها الكتابة. أما الرقيب الداخلي فمعركتي معه مستمرة، فهي تتجدد من رواية لأخرى.
تقول: “رغم وفرة الكتابات عن الحدث السوري، لكنها لم تجار حجمه ولا وقائعه… مازالت الكتابة الأدبية منذ بداية الأزمة في حالة انتظار، إلا من استثناءات قليلة جداً. عموماً لم يفصح الأدب السوري عن مواقف الذين اختاروه مهنة وحياة، فالأديب الملتزم، لم تظهر مواقفه في كتاباته، بحجة أن الأدب يحتاج إلى وقت لاستيعاب مثل هكذا حدث تاريخي”. لو تشرح لنا أكثر.
كثير من الروائيين اختاروا الانتظار، أنا أتفهم هذا الاختيار. فالروايات لا تكتب لمجرد أن الروائي يريد أن يكتب، أسوأ ما يفعله أن يكون روائي مناسبات. يحتاج الروائي إلى وقت لاستيعاب الحدث واحتوائه، ومن ثم إعادة صياغته على شكل رواية. وهو ترتيب نموذجي. لكن الأمر أيضاً متعلق بطبيعة الروائي، هناك من يتأثر بالحدث إلى حدّ أنه لا يستطيع المضي في الحياة، دونما الكتابة عما اعترضه وزلزل كيانه، قد يكون تسرعاً، لكن ها قد مضى على الحدث السوري ست سنوات، وما يجري يصفعنا، وهو مكشوف جداً!! الكتابة في جانب منها مسألة شخصية بحتة، لا كاتب يستطيع عزل نفسه عنها، الكارثة السورية باتت في لب تصوراتنا، للحياة والحاضر والمستقبل. نعم، لا يشترط الكتابة الآن، لكن ألا تحجب عن الآن. كلانا لديه وجهة نظر. في النهاية تتكلم الروايات. فلا نتمهل ولا نستعجل، إنه زمن مفتوح، فالمأساة أكبر من أن تكون أسيرته.
في العديد من أعمالك الروائية تشير إلى أن سوريا الحديثة، هي بين مثقّف متآمر، مافيوي، تاجر، مزوّر، فاسد، وإسلامي ورجل استخبارات، كاشفاً عن أمراض الوسط الثقافي وعلاقته بالسلطة، تقول في مقالة لك: “يساريو السلطة العلمانيون اليوم، المدينون لنشأتهم البعثية القويمة والمتينة، يخوضون حروب السلطة الثقافية”. هل لك أن تتوسع في رؤيتك حول هذه الإشكالية؟
باتت أقدار سورية رهينة هذه المنظومة الفاسدة، والمشين وجود مثقفين يدافعون عنها على أنها سورية الحديثة. بينما سورية منكوبة، والشعب يعيش تحت وطأة حصار الجيش ورجال الأمن والشبيحة والميليشيات المذهبية… بتعاميهم عن هذه الكارثة ينكرون وجوده. يعرفون أنهم يدافعون عن أكاذيب، ومن المؤسف أن يكون من بينهم يساريون سجنوا في العقود السابقة، لم يقفوا إلى جانب الثورة التي طالما عملوا لها، وهو مرض منتشر بين بعض يساريي وقوميي العالم العربي.
حاولت تفسير هذه النزعة في “السوريون الاعداء”. بالنسبة إليهم، المعارضة والثورة احتكار، وأي معارضة وثورة لا تنبثق منهم، فهي على خطأ، أخطأت موعدها، والمكان الذي خرجت منه، أما البشر الذين قاموا بها فهم على صلات بالخارج، بالتالي هم ضدها. أي أنهم يجب أن يكونوا في المقدمة وعلى الآخرين اللحاق بهم. لا يؤمنون بحق الناس بالاحتجاج، ولا أن هناك مظلومين غيرهم، وكأن الثورة سر محفوظ لديهم لا ينازعهم عليها أحد.
في «خطوط النار» الصادرة عن “دار رياض الريّس” في 2011، عدت مرّة ثانية إلى بلاد الرافدين التي مثّلت مسرحاً لروايتك السابقة «جنود الله» في 2010، متطرقاً إلى مواضيع في غاية الحساسية. منقباً وموغلاً في قلب الصراع الشرس المحتدم في العراق. هل هناك حدث معين حفزك لكتابة هاتين الروايتين؟
هناك تصور يشمل أعمالي الروائية، هو أنني أريد الكتابة عن العصر الذي عشته، لا يعقل أن أكون من هذه المنطقة، ولا تظهر سيرتها في كتبي، إن دائرة تحركي لا تتوقف عند حدود سورية، البلاد العربية كلها بلادي، ولا أجد أي مبرر كي لا أكون عربياً سورياً، أنا لا أحس بالغربة في أي بلد عربي، ربما لا أنسجم أو يعذبني الحنين إلى مدينتي والأصدقاء، لكنه ليس منفى. عندما كتبت عن العراق ومن قبلها عن مصر ولبنان… كنت أتحرك فوق أرض هي أرضي.
سؤال «جنود الله» الذي طرحته على نفسي في سورية، وجدت جواباً له في العراق، وكان عن الجيل الذي تلانا، لماذا جيلنا كان يسارياً، بينما أولادنا تأسلموا بين معتدلين ومتزمتين، أصوليين وجهاديين؟
أما في «خطوط النار» فكان السؤال الصعب أيضاً من خلال حادثة اغتصاب لفتاة عراقية من جنود أمريكان، وعن حال الطائفية التي بدأت تستشري في المنطقة. لم أدرك وقتها أن المأساة كانت في طريقها إلى سورية. لم أكن أتنبأ. كانت كل قناعتي أن شعوب هذه المنطقة لن تنفصل معاناتها عن بعضها بعضاً. ولن تنهض إلا معاً. لذلك شملت عاصفة الربيع العربي المنطقة، وهكذا أيضاً استعادت شتاءها الديكتاتوري.
أصدرت “دار رياض الريّس” في بيروت مؤخراً، الطبعة الثالثة من رواية «موزاييك دمشق – 39»، والطبعة الثالثة أيضاً من رواية «تياترو 1949»، وكانت «موزاييك – دمشق 39» قد صدرت للمرّة الأولى في العام 1991، وهي أول نتاجاتك الروائية. فهل يستمد الإصداران الآن راهنيتهما لصلتهما بالحدث السوري المتفجر؟
شكلت «موزاييك» و«تياترو» المرحلة الأولى من مشروعي الروائي، وكانتا المدخل إلى روايتي الثالثة «صورة الروائي». فالمرحلة التي تخوضها هذه الروايات الثلاث، تتعرض في خلفياتها المؤثرة والفاعلة إلى مرحلة الاستقلال ومن بعده الانقلاب السوري الأول، ثم استشراء الانقلابات في المنطقة. هذه هي صورة العالم العربي في السبعينيات من القرن الماضي. وفي المقدمة يتحرك البشر نحو المستقبل، مقيدين بسياسات لا يدركون كنهها، تتحكم بمصائرهم.
ولم يكن ما بعد سلسلة الانقلابات سوى التعثر والفساد وتصلب الدكتاتوريات. وإذا كانت هذه الروايات قد كتبت في العقد الأخير من القرن الماضي فهي تؤسس للأحداث التالية، وكان من أهمها التوريث وتأبيد الحاكم وسيطرة الدولة الأمنية الشمولية.
وإذا كنت راغباً في تواجد هذه الاعمال بإعادة طبعها، فربما للقول أيضاً إن سورية ليست بلا تاريخ، ولم يبدأ تاريخها بانقلاب آذار، ولا بتصحيح تشرين. وأن تاريخها القريب ليس أنه عظيم أو مضيء، ليس هذا ما قصدته، قصدت القول بأنه كان واعداً.
يرى النقاد أن معظم رواياتك «مرسال الغرام» في 2004، «مشهد عابر» في 2007، «عزف منفرد على البيانو»،«السوريون الاعداء» في 2014، وأخيراً «الشاعر وجامع الهوامش»، هي روايات مشغولة بهمٌّ توثيقي لا يحيد عن الواقع بفجاجته العبثية، وسودوايته المضحكة المبكية، أنت الذي ترى أن “الأدب مثل التاريخ لا يرحم”. ما هي مهمة الأدب الأساسية حسب رأيك؟
نعم، هناك هم توثيقي، لكنه لا يهيمن على الرواية، ولا يستولي عليها، وإنما هو واحد من أبعادها، إنه أحد الخطوط في داخلها، نابع من اعتقادي بأن هذا الخط يضيف إلى الرواية بعداً واقعياً وتاريخياً، ما يشكل إثراءً للمشهدية الروائية، ويعزز تعددية سطوحها، فأنا لا أكتب من فراغ أو من خيال محض، أرغب في تآلف اليومي والسياسي، الواقعي والتوثيقي، التخيلي والفانتازي… التوثيق سواء التاريخي أو الواقعي يؤكد على نظرتي إلى الرواية في أنها يجب أن تكون مكتفية بذاتها، بمعنى ألا ضرورة للعودة إلى شيء ما خارجها، إلا إذا أراد القارئ التوسع.
الأدب لا يرحم… هذا صحيح. لماذا؟ لأنه يذهب إلى البواعث حتى الخفية منها، ويمنح الفرصة للشخصيات لكي تبرر وتسوغ وتدافع عن نفسها. الرواية بطبيعتها فن ديمقراطي يتيح المجال لجميع شخصيات الرواية التعبير عن أنفسها.
في حوار سابق معك تقول: “من أكبر إخفاقات المثقفين أنهم لم يدركوا مبكِراً خطر الدعوات المتأسلمة والطائفية، وعندما واجهوها متأخرين كان تأثيرهم ضعيفاً، بحيث لم يستطيعوا تدارك خطرها، بعدما تغلغلت في الداخل، وفرّخت فصائل مقاتلة، شرّعت الفرقة والتشرذم”. هنا وضعت الإصبع على الجرح الغائر، وعليه أسألك كيف ترى كروائي الخلاص لنخرج من عنق الزجاجة بعد كل أنهار الدم؟ وأي دور للكاتب في استشراف المستقبل؟
افتقد المثقفون القدرة على تشخيص الأوضاع خلال الكثير من مراحل الثورة، إضافة إلى تشرذمهم، ودخولهم في خلافات كانت تافهة، بالقياس إلى المفصل التاريخي الذي يواجههم. المشكلة أيضاً كانت في أن نقطة ضعف الثورة وقوتها في آن واحد هو في عفويتها وتلقائيتها، المثقفون لم يتداركوها بالالتحام مع الناس، اعتقدوا من فرط امتداداتها واستعداد الناس للتضحية وتأييد الخارج أن الثورة منتصرة لا محالة، فكانت تنظيراتهم عاجزة عن ملامسة الواقع الذي كان في تردٍ، واستطاعت قوى مضادة وضع يدها على الثورة بالمشاركة فيها لحساب أجنداتهم. وإذا انتقلنا إلى هذه المرحلة وهي ليست الأخيرة، فالحرب الدائرة خرجت من أيدي جميع الأطراف، إنها قرار الخارج؛ الدول الكبرى وإلى حد ما الدول الإقليمية. بينما السوريون لا قرار لهم في أمر يعنيهم وحدهم. مصير سورية يصنعه خصومها، هذه جريمة أخرى من جرائم النظام، سلّم الخارج أقدار البلد.
الكاتب لا يستشرف المستقبل، وإن حاول، فهو يصيب ويخطئ، وإذا أصاب فقد كان على موعد مع المصادفة، مفاتيح المستقبل ليست بيد أحد، لأننا لا نأخذ المستقبل بالحسبان، ما زلنا غارقين في الماضي ومخاضات الحاضر. لذلك لا يتحدث عن المستقبل سوى قارئي الحظوظ والمتنبئين بالغيب… حتى الآن لم يلح، أصبح المستقبل “چودو” العرب.
هل ترى ما يراه بعض النقاد من أنك “ابن للرواية التاريخية – الاجتماعية”، منذ روايتك الأولى، ذلك أنك اخترت الحفر في التاريخ السياسي لسوريا، وقررت جعل التاريخ مجرد خلفية للمشهد الاجتماعي؟ هل تدرج رواياتك ضمن “الروايات التاريخية” أم هي “رواية الذاكرة”؟
بشكل عام، أشدّ ما تستفزني التصنيفات، فهي تحجر على الكاتب وتضعه في خانة، تُسهل على النقد ومتابعي الشأن الثقافي، الاسترشاد بها. هذا التبويب قد يرافقه طوال حياته الأدبية، وربما كان هذا التنظير لا يزيد عن خطأ فاحش. بحيث يصبح مثل سرير بروكرست على كل رواية ألا تخرج عن هذا التصنيف، كما يمكن التعليق على أي كتاب له من ضمن هذا المنظور.
الوسط الثقافي لا يقرأ، وليس هذا سراً، إنه كسول، ومرتاح إلى كسله. كذلك متابعو الشأن الثقافي نادراً ما يقرأون، إلا إذا كان الكتاب ذو حجم صغير وموضوع لطيف، وأثار كما يقال ضجة، فيقرأه من أجل الضجة المفتعلة. في الواقع، الروائي يعتمد على القراء.
أحدهم قال عني إنني أكتب روايات بوليسية، فأصبح كل من يكتب عني يستعين بهذه الوصفة السحرية، أو أنني أكتب روايات تاريخية، أو أنني ناقم على الوسط الثقافي، أي أن كتاباتي ضده، أو… وهذه الوصفات قصيرة النظر ومبتسرة ومتحاملة، وتعفي النقد الكسول من التفكير. المؤسف أن الذي يحرك الثقافة أصحاب الثقافة المحدودة، فآرائهم الطائشة تبدو بحكم عدم نضجها جريئة، بينما هي كيدية، وإذا صبت في المديح فمن نوع المجاملة الرخيصة.
أقول إن الروائي في بلادنا لا يستطيع إهمال الواقع ولا السياسة أو التاريخ، ولا يمكن الكتابة عن الجنس والمرأة والفقر والتعاسة إلا بالتشابك مع الفساد.. هذه ليس وصفة إنها واقع الحال. والروائي لا يستطيع النجاة من هذه الدائرة، مجرد ما يقرر كتابة رواية يسقط فيها، هذا إذا كان الواقع مرجعيته… إلا إذا جعل الروايات الغربية التي تترجم بالعشرات، ومعها الأفلام الأمريكية مرجعيته في كتابة الرواية.
هل يحق للسّارد الذي يكتب رواية تاريخية أن يغير حقائق تاريخية معروفة على مستوى الحدث أو الشخوص؟
إذا كان يكتب رواية تاريخية أو يتعرض للتاريخ، فعليه التقيد بالحقائق التاريخية سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات، ويمكن أن يعفي نفسه من كل هذه الإشكالات إذا كانت رواية تاريخية من النوع الفانتازي، أي يأخذ الأشخاص والأحداث، ويضعهم في عالم متخيل. أشبه بما جرى عندما اختلقت الدراما نوعاً مقارباً في المسلسلات التلفزيونية، وحصدنا مهازل لا أول لها ولا آخر، فالحدث يجري في بلد ما، وعصر ما، وأبطال المسلسل ملابسهم ملونة مثل المهرجين، ويشربون الخمور وربما العصير، ويُقتلون ويَقتلون لدواعي الثأر، ويعشقون لمجرد العشق، ويتغزلون للتغزل وحده… كل هذا لئلا تتداعى أفكارنا إلى بلادنا.
هل تفكر اليوم بكتابة سيرتك الذاتية روائياً؟ وبرأيك ما هو الحدِّ الفاصل بين تجربة الروائي الشخصية وأعماله الروائية؟
حالياً لا أفكر، هذا أمر لم أقرره بعد، ربما في المستقبل، هذا يعتمد على أية صورة سأواجه ذاتي. على كل حال، لا تخلو رواية من رواياتي من شيء مني، من تجربتي أو حياتي الشخصية، أو ما يؤرقني… أعتقد أن كتاباتي لصيقة بي على وجه من الوجوه، وكل واحدة بطريقة مختلفة؛ حياتي تتسلل إلى رواياتي رغماً عني.
مَنْ مِن شخوص رواياتك كان قريباً بالفعل من فوّاز حدّاد؟
أغلب شخصيات رواياتي جزء مني إن لم تكن شديدة القرب إليّ. لا يمكن التقدم في الرواية دون التماهي معها، تتقمصني مثلما أتقمصها. تتكلم من خلالي، أو أنني أتكلم من خلالها، يصعب الفصل بيني وبينها، وإن كانت لا تشبهني، وأقرب إلى أننا على تضاد. لهذا قلت مرة إن الروائي منتحل شخصيات.
هل توافق الرأي القائل إن العام 2005، بكل سياقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، شكل انعطافة كبيرة في مسار الرواية السورية ما يدعونا إلى اعتباره عام انطلاقة طوفان «الرواية السورية الجديدة»، طوفان فجّر “بركان الصمت”، ليولد بعده جيل كامل من كتّاب الرواية مختلفي التوجّهات الفكرية؟
أعتقد أن ارهاصات الانعطافة في الرواية السورية بشكلها العريض بدأت مع الألفية الثالثة، بينما من قبل كانت تظهر على شكل انبثاقات فردية، مع الربيع العربي تحددت المرحلة الأولى بين أنواع ثلاثة من الكتابة، الأولى التي وجدت حرية بلا ممنوعات ومحرمات سياسية. والثانية، مع النظام لا تجد متنفساً إلا في الكتابة ضد الإرهاب الذي كان النظام أحد صانعيه، والثالثة ستعتمد لعبة الحياد، وتزعم أنها معارضة وطنية في الداخل، فتزاوج بين الموالاة الخفية ومعارضة المعارضة، تنتقد الأجهزة والفساد كمقدمة للانهيال على الثورة بالانتقادات إلى حد تحويل الربيع العربي إلى جحيم، ما يبرر الدعوة إلى التصالح مع النظام.
هاجس الحرية يفرق بين الثلاثة، وهو الذي ستعول عليه الرواية السورية، ليس الحرية السياسية فقط، وإنما الحريات بشكل عام، أي رواية متحررة من القيود، لكنها حرية مسؤولة تجاه المجتمع والتاريخ والعدالة والحقيقة.
عموماً أنا متفائل، هناك توجه نحو الرواية، الأجيال الشابة وجدت فيها أداة تعبير قوية. أما الحكم على نتاجاتهم فالتقصير من النقد. يجب أن يتعرف الروائيون الجدد إلى موقعهم في سيرورة الرواية، وسوية كتاباتهم، وعما ينقصهم، فالحياة لا تتيح مجالاً فسيحاً للأخطاء الجسيمة.
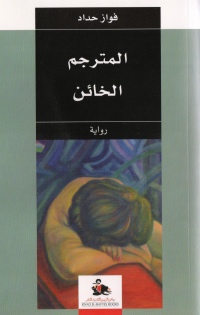
وصلت روايتك «المترجم الخائن» إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2009، ما الذي يميز هذه الرواية عن سائر أعمالك السابقة لتترشح لهذه الجائزة؟ وماذا تضيف الجوائز الأدبية (البوكر، كتارا، الشيخ زايد، الشارقة، وغيرها) للكاتب؟ وكيف ترى تأثيرها في حركية الرواية العربية؟
لا يميزها الشيء الكثير، إنها جزء من عالمي الروائي، ولا أدري لماذا رشحت للجائزة، فهي تفضح الفساد الثقافي، ومافيات الثقافة في العالم العربي. من خلال طرح موضوعات الترجمة والغزو الأمريكي للعراق، وما قيل عن زرع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وصورة عالمنا بعد ضربة نيويورك، واغتراب المثقف. وبما أن لا معايير للجوائز فأنا أجهل السبب. فأنت لا تعرف لماذا رشحت أو لماذا استبعدت، ويبدو أن هذا النوع من الغموض يواتي الجوائز، لذلك أنا لا أثق بها، ولا بلجان التحكيم، ولا بالهدف منها، وأعتقد أن تأثيرها في حركية الرواية العربية ضار ومشوش، هذه الجوائز قد تكون عاملاً في تضخيم الكم، وتبخيس النوع، ومن الطبيعي أن تستهدي بالعلاقات الشخصية، وما حصل حتى الآن هو أنها أسهمت في تمييع الرواية.
هناك من يرى فيما يتعلق بغياب الروائي السوري عن التتويج في الجوائز الأدبية أن “النقص الهائل في نفوذ المثقّفين السوريين في أمكنة معينة كلجان تحكيم الجوائز، أو أقسام الثقافة في الصحف المهمة، يولد شعوراً بالمظلومية لدى الكاتب السوري”. فهل توافقه الرأي؟
إذا كانت المسالة مسألة نفوذ في لجان التحكيم أو أقسام الثقافة في الصحافة، فبئس هذه الجوائز التي لا ترصد للرواية، ويؤثر فيها ثقل الحضور والتواجد في الأوساط المهيمنة والفاعلة في الجوائز. أي أن على الروائي أن يحسّن علاقاته الثقافية مع الدوائر الثقافية بأنواعها، ويتزلف إليها بالثناء والمديح، ومن ثم يأتي دور الرواية. الملاحظ أنه بات من مهمات الروائي، أن يكرس وقته وحياته لترويج روايته، وتكريس سمعة متميزة لعمله الروائي، إضافة إلى تنشيط حفلات التوقيع، واختلاق مناسبات ثقافية للدعاية لنفسه، والطلب من الأصحاب والخلان الكتابة عن روايته، والقيام بدعاية محمومة على وسائل التواصل، والحث على دعوته إلى معارض الكتب والأنشطة والتواجد فيها لمجرد التواجد… كل هذه الأعمال التي باتت ترافق العمل الروائي مصطنعة، ولا علاقة لها بصناعة الأدب، إنها صناعة أخرى.
حسب اعتقادي، لا مظلومية للروائي السوري، بالعكس عليه أن يشعر بالفخر لأنه لم يشارك في موائد الانتفاع. وأقول عن ثقة، إن روايات السوريين الصادرة في زمن الثورة، والتي موضوعها الربيع العربي، استبعدت من الجوائز دون أن تقرأ!! بدعوى أن الثقافة لا علاقة لها بالسياسة!! أي أنهم لا يريدون الدخول في “النزاع” السوري. مع أن أعظم الروايات كتبت عن الحرية ضد الظلم والاستبداد والدكتاتوريات. حتى جائزة نوبل لم تهمل العامل السياسي في منح الجائزة كما حدث مع “بوريس باسترناك” وغيره كثير. فالمغزى السياسي لا يُنظر إليه من ناحية أنه ضد دولة ما، وإنما في التأكيد على العدالة والحقيقة والإنصاف. ومثلها الكثير من الجوائز، في السينما مثلاً، هل تحرم مهرجانات الأوسكار وكان وفينيسيا الأفلام القادمة من الجزائر وإيران وأمريكا اللاتينية من جوائزها لأن السياسة مرعبة في مجال الفن والأزياء والدراما والكوميديا والترفيه؟ يبدو أنه في بلادنا وحدها تصر الجوائز على عدم الانحياز لأي طرف، وهو من دواعي النزاهة الكاذبة وتلفيق حياد أنجز بمنع روايات من المشاركة.
من هذا الجانب، إذا كانت الجوائز تقاطع السوريين، فلماذا المشاركة؟ برأيي يحُسن الروائيون السوريون عملاً بمقاطعة الجوائز.
ما تريد الجوائز إيقاعه في أذهان القراء، أنها تمنح الروايات الأهمية ممهورة بشهادة جودة، وهو أمر خطير… لو أن نقاداً راجعوا سجلات هذه الجوائز وأعادوا النظر في الروايات المرشحة والفائزة لاكتشفوا حجم الإهمال الكبير الذي لحق بالكثير من الروايات لحساب الجغرافيا والعلاقات الشخصية… الإهمال هو فساد أيضاً.

وجدت روايتك «جنود الله» طريقها إلى الترجمة بالألمانية وصدرت تحت عنوان «سماء الله الدامية». فإلى أيّ مدى تساهم الترجمة في نقل كتاباتك إلى ضفاف العالمية؟ وهل أنت معني بأن يكون نصك عالمياً؟
أنا معني بأن أُقرأ لدى أوسع قاعدة من القراء في داخل بلادي وخارجها، فأنا لا أكتب لنفسي، وإن كانت الكتابة تشكل لي عزاءً كبيراً، بل وتدور حولها حياتي كلها. روايتي «جنود الله» قرئت بالألمانية، وهو أمر مهم وأرضاني. وما أدركته من هذه التجربة الجيدة، أن الغرب يركز على الأمور التي تعنيه بالدرجة الأولى، ولا يهمه أن يفهمنا أو يبني جسوراً معنا. إذا أراد الكاتب العربي أن يكون عالمياً، فعليه التقيد بأجنداتهم في الجنس والمثليين والمرأة والأقليات… طبعاً من وجهة نظرهم، وحسب أولوياتهم، أي أن تستعير ما يرغبون في معرفتهم عنك، وهكذا تحقق تواجداً في أسواق القراءة. أما أن تكون عالمياً، فيجب أن تعرف ما الذي يريدون قراءته. نحن ليست لدينا موانع كبيرة حول الإشكاليات السابقة، ولسنا ضدها، لكن لدينا رؤية لها، حسب أجنداتنا وأولوياتنا. مثلاً رواية «جنود الله» تتعرض إلى عدة إشكاليات. كانوا انتقائيين وركزوا في مراجعاتهم حولها والترويج لها على ما يريدونه منها. بالنسبة لي، ما يعنيني منها أكثر مما يعنيهم، غيبوا إشكالياتنا لحساب إشكالياتهم.
أخيراً، ما هو جديدك على مستوى الكتابة في المستقبل القريب؟
من المبكر أن يكون لدي عمل في المستقبل القريب. فعملي الأخير «الشاعر وجامع الهوامش» صدر حديثاً، وإذا كان هناك من جديد في المستقبل، فسوف أحاول استكمال هذه المرحلة من الزمن السوري، وبذلك أضع نقطة النهاية على مساهمتي في رؤية عالمي الممزق، عالمي الذي أخشى أن أكون قد فقدته.
روايات فوّاز حدّاد الصادرة ما بين عامي 1991 و 2017:
«موازييك دمشق 39»، دار الأهالي، طبعة أولى: دمشق، 1991.
«تياترو 1949»، إصدار خاص، طبعة أولى: دمشق، 1994.
«صورة الروائي»، دار عطية، دمشق، 1998.
«الولد الجاهل»، دار الكنوز الأدبية، دمشق، 2000.
«الضغينة والهوى»، دار كنعان، دمشق، 2001.
«مرسال الغرام»، دار رياض الريّس، بيروت، 2004.
« مشهد عابر»، دار رياض الريّس، بيروت، 2007.
«المترجم الخائن»، دار رياض الريّس، بيروت 2008.
«عزف منفرد على البيانو»، دار رياض الريّس، بيروت، 2009.
«جنود الله»، دار رياض الريّس، بيروت، 2010.
«خطوط النار”، دار رياض الريّس، بيروت، 2011.
«السوريون الأعداء»، دار رياض الريّس، بيروت، 2014.
«الشاعر وجامع الهوامش»، دار رياض الريّس، بيروت، 2017.






