أغلق نسيم الخط وانكفأ على نفسه. لم أعد أسمع سوى الصمت. شعرت بالطمأنينة. كمن يغمض عينيه فجأة. وليس الإغماض هنا مجرّد فعل عضلي. بل كمن يغمض عينيه وقلبه وروحه وينطفئ فجأة كل القلق وكل الخوف ويحلّ محلّهما إحساس بالخفّة والتخفّف من كل ما سبق وكل ما سيأتي. إنه التخفّف من الذاكرة. كم مرة حلمت أنني أنفض رأسي في الهواء فتتسرّب منه كل الذاكرة وأرتاح. كم تمنّيت أن أنسى من أنا وماذا أدعى وأين ولدت ومع من عشت ومن صادقت وأين مشيت، في أي شوارع بالضبط عثرت على نفسي وعلى من أحب، تمنّيت أن أنسى، أن أفقد ذاكرتي كلّها دفعة واحدة. لأنني أعرف أن الذاكرة إما تكون أو لا تكون. إما أن تتصالح معها بكل ما تحمله من وطأة وهشاشة وفرح وذعر أو تتخلّى عنها نهائياً إلى حدّ أنك تنسى إسمك. وأنا أريد أن أنسى إسمي. أن أنسى إسمي؟ فعلاً؟ أم أنني أريد أن ينسوا إسمي؟ هل أنا موجوعة من نفسي أم مما ينتظره الآخرون من نفسي؟ عشت لسنوات طويلة مقتنعة بكراهيتي لذاتي. ثم استفقت في يوم من الأيام واكتشفت أنني أحبّها وأستحقّها إلا أن ما يؤرقني هو الآخرون. أولئك الذين احتملتهم وحملتهم على كتفي لسنوات طويلة حتى سكنني نفور ما. وظننت أنه نفور من نفسي. إلا أنه لم يكن في الواقع سوى اشتياق لذاتي، لمن أكون. أشتاقها وحيدة، خفيفة، لا تعيش إلا متطلّباتها. إذ لماذا نرهق أرواحنا لتعيش متطلّبات الآخرين، لتلبّيهم، وتمنحهم الطمأنينة؟ ما فائدة أن نمنح الآخرين الطمأنينة في حين أننا نعيش قلقاً مرعباً؟
أغلق نسيم سماعة الهاتف وانكفأ على نفسه وأنا شعرت بطمأنينة غريبة. نهضت من السرير وجوع رهيب يمسك بمعدتي، وكأنني لم أتذوّق لقمة منذ أيام. فأنا فعلاً، لم أعد أتذوق الكثير. صرت كائناً ضد الأكل. عدوّة للأكل. أمسك بقطعة الخبز وكأنني أمسك بحجر سأبتلعه ويعلق في حنجرتي ويصل بشق النفس إلى معدتي ويصيبني بالتعب. لم أعد أجرؤ على ابتلاع الكثير. ما أن يلامس الطعام معدتي حتى أشعر بالتعب والإعياء كأنني ابتلعت خروفاً. الجوع يشعرني بالأمان. وكأن فراغ معدتي يشي بفراغ رأسي وذاكرتي وروحي. أحب ذلك الفراغ. أروح أبرطع فيه كغيمة صغيرة وحيدة في سماء شاسعة. الجوع يشعرني بالخفة، يحرّرني من أي التزام مرهق حتى التزام الهضم. عملية الهضم تحتاج إلى جهد لم أعد أحتمله حتى. القلب يضطر للخفقان أكثر من المعتاد والمصارين تنقبض وتنفرج والبطن يصدر أصواتاً. نهضت من سريري مستمتعة بجوعي هذه المرة وعرفت أنني رغم ذلك الجوع الكبير لن آكل إلا القليل. خرجت من غرفتي إلى الصالون. أمي تجلس على الكنبة الحمراء تمسك بكتاب بدأت به قبل أسابيع طويلة. وأقسم أنها تحدّق في الصفحة ذاتها (٢٤) منذ أيام. أمي التي صارت كومة صغيرة مرمية على الكنبة تحت غطاء رقيق، تقرأ الجملة وتعيدها وتعيد قراءتها وما أن تنتقل إلى الجملة التالية حتى تكتشف أن عليها إعادة قراءة الجملة السابقة التي قرأتها مرّات ومرّات. تروح تحدّق في الجملة ذاتها وتقرأها وتعيد. لا أعرف إن كانت تقرأها فعلاً لساعات طويلة أم أنها تصفن فيها كي لا تصفن في الفراغ. ذلك الفراغ يزيد إحساسها بالجنون. هي لم تفقد عقلها لكنها تتوهّم ذلك. تقول لي إنها ستصاب بالزهايمر قريباً جداً. وأنا أرجوها مازحة أن تستعجل. تنظر إلي بعتب وتبتسم ابتسامة غريبة لا أعرف كنهها لكنني ألمح مرارة ما تتسلّل من تلك الابتسامة المقفلة والشاردة والمحدّدة بثوان قليلة. فتنة أمي كانت في ابتسامتها. هي التي تجيد الضحك والفرح، ها هي كومة جسد هزيل تحت غطاء رقيق. أقول لها إن الزهماير يخفّف من وطأة الموت. يجعلنا نتمنّى موتها بدلاً من ترقبّه بخوف. يجعلنا نستبدل المأتم بالاحتفاء. يجعلنا؟ من نحن؟ تسألني أمي فأصمت.
أمي الجالسة الآن على الكنبة تقرأ في الصفحة (٢٤) ذاتها منذ أيام، كبرت فجأة. لم أستوعب كيف كبرت أمي. نمنا وكانت شابّة، استفقنا وإذ بها كبرت. أتكون كبرت في الليل؟ أتكفي ليلة واحدة؟ أتكفي حفنة أحلام ليلة واحدة ليكبر المرء إلى هذا الحد؟ وأقول لحسن الحظ أنها كبرت في الليل وليس في قلب النهار مثلاً، لكنت أصبت بالذعر. لو أنها مثلاً دخلت إلى المطبخ لتحضّر فطورها، وخرجت منه بعد دقائق وقد كبرت. أو لو أنها قالت لي بصوتها الهادئ إلى حد مغيظ: “سليمى أنا فايتة إتحمّم”، ثم خرجت من الحمام كبيرة. لحسن الحظ، كبرت أمي في الليل، واستفقنا عليها كبيرة في السن. من نحن؟ هي وأنا فقط. حتى عندما اختفى فؤاد، لم تكبر أمي. بكت كثيراً لكنها لم تكبر. أتكون الدموع هي السبب؟ ربما. الدموع تغسل الروح كما تقول أمي. أو أن الدموع أخذت محل الكبر. إما كانت ستبكي أو ستكبر. بكت كثيراً وبحرقة حتى جفّت دموعها كما تعيد لي مرّات ومرّات. وعندما جفّت دموعها، نامت أمي شابة، واستفاقت عجوزاً. لم أقل لأمي إنني لم أنم منذ اختفائه. لم أقل لها إنني أتمنى موته كل مساء وكل صباح وكل لحظة. أدعو الله وأصلّي وأحفظ آيات من القرآن، ليستجيب ربٌّ ما إلى دعواتي. أحاول عبثاً إبعاد صورته عن مخيّلتي.
ظننت في الأشهر الأولى من اختفائه، أن فعل إغماض عيني هو الذي يستحضر صورته إلى مخيّلتي، فامتنعت. امتنعت ليالٍ طويلة عن إغماضهما حتى أصبت بالإنهاك ونمت ساعات طويلة ثم صحوت مستعيدة بعض الطاقة وفتحتهما من جديد على الليل والنهار لأسبوع وهكذا. لم أقل لها ولم تقل لي. كنت متأكدة من أنها تتمنّى موته أيضاً. إذ كيف لقلب الأم أن يهدأ ويبرد إن كان ابنها حيّاً يتعرّض للتعذيب كل لحظة؟ وأنا كنت لأسعف روحي، أقول لنفسي إن قلب الأم دليلها وإن أمي تحسّ أن فؤاد رحل عن هذه الدنيا، لذلك تنام مطمئنة. لا بدّ أنها تعرف أو كيف استطاعت الاستمرار كل هذه الأشهر؟ صحيح أنها كبرت فجأة في الليل، إلا أنها تجلس الآن هادئة على الكنبة تقرأ الصفحة (٢٤).
مرة، رويت لكميل كيف أنني في صغري كنت أتخيّل والدَيّ وأخي الوحيد يتعرّضون للإهانة أو الضرب أو التعذيب. أتخيّلهم يغرقون. ليس غرقاً طبيعياً من ذاك الذي يخاف منه نسيم، بل أتخيّل أشخاصاً شرّيرين يتلذّذون بإغراقهم وتعذيبهم. وكنت أبكي في الليل وحيدة في فراشي مع معرفتي بأنهم جميعاً بخير، يرقدون في أسرّتهم. رحنا نفتّش، كميل وأنا، عن أسباب تلك الخواطر والأفكار. إذ كيف لطفلة في التاسعة أو العاشرة، تعيش في بيت هادئ لا ينقصه الحب ولا السكينة، أن تخطر في بالها أفكار عنيفة كهذه. لا أذكر ردّ فعل كميل بدقّة. لكنني أذكر أنه وصف ما كان يحدث معي بجلد الذات. نعم كنت أجلد ذاتي، ومازلت. أرى أبي راكعاً على ركبتيه يقبّل قدمي شخص ما. اليوم أظنّ أن الشخص كان ضابطاً. لكنني لست متأكدة إن كنت في طفولتي أتخيّله ضابطاً، أم أن فكرة الضابط مكتسبة مع الوقت ومع مرور زمن من الصور الشبيهة والحقيقية. لم تعد هذه الصور متخيّلة! هناك من يقبّل قدمي ضابط كل لحظة في اليوم! هل الفكرة بسيطة إلى هذا الحد! هل تصدّقون؟ ألا نقول في جلساتنا إن ثمة إنساناً يموت كل لحظة في هذا العالم الشاسع؟ ألا نقول إن ثمة امرأة تضع طفلاً كل ثانية؟ وأيضاً بتنا نقول إن ثمة كائناً سورياً يركع على ركبتيه كل لحظة من اليوم ليقبّل مرغماً قدميّ ضابط ما.
بعد أن اختفى فؤاد، عاتبت نفسي. إذ ما نفع ذلك الاستغراق في جلد الذات في طفولتي؟ ها أنا اليوم أضطر لفعل الأمر ذاته، لأسباب مقنعة وليست مجرّد خيال. لو أنني كنت أعلم. لو أنني توقّعت حدوث الأمر، لما استغرقت في تلك الأفكار في وقت مبكّر. لاستمتعت بنوم هادئ لا يعكّره خيال مريض. ثم صرت أواسي نفسي بموت أبي. لقد مات أبي قبل عشر سنوات. لم يمت تحت التعذيب ولم يتعرّض للإهانة كما كنت أتخيّله دائماً. أمي تقول إن الخوف قتله. لكنني لا أصدّقها. ربما لا أحبّ تصديقها. لقد مات أبي. كان في الستين ومات. نام ولم يستفق. مثل أمي التي نامت واستفاقت عجوزاً. هو لم يستطع أن يحقّق تلك القفزة بين العتبتين فسقط في الموت. ربما لم يشأ أن يكبر ففضّل أن يموت. لكنه مات وأخذ معه “جلد ذاتي” المتعلّق به. فلم أعد أتخيّله إلا بكامل أناقته ورهافته واقفاً أو جالساً وليس راكعاً.
كنت في الخامسة عندما تركنا مدينتنا راحلين إلى دمشق. لا أذكر عن تلك المرحلة إلا نتفاً من الصور أرجّح أنها ليست ذاكرتي بل ذاكرة أمي المروية. فأنا أضيع في ذكريات طفولتي بين ما أحتفظ به في ذاكرتي فعلاً وما روي لي أو أمامي. تحكي أمي كيف تبوّل أبي في ثيابه وراح يرجوها أن يحزموا أمتعتهم ويحملوا طفليهم ويرحلوا إلى دمشق. أمي لم تعثر على الكلمات. بنطال أبي البني صار داكناً تحت منطقة المثانة وعند الفخذين. لقد تبوّل أبي في ثيابه. اليوم أفكر كيف أن تلك القصة روتها لنا أمي في إحدى الصباحات بعد موته. لماذا روتها بعد موته؟ لماذا أرادت لنا أن نعرف؟ هل لتقنعنا أن الخوف هو الذي قتله؟ وقالت أيضاً إنه قرّر الرحيل عن مدينتهما حماة مع أنه طبيب! قالتها بالضبط هكذا. بعد أن أنهت جملتها تخيّلت إشارة تعجّب تغلق فمها. رفعت حاجبيها وهزّت رأسها هازئة به. لم أعرف حتى اليوم إن كانت تفتقده. ينتابني شعور بأنها ارتاحت مع موته. هي لم تقل لي يوماً إن موته أسعدها. لكنني أرى ذلك في جسدها وروحها وعينيها. قالت مرة ما معناه إن الخوف مرهق ومنهك. قالت إنها عاشت معه إثنين وثلاثين عاماً من الخوف. عندما تقول أمي الرقم تكزّ على الأحرف وتفصلها بعضها عن بعض لنشعر بوقع الأعوام ووطأتها “تنين وتلاتين سنة!”. نعم، لقد ترك والدي مدينته خوفاً مما رآه في الشوارع من قتل وإبادة. هرب مع عائلته إلى دمشق وظلّ هناك حتى بعد أن انتهت المجزرة وعاد كل من نجا إلى بيته وحياته. بالتأكيد عادوا إلى بيوتهم، لكن هل عادوا إلى حياتهم فعلاً؟ هل تستوي الحياة وتعود إلى إيقاعها وكأن شيئاً لم يكن؟ هل يستعيد من تنفّس رائحة الموت حاسّة الشم؟ أبي لم يحدّثنا ولا مرة عن حماة. وكأنه استطاع الوصول إلى ما أعجز عن الوصول إليه. استطاع محوها من ذاكرته. استطاع الاحتفاظ بما يريد من تلك الذاكرة. سكنّا في منطقة “عين الكرش” وأبي استأجر عيادة في العمارة ذاتها. “كيف له أن يعالج الدمشقيين بعد أن هرب من إسعاف أبناء مدينته؟”. هذا السؤال يتردّد في مخيّلتي كالصدى من كثرة ما ردّدته أمي أمامنا. وأنا كنت أشفق على أبي. وعندما أتخيّل حفلات التعذيب التي يتعرّضون لها هو وأمي وفؤاد، أكثر ما كان يوجع قلبي هو أبي. أراه الأكثر تأثراً بينهم من الوجع. ألمح وجهه ينكمش من الألم. وأكثر ما كان يقهرني، مفردات الاستجداء والاستعطاف التي تخرج من فمه الجريح على شكل تمتمات متعبة. أتخيّله يقول لهم: “دخيل الله اقتلوني، ريحوني، ما عاد اتحمل”. وأبكي. وأشتاق إليه في الليل فأتسلّل من سريري إلى غرفتهما، أروح إلى حافة السرير اليمنى حيث ينام والدي. أقف فوق رأسه. أمدّ إصبعي الصغير إلى أنفه فأطمئن إلى أنه مايزال على قيد الحياة رغم حفلة التعذيب الدامية تلك. (عندما قرأت مخطوط رواية نسيم الأخيرة، رأيت نفسي. سرقني نسيم وكتب روايته تلك. لم أقل له ذلك). أما أمي وفؤاد فكانا دوماً أشدّ مقاومة! وملامح وجهيهما لا تستجدي شفقة. على العكس، فيها شجاعة وعناد. أبي وحده كان منظره يشلع روحي. لحسن الحظ مات أبي ولم يضطر إلى إبراز هويته على إحدى الحواجز والتعرّض إلى أسئلة محرجة.
هل ربط كميل بين ولعي بجلد الذات وبين مجزرة حماة وانتقالنا إلى دمشق؟ لا أذكر ولا أعتقد أنه فعل. لأنني لا أعرف ما حدث بالضبط ولم أعش في دمشق إلا حياة مستقرة. أذكر أن صورة لحافظ الأسد كانت معلّقة في عيادة والدي. وأذكر أن الأمر كان يغضب أمي إلى حدّ بعيد. “حاطط صورة اللي قتل أهلك؟ فرحان فيه؟ ما بيكفي إنك هربت؟ بتعرف اللي بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته؟”. كانت تسأله هذا السؤال دون أن تكلّف نفسها عناء الإجابة عنه. فلا تقول له مثلاً: “أنت هو الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، بل تتركه حائراً موجوعاً على الأرجح أمام إلحاحها الدائم على لومه. وتضيف غالباً بما يشبه التمتمة: “ما عتب على باقي السوريين اللي سكّروا أبواب بيوتهم بوجهنا”. وهنا أيضاً لا تضيف أن العتب لا يجوز في هذه الحالة لأن بعض أبناء البلد (والدي على رأسهم) هرب، تاركاً أبناء جلدته يموتون وحدهم دون أن يسعفهم أو على الأقل يقف إلى جانبهم، يتنفّس رائحة موتهم، ويحدّق في جثثهم مرمية في الشوارع يرشح منها الدم. وأبي كان يردّ عليها بائساً: “إي لأني من حماة علّقتها للصورة! لأن ذنبي أعظم”. يقول هذه العبارة وعبارات أخرى مشابهة ويرحل من البيت إلى العيادة أو إلى المقهى حيث يلتقي بأصدقائه. كانت الصورة بشكل من الأشكال، اعتراف بأنه لا ينتمي إلى ذلك المكان. بأنه فكّ ارتباطه وانتزع ما حدث من ذاكرته وسامح وتسامح وتصالح. أبي لم يكن يريد سوى أن يعيش ويعيّش عائلته الصغيرة. فماذا أرادت أمي طوال تلك السنوات من العتب واللوم والإلحاح على تذكيره بخيانته العظمى؟ ماذا أرادت غير أن تعيّشنا بكرامة؟ أكانت تتمنّى لو بقينا في حماة وقتل زوجها مثلاً؟ هل كان موت زوجها كغيره من الحمويين سيساعدها على الاستقرار في ذاكرة عاشها الآخرون من أبناء مدينتها؟ هل الموت في بعض حالاته، تحفيز للحياة والكرامة؟ هل كانت أمي تفضّل العيش أرملة بكامل كرامتها وشجاعتها عن العيش بصحبة زوج “جبان” و”خنوع” طوال “تنين وتلاتين سنة”، مع التشديد على الأحرف والمباعدة بينها.
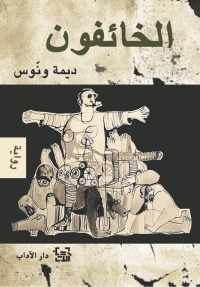
قلت لنسيم مازحة أن يكتب قصة أبي. لكنه لم يستجب للمزحة حتى في إطار المزاح. نعم، نسيم جدّي إلى حدّ الضجر. حتى أنه لا يجيد المزاح. يرمي نكتة ما أو مزحة بنبرة مفرطة الجدية، محتفظاً بعبسة حاجبيه وتلك العقدة التي تربط بينهما حتى باتت جزءا من خطوط وجهه وكأنها ولدت معه وولد معها. عقدة موجودة بينهما ومستقرّة بقوة وكأن روحه خرجت منها وليس من صدره ولا من رحم أمه. وكأن تلك العقدة هي التي بثّت الروح فيه. نسيم لم يكتب قصة أبي. وأمي أيضاً لم أعثر عليها في مخطوط روايته الأخيرة. لكنّه سرقني. لم أقل له ذلك. ثم إنني لو قلت، سينفي حتماً. سيقول إن قصّة بطلة روايته لا تتلاقى مع قصّتي ولا بأي شكل من الأشكال. وأنا سأرتبك وأتلعثم لأنني لن أجد مهما حاولت بشقاء أي دليل ملموس على أنني هي، تلك مجهولة الإسم. لماذا تركها بلا إسم؟ هل لأنه أراد الكتابة عني؟ فهو لن يتجرّأ على تسميتها سليمى بالتأكيد، ولو اختار لها إسماً آخر ستتعطّل مخيّلته ويصيبها شرود ما. لذلك تركها على الأرجح بلا إسم محدّد. لكنها أنا! صحيح أنها تنتمي إلى عائلة أخرى وعاشت ذاكرة مختلفة تماماً، إلا أن روحينا تسبحان في الفلك ذاته. لم أقل له. لا أملك حجّة قوية. سيقول لي ربما إننا ننتمي للجيل ذاته ونعيش في نفس المدينة ونتشارك تفاصيل عامّة عاشها كل السوريين، إضافة إلى أننا نزور كميل. لن أعرف كيف أشرح له أن شبهنا لا ينطلق من تلك المسائل، ولا حتى من زيارتنا لكميل. ثمة ما هو أعمق من مسألة الجيل والبلد والطبيب.
لفتتني لغة روايته تلك. لم أعثر فيها إلا على يوميات مكتوبة بلغة صحافية متفاوتة العذوبة. وكأنه في عجزه عن كتابة رواية عن الثورة، اختار اليوميات ليبرّر لنفسه تلك الركاكة.






