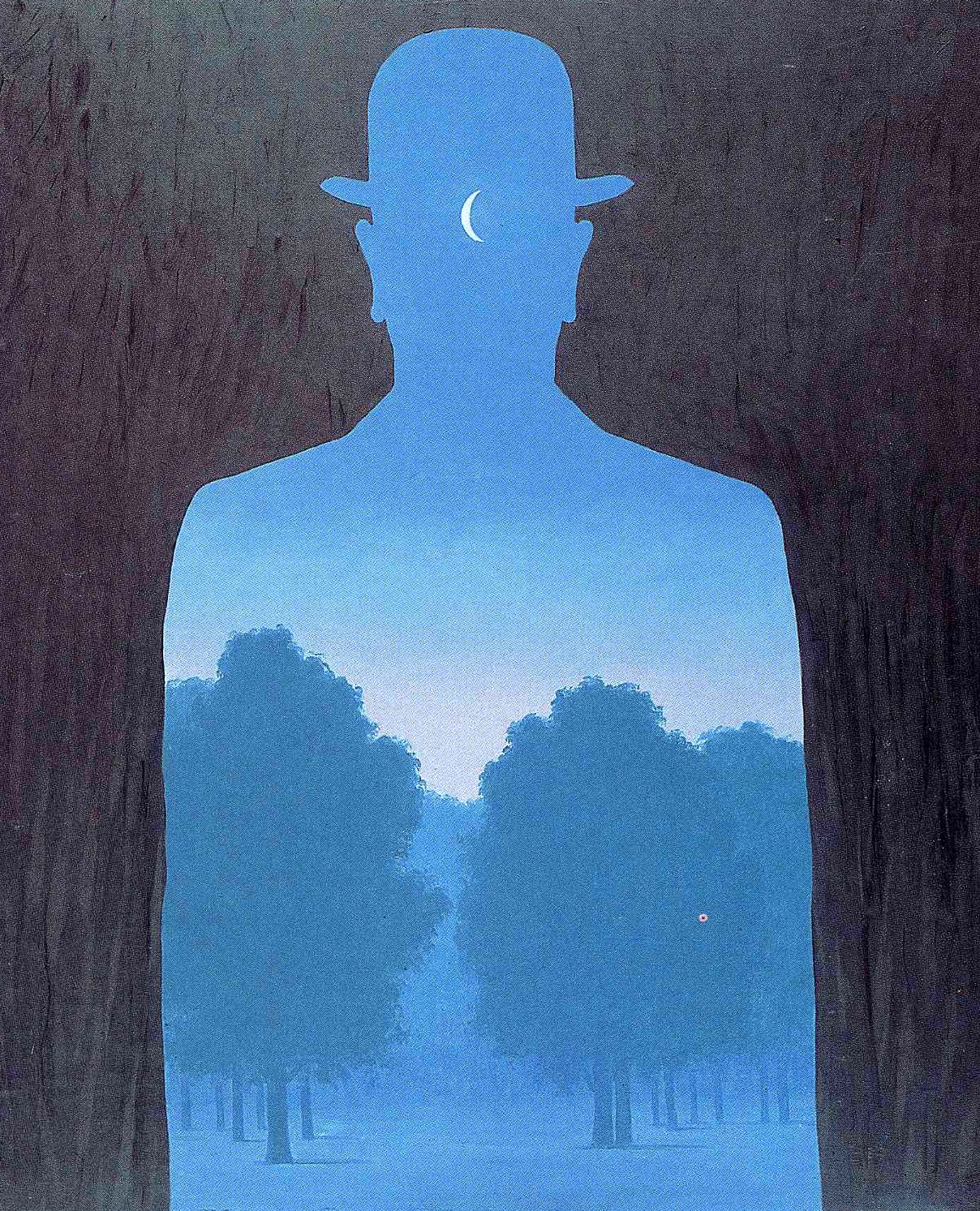هذا النص هو جزء من رواية أعمل على كتابتها، وقد نُشر بالألمانية تحت عنوان: Ein tödliches Erbe namens Erinnerung وترجمته لاريسا بندر، وذلك حين كنت في منحة للكتابة هذا الصيف في سويسرا.
ليس الحرّ اللزج الذي يلتصق بجلدك، البيوت العتيقة كجدّات الحكايات، ولا رائحة الطبخ في الأزقة الضيقة بين شبابيك مزروعة بالورود، ما جعلني أذكر قريتي في كل شبر أقطعه هنا في هذه القرية السويسرية التي اسمها:Stein am Rhein، قريتي البعيدة المنسية على سفوح جبال الساحل في سوريا. لا! الأمر أشد عمقاً ومضيّاً في الذاكرة! أفهم اليوم لماذا كانت الربة “نيموسيني”، آلهة الذاكرة في الأسطورة الأغريقية، من أهم وأقوى الربّات. فتأثيرها كان مغايراً لقوة “زيوس” الغاضبة، جليّة التأثير، الآنية والمباشرة إلى الحدّ الذي باتت فيه اعتيادية! تأثير “نيموسيني” خفيّ، جوانيّ، وممتدّ عبر الزمن، إلى الحدّ الذي لا يراه الكثيرون أو حتى يفهمونه، لكنهم مع ذلك يسقطون صرعى جبروته: سطوة الذاكرة. هل هذا ما عاقبتني به “نيموسيني” كما عاقبت عصاتها مراراً: عدم النسيان! العصاة مثلي أولئك الذين حاولوا الهروب من أنفسهم؟!
تُقرع أجراس الكنيسة القديمة StadtKirche مراراً هنا في Stein am Rhein، لها عطنة تاريخ قديم! أدخل بوابتها العالية وأتأمل جدرانها العارية شديدة البساطة، ولا أذكر إلا المقام في قريتي البعيدة! ربما عليّ أن أحارب جبروت الذاكرة في الغربة، قبل أن أعتاد على المجتمع الجديد والثقافة الجديدة واللغة الغريبة. صراخ الذاكرة والحنين في الأحشاء، ألم حارق حادّ يأكل الروح باستمتاع، لعنة تقتل ببطء وتشفّ، تأسرك في قضبانها حتى لا تجد سبيلاً سالكاً للخروج!
بين الكنيسة والمقام:
“مسعود العلّوني” كان خادم مزار الخضر في قريتنا، أو المقام كما نسميه هناك، لا يشبه خادم الكنيسة هنا بحال. خادم الكنيسة يقف مبتسماً بقيافته الباذخة حتى لكأنه يمثّل فيلماً عن العصور الوسطى، أما رائحة “مسعود العلوني” فقد كانت مزيجاً من رائحة روث بقر، طين قديم رطب، مع عطنة جسد مضت شهور على اغتساله آخر مرة. رائحة حاضرة ككثير من الروائح الأخرى التي تلتصق بالذاكرة كما تلتصق علقة نهمة بجلد طري: رائحة الأرض بعد أول مطرة خريف تلا صيفاً طويلاً. رائحة الخبز الذي خرج لتوّه من الفرن. رائحة الحليب التي تفوح من فم صغيرك كرائحة ملائكة الجنة. رائحة طبخ الأمهات بالثوم والكزبرة، وكذا رائحة عرق من نحبّ! أما المقام فقد كان غرفة وحيدة عارية في وسط الغابة العملاقة التي تمتدّ بجانب النهر الكبير. الغابة والنهر كانا وسط وادٍ تحيطه هضاب منخفضة. أما بيوت القرية، ومنها بيت جدي، فقد كانت منتشرة على قمم الهضاب وتطلّ بمعظمها على الغابة. النهر الكبير احتضن أول آثار بشرية لإنسان قبل ما يزيد عن 700000 عام. جدتي لأبي “جميلة” كانت تقول بأن المقام هو قبر الخضر، النبي القديم قدم البشرية، الذي أقام هنا وتعبّد ربه. أما الخضر هنا في Stein am Rhein فتراه محفوراً، برمحه العملاق والتنين المهزوم قبالته، على عشرات البوابات المعدنية التي تسدّ منافذ تصريف المياه!!
كانت جدتي تنزع شريطة صغيرة من الثياب الخضراء المباركة التي تزنّر قبر الخضر، وتربطها حول معصم يدي وهي تتمتم. زيارة مقام الخضر مع الجدّة شيء يشبه طقوساً وثنية: نخلع أحذيتنا خارجاً ونلج المقام، تخبط الجدّة بقدميها على الأرض بقوة كي تسمعنا الأفعى التي تسكن المقام وتتركنا لحالنا. تخبط عدة خبطات ثم تقف بهدوء للحظات قبل أن تطمئنني بأن دخولنا آمن. بعد لحظات أخرى تبدأ بحرق حبّات البخور وهي تلهج بالأدعية. عطنة الغرفة القديمة مع دخان البخور المحترق تملأ خياشيمي، أشعر بدوار خفيف، كما أشعر الآن بدوار خفيف وأنا جالسة في بهو الكنيسة القديمة. كانت الجدّة تأخذ شيئاً من الزيت المبارك وتمسح به جبيني، وتجلس بجانب الزاوية لتغرق في صلواتها الخاصة. القبر مليء بالصور الملقاة على سطحه، ونسخ مختلفة من كتاب القرآن، كُتب على هوامشها أدعية وطلبات للنبي الخضر علّه يستجيب ويحققها. لطالما حاولت قراءة ما هو مكتوب على الهوامش، كان الأمر صعباً عليّ وأنا في سنتي الثامنة، لكني كنت ألتقط قليلاً من المعنى: أم تطلب من النبي الخضر حماية ابنها، فتاة تطلب منه عريساً، وأب يترجّى عودة ابنه الغائب. تنهرني جدتي وتقول بأن عليّ ألّا أقرأ ما هو مكتوب خلف الصور، هذا قد يؤخّر تحقيق الله لأمنيات أصحابها، فهذه أسرار بين البشر وربهم، وما النبي الخضر إلا وسيط بينهم، ومن يسرق كلمات الناس كمن يسرق مالهم!
لكني لم أستطع يوماً أن أزجر فضولي. في السنوات اللاحقة سأقرأ دوماً أدعية الناس في كل مرة أزور فيها مقاماً من المقامات الكثيرة في قرى الساحل، وأسأل نفسي دوماً هل كانت الجدّة لتترك الصور بحالها، دون أن تقرأ كل حرف مكتوب خلفها، لو كانت تعرف القراءة؟!
تترك جدتي “جميلة” نهاية كل زيارة بضع قطع نقدية في صندوق معدني صغير خلف الباب. حين ألقي بعض القطع النقدية الآن في صندوق الكنيسة أذكرها. تهمس وهي تربّت على الصندوق: “اللقم تمنع النقم، يا رب بارك بهذا المال”. أقول لها: سيأخذها مسعود العلوني، وأكشّر بقرف. تمسكني من أذني وتضغط بقوة تجعل الدماء كلها تتركّز في شحمة أذني: هذا رجل مبروك، لا يجب أن تتحدّثي عنه هكذا!! ثم إن “الكريم حبيب الرحمن، والبخيل حبيب الشيطان”.
كم عليّ أن أجد تعويذة لكسر هذه اللعنة الصارمة: لعنة الذاكرة، والمضي قدماً في عمري. في كل ما مرّ كنت أتخلّص من عبء الذاكرة بالغوص فيها أكثر. حين تريد قتل شيء لا تهرب منه، بل بالعكس واجهه بكل حواسك، غص به، دعه يغمرك، يجتافك، وحينها فقط يمكنك أن تغلبه. الهروب ليس إلا شحنة إضافية من الخسارة. ليس بإمكاني التخلّص من أسر الحكايات حتى أعيد إنتاجها. ولمن لا يعرف، أسر الحكايات أشدّ هولاً من أسر الطغاة!
الضياع بين غابتين:
حين كنت أخرج من غرفة المقام المعتمة في ضيعتنا أبقى مغمضة العينين قليلاً حتى أعتاد الضوء الساطع. تبدو الغابة حولنا أشد إشراقاً. أشجار السنديان والبلوط العملاقة، التي يصل عمرها إلى آلاف السنين، تتمدّد بكامل بهائها، واثقة ثقة من على أرضه. رائحة الخشب العتيق والطحالب التي تعشّش بين شقوقه هي كذلك من ضمن الروائح التي لا يمكن أن تغادر الذاكرة! لهذا ربما لا أذكر إلّا غابة قريتي وأنا أتمشى هنا في الغابة السويسرية الخلّابة في Stein am Rhein، فرائحة الطحالب المتعشّقة بخشب الأشجار تشدّني بلؤم ثم ترميني، بل تشلفني، بكل ما أوتيت من قوة إلى الوراء!
في غابة قريتي كانت جنيات الغابة تسكن، أحاول أن أركّز نظري هنا علّي ألمح جنية طائرة! الجنيات عادة لم تترك أحداً سالماً حين يمرّ في الليل وسط الغابة، فهذه مملكتها الليلية، وويل لمن ينتهك حرمتها. حدث مرات كثيرة أن عثر أهالي قريتي على رجال غلبهم فضولهم القاتل لرؤية جمال الجنيات في الليل، يعثرون على جثثهم تحت الأشجار: مرة يكون الشعر أبيض تماماً، ومرة تملأ الكدمات الزرقاء الجسد القاتم! ومرة تكون الجثة متخشّبة في وضعية ما! في كل مرة كانت القصص تستفيض عن عقاب من يجرؤ على اقتحام مجتمع الجنيات المغوي والسحري في الليل. وفي الليل كان يمكنني أن ألمح أطياف الجنيات من بعيد من أمام بيت جدّي: فساتينها بأذيال طويلة تدور وترقص تحت ضوء القمر فوق ذؤابات الأشجار العالية والبعيدة، وفوق مياه النهر الفضية كذلك. حين كنت أنصت كان يمكنني أن أسمع صوت ضحكاتها الماجنة ووشوشاتها. كانت تدعوني إليها، وكنت أتوق لأن أذهب هناك. أفكّر بأنها قد تتعامل معي كفتاة صغيرة بشكل مغاير عن تعاملها مع الرجال الأفظاظ الفضوليين، فلم يعرف أحد كيف من الممكن لها أن تتعامل مع النساء؟! لكني مع ذلك كنت أخاف. الجدّة تهمس لعمتي بأنها تخاف أن تلحس الجنيات عقلي، وأغافلهم ذات ليل لأغدو إلى هناك كالمسرنمات! أسمعها وهي تؤكد للعمّة أن تظل تراقبني على مدار الوقت فـ”درهم وقاية خير من قنطار علاج”، لذلك فقد كانت العمة لا تغفل عني حتى أغطّ في نوم عميق بجانب الموقد الحجري، الذي كنا نسمّيه: الوجاق.
في الصباح توقظني رائحة التنور الذي تصنع فيه جدتي خبزنا لليوم، رائحة قادمة من الجنة تدخل من الخياشيم إلى الروح لتصعد بها إلى سماء اللذة. تقول لي الجدة حين تلمحني خارجة من البيت فاركة عينيّ من آثار النوم:
أنت أجمل من جنيات الغابة يا ابنتي!
كنت أشعر بأنها تعتذر مني بشكل ما على صرامتها الدائمة، وعلى مراقبتها الدائمة لي أيضاً! تغمرني فأشمّ رائحة الحطب وزيت الزيتون وعطنة القشّ الرطب الذي تحشو به المخدّات. لكنها وحالما يحلّ الليل تعود إلى صرامتها القديمة ذاتها!
بحيرة نهرنا الكبير والـ Bodensee:
بين صوري الخاصة ثمة صورة مشقّقة من أطرافها تبدو حبال التبغ فيها وهي تزنّر جدّي المتعبين. فجداي كانا يزرعان التبغ في الحاكورة القريبة من البيت. هناك من خطر له أن يلتقط لهما صورة في مثل هذا الوقت العصيب! لكن العيون استطاعت، حتى بعد أكثر من ثلاثين عاماً، أن تُغرق قطعة من الكرتون، تسمّى صورة فوتوغرافية، بكل هذا الكم من الألم! فلم يكن ذاك الصيف قد حلّ حتى كانت آليات غريبة عملاقة قد احتلّت القرية. ماذا يحدث؟!! راحت الآلات تقطع أشجار الغابة المعمّرة واحدة تلو الأخرى، أسمع صوت صرخاتها المتألمة وهي تهوي على الأرض بعد قصّ جذوعها العملاقة. حينها قال لي جار بيت الجدّ إن الدولة قررت بناء سدّ كبير مكان الغابة، ستُطمر الغابة وتتمدّد بحيرة النهر الصغيرة لتصبح بحيرة سدّ كبيرة كبيرة، وقد تنطمر بيوت القرية كلها أيضاً تحت الماء!
قطّعت الآلات العملاقة معظم أشجار الغابة، وذات صباح اتجهت إلى مقام الخضر في وسطها وهمّت بهدمه. الجدّة “جميلة” كانت تصرخ من البعيد وهي تراقبهم بأن آلاتهم ستتوقف عن العمل الآن، أو سيتوقف قلب سائق الآلة ويموت من فوره.. الله لن يتركهم يدمّرون مقام حبيبه.
أما الجدّ فقد كان قد بدأ رحلة مرضه الطويلة والأخيرة.
لكن الآلات دمّرت المقام كلّه في ذلك الصباح، ومعه كل المعالم المحيطة، دون أن تخرب، ودون أن يتوقف قلب صاحبها!! الجدّة وصل عويلها المرّ إلى السماء: يا وحوش.. أما الجدّ فلم يقم بعدها من فراشه.
حين عدنا لزيارة القرية بعد شهور طويلة كانت الغابة قد اختفت. وحلّت مكان بحيرتنا الصغيرة بحيرة كبيرة متوحّشة غمرت المنطقة بأسرها، ووصلت حتى منتصف الهضاب المحيطة! وحدها بيوت القرية العالية نجت من الطوفان. رؤوس بعض الأشجار العملاقة، التي تُركت في مكانها، تبدو من تحت صفحة الماء الساكنة كأنها أيد مرتفعة لناس مستغيثة تنازع الغرق. هنا حين أجلس بجانب الـ Bodsenee، أو كما نسميها بالعربية: بحيرة كونستانس، أحاول أن أركّز جيداً في صفحة الماء الساكنة: هل هناك أشجار غرقت فيها؟! الهدوء الذي أسمعه هنا يذكّرني كثيراً ببحيرة قريتي البعيدة.
هاجرت الحيوانات هناك بعد ذلك، لم نعد نسمع صوت تغريد عصافير الغابة عند الفجر، ولا صوت البومة وصراصير الليل، ولا ضحكات الجنيات كذلك. حتى الجنيات غادرت الغابة؟! حين سطع القمر يوماً لمحت من البعيد بعض أطيافهن ترفرف بفساتينها الطويلة فوق صفحة الماء ثم اختفت!
ثم ماذا بعد ذلك؟! إلى متى سيبقى كل شيء، وأي شيء، هو عتبة للولوج إلى ذاكرة ما مرمية في رأسي؟! لكن في حياة النزوح لا يمكنك أن تعود إلى جدار كتبت عليه يوماً جملة وأنت صغير إلا بذاكرتك. ليس هناك أزقة للطفولة، ولا أصدقاء تكبر معهم، وترى عمرك الذي يمرّ على أجسادهم إلا في الذاكرة. حياة النازحين حياة بلا أمان، بلا موطئ قدم، بلا روائح للأمكنة، وحدها الذاكرة تكبر مع أجسادنا التي تكبر. ذاكرة المرتحلين، أياً كان أولئك المرتحلون وأياً كانت البلاد التي يرتحلون إليها، هي نتف من هناك! ربما لهذا السبب تلتصق ذاكرتهم بأرضهم الأولى، تلتصق كشجرة زيتون بالتراب، وتمتدّ بجذورها عميقاً لنسيان ذاكرة الترحال.
لن يفهم أحد لم يجرّب الترحال يوماً ماذا تعني حقيقة الترحال! حين تضطر إلى خلع جذورك من مكانها، والمضيّ بها معرّضاً إياها للبرد، للغربة، للأغراب، للمحيط الجديد، وربما للغة جديدة! وتراقب تلك الجذور وهي تيبس ابتداء من نهاياتها، لتذوي شيئاً فشيئاً.