يانيس فاروفاكيس: كارل ماركس تنبأ بأزمتنا الحالية وأشار إلى طريق الخروج.
نشرت في الغارديان بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٨
سرّ نجاح أي بيان، هو أن يخاطب قلوبنا كقصيدة شعر، بينما يلوّث عقولنا بالأفكار والصور التي تكون مذهلة تمامًا. والواقع أنه علينا أن نفتح عيوننا على الأسباب الحقيقية للتغيرات المذهلة والمزعجة والمثيرة التي تحدث حولنا، كاشفين عن الاحتمالات التي يحبل بها واقعنا المعاصر، والحق أن ذلك يجعلنا نشعر بالعجز اليائس لأننا لا نستطيع كشف هذه الحقائق، ولكن من شأن هذا أن يزيل الستار عن الواقع غير المستقر، الذي كنا نعيش فيه كما لو أننا تافهين متواطئين، لا نتوقف عن إنتاج طرق مسدودة. وختامًا، يبدو أنه علينا أن نحظى بقوة سيمفونية بيتهوفن، التي يمكنها أن تحثنا على أن نصير عملاء لمستقبل ينهي المعاناة الجماعية غير الضرورية، وتلهم الإنسانية لأن تدرك قوتها لتحقيق الحرية الأصيلة.
ليس ثمة بيان قد نجح في فعل ذلك، أفضل من هذا الذي نُشر في فبراير 1848 في شارع ليفربول بلندن، بتكليف من الثوار الإنجليز. البيان الشيوعي، أو بتعبير آخر بيان الحزب الشيوعي، كما نُشر أول مرة، وقد كتب البيان شابان ألمانيان، كارل ماركس، ذو الـ 29 عامًا، الأبيقوري، ذو العقلية الهيجلية، وفردريك أنجلز، صاحب الـ 28 عامًا، ووريث طاحونة بمدينة مانشستر.
كعمل من أعمال الأدبيات السياسية، لا يزال البيان الشيوعي لا نظير له، بما فيه العبارة الافتتاحية التي تقول (ثمة شبح يطارد أوروبا، هو شبح الشيوعية)، والتي تحمل صبغة شكسبيرية، وكما لو أن هاملت يواجه شبح أبيه المقتول، يضطر القارئ عند قراءته للبيان أن يتساءل: “أينبغي عليّ أن أتكيف مع الوضع الراهن، أعاني من الجراح والخيبات والخسائر التي تنعم عليّ بها إكراهات التاريخ الحتمية؟ أم عليّ أن أنضم لهذه القوات، وأحمل السلاح ضد هذا الوضع الراهن، بمعارضته، والدخول في عالم جديد شجاع؟”.
بالنسبة للقرّاء الحاليين لماركس وأنجلز، لم يكن البيان معضلة أكاديمية تُناقش في صالونات أوروبا، كان بيانهم عبارة عن دعوة للتحرك، وغالبًا ما كانت الاستجابة لشبح البيان تعني الاضطهاد، وفي بعض الحالات السجن المشدد، واليوم، يواجه الشباب معضلة مشابهة، وهي أن تتكيف مع النظام المعمول به، غير القادر على إعادة إنتاج نفسه، أو أن تواجه هذا النظام، بتكلفة شخصية كبيرة، إذا شئت البحث عن طرق أخرى للعيش والعمل؟، وعلى الرغم من أن الأحزاب الشيوعية قد اختفت تمامًا من المشهد السياسي، إلا أن روح الشيوعية التي تؤسس البيان تظهر أنه من الصعب الصمت.
بيد أن طموح أي بيان هو أن يرى ما وراء الأفق. لكن أن تنجح في وصف عصر سوف يأتي بعد نشر البيان بقرن ونصف بدقة مطلقة، مثلما فعل ماركس وأنجلز، فذلك مذهل حقًا، تأسست الرأسمالية في نهاية أربعينيات القرن 19، محلية، ومفتتة، وخجولة. ولم يكد ماركس وأنجلز أن يتفحصاها بنظرة واحدة طويلة، إلا وقد تنبآ بالرأسمالية المعولمة، المصفحة، والسخيفة وغير الضرورية. هذا هو المخلوق الذي ظهر عام 1991، في اللحظة التأسيسية التي ادّعت موت الماركسية ونهاية التاريخ.
والواقع أن الفشل التنبؤي للبيان الشيوعي قد تم المبالغة فيه كثيرًا، وأتذكر كيف أن حتى الإقتصاديين في الجناح اليساري في أوائل سبعينيات القرن المنصرم، قد طعنوا في التنبؤ المحوري للبيان، وأقرّوا أن رأس المال يمكن أن “يختبئ في أي مكان، ويستقر في أي مكان، ويؤسس صلات في كل مكان”. بالاعتماد على الحقيقة التي كانت شائعة في ذلك الوقت والتي تسمى، بلاد العالم الثالث، فقد جادل هؤلاء بأن رأس المال سوف يفقد فقاعات جيدة، قبل أن يتوسع مرة أخرى في حواضر العالم الأول، في أوروبا وأمريكا واليابان.
وقد كانوا صائبين عمليًا، ذلك أن الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية متعددة الجنسية عملوا في محيط أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحصروا أنفسهم في دور مستخرج الموارد الاستعماري، وفشلوا من ثم في نشر الرأسمالية هناك. وبدلًا من ان يغمروا تلك البلاد بالتطور الرأسمالي (محولين حتى أكثر الدول بربرية إلى دول حضارية)، جادلوا بأن رأس المال الأجنبي يعيد إنتاج التخلف في العالم الثالث. كان الأمر كما لو أن البيان قد وضع الكثير من الثقة في قدرة رأس المال على الانتشار في كل زاوية. غير أن كل الاقتصاديين، حتى المتعاطفين منهم مع ماركس، قد شككوا في تنبؤات البيان من أن “استغلال السوق العالمي” سيعطي “شخصية عالمية للإنتاج والاستهلاك في كل بلد”.
وكما اتضحت صحة البيان، ولو متأخرًا. سوف يتطلب هذا انهيار الاتحاد السوفييتي وإدخال ملياري عامل صيني وهندي إلى سوق العمل الرأسمالي لتأكيد صحة هذا التوقع. وفي الواقع، ليتعولم رأس المال بشكل كامل، كان على الأنظمة التي تعهدت بالولاء للبيان أن تتمزق أولًا، هل سبق للتاريخ أن شهد مفارقة أكثر لذة من تلك؟
أي شخص يقرأ البيان اليوم، سيتفاجأ عندما يكتشف صورة عالم يشبه عالمنا المعاصر، الذي يتأرجح بخشية على حافة التجديد التكنولوجي. أما في العصر الذي صدر فيه البيان، فقد كان المحرك البخاري هو الذي طرح التحدي الأكبر لإيقاعات وأنماط الحياة الإقطاعية. فقد اجتاح الفلاحون تروس وعجلات هذه الآلة الجديدة، وظهرت طبقة جديدة من الأسياد، من ملاك المصانع والتجار، وسيطرت طبقة من النبلاء على المجتمع. أما في العصر الحالي، يمثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة تهديدات مدمرة، فهي تعد الناس بإزالة جميع العلاقات الثابتة والمجمدة بسرعة، وكما يعلن البيان، أن الثورة التي حدثت في أدوات الإنتاج ستحول علاقات المجتمع برمتها، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث ثورة مستمرة في الإنتاج، واضطراب مستمر في جميع الظروف الاجتماعية، وعدم اليقين والهياج الدائم.
ومع ذلك، بالنسبة لماركس وأنجلز، كان يجب الاحتفاء بهذا التشويش، فقد كان يمثل حافزًا كبيرًا للدفعة النهائية التي تحتاجها الإنسانية لنتخلص من تحيزاتنا المسبقة، التي تدعم الانقسام العظيم بين هؤلاء الذين يملكون الآلات، وهؤلاء الذين يصممون ويشغلون ويعملون عليها. “كل ما هو صلب يذوب في الهواء، وكل ما هو مقدس يتم تدنيسه”، لقد كتبا في البيان عن تأثير التكنولوجيا، “وفي النهاية، الإنسان مجبر لأن يواجه حواسه الرصينة، وظروفه الحقيقية للحياة، وعلاقاته بنوعه”. ومن خلال تبخر تصوراتنا المسبقة وادعاءاتنا الكاذبة بلا رحمة، يجبرنا التغير التكنولوجي، يركلنا ويصرخ فينا لأن نواجه حقيقة كيف هي مثيرة للشفقة علاقاتنا مع بعضنا البعض.
واليوم، نحن نرى الفاتورة في ملايين الكلمات، المطبوعة وعبر الإنترنت، تستخدم في النقاش الدائر حول استياء العولمة، بينما يحتفى بقدرة العولمة على تحويل مليارات من الناس من الفقر المدقع إلى الفقر النسبي، ذلك أن الصحف الغربية الموقرة، والشخصيات الهوليوودية، ورجال الأعمال في وادي السليكون، والأساقفة، وحتى الممولين المليارديرات، كلهم يرثون بعض التداعيات غير المرغوب بها. وتتمثل تلك التداعيات في عدم المساواة الذي لا يحتمل، والجشع الوقح، والتغير المناخي، واختطاف ديمقراطيتنا البرلمانية من قبل موظفي البنوك وفاحشي الثراء.
لا شيء من هذا ينبغي أن يفاجئ قارئ البيان، ذلك أن البيان يقر، أن المجتمع ككل، سينقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين معاديين، إلى طبقتين كبيرتين تواجهان بعضهما. وهكذا، كلما كان الإنتاج ممكنًا، وكان هامش الربح لصاحب الآلة هو الدافع الذي يقود الحضارة، سوف ينقسم المجتمع بين حاملي أسهم لا يعملون، وبين عمال غير مالكين لأجورهم. أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، فهي كما لو أنها الديناصور الجاهز دومًا للانقراض.
وفي الوقت نفسه، فإن فاحشي الثراء سوف يشعرون بالذنب والتوتر عندما يشاهدون حياة كل فرد آخر تغرق في تزعزع وخطورة عبودية الأجر، والحال أن ماركس وأنجلز قد تنبآ أن هذه الأقلية القوية للغاية ستثبت في النهاية أنها غير جديرة بحكم هذه المجتمعات المستقطبة، لأنها لن تكون في وضع يسمح لها بضمان أجور العبيد وجودًا موثوقًا. وبينما هم منعزلون في مدنهم المسورة، سيجدون أنفسهم مهووسين بالقلق وغير قادرين على التمتع بثرواتهم. غير أن بعضهم سيكون ذكياً كفاية ليدرك مصالحه الذاتية الحقيقية على المدى الطويل، وسيعترف أن دولة الرفاه هي أفضل بوليصة تأمين متاحة حتى الآن. لكن واحسرتاه، فكما يفسر البيان، كطبقة اجتماعية، سيكون من طبيعتها أن تبخل في دفع أقساط التأمين، وسيعملون دون كلل من أجل أن يتجنبوا دفع الضرائب المفروضة.
أليس هذا ما حدث؟، فاحشو الثراء هم مجموعة غير مستقرة، مستعصون على الدوام داخل وخارج عيادات التخلص من السموم، يبحثون بلا هوادة عن العزاء من الوسطاء النفسيين ومرشدو رواد الأعمال، وفي الوقت نفسه، يكافح الجميع من أجل وضع الطعام على الطاولة، ودفع الرسوم الدراسية، ومحاولة الجمع بين بطاقتي ائتمان أو محاربة الاكتئاب. الحق أننا نتصرف كما لو كانت حياتنا خالية من الهموم، مدعين أننا نعمل ما نحب ونحب ما نعمل، لكن في الوقع نحن نبكي كل ليلة حين يأتي موعد النوم.
بيد أن المصلحين والسياسيين المؤسسين وخبراء الاقتصاد الأكاديميين يستجيبون لهذا المأزق بالطريقة نفسها، إصدار بيانات استنكارية لهذه الأعراض (عدم المساواة في الدخل)، بينما يتجاهلون الأسباب (الاستغلال الناجم عن حقوق الملكية غير المتكافئة على الآلات والأراضي والموارد). هل من المستغرب أننا – بعد كل ذلك – في طريق مسدود؟ نترنح في اليأس الذي يخدم فقط الشعبويين الساعين لمحاكمة أسوأ غرائز الجماهير؟

مع الارتفاع المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، نقترب أكثر من أي وقت مضى من اللحظة التي يجب أن نقرر فيها كيف نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة عقلانية وحضارية. ذلك أننا لا نستطيع أن نختبئ خلف حتمية العمل والمعايير الاجتماعية القمعية التي تستلزمها. الحال أن البيان يعطي قارئه في القرن الـ 21 الفرصة لأن يرى من خلال تلك الفوضى ويتعرف على ما يحتاج أن يفعله، لذا، فإن الأغلبية بإمكانها أن تهرب من هذا السخط لترتيبات اجتماعية جديدة، حيث “التطور الحر لكل فرد هو شرط التطور الحر للجميع”. وعلى الرغم من أن البيان لا يحتوي على خريطة طريق لكيفية الذهاب إلى هناك، غير أن البيان لا يزال مصدرًا للأمل لا يجب أن يصرف النظر عنه.
إذا كان البيان يحمل السلطة نفسها لإثارة الحماسة والعار فينا كما كان يفعل عام 1848، فذلك بسبب أن الصراع بين الطبقات الاجتماعية قديم قدم المجتمع نفسه، والحال أن ماركس وأنجلز قد لخصا هذا الأمر في 13 كلمة جريئة: “إن تاريخ المجتمعات الموجودة حتى الآن ما هو إلا تاريخ الصراعات الطبقية”.
من الأرستقراطيات الإقطاعية إلى الإمبراطوريات الصناعية، دائمًا ما كان وقود التاريخ هو الصراع بين التقنيات الثورية المستمرة والاتفاقيات الطبقية السائدة. مع كل تعطل في تكنولوجيا المجتمع يتغير شكل الصراع بيننا. تموت الطبقات القديمة، لكن في النهاية لم يزل هناك طبقتان قائمتان فقط، الطبقة التي تملك كل شيء، والطبقة التي لا تملك أي شيء، البرجوازية والبروليتاريا.
هذا هو المأزق الذي وجدنا أنفسنا فيه اليوم. فبينما كنا نظن أننا مدينون للرأسمالية لأنها قللت الفروق بين المالكين وغير المالكين، أراد ماركس وأنجلز أن ندرك أن الرأسمالية غير متطورة بشكل كاف لتنجو من التكنولوجيات التي تنتجها. أما واجبنا اليوم فهو أن نمزق المفهوم القديم لوسائل الإنتاج المملوكة للقطاع الخاص، وندفع عمليه التحول، التي يجب أن تشمل الملكية الاجتماعية للآلات والأراضي والموارد. والحال أنه عندما يطلق العنان للتكنولوجيات الجديدة في المجتمعات المرتبطة بعقود العمل البدائية، سيتبعه البؤس بالجملة، في كلمات البيان التي لا تنسي: “إن المجتمع الذي يستحضر مثل تلك الوسائل الضخمة للإنتاج والتبادل، يشبه الساحر الذي لم يعد قادرًا على السيطرة على قوى العالم السفلي الذي استدعاه من خلال تعويذاته”.
ودائمًا ما سيتخيل الساحر أن تطبيقاته ومحركات البحث والروبوتات والبذور المعدلة وراثيًا ستجلب الثروة والسعادة للجميع، غير أنه بمجرد إطلاقها في المجتمعات المقسمة بين العمال المأجورين والملاك، ستدفع هذه الأعاجيب التكنولوجية الأجور والأسعار إلى مستويات تحقق أرباحًا منخفضة لمعظم الأعمال. فقط التقنيات الكبيرة، والشركات الكبرى، وقليل من الشركات القليلة هي التي تستفيد حقًا، وتفرض علينا قوة سياسية واقتصادية كبيرة على نحو استثنائي. والحق إننا إذا واصلنا الموافقة على عقود العمل بين صاحب العمل والموظف، فإن حقوق الملكية الخاصة ستحكم وتقود رأس المال إلى أهداف غير إنسانية. إنما فقط من خلال إلغاء الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج الضخمة واستبدالها بنوع جديد من الملكية المشتركة التي تعمل بالتزامن مع التقنيات الجديدة، ستقلل نتيجة لذلك من عدم المساواة وسنكون في طريقنا لنجد السعادة الجماعية.
وفقًا لنظرية ماركس وأنجلز المكونة من 13 كلمة في التاريخ، فإن المواجهة الحالية بين العامل والمالك كانت مضمونة دائمًا، ويوضح البيان في سطوره: “إن الأمر الذي لا مفر منه، هو سقوط البرجوازية، وانتصار البروليتاريا”، لكن حتى الآن لم يحقق التاريخ كلمات البيان، غير أن المنتقدين دائمًا ما ينسون أن البيان شأنه شأن أي دعاية جديرة بالاهتمام، يقدم الأمل على شكل يقين، وذلك مثلما حشد اللورد نيلسون قواته قبل معركة طرف الغار حينما أعلن أن إنجلترا توقعت من جنودها أن يقوموا بواجبهم (حتى إذا كان لديه شكوك جسيمة بأنهم سيفعلون)، فإن البيان يمنح البروليتاريا الأمل بأنهم سيقومون بواجبهم لأنفسهم، ويلهمهم لتوحيد وتحرير بعضهم البعض من روابط عبودية الأجور.
هل سيفعلون؟ يبدو أن ذلك من غير المحتمل طبقًا للشكل الحالي، ولكن، مرة أخرى، كان علينا أن ننتظر ظهور العولمة في التسعينيات قبل أن يتم تقدير البيان لإمكانات رأس المال تقديرًا كاملًا. ألم يكن من الممكن أن البروليتاريا العالمية التي تزداد خطورتها يومًا بعد يوم تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن تتمكن من لعب الدور التاريخي الذي توقعه البيان لها؟ في حين أن هيئة المحلفين لا تزال غير موجودة. الحال أن ماركس وأنجلز يخبرانا أنه إذا ارتعدنا من خطاب الثورة أو حاولنا صرف انتباهنا عن واجباتنا تجاه بعضنا البعض، فسوف نجد أنفسنا عالقين في دوامة صلبة يتشبع فيها رأس المال، بل ويساهم في إعطاب روحنا البشرية، الواقع أن الشيء الوحيدة الذي يمكننا أن نتأكد منه، وفقًا للبيان، هو أنه إذا لم يكن رأس المال متجذراً في المجتمع، فإننا سنشهد تطورات عميقة ومهمة.
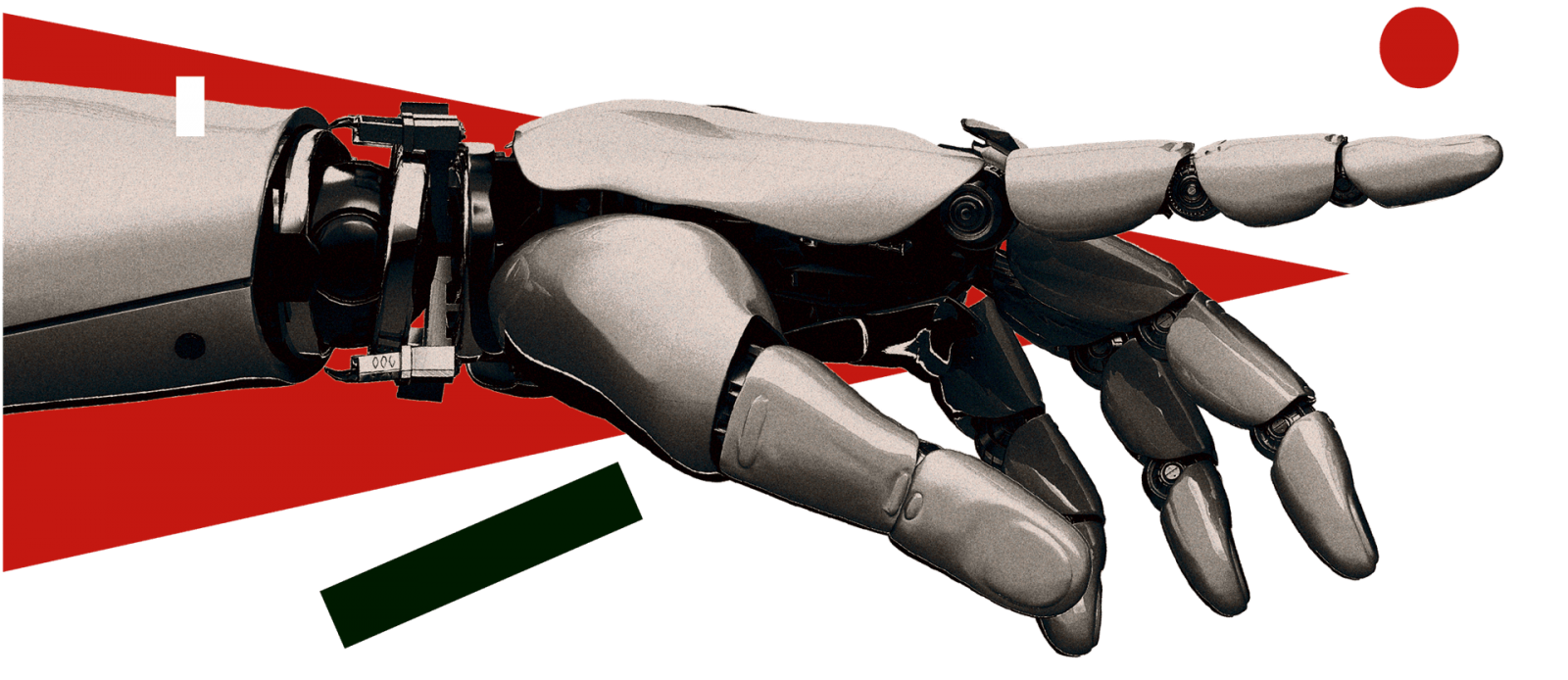
أما بالنسبة لموضوع الديستوبيا، فإن القارئ المتشكك سيكثر من السؤال، ماذا عن تواطؤ البيان نفسه في إضفاء الشرعية على الأنظمة الاستبدادية وسرقة روح حرّاس معسكرات الاعتقال؟ بدلًا من أن نرد بشكل دفاعي، سنشير إلى أن لا أحد يلوم آدم سميث على تجاوزات وول ستريت، ولا أحد يلوم أيضًا العهد الجديد على محاكم التفتيش. والواقع أننا يمكننا أن نتخيل كيف أن مؤلفي البيان قد يكونا قد أجابا على هذه التهمة. الحال أنه حالما استفادا من إدراكهما المتأخر، فإن ماركس وأنجلز سيعترفان بخطأ هام في تحليلهما، ألا وهو نقص الانفعالية، الأمر الذي يعني أنهما قد فشلا في إعطاء فكرة كافية، وحافظا على الصمت الحكيم حول تأثير تحليلهما الخاص على العالم الذي كانا يقومان بتحليله.
الواقع أن البيان قد أخبرنا بقصة قوية وبلغة لا هوادة فيها، هدفه تحريك القراء من لامبالاتهم، غير أن ما فشل ماركس وإنجلز في التنبؤ به هو أن النصوص القوية والوصفية لها ميل كبير إلى شراء التلاميذ والمؤمنين، ككهنوت، حتى يستخدم المؤمنون القوة التي منحها لهم البيان لصالحهم الخاص، ومع ذلك فإنهم قد يسيئون معاملة الرفاق الآخرين، ويبنون قوتهم الخاصة، ويكتسبون مواقع النفوذ، ويبدون كالأطفال سريعي التأثر، ويسيطرون على المكتب السياسي ويسجنون أي شخص يقاومهم.
وعلى نحو مماثل، فشل ماركس وأنجلز في تقدير تأثير كتاباتهما على الرأسمالية نفسها، وإلى الحد الذي ساعد في تشكيل الاتحاد السوفييتي، ودوله التابعة في أوروبا الشرقية، وكوبا كاسترو، ويوغوسلافيا تيتو، وعدة حكومات ديمقراطية اجتماعية في الغرب، ألا تتسبب هذه التطورات في سلسلة من ردود الفعل التي من شأنها أن تحبط توقعات وتحليلات البيان؟ بعد الثورة الروسية ومن ثم الحرب العالمية الثانية، أجبر الخوف من الأنظمة الشيوعية الرأسمالية إلى تبني خطط معاشات التقاعد، والخدمات الصحية الوطنية، وحتى فكرة أن الأغنياء يمولون الطلاب الفقراء والبرجوازيين الصغار لحضور دروسهم في الجامعات الليبرالية التي بنيت لغرض محدد. وفي الوقت نفسه آثار العداء العنيف الذي أثبتت خصوبتها بشكل خاص لشخصيات مثل جوزيف ستالين وبول بوت.
أعتقد أن ماركس وأنجلز كانا يأسفان لعدم توقع تأثير البيان على الأحزاب الشيوعية التي تنبأ بها. كانا نادمين لأنهما تجاهلا نوع الديالكتيك الذي أحبا تحليله، كيف ستصبح الدول العمالية أكثر استبدادية في استجابتها لعدوان الدولة الرأسمالية، وكيف ستنمو هذه الدول الرأسمالية متحضرة على نحو متزايد، في استجابتها للخوف من الشيوعية.
طوبى للمؤلفين الذين تنجم أخطاؤهم عن قوة كلماتهم. فهؤلاء هم الذين تصحح أخطاؤهم نفسها بنفسها. في يومنا الحاضر، اختفت تقريبًا الدول العمالية المستوحاة من البيان، وحُلت الأحزاب الشيوعية أو هي في حالة من الفوضى، لكن بعد تحريرها من المنافسة مع الأنظمة المستوحاة من البيان، تتصرف الرأسمالية المعولمة كما لو أنها مصممة على خلق عالم أفضل يفسره البيان.
ما يجعل البيان ملهمًا حقًا اليوم، هو التوصية التي أرسلها لنا هنا والآن، في عالم تتشكل فيه حياتنا باستمرار من خلال ما وصفه ماركس في مخطوطاته الاقتصادية والفلسفية السابقة بأنه “طاقة” عالمية تخترق كل الحدود وتطرح نفسها باعتبارها السياسة الوحيدة، والعالمية الوحيدة، والحد الوحيد والسند الوحيد، من سائقي أوبر ووزراء المالية إلى المديرين التنفيذيين والبسطاء اليائسين، يمكن أن نكون معذورين جميعًا بسبب شعورنا بالإرهاق من هذه الطاقة. إن الرأسمالية منتشرة بدرجة كبيرة لدرجة أنه قد يبدو من المستحيل في بعض الأحيان تخيل عالمنا بدونها، بيد أن ذلك مجرد خطوة صغيرة من الشعور بالعجز ومن ثم الوقوع ضحية لحقيقة تبدو مؤكدة ألا وهي أنه ليس ثمة بديل. لكن، يدعي البيان، وبشكل مدهش، أنه عندما نكون على وشك الخضوع لهذه الفكرة، نكتشف أن هناك بدائل عديدة.
والحال أن ما لا نحتاجه في هذا المنعطف هو العظات حول الظلم في كل شيء، وإدانة تزايد عدم المساواة أو الوقفات الاحتجاجية لسياسات ديمقراطيتنا المتلاشية. ولا ينبغي لنا أن نتعامل مع أفعال يائسة من التنافر الرجعي أو الصرخة للعودة إلى ما قبل الحداثة، وما قبل عصر التكنولوجيا حيث بإمكاننا التمسك بحضارة القومية. الواقع إن ما يروج له البيان في لحظات الشك والخضوع هو تقييم موضوعي واضح للرأسمالية وأمراضها، من خلال الضوء الثاقب من العقلانية.
يناقش البيان أن المشكلة مع الرأسمالية ليس لأنها تنتج الكثير من التكنولوجيا، أو أنها غير عادلة، مشكلة الرأسمالية هي أنها غير عقلانية، إن نجاح الرأسمالية في نشر نفسها عن طريق فكرة التراكم، حيث أن التراكم هو ما يجعل العمال البشر يعملون مثل الآلات لقاء أجر زهيد، بينما تُبرمج الروبوتات من أجل إنتاج أشياء لم يعد العمال قادرين على تحمل تكاليفها وبدورها الروبوتات لا تحتاج الإنسان. تفشل الرأسمالية في الاستخدام الرشيد للآلات الرائعة التي تنتجها، وتحكم على أجيال كاملة بالحرمان، وتنتج بيئة متداعية، وبطالة مقنعة، وعمالة ناقصة ووقت فراغ يقضيه الإنسان في السعي إلى التوظيف والبقاء على قيد الحياة بشكل عام. حتى الرأسماليون يتحولون إلى روبوتات مثيرة للقلق، يعيشون في خوف دائم من أنه ما لم يحولوا إخوانهم البشر إلى سلعة، فإنهم سيتوقفون عن أن يكونوا رأسماليين، ينضمون إلى الرتب المقفرة لتتوسع البروليتاريا.
وهكذا، إذا كانت الرأسمالية تبدو غير عادلة، فذلك لأنها تستعبد الجميع، الأغنياء والفقراء، تبدد الموارد البشرية والطبيعية. كما أن “خط الإنتاج” نفسه الذي يضخ ثروة لا حصر لها ينتج عنه أيضًا رضا عميق وسخط على نطاق صناعي ما. لذا، فإن مهمتنا الأولى، وفقًا للبيان، هي التعرف على مدى ميل هذه ” الطاقة” القهرية لتقويض نفسها.
عندما يسألني الصحفيون، من أو ما هو أكبر تهديد للرأسمالية، أتحدى توقعاتهم بأن أجيب: “رأس المال”. وبطبيعة الحال، هذه هي الفكرة التي كنت قد انتحلتها منذ عقود من البيان نفسه. بالنظر إلى أنه ليس بالإمكان أو من غير المرغوب فيه إلغاء “طاقة” الرأسمالية، فإن هذه الخدعة هي التي تساعد على تسريع تنمية رأس المال (بحيث يحترق مثل نيزك سريع عبر الغلاف الجوي) بينما يقاوم (من الناحية الأخرى) ومن خلال العقلانية والعمل الجماعي، ميله إلى هزيمة روحنا البشرية. وباختصار، إن توصية البيان هي أن ندفع رأس المال إلى الحدود مع الحد من عواقبه أو التحضير لتجذيره اجتماعيًا.

صحيح أننا بحاجة إلى المزيد من الروبوتات، وألواح شمسية أفضل، واتصالات فورية، وشبكات نقل خضراء متطورة، لكن بالمثل، نحن بحاجة إلى تنظيم أنفسنا سياسيًا للدفاع عن الضعفاء، وتمكين الكثيرين، وتمهيد الطريق لقلب عبثية الرأسمالية. من الناحية العملية، يعني هذا التعامل مع فكرة أنه لا يوجد بديل عن الاحتقار الذي نستحقه بينما نرفض كل الدعوات إلى “العودة” إلى وجود أقل حداثة. لكن الحق أنه لم يكن هناك شيء أخلاقي في الحياة في ظل الأشكال السابقة للرأسمالية. العروض التلفزيونية التي تستثمر الحنين إلى الماضي بحساب شديد، مثل مسلسل “داونتاون آبي”، المفترض أن هذا ما يجب أن يجعلنا سعداء، لكن في الوقت نفسه، قد يشجعنا ذلك أيضًا على تسريع معدل التغيير.
الحال أن البيان هو واحد من تلك النصوص العاطفية التي تتحدث إلى كل واحد منا بشكل مختلف في أوقات مختلفة، مما يعكس ظروفنا الخاصة. منذ عدة سنوات، وصفت نفسي بالماركسي المتقلب التحرري، وقد تنازعت مع ماركسيين وغير ماركسيين على حد سواء، لكن بعد فترة وجيزة، وجدت نفسي في موقف سياسي لا أُحسد عليه، خلال فترة صراع بين الحكومة اليونانية آنذاك وبعض أقوى وكلاء الرأسمالية، إن إعادة قراءة البيان لغرض كتابة هذه المقدمة كان يشبه إلى حد كبير دعوة أشباح ماركس وأنجلز إلى الصراخ في أذني بخليط من اللوم والدعم.
تحكي مذكراتي في الوقت الذي خدمت فيه كوزير للمالية في حكومة اليونان عام 2015، الكيفية التي سحق بها الربيع اليوناني من خلال مزيج من القوة الغاشمة (من جانب الدائنين اليونانيين) والجبهة المنقسمة داخل الحكومة التي أعمل بها، إنها صادقة ودقيقة بقدر ما أستطيع فعلها، ومع ذلك، من وجهة نظر البيان، كان الوكلاء التاريخيون الحقيقيون يقتصرون على الظهور في دور ضحايا شبه سلبيين. “أين البروليتاريا في قصتك؟ يمكنني أن أسمع صوت ماركس وأنجلز يصرخان عليّ الآن، “ألا ينبغي أن يكونا هم الأكثر قدرة على مواجهة الرأسمالية، مع دعمك من الخطوط الجانبية؟”
ولحسن الحظ، إعادة قراءة البيان قد يقدم بعض العزاء أيضًا، معتمدًا على وجهة نظري بشأن البيان كنص ليبرالي وتحرري حتى، وإذا كان البيان ينتقد الفضائل البرجوازية لليبرالية، فإنه يفعل ذلك إنما بسبب تفانيه وحبه لها. فالسعادة، والحرية، والاستقلال الذاتي، والفردانية، والروحانية، والتنمية الموجهة، هي المثل العليا التي جعلت ماركس وأنجلز فوق كل شيء. وإذا كانا غاضبين من البرجوازية، فلأنها تسعى إلى حرمان الأغلبية من أية فرصة كي تكون حرة. ونظرًا لالتزام ماركس وإنجلز بفكرة هيجل الرائعة التي تفيد بأنه لا أحد حرًا طالما ان هناك شخصًا واحدًا متسلسلًا، فإن شجارهما مع البرجوازية هو أنها تضحي بحرية وفردانية الجميع على مذبح التراكم الرأسمالي.
على الرغم من أن ماركس وأنجلز لم يكونا من الفوضويين، إلا انهما كرها فكرة الدولة وقدرتها على التلاعب من قبل طبقة لقمع طبقة أخرى، بل ورأيا ذلك شرًا ضروريًا في أحسن الأحوال، سيعيش في المستقبل الجيد بعد الرأسمالية ليخلق مجتمع لا طبقي. إذا كانت هذه القراءة للبيان متماسكة، فإن الطريقة الوحيدة لتكون الدولة شيوعية هي أن تكون تحررية، والحال أن استدعاء البيان إلى “الاتحاد” لا يتعارض في الواقع مع أن يغدو المرء حاملًا لبطاقة ستالينية، أو مع السعي لإعادة تشكيل العالم في صورة الأنظمة الشيوعية المنحلة الآن.
عندما يقال ويُفعل كل شيء، فما هو بيت القصيد من البيان؟، ولماذا ينبغي على أي شخص، وخاصة الشباب اليوم، أن يهتم بأمور التاريخ والسياسة وما شابه؟.
اعتمد ماركس وإنجلز في بيانهما على إجابة بسيطة مؤثرة: السعادة الإنسانية الأصيلة والحرية الحقيقية التي يجب أن ترافقها. بالنسبة لهما، هذه هي الأشياء الوحيدة المهمة حقًا. لا يعتمد بيانهما على استدعاءات الواجب الجرمانية الصارمة، أو مناشدات المسؤوليات التاريخية التي تلهمنا بالتصرف، أنه لا يفسر تفسيرًا أخلاقيًا، أو يشير بأصبعه. حاول ماركس وأنجلز التغلب على تثبيت الفلسفة الأخلاقية الألمانية ودوافع الربحية الرأسمالية، مع نداء عقلاني، ولكنه مثير إلى حد بعيد لأساسيات طبيعتنا البشرية المشتركة.
بيد أن المفتاح لتحليلهما هو الهوة الدائمة التوسع بين أولئك الذين ينتجون والذين يملكون أدوات الإنتاج. إن الترابط الإشكالي لرأس المال والعمل المأجور يمنعنا من الاستمتاع بعملنا ومصنوعاتنا الفنية، ويحول أصحاب العمل والعمال، الأغنياء والفقراء، إلى بيادق مرتعشين، يرتعشون بسرعة ويسيرون نحو وجود بلا معنى من قبل قوى خارجة عن سيطرتنا.
لكن لماذا نحتاج للسياسة للتعامل مع هذا. أليست السياسة الحالية مهلهلة، لا سيما السياسة الاشتراكية، التي زعم أوسكار وايلد ذات مرة أنها “تأخذ الكثير من الأمسيات”. جواب ماركس وأنجلز هو: “لأننا لا نستطيع إنهاء هذه البلاهة على نحو فردي. لأنه لا وجود لسوق يمكن أن ينتج عنه ترياق لهذا الغباء. يبدو إن العمل السياسي الديمقراطي الجماعي هو فرصتنا الوحيدة للحرية والاستمتاع، ولهذا يبدو أن الليالي الطويلة ثمن صغير علينا دفعه.
قد تنجح البشرية في ضمان الترتيبات الاجتماعية التي تسمح “بالتنمية الحرة لكل واحد” بأنها “شرط للتنمية الحرة للجميع”. ولكن، مرة أخرى، قد ينتهي بنا المطاف في “الخراب العام” للحرب النووية أو الكارثة البيئية أو السخط المؤلم. في لحظتنا الحالية، لا توجد ضمانات. يمكننا أن ننتقل إلى البيان للإلهام والحكمة والطاقة، ولكن في النهاية، ما يعم هو مسؤوليتنا.






