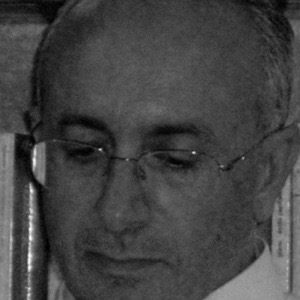تمر القضية الوطنية الفلسطينية في أحلك أيامها بل أخطرها منذ نكبة عام ١٩٤٨، فهي لم تعد على الأقل لفظياً “قضية العرب الأولى” وإن لم تكن هي بالفعل كذلك، ولم تعد عنواناً للقوى التقدمية على الصعيد العالمي ولم تعد تمتلكُ أي خيارٍ لفرض حضورها ولإسماع صوتها إذ غاب الفدائي الثوري المغوار وحضر الدبلوماسي وكياسته الخجولة مكانه.
ثقافة المقاومة استُبدِلت بثقافة المساومة والمفاوضات الماراثونية ولم يعد حق العودة الشعار الناظم للكل الفلسطيني، ذلك الكل الذي قامت اتفاقية أوسلو بتجزئته وتقطيع أوصاله. “الداخل الفلسطيني” أُغرِق بعقلية الاستهلاك الفردي والمديونية وحُكِمَ بقوة النار والحديد التي تشاركت فيه سلطتي أوسلو في رام الله وفي غزة إضافة لقمع الأجهزة الأمنية والعسكرية للمُحتَل الغاشم.
أما الشتات الفلسطيني وتحديداً في “دول الطوق” (طوقاً على الفلسطيني وليس طوقاً على إسرائيل) فلم يكن أسعدَ حظاً إذ لم يعد الرديف الأول للعمل الوطني بفعل تهميشه المقصود من قِبَلِ السياسات الأوسلوية ومن قِبَلِ النظام الرسمي العربي المتوجس منه شراً.
وهكذا، جرى استبدال النضال من أجل العودة والتحرير بالنضال من أجل الدولة الكانتونية والبانتوستانية تحت ظل حراب الاحتلال وقد جرّ هذا الاستبدال لوضعٍ لم يعرف له التاريخ مثيلاً: يقوم المُستعمَر بحماية المُستعمِر عبر تنسيق أمني رُفعَ لمرتبة القداسة. لم يعد شعار العودة والتحريرالشعار المقدس للجماهير الفلسطينية بل سياسة التعاون الأمني مع المُحتل هي الممارسة المُقدسة لسلطة تتباهى بسلميتها أمام العالم لعل تهاونها يجلب لها عطف العالم لكي يُجبر إسرائيل على منح هذه السلطة دولتها العتيدة.
لكن، وبانتظار الدولة (أو بانتظار”غودو”) العبثي والتي لن تأتي أبداً، تواصل السلطة الأوسلوية الحديث عن الحل الوهمي المُسمى بـ “حل الدولتين” ورغم وهميته الفاقعة، يبقى كورقة توت وحيدة لحماية عورة هذا الحل التصفوي للقضية الوطنية. ولذا، فإن العمل على إسقاط حل الدولتين هو عمل نضالي بامتياز وذلك من أجل إعادة تعريف القضية الوطنية بعيداً عن التلوث الأوسلوي الذي أدخله اليمين “العلماني” (فتح) واليمين الديني (حماس) في صلب الوعي الوطني الفلسطيني. نزع الأوهام من الوعي الفلسطيني يتطلب تلك العودة إلى بديهيات الصراع حول فلسطين التاريخية المدعوة صهيونياً للتحول الكلي لأرض إسرائيل حيث يتقلص الوجود الفلسطيني بعد تحويل الجزء الأكبر منه إلى شتات اللجوء فيما سيتبقى وجود أقلياتي من سكان غيتوات مغلقة في مراكز مدينية مُحاصَرة من الخارج بالقوى العسكرية الصهيونية ومن الداخل بقوى الأمن الفلسطيني المُتعاونة مع قوى الاحتلال.
نزع أوهام الحل السلمي وإقامة الدويلة المسخ هو بمثابة نزع استعمار العقل والوعي الفلسطيني والذي نجحت إسرائيل بالتعاون الوثيق مع النظام الرسمي العربي بترسيخه في العقل الجمعي الفلسطيني في الحقبة الأوسلوية المشؤومة. بالطبع، تتحمل القوى المركزية التاريخية في الحركة الوطنية الفلسطينية مسؤولية كبرى في إنجاح عملية الاستعمار الذهني هذه وذلك عبر سلسلة تراجعاتها وفشلها في بلورة مشروع وطني قائم على ثوابت الحق الفلسطيني في فلسطين التاريخية. التنازل عن الحق التاريخي بحجة مرحلية النضال منذ إقرار برنامج “النقاط العشر” هو ما فتح الباب مشرعاً للولوج في المرحلة الأوسلوية والتي أدت إلى الوصول إلى “صفقة القرن” وورشة البحرين وسلامها الاقتصادي المُدعيّ زوراً بالوقوف خارج “السياسة”.
وبمواجهة هذه المخاطر الجسيمة والتي يمثلها هذا النظام الدولي والإقليمي الجديد ومحاولاته فرض التصور الصهيوني لفلسطين كأرض إسرائيل، لا بدّ من رفع شعار “الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة من النهر إلى البحر على أرض فلسطين التاريخية”.
نزع الوعي الاستعماري من الوعي واللاوعي الفلسطيني
لكي لا تتحول صفقة العصر الترمبية إلى نكبة جديدة تُضاف إلى نكباتنا المتواصلة ولكي لا تتحول بفضل موازين القوى المُختَلة لصالح الحلف الصهيوني/الامبريالي/الرسمي العربي إلى واقع جديد مُسَلمٌ به في الوعي وفي طبقات اللاوعي الدفينة في الذهن الجمعي الفلسطيني، لا بدّ من إعادة تعريف القضية الوطنية كقضية كولونيالية وليس كقضية احتلال بدأ عام ١٩٦٧. هذا التعريف هو ضرورة قصوى للخروج من ذهنية إقامة الدويلة على جزء من أرض فلسطين التاريخية. هنا، إعادة التعريف هذه مرتبطة بتعريف أكثر دقة للطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني ألا وهي تلك الطبيعة الخصوصية لكولونيالية استيطانية إحلالية هادفة للسيطرة على الأرض وطرد الجزء الأكبر من أهل هذه الأرض لكي تتحول أرض فلسطين التاريخية إلى أرض إسرائيل. ومن شأن إعادة هذا التعريف الدقيق لطبيعة الصراع على أرض فلسطين أن يساهم في التخلص من “إيديولوجيا” الدويلة المُتغلغل في الوعي الفلسطيني، تلك الإيديولوجيا التي مهدت الطريق للقبول بالحل الأوسلوي ومخرجاته الطبيعية: الحل الترمبي للصراع في ورشة البحرين وما سبقها وما سوف يعقبها في الأيام القادمة. تلك الأيديولوجية الكولونيالية المُتغلغلة في الوعي الفلسطيني هي من أنتجَ صفقة العصر الأولى: اتفاقية أوسلو وملحقاتها في السلم الاقتصادي، ففي الصفقة الأولى، تنازل الفلسطيني عن حقوقه التاريخية واعترف بشرعية الخطاب الصهيوني على حساب الخطاب الفلسطيني الذي هزمته قيادات العمل الوطني على أياديها بقبولها مقدمات الطرح الصهيوني وحقوقه بإقامة دولته على الجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية.
إن من قبل الصفقة الأولى لا يمكن له أن يقاوم نتائجها الطبيعية: الصفقة الثانية كتتمة منطقية للأولى وما محاولات “مقاومتها” إلا ذر للرماد في عيون الشعب ومحاولةٍ بائسة لاستعادة “عذرية” وطنية مفقودة. مقاومة السلام الاقتصادي لورشة البحرين، أي القبول بسلطة إدارة ذاتية “بلدية” على مراكز مدينية دون سيادة سياسية وتحت ظلال حراب الاستعمار الكولونيالي الصهيوني هو واقع الحال لسلطتي أوسلو في رام الله وفي غزة، فما معنى تلك “المقاومة” وما هي مصداقيتها ما دامت تتم من تحت وابل خراب المشروع الوطني الذي تمثله إيديولوجيا الدويلة المشؤومة؟
إن المقاومة الحقة تحتاج إلى الاعتراف العلني بأن “السلام الاقتصادي” المرفوض في ورشة البحرين هو ذات السلام الاقتصادي المُقرَ في “اتفاق باريس” الاقتصادي كركن أساسي من أركان السلطة الأوسلوية مُضافاً له ركن التعاون الأمني”المُقدس”. إن هذه “المقاومة” المزعومة ما هي إلا نوع رديء من صبغة مغشوشة لن تُخفي شيخوخة وهرم السلطة الأوسلوية والتي لن تنجح في ثني بعض من وُصفَ بـ “الخونة” من تجار وكمبرادور ممن يعلنون صراحةً مشاركتهم في ورشة تصفية القضية الوطنية.
إن الاختراق الإسرائيلي لبُنى المجتمع الفلسطيني المحلي سبق وأن حقق اختراقات مُمَيزة لبُنى النُخب السياسية والثقافية من قبل ذلك بكثير. إن البكاء على أطلال المشروع الوطني ممن ساهم بفعالية في تدميره قد ينُمَ عن خبث سياسي أو عن “لاوعي” دفين لن تجدي معه وصفات سحرية لمقاومة مُتجددة، مقاومة غير ممكنة في ظل سيادة إيديولوجيا “الدويلة على جزء من أرض فلسطين”.
الدولة الفلسطينية الواحدة ونزع الوعي الكولونيالي الصهيوني من الذهن الجماعي
إن مقاومة حقة للسلام الاقتصادي، أي سلام الخبز مقابل الحرية، سلام الرضوخ مقابل المقاومة، يتطلب قلب الطاولة على الفكر الأوسلوي برمته وهذا يستوجب تغيير الشعار الناظم للعمل الوطني من شعار حل الدولتين إلى شعار النضال من أجل فلسطين كدولة علمانية ديمقراطية واحدة لجميع مواطنيها ولجميع جموع اللاجئين المطرودين من وطنهم هم وأجيالهم اللاحقة على امتداد السبعين عاماً الماضية.
هذا الانقلاب الجذري على مقدمات الطرح الأوسلوي التصفوي للقضية الوطنية لا بدّ وأن يكون انقلاباً جذرياً دون مهاودة تُذكَر وذلك
لإحداث عملية “تنظيف” لوعي وطني جرى تلويثه على امتداد الحقبة التفاوضية المزعومة وهو ما يُشكل الأرضية المُثلى لتطبيق الحل الترمبي الحالي لتصفية نهائية للمشروع الوطني الفلسطيني. على امتداد صفقة القرن الأولى، تضافر “القسر”و”الإكراه” (أنطونيو غرامشي) كأداة للسياسة الأوسلوية بشقيها الفلسطيني والإسرائيلي مع “الإقناع” الاقتصادي الهادف إلى انتزاع قبول الطرف الضعيف بشروط وقواعد اللعبة السياسية (سلطة دون سيادة) وقواعدها الاقتصادية في الملحق الاقتصادي لباريس (رخاء اقتصادي ضمن قوانين السوق الرأسمالية المُتَحَكَم بها إسرائيلياً). إلحاق “الطرف” الفلسطيني اقتصادياً بـ “المركز” الإسرائيلي (سمير أمين) كان سياسة قسرية عنيفة لم يلعب فيها الإقناع سوى دوراً ثانوياً وتكميلياً وهذا ما تحاول أن تسد ثغراته هذه الصفقة التكميلية الجديدة لترمب والتي سوف تبني ركائزها على أرضية ما أنجزته الصفقة الأولى إذ أن الوعي الوطني سبق وأن دُجِنَ على يد سلطتَي أوسلو: لقد جرى “كيّ” الوعي الوطني وتطويعه وإرهاقه بالسعي لكسب العيش وما رافقه من ثقافة “الموزع الآلي/ATM” على أبواب المؤسسات البنكية لصرف رواتب آخر الشهر والتي يترقبها بلهفة ذلك المواطن/المُستهِلك والمُثقل بديون البنوك واستحقاقاتها. المواطن الفرد لم يعد متماهياً مع القضايا الجمعية ومع الحس الوطني المُتراجع ولم يعد التظاهر ممارسة سياسية جماعية سوى في حالات ٍ تتمايز بطابعها المطلبي اللامُسَيَس (التظاهرات الحاشدة ضد قانون الضمان الاجتماعي فاقت بكثير تظاهرات يوم الأرض).
نزع التسييس الذي تطمح له الصفقة الثانية سبق وأن حققته الصفقة الأولى بامتياز. تحول المواطن عن الهموم الجماعية نحو الهموم الفردية جعل منه مواطناً “متفرجاً” على ما يجري وما يُخطَطُ له لتحديد مصيره ومصير المشروع الوطني برمته. المواطن الفرد المُستهلِك والمُستَهلك بهمومه اليومية هو الفرد الفلسطيني الذي تراهن الخطة الترمبية على قبوله بالاستسلام النهائي لمشروعها التصفوي. الفلسطيني المُسالِم، المُحافِظ والمُعتدل هو الفلسطيني المثالي الذي صنعته الصفقة الأولى لأوسلو عبر ذلك الطابع الزبائني/المصلحي الرابط ما بين المواطن و”السلطة” (وبالتالي، أي سلطة) في ظل تداخل وتراكب المصالح الضيقة لممثلي الحمائل المتنفذة وكبار التجار وكبار موظفي”السلطة” ممن تتمفصل مصالحهم المادية مع علاقاتهم العائلية والعشائرية.
تراجع المشروع الوطني وتشظيه إلى جزيئات غير مترابطة لن تنفع معه عملية ترقيع مُقترحة من بعض الأصوات الوطنية الغيورة على المصلحة الجمعية للشعب الفلسطيني (إعادة تفعيل منظمة التحرير، مثلاً) فأمام حجم الكارثة الوطنية لا بدّ من حلول جذرية وأول هذه الحلول هو الانحياز العلني بدون لبس وتردد لشعار دولة فلسطين العلمانية الديمقراطية واختطاط برامج عملية لتطبيق هذا الشعار على أرض الواقع المحلي والإقليمي والدولي. إن تطبيق خطة عمل ميدانية تجمع القوى الحيّة من الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده تستوجب بناء كيانات شعبية شابة، نقابية ومطلبية وتشبيكها خارج الأُطر القديمة والتي ثبت عقمها وتبعيتها لفصائل عفى عنها الزمن وشاخت دون أن توصل المشروع الوطني إلى بر الأمان. بناء الكيانات الجديدة بشكل لامركزي للعمل معاً تحت برنامج نضالي وطني جامع هو الرد الوحيد على ما يجري التخطيط له من قِبَلِ التحالف الصهيوني الإمبريالي بالتواطؤ مع النظام الرسمي العربي.