وُلدَ أمجد ناصر نواحي العام ١٩٧٨، في العاصمة اللبنانية بيروت. أي بعد قرابة ثلاثة وعشرين سنة على ولادة يحيى النعيمي، الشاب البدويّ الذي اتخذ القرار الصعب بالافتراق عن مصائرِ العائلة، والالتحاق بنبض الحياة ونداءاتِها، وكان يرجع صداها آنذاك من بيروت. عقبَ سنتين قضاهما في عمّان قادمًا من مدينة صغيرة هي “المفرق” شمال الأردن.
لم تكن عمّان، أو المفرق بطبيعة الحال، لتلبّي حاجة الشاب الطامح والحالم. فالمنطقةُ على أبواب الانفجار، والحالمون ليس لأرواحهم طمأنينة، ولا لآفاقهم حدود. وبيروت، التي كانت تغلي في تلك السنوات، وتواجه حربًا سوفَ تغيّرُ وجهَ المنطقة إلى أجلٍ لم يكن يُعلمُ حينها، كانت أيضًا، فردوسًا لكلٍ من المهاجرين واللاجئين، والمبدعين والسياسيين والثوريين والحالمين. وقد اجتمعت كلّ هذه الصفات في يحيى النعيمي حينئذ.
ولادةُ أمجد ناصر تلك، في بيروت، وإن جاءت لأسبابٍ أمنيّة بدايةً، حيثُ غيّرَ يحيى النعيمي اسمه إلىَ أمجد ناصر، بحكمِ عمله في صفوف دوائر الثقافة والإعلام الفلسطينية، من مجلة “الهدف” التي أسسها ورأس تحريرها غسان كنفاني، إلى الإذاعة الفلسطينية التي عملَ فيها خلال حصار بيروت، وكان لابدّ من تغيير الاسم جريًا على عادة الفصائل الفلسطينية آنذاك. إلا أنها – أي الولادة – حملت معها مصيرًا غيرَ متخيّلٍ لشخصٍ لم يكن موجودًا قبل ذلك. وهي أيضًا، بقدرِ ما حرّرت القادمَ من المفرق من أثقال فرضتها عليه شروطه كـ”يحيى النعيمي”، ابن تلك الجغرافيا وذلك التاريخ، البدوي الذي “خرج من عشيرته ولدًا” راغباً في كتابة سيرته بيده، فإنها أعطتهُ ميزةً نادرة في مراقبة مسيرة حياة “أمجد ناصر” الذي وُلدَ للتو.
عاش أمجد حياته حمايةً لحياة يحيى النعيمي إذن! قبل أن يتّضح له أن القدر الذي اختار للبدويّ الحياة، اختارَ لمُنقذهِ ومُحرّرهِ الشقاء… والمنفى.
شكّلَ المنفى مفصلًا آخرَ، يكادُ يكون الأشدّ أهمية في حياة صاحب “سُرّ من رآك”. ذلك أنّ الخروجَ الفلسطينيّ من بيروت بعد الاجتياح أخذَ الطابع الجنائزيّ الوداعيّ لأغلبِ الذين عاشوه، كأنما كان الخارجون يودّعون أنفسهم التي تركوها في لبنان، في المخيمات المتروكة للمجازر، وفي شوارع وأحياء المدينةِ التي تحقّقَوا فيها كمناضلين وكتّاب ومشاريع شهداء. وفي حالة أمجد ناصر، فإنّ المنفى أشدّ تركيبًا وتضاعفاً. ففي كلّ خطوةٍ كان يخطوها، كان يستقبلهُ منفىً ما، مرحّبًا فاتحًا ذراعيه ودودًا، ولئيمًا أيضًا!
نفى نفسهُ إلى عمان، حينَ أرادَ البدء بـ “خبطِ الأجنحة”. فلم تكفِ السماء الفاصلة بين المفرق والعاصمة، فنفاها إلى بيروت. ثمّ نفى يحيى النعيمي من حياتهِ اليومية، وأسكنهُ صدرَ أمجد ناصر. بعد هذا، سوف يصبحُ الترحال من بيروت إلى قبرص، ومن قبرص إلى لندن، تحصيل حاصل لأجنحةٍ اعتادت الخفقان.
في لندن أخذت السيرةُ بعدًا جديدًا. إذ يصعبُ التكهّنُ بشكلِ وآثارِ الهجرة، على اسمٍ منفيٍ أصلاً عن جسدهِ، المنفيّ بدوره إلى أرضٍ مغايرة، ومعادية!
هناك التقى الشخصان، المحميّ والحامي، بعد أن اكتشفا أنهما معًا، كانا عرضةً للموت، في الأرض التي أنبتت كلاّ منهما على حدةٍ. وكان لا بدّ من منفىً محايد، يلتقي فيه الاثنان، حيث بالإمكان مراجعة التاريخ الشخصي لكلّ منهما، من دون رغبة بالقصاص.
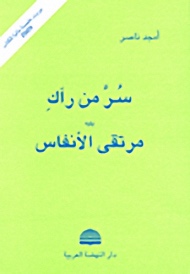
فلقد وُلد في لندن ثالث لأمجد ويحيى، وفرضت عليهما المدينة التعرّف عليه وتدبّر أمورهِ الحياتية، وفرزَ أفكارهِ التي ستشكّل منظومته الأخلاقية وعدّتهُ الفكريّة، للتعرّفَ إلى عالمه الجديد، من زاويةِ المقيمِ، لا الحالم الثوريّ، أو الطارئ العابر. غير أنّ المقيم ما كان في حقيقةِ الأمرِ سوى لاجئ آخر، تُخرجهُ رغبتهُ بالمزيد من مرابع صباه (أهي خطيئته الوحيدة؟!) ثمّ يتكفّلُ قدرهُ بما تبقى، فيُخرجهُ أعداؤهُ من بقيّةِ بيوتهِ المؤقتة، ويثقلونه بشروطهم “البيضاء” لنيل شرف الإقامة في بيوتهم، ليعيشَ وحيدًا وسطَ جموعٍ من الوحيدين، مكتملَ الحريّة!
أن تخرجَ من بيروت مع الفلسطينيين المُهجرين من بلادهم مرتين، وتصلَ فيك الأقدار إلى بريطانيا تحديدًا، الدولة التي أعطت فلسطين لغير أهلها عنوةً، فذاك سوفَ يفرضُ عليكَ عزلةً اختياريةً عمن تسببَ في بلواك. فماذا والحال أنّ بريطانيا نفسها، كانت مُنتبذًا للغرباء أكثر من كونها ملجأ؟!
ماذا والحالُ أنّكَ لن تلفِتَ انتباهَ ركّاب حافلات قطارات الأنفاق، إلا إذا كنت تتحدثُ مع أحدٍ بلغةٍ غير إنكليزية، “كأنكَ لم توجد في مرمى نظرهم”، وفق تعبيرهِ في كتاب “خبط الأجنحة” – سيرة المدن والمنافي والرحيل، الذي أصدرته دار رياض الريس عام ١٩٩٦، ثمّ أعادت منشورات المتوسط نشرهُ في طبعة مزيدة عام ٢٠١٧. يقولُ:
«عندها فقط يتحقق وجودك بمعناه المتطاول على تقاليد الصمت المقدس، المنتهك لحرمِ السلوك المتحضّر (تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، وحريةُ الآخرين مكفولةٌ بالصمت). حيثُ رَفْعُ الصوت بلغةٍ عربية ذات جرس حاد، يُشكّلُ اعتداء على أذن الآخر».
ثالثُ – ناصر والنعيمي – ذاك، وإن كانت لندن أشدّ رأفةً عليه من مدنٍ أخرى كان يُمكنُ أن يؤول إليها مصيره، لكونها لم تشكّلُ عائقًا بينهُ وبين خبزهِ اليومي، ولتوفّرِ الوسط العربي المكتفي بذاته بين ظهرانيها، إلا أنها شكلت الاصطدام الأولَ بين البدويّ والشاعر المناضلِ من جهة، وبين الثالث اللاجئ الباحث عن هويّةٍ يُعرّفُ بها نفسهُ أمام كل هؤلاء “الآخرين” من جهة أخرى. وتلك مهمة شاقة على نمطي الشخصية هذين، إذ إن كلا منهما يُعتبرُ تعريفًا بحدّ ذاتهِ: البدويّ بالعلاقة الوطيدة المعروفة بينه وبين تاريخهِ وأصله وبيئته ومفرداتها الشعرية، والقيم المُتمَثّلة لدى أهله. والشاعر الثوريّ الذي ينتابهُ شعورٌ طبيعيّ أنّهُ مُعرّف لدى العالم بأسره، مستندًا في تعريفهِ لنفسه إلى تعريفِ قضيّته، ملتحمًا معها غير منفصلٍ عنها.

صراعٌٌ أرخى بظلاله على سيرة أمجد ناصر، الشخصية والشعرية، ومنحَ السّيرتين أبعادًا أكثر رحابة واتساعًا، وزودهما بما يلزم من التجريب الشعريّ المتوالدِ من رحم التجريبِ الذي خضعت لهُ شخصية يحيى النعيمي منذُ نبوءاتِ جدتهِ بحياةٍ قلقة، إلى رغبة أجنحتهِ بالخفقان ترجمةً حركيّةً لنزعةِ الحريّةِ لديه.
ولكي تكتملَ فصول الحكاية، فإنّ على التجربةِ الشعرية التي وُلِدت من رحمِ قصائد البدو والسهوب والنجوم، وترعرعت وسط حقول الألغام والخسران في بيروت، ونضجت على نارٍ هادئةٍ وعاطفةٍ أشدّ حذرًا، إثر اتّضاح الأسئلةِ التي ساعدتها الهجرة الطويلة والتجربة في التجلي، فقد اختار أمجد ناصر، محقًا، أن يردّ الأمانةَ لأصحابها، ويسمح لأجنحة يحيى النعيمي أن تستقرّ من حيث بدأ اصطفاقُها بالضبط قبل أكثر من أربعين عاماً. حيثُ أرضُ قصيدتهِ الخصبة، وهويّتهُ الحقيقيةُ التي آن أوانُ استعادتها.






