تتناول زينة حلبي في بحثها “تفكيك المثقف العربي: النبوءة والمنفى والأمة” حال الثقافة العربية الراهنة واضعة إياها في الإطار التاريخي-الثقافي للمشروع القومي العربي ومحوره انتقال هذا المشروع من مرحلة البناء إلى مرحلة التفكك، أي من مرحلة صعوده إبان فترة الحرب الباردة إلى مرحلة انحساره وتفككه في طور الما-بعد، أي، ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية وما بعد أوسلو وما بعد حرب الخليج (أوائل تسعينات القرن الفائت). تنبري هذه المقالة القصيرة إلى معاينة نقدية لكل من: (1) مفهوم “المثقف العربي” الذي تنصّبه حلبي ممثلا للتحوّلات الجارية في الإطار التاريخي-الثقافي المذكور وساردا لصعوده ولأفوله ولمآلاته الراهنة، و(2) منهج “المقاربة الجامعة للأجناس” (“transgeneric approach”) الذي يتصّل اتصالا وثيقا بمفهوم “المثقف العربي” والذي تعتمده المؤلفة في بحثها، وذلك لاقتراح ترسيم نقدي للمساحة التي يشغلانها وللمناطق التي يشيحان عنها. وقوفا على هذا، سوف أحذو فيما يلي حذو المؤَلَّف أمامنا باتخاذ تجربة الشاعر الفلسطيني محمود درويش نقطة انطلاق نحو رؤية مختلفة لهذه التجربة لنتبيّن من خلالها مناطق الضوء والعتم التي يفرشها أمامنا هذا الكتاب.
ففي الأول تختار الباحثة “المثقف العربي” قلبا وقالبا، أو شخصية ومفهوما، آنية لسردها وترسّم لنا ملامح “المثقف العربي” لتصب تجربة محمود درويش في قالب “المثقف العربي” في حالة تكوّنه الأول. من ذلك، يصبح درويش التجسّد والأنموذج الأصلي (archetype) للمثقف العربي في حالته الأولى. تعرّف حلبي مثقفنا العربي هذا كنبيّ منفيّ. وإذا ما كانت هذه المكوّنات الهيكل اللّب الذي تقوم عليه بنية المثقف العربي ليصبح ما هو عليه، أي ليصبح المثقف العربي دالا بصفته هذه على نفسه بنفسه، يأتي دور الانحسار فيموت اللّب، ويظلّ الاسم “المثقف العربي”، أو جرا على ذلك “الثقافة العربية”، عنوانا وعباءة يلبسها ما-بعد “المثقف العربي” الذي يراجع بحكم رداءه أو اسمه تجربة المثقف العربي في دورها الأول مراجعةً تحوّرها في المُعاصرة، أي في الزمن المعاصر (contemporary)، وهو غير الراهن أو الحاضر، وهو الذي يركن وجوده أصلا إلى استمرارية سردية “المثقف العربي” المحكومة إلى الزمان الما-بعد (حداثي). وفي وصف الباحثة حلبي لدرويش كنبيّ منفيّ يتماهى القلب والقالب، أي أن العوامل المكوّنة لشخصية المثقف العربي النبيّ المنفيّ تنضفر معا لتكوين حيّ للمثقف العربي فيتجلّى محمود درويش إثر ذلك أنموذجا أصليا مثاليا للمثقف العربي لتُقاس بحسب صورة شخصه الأولى هذه أحوال “المثقف العربي” (وثقافته) الثلاثة: الصعود والسقوط ومن ثم التحوّر (making and unmaking).
ينطلق النقد المطروح ههنا للكتاب من اتفاق كامل مع المؤلفة بشأن تعريفها للمثقف العربي واعتبارها محمود درويش مثقفا عربيا وتشخيصها الحاكم بنهاية واندثار المثقف العربي مع فشل مشروعه النهضوي من جهة ارتباط هذا الأخير بمشروع قومي عربي فشل في تحرير الأرض والإنسان لدى وصوله إلى نهايته في مرحلة الما-بعد (القائمة اليوم على حالها). ثمّة أن الإعلان عن موت المثقف العربي، بما هو إعلان أي بما هو تصريح يفصّل لقارئه جزئيات حالٍ واقعٍ حاصل، عبارة عن وصف صحيح يعبّر على مستوى الثقافة العربية عمّا آل إليه مشروع النهضة العربية القومي منذ تسعينات القرن الماضي (على الأقل). ولما كان الإعلان عن موت “المثقف العربي” مثل غيره من الإعلانات—كمثل الإعلان عن “موت الله” (نيتشه) أو الإعلان عن موت المؤلف (بارت) أو غيرها—وصفا تحقيبيا يربط زمانيته بحياة “المرحوم”، أي بسنيّ حياته وبذكراه من بعد موته، يوقظ الإعلان لدى جمهور سامعيه وعيا ذاتيا بواقعهم الراهن بما هو عهد ذاكرة زمان ولّى بحياته من غير أن ينصرف ظل ذكراه. الإعلان عن موت المثقف العربي إذا يبشر بموت القلب يستبقي القالب. يناظر اقتران القلب والقالب اقتران المتن بالهامش: يحوّل الإعلانُ الحاضرَ في الوعي الذاتي لمن يصغي إليه إلى زمن المثقف العربي المعاصر، وهو وعي الهامش القابض على قالب المثقف العربي مستذكرا متنه. لحظة الإعلان عن موت “المثقف العربي” لحظة حاسمة بامتياز، وهي قائمة في صلب تعريف المؤلفة للمثقف العربي وعليها فقط تقوم إمكانية صعود المثقف العربي المعاصر. يغيب عن السرد الذي نقرأه في هذا الكتاب التفات نقدي من طرف مؤلفته إلى هذا العامل الحاسم كما لو كان واقعا مفهوما ضمنا. وعلى هذا نلقى هذا البحث يصوّر المعاصر وكأنه نتيجة حتمية وطبيعية لأفول الماضي الذي انقشع بفشله أفق المستقبل ليستكين الحاضر المنكوب إلى معاصرةٍ تلتفت إلى الوراء لفتة مملوءة بالسخرية والتهكم والسوداوية (إيليا سليمان مثالا). تحوي هذه الدراسة فعل الصناعة المفاهيمية. لكن حلبي لا تلتفت إلى آثارها، فكأن المعاصر هو الحاضر، والحاضر هو المعاصر، بالضرورة. إنما وفي واقع الأمر، فإنه لا يمكننا استيلاد الإعلان عن موت “المثقف العربي” بدون أن نصنع من قبل ذلك مفهوم “المثقف العربي” في داخل سردية التفكك (unmaking)، وهي سردية إعلانية يقوم عليها الوعي الذاتي المعاصر (بالمعاصرة).
بناءً على هذا كلّه يسعني الآن أن أضيف بأن امتحان القيمة المستفادة من الإعلان (عن موت المثقف العربي) منوطة بالتقرير بين كونه إعلانا أجوفا يضيع رنين وقعه كتبدّد الصدى في فراغ وبين التقرير بقدرته على تكوين وعي ذاتي هو الهامش الذي تحشوه المعاصرة في القالب. بكلمات أخرى، إذا ما اتفقنا على أنه لم يتبق، بإعلاننا عن موت المثقف العربي، من المثقف العربي إبان عهده الذهبي غير اسمه، أو قالبه، أو ذكراه من بعد موته، فما هو، في الحاصل، تعريف زينة حلبي للمثقف العربي المعاصر؟ وإن أحاط هذا المعاصر باسم المثقف العربي فعلا، فهل هو محيط بالحاضر كذلك؟ أو، إذا ما تبيّنا مصطلح المثقف العربي واتفقنا على صحة خبر موته، ففي أيّ حال ومكان نجد معاصرة “المثقف العربي” تضيء حاضرنا الراهن وأنّى ومتى نلقاها ترهنه للعتمة؟
للإحاطة بمصير المثقف العربي في راهن الما-بعد علينا أن نعرج إلى المنهج الذي تعتمده الدراسة، “المقاربة الجامعة للأجناس”، والذي يلازم فيها مفهوم “المثقف العربي” ملازمة الضوء للشمس. تفتح “المقاربة الجامعة للأجناس” أمام المؤلفة مجالا واسعا يمكّن تعريفها للمثقف العربي من الإحاطة بما هبّ ودبّ من الصناعات الفنيّة والأدبية والعلمية بدون التزام حدود جنس أدبي أو جنس فنّي بعينه، فيعينها على سبيل المثال من مقارنة الرواية والفيلم. وهي وبذلك تتجاوز في الما-بعد المعاصر حدود الأجناس الأدبية وإمكانيات مقارناتها النقدية والتي قد كان المثقف الحداثي (العربي) قد وضعها من قبل فأضحت بائدة بتبدده. كما وتمكّنها هذا المقاربة في الآن ذاته من عبور حدود العالم العربي الجغرافية وكذلك حدود اللغة العربية باعتبارها لغة المثقف العربي وثقافته، جانحة بذلك نحو رحابة المحيط الكوني الأوسع الذي يجمع إضافة إلى ما يجمع من جغرافيا العالم العربي ولغته، آداب وفنون المهجر “العربي” لتصوغ منها معاصرة ما-بعد المثقف العربي في واقع ما-بعد حداثي.
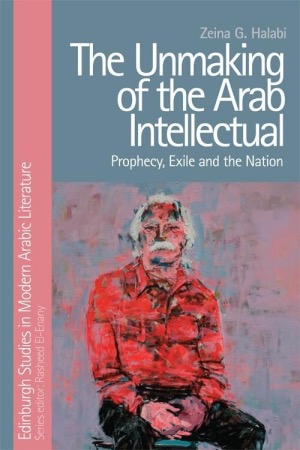
يفسر مفهوم “المثقف العربي”، مصحوبا بما يلازمه من مقاربةٍ جامعةٍ للأجناس، ما يفسر من الحاضر الراهن محوّرا لنفسه هذا الحاضر زمنا معاصرا له. لكنه، وإن فسّر وأفاد، لا يحيط بالحاضر الراهن، بل وأكثر، فهو وإن أظهر نجده، وبحكم قدر الإحاطة التي تحيط بها المنهجية التي يعتمدها بحاضرنا، يغيّب أمورا أخرى. فمن الجهة الأخرى، فإننا باعتمادنا هذا المفهوم للمثقف العربي ومثله اعتمادنا ما يلازمه من منهجية “المقاربة الجامعة للأجناس” بصفتهما ممثلين للثقافة العربية بما باد منها وبما عاصرت نجدنا، إذا ما أعدنا تجربة محمود درويش إلى الواجهة، صارفي النظر عن محمود درويش الشاعر وعاجزين عن فهمه. بحسب مفهوم المثقف العربي الذي يضيء تجربة محمد درويش بصفته مثقفا عربيا، يتحوّل درويش إلى شاعر بحكم كونه مثقفا عربيا ويتحول الشعر، بما هو شعر، إلى جنس أدبي يصطف إلى جانب غيره من الأجناس الأدبية والفنية وغيرها. ففي الأول يغيّب الفهم المنقول إلينا بواسطة مفهوم “المثقف العربي” الشعرَ، وذاك ليجعل منه جنسا أدبيا ما ثانيا. نعم كان محمود درويش مثقفا عربيا ولكنه كان من قبل ذلك شاعرا (عربيا)، ذلك مثلما كان ادوارد سعيد، أولا وقبل كل شيء، وإن فكّر وصاغ أفكاره العلمية باللغة الإنجليزية، مثقفا عربيا. والأهم من ذلك أيضا، هو فهم درويش لنفسه شاعرا، مثلما كان فهم سعيد لنفسه مثقفا. بالطبع لا يغيب شعر درويش عن سردية حلبي ونجدها تشير إليه وتنتبه وتنبّه إلى تمايزه، لكن صياغتها لتمايزه هذا فتجعله تمايزا محكوما لمفهوم المثقف العربي يدور في مداره: فمن ناحيتها يصبح الشعر جنسا أدبيا محشورا في إطار مفهوم سارتري للأدب الملتزم الذي يدع الشاعر يعي الشعر حاملا لقدرة تحررية من نوع خاص فقط لا غير.
إلا أن تقديم درويش الشاعر على درويش المثقف فيؤدي بنا إلى كشف آخر للحاضر الذي انتحله “المثقف العربي” المعاصر لنفسه، ليطلق هذا التقديم في طريقه ما كبته هذا الأخير من إمكانيات أخرى لفهم الماضي والراهن وعلاقاتهما التي تفوق بتعقيداتها علاقة المثقف العربي المعاصر في عهد ما-بعد المثقف العربي المائت. لا يحرر هذا التقديم الشعر من إطار الجنس الأدبي الذي حصره فيه مفهوم “المثقف العربي” فحسب، وإنما يطرح تصوّرا جديدا لزمن الحضارة/الثقافة (العربية) وحقبها وآنياتها يتجاوز التصوّرات التي تحقّب للحداثة وما يلتصق بها من ما-بعد الحداثة.
ومن هذا المنظور تتجلّى قصيدة “مديح الظل العالي”، التي تتعرض لها حلبي في بحثها، شعرا بحتا من قبل أن يحملّها مفهوم “المثقف العربي” بمعاني الحداثة العربية وتبعات التصنيفات الحديثة للأجناس الأدبية والفنية. إن قراءة حلبي لقصيدة “مديح الظل العالي” كتعبير عن مشروع العلمنة والتحديث وبناء الأمة الذي قام بها المثقف العربي صحيحة تماما، ولكنها عاجزة عن الإجابة عن السؤال عن معاني إحاطة الشعر بالذات بهذا المشروع، اللهم إلا من خلال حشر الشعر (الدرويشي) في خانة الأدب الملتزم، ليصعد بصعوده وليهبط بهبوطه. وأحد هذه المعاني، التي تعتم عليها قراءة حلبي، أننا نلقى الشعر، وفي “مديح الظل العالي” بالذات، يطلق صرخة “حريتي فوضاي”: حرية لا تلزم الشعر بمشروع المثقف العربي، بل تلزم الأخير بالأول. كما وأنها حرية لا تشيح عن مشروع المثقف العربي نحو مذهبية الفوضوية بل تبقى فوضى خالصة، لتصل القصيدة كلها إلى نتيجة مفادها “ما أصغر الدولة”، وهي نتيجة تحيط بمشروع المثقف العربي من غير أن يحيط بها، وإلى ألاّ تعتمد صحتها لا زمانية المثقف العربي البائد ولا ذاك المعاصر لتقوم لها قائمة.
على ضوء هذا المثال الأخير، يدعونا هذا النقد إلى تناول آخر لتجربة درويش الشاعر: إلى تناول ينتشل مسائل مثل مسألة “العداوة بين هومر (الشاعر) وأفلاطون (الفيلسوف)” أو مسألة “والشعراء يتبعهم الغاوون” وهي مسائل أقل ما يمكن أن يقال عنها حقيقة أنها لا تنضوي تحت أسئلة العلمنة والتحديث وبناء الأمة، بل على العكس، فهذي مسائل، وإن غُيّبت، لا تغيب عن هذه الأسئلة اللاحقة ومن شأنها إضاءتها بشكل يتجاوز حدود الدراسات المناطقية (Area Studies) وزمانية حرب 1967 ومفهوم المعاصرة الذي اخترعته لنفسها.






