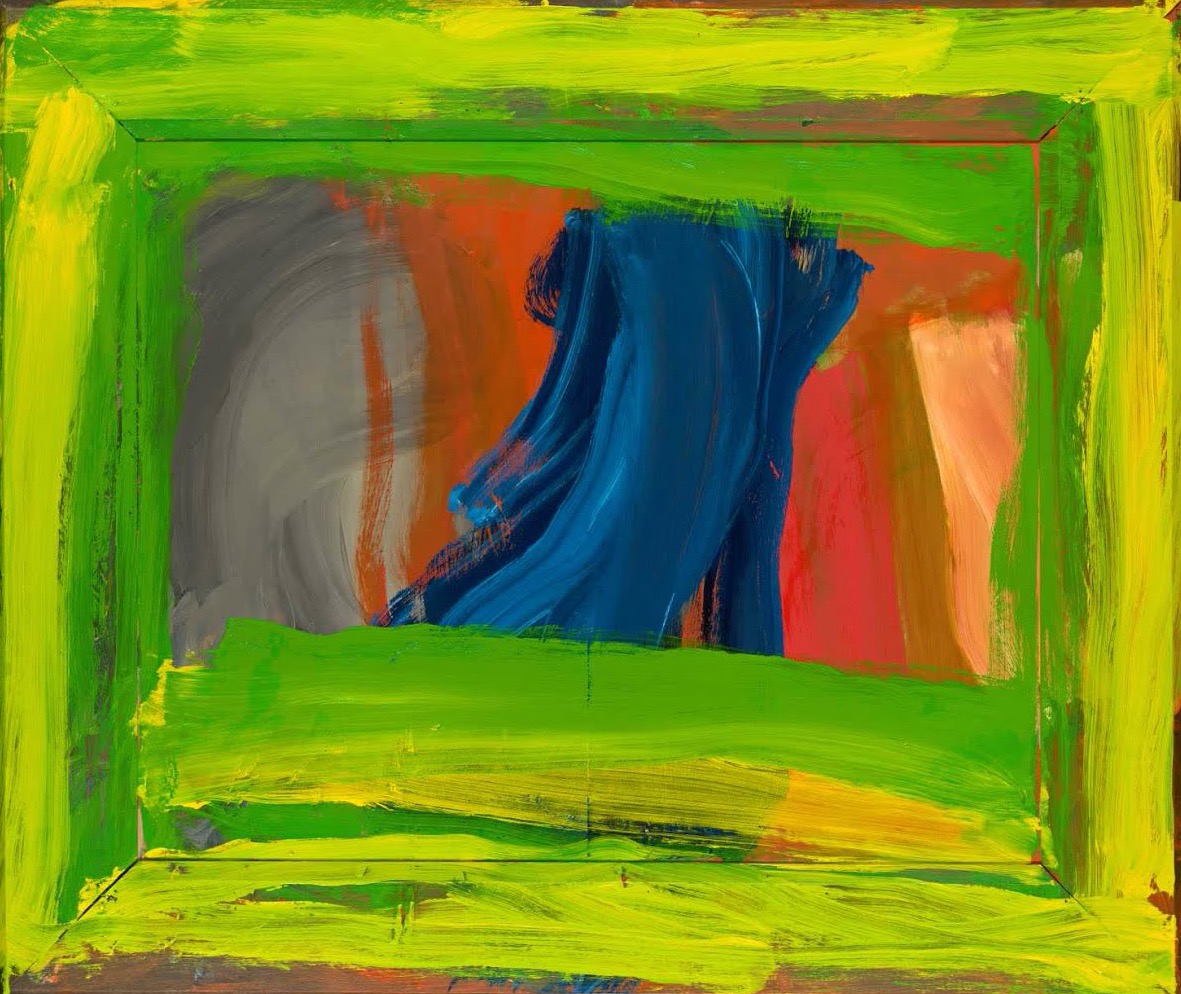ينطلق الفيلسوف ناصيف نصّار في مشروعه للاستقلال الفلسفيّ، الذي بدأ بوضع منهجه في كتابه “طريق الاستقلال الفلسفي”، من مقولة أنَّ الفلسفة العربية علقت بعد هزيمة حزيران 67 بين الأصالة والحداثة. حيث أنَّ الفلاسفة المعاصرين العرب إمّا ارتدّوا إلى فلسفة العصر العربي الوسيط، بصفته العصر الذهبي، أو لجأوا إلى ترجمة الفلسفة الغربية وإعادة دراستها وإنتاجها إمّا باللغة العربية أو بلغات أجنبية.
يسحب نصّار هذه الفرضية في كتابه “منطق السلطة” على مؤسّسات الدولة ليُخرج فكرته من الشرح النظري إلى التطبيقات العملية. ويُبيّن أنَّ الدولة عالقة بمسميّات دستورية تضفي طابعًا دينيًّا عليها لكن في ذات الوقت لدى الدول العربية مجالس نوّاب لها صفة تشريعيّة، ويتساءل هُنا عن الشلل في اتخاذ صفتين تشريعيتين، داخل جسد واحد، تكادان تكونان متناقضتين. ويُبيّن عبر ذلك أنَّ الحُكم في العالم العربي مشلولٌ بسبب استيراده شكل الحكم الذي يتمثّل بفصل السلطات مع إبقاء يد سلطات تنفيذية على المؤسسات التشريعية أو القضائية (كحالة لبنان الذي يُعاني من عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وهناك حالات أُخرى تُبقي للسلطة التنفيذية حق حل مجلس النواب مثلاً أو أن يكون هناك رأس أعلى على السلطتين).
لكن في مناطق أقلَّ سياسيّة وأقرب للحياة اليومية اقترح مرّة أُستاذ لنا في الجامعة في مساق النهضة العربية عن مثالٍ يُمكننا التماهي معه أكثر؛ فبالنسبة له فإنَّ استيراد الآلة دون ثقافتها يؤدّي بنا إلى التعامل معها باستعمال ثقافتنا في عصر ما قبل استيرادها. فعندما يلتقي سائقان يعرفان بعضهما على الطريق قد يتوقفان ليُلقيا التحيّة على بعضهما البعض وربما فتح حديثٍ صغير. وقد وصف الأستاذ المذكور هذه الحالة بقوله إنّنا نقود السيارة بذهنية من يجرُّ حمارًا، فثقافة السيارة لم تتشابك في ذهنيتنا لأنّنا لم نُبدعها ولم نستوردها بالكامل.
أُحبُّ أن أستعمل هذا المثال في العادة لتفسير مقولة نصّار عن الفلسفة بأنّنا عالقون بين الأصالة التي نفتخر بها والحداثة المُعجبون بها، لكن علقتنا هذه تُبقينا في حالة شلل دائم، لأنَّ الأصالة لا يمكن أن تُعبّر عن واقعنا المُعاصر، والحداثة إن استمرينا باستيرادها شكليًّا، لا يمكن أن تتواءم مع الواقع ذاته، لذا فالإبداع ورفض الواقع هو أمرٌ واجب علينا.
هذا الشلل دائمًا ما نسمع أصداءه في المؤسسات التي هي عندنا ولا تعمل بفعاليّة المؤسسات الأجنبية عمومًا والغربية تحديدًا كالمؤسسات الأكاديميّة، إن كانت الجامعات أو المدارس، ومؤسّسات البحث العلمي. وحتى في المجال الثقافيّ كالمسارح والفنون البصريّة ودور النشر بل وعلى مستوى المنتخبات الرياضيّة أيضاً.
كمؤدٍ صوتي في مجال الدوبلاج أتساءل دائمًا لماذا لا نُعطى الفُرصة لتركيب الشخصيات التي نؤديها بأنفسنا بأصواتنا ولغتنا ونكتفي بسياسة المحطّات التي تطلب أصواتاً مطابقة للأصوات الأجنبية أو حتى في الأداء فغالباً ما يكتفي المخرج في الاستوديو بالطلب: “اسمع الأجنبي، واعمل متل ما عمل.” ومن الملاحظ أنّ الترجمة تكون محوّرة عن الأصل لكي “تُلائم” ثقافتنا فيخلُصُ المحتوى بأن يكون باللّغة العربية الفصحى بشكلٍ سليم و”مُلائم” لثقافتنا بالرغم من أنَّ العملية انتهت به بأن يكون مبتوراً ومزعجاً للمشاهد. كثيرٌ من العاملين بمجال الدوبلاج لا يحبّون مشاهدة إلّا الأعمال الأصلية بلغتها الأصلية لأنّهم غير مقتنعين بالعمل النهائي.
أسأل أحياناً المخرجين الفاعلين في مجال الدوبلاج عن رغبتهم في المشاركة بأعمال أصلية وإبداع الشخصيات والحبكة فيأتيني الجواب: “لماذا أريد أن أفعل ذلك؟ إن كانت تأتيني الحلقة مع توقيتها وترجمتها ولا يتطلّب منّي الأمر سوى تركيب صوتٍ على الصورة مع متابعة النطق واللّغة فلماذا أُتعب رأسي باختراع الشخصيات والحبكة من الصفر؟”
مجالٌ بأكمله، يريد المحتوى الأجنبي لكن بلغة عربية سليمة، أقلُّ ما يُمكن وصفه هو الشلل إن لم يكن الانحدار. فإن لم يكن هُناك إنتاج محليّ بثقافة محليّة فستبقى العقلية المحافظة التي تبحث عمّا “يُلائم” تصطدم بمحتوى أجنبي لا يُلائمها فتبتره على حساب النوعية عوضاً عن إبداع ما يُلائمها ويرفع من نوعية هذا الفن.
هذه الأمثلة ليست سوى مُبسّطات لفكرة نصّار الاستقلالية عن حاجة النظر إلى الاستقلال الفكري في كافّة المجالات بما فيها مجالات الثقافية التي لديها نموذج تجاري (كالإنتاج التلفزيوني والإعلانات وحتى نشر وبيع الكتب) فلا يجب أن نكتفي بوجود الحداثة شكلاً والعمل بأسلوبٍ أصلاني فينتهي بنا الأمر بمدمّرين للنوعية التي لدى الإثنين؛ فمع نجاح نموذج سوق الورّاقين في العصر العبّاسي لا يمكننا استيراد مؤسسات النشر والتوزيع ومتاجر الكتب (وهي مجالات عمل منفصلة) وجمعها معاً في مؤسّسة واحدة كأنّها حانوت ورّاق دون أن نُعاود الاصطدام بالشلل الذي يُصيب المجتمع فننتهي إلى مقولات كـ: “سوق الكتاب يموت، والعرب لا يقرأون، ونحن شعوبٌ جاهلة.” فقط لتبرير الفشل.
إن كانت هُناك مشكلة في النتيجة فالنبحث عن المشكلة في الأداء ونحلها بما يتواءم مع من نحن عوضاً عن الاستمرار في الخطأ والقول بأنَّ الغرب يسبقنا، فنحن دون شك سنبقى مُتأخّرين عنه إن أصرينا على الاهتداء به ولحاقه.