بعد 21 رواية كتبها ما بين عامي 1970 و2017 يؤكد الروائي السوري نبيل سليمان (1945)، أنه لم يكتب بعد روايته التي يريد. صاحب رباعية «مدارات الشرق»، و«جداريات الشام – نمنوما»، و«ليل العالم»، يكشف في حواره مع “رمان” الكثير من التفاصيل المثيرة عن سيرته في دروب الحياة والكتابة الإبداعية، والكتابة المضادة، في زمن الطغيان والديكتاتورية.
منعت سلطات النظام توزيع روايتيك «ليل العالم» (2016)، و«جداريات الشام – نمنوما» (2014) في سوريا، لما تقدمانه من لوحة بانورامية عمّا يحدث منذ ست سنوات في البلد، ولما فيهما من جرأة وتعرية للنظام البعثي الحاكم، كما تعرضتَّ لأكثر من اعتداء بالعنف منذ العام 1970 بعد صدور روايتك «ينداح الطوفان»، ما هي أسباب المنع؟ وهل كشف المستور أو الحديث عن المسكوت عنه وكسر “التابوهات”، ثيمات فكرية تتوارى خلف بنائك الروائي؟
بعيد صدور روايتي الأولى «ينداح الطوفان» عام 1970، تنطّع لها، ولي، ولأسرتي، الرقيبُ الاجتماعي في هيئة مثقف ما، قرأ الرواية، فطابق بين شخصيات فيها وبين شخصيات من حولي، ووسوس محرضاً، وكانت نعمة الاعتداء الأولى.
ليس الرقيب الرسمي أو السياسي أو الحزبي، وهو ما أسميه: الرقيب السلطاني، بأكبر شراً ومكراً من الرقيب الاجتماعي الذي قد يتلفع بالدين أو الأخلاق أو الأعراف… وقد لاقى الرقيب الرسمي في وزارة الإعلام بالمنع روايتي الثانية «السجن» عام 1972، مما اضطرني للذهاب بها إلى بيروت، وبذا أحسن المنع إليّ، فلولاه ما نشرت الرواية يومئذٍ في عاصمة النشر.
ولم تفتأ السلسلة تكرّ منذ ما يقرب من نصف القرن، فمنعت رواية «جرماتي أو ملف البلاد التي سوف تعيش بعد الحرب» التي صدرت عام 1977 في القاهرة، وظل توزيعها ممنوعاً في سوريا حتى عام 1995.
وعاد إليّ الرقيب المجتمعي بصدد رواية «أطياف العرش» التي صدرت في القاهرة عام 1995، وكان منها المسلسل التلفزيوني «الطويبي» الذي منع عرضه في سوريا. أما الاعتداء الجسدي الأكبر الذي تعرضت له في 1/2/2001 فقد كان جواب ذوي الشأن على رواية «سمر الليالي» التي صدرت قبل الاعتداء بأربعة أشهر.
في عام 2014 صدرت «جداريات الشام – نمنوما» مع عدد أيار(مايو) من مجلة “دبي الثقافية”، لكن الرقابة السورية منعت توزيع الرواية والمجلة.
ومع عدد كانون الثاني (يناير) 2016 من مجلة “دبي الثقافية” أيضاً صدرت روايتي «ليل العالم» فمنعت الرقابة السورية توزيع الرواية وسمحت بتوزيع المجلة.
لأن كل واحدة من هذه الروايات أسقطت ورقة التوت عن واحدة أو أكثر من عورات النظام الاجتماعي السياسي، كان المنع، أو كان الاعتداء مع المنع: مرة لأنك تهتك نفاق الشيخ/رجل الدين أو تحالفه مع ذوي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ومرة لأنك تهتك اعتقال وتعذيب الشابات السوريات السياسيات يميناً ويساراً في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ومرة لأنك تتبصّر في قمع المظاهرات السلمية، وتمجيدها، سنة 2011، ومرة لأنك تتبصّر في سقوط رموز النظام في مدينة الرقة سنة 2013. ولن يعدم رقيب ما أن يجد بغيته في رواية ما، لي، مادام كسر “التابوهات”، أياً كانت، شاغلاً مكيناً لكتابتي.
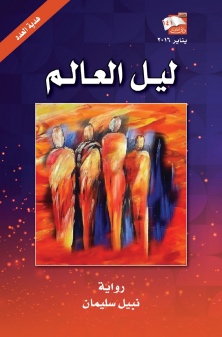
في بلد الرقابة فيه مشدّدة، هل تمتلك موهبة التحايل على الرقيب؟ وإلى أي مدى كنت حرّاً في الكتابة؟ وهل واجهت مشاكل في هذا الشأن سابقاً في غير بلدك؟
لعل أحداً لايزال يذكر كيف لاعب وواجه “الديمقراطيون الروس” الرقابة القيصرية في القرن التاسع عشر.
لقد تعلمت منهم الكثير من فنون اللعب والمواجهة. وأيسر ذلك أن الرواية التي تتوقف رسالتها على جملة أو كلمة، سيكون فيها من الخلل الفني ما فيها. والحق أنني طوال عمري أنسى الرقيب تماماً أثناء كتابتي الأولى للرواية، وبالكاد أتذكره في الكتابة الأخيرة. فالمسألة ليست مسألة هتافات أو شعارات رنانة، ولا بذاءات أو تجديفات مطنطنة. المسألة هي مسألة الفن أولاً وأخيراً. ولأنها كذلك فهي أولاً وأخيراً مسألة “رسالة” الرواية بالمعنى التاريخي، بالمعنى السياسي العميق إن شئت. وبفضل ذلك كله أدّعي أنني حرّ في كتابتي بنسبة كبرى، وقد كبرت هذه النسبة ربما بفضل العمر، والتراكم، واتّساع إمكانية النشر، وبالتالي تراجع ضغط الرقيب، وبخاصة الرقيب الرسمي.
أما ما لاقيت من الرقيب في غير بلدي، فهو يسير، حيث منعت الكويت عدداً من رواياتي، لسنوات طويلة حتى تحقق الانفتاح في معرض الكتاب فيها العام الماضي 2016. ومن عجائب الرقابة أنها منعت في مصر رباعية «مدارات الشرق» منذ عشرين سنة وبعد تدخل الراحلين سمير سرحان وجمال الغيطاني تم توزيع الرباعية، ولكن بعد الاكتفاء بعنوان كل جزء في كشوف التعبئة التي ينظمها الموزع لاستيراد الكتب، لأن عنوان الرباعية ظل ممنوعاً لسنوات، ولكن فقط في الاستيراد، وليس في التوزيع!!
تقول: “صرت أصدّق أنّ في حياة كلّ كاتب مشروع العمر الذي يُكتَب مرّة واحدة ولا يتكرر”. ما هو مشروعك الروائي؟ وأين يمكن للقارئ أن يتلمس ذلك فيما نشرت من الروايات؟
حديثي عن “مشروع العمر” جاء بعد نشر رباعية «مدارات الشرق» التي جاءت في 2400 صفحة، وقضيت في كتابتها ما بين 1986-1993. وكنت أقصد أن تلك الرباعية هي مشروع العمر، وأن الكاتب يرتكب هذه الجريرة مرة واحدة في حياته.
الآن، وبعد قرابة ربع قرن من ذلك الحديث، يلتبس الأمر عليّ كلما دوّمتْ فيّ أحلام الكتابة الروائية، أرجّح أنه قد يكون للكاتب(ة) أكثر من مشروع عمر. والآن يزداد الأمر عليّ التباساً، كما يزداد وضوحاً على أن مشروع العمر هو مشروعك الروائي.
حسناً، سأكتفي بالإشارة إلى أجزاء «مدارات الشرق»، وهي: (الأشرعة – بنات نعش – التيجان – الشقائق)، وبالإشارة إلى روايتي «جداريات الشام – نمنوما» و«ليل العالم».
لو سألتك عن أهم المحطات المؤثرة في حياتك كاتباً وإنساناً ومبدعاً ملتزماً، كيف تقدمها للقراء؟
كثيرة هي هذه المحطات، سواء تعلقت بالصداقة أم القراءة أم المكان أم الحدث… وبالطبع تتفاوت درجة التأثر والتأثير، ولك أن تعدّ: صداقة بوعلي ياسين التي امتدت قرابة أربعين عاماً، حرب 1967، قرية البودي التي أقمت فيها ما بين 1962-1966، مدينة الرقة التي أقمت فيها ما بين 1967-1972، قراءتي لـ«ألف ليلة وليلة» آنئذٍ، مدينة حلب التي أقمت فيها ما بين 1972-1978، رحلتي الأولى إلى بيروت مع بوعلي ياسين ما بين تشرين الأول (أكتوبر) 1979 وآذار (مارس) 1980، رحلتي الأولى إلى فرنسا عقب بيروت ولستة أشهر أيضاً، موت والدي عام 1989، الاعتداء المجهول المعلوم عليّ عقاباً أمنياً على رواية وندوة في 1/2/2000، المظاهرات السلميّة السورية من اللاذقية إلى حماة إلى… سنة 2011، الاعتداء على بيتي وسيارتي ومواجهة الموت عقاباً على مساهمتي المتواضعة جداً في حراك 2011، وعبر كل ذلك كانت امرأة…

كتبت «السجن» عام 1972 وهي رواية تحكي تجربة الاعتقال في السجون السورية، على الرغم من أنك لم تعش تجربة الاعتقال، هل هناك حدث معين حفزك على كتابة هذه الرواية؟
عرفت الاعتقال مرتين؛ الأولى لنصف ليل ونصف نهار عام 1978 في اللاذقية، والثانية لنصف نهار وليلة بطولها في مطار القاهرة عام 1980.
أدرك أنها تجربة بالغة التواضع، ولا تقاس بما عرفته الآلاف المؤلفة منهم ومنهنَّ في سوريا خلال نصف قرن من الكابوس البعثي. من هذه التجربة السورية التي تفوق الخيال، والتي غذّت أدب السجون بالكثير، استلهمت رواية «السجن» التي تخاطب ما كان أثناء الوحدة السورية المصرية 1958-1961، ولكن بلا تعيين للزمان والمكان، وعبر تجربة الصديق نبيه خوري. وربما عليّ أن أضيف هنا أن عبد الرحمن منيف هو من حرضني عندما كان يكتب «الآن هنا» على أن أكتب رواية أخرى عن السجن، فتابعت تجارب الشابات السياسيات السجينات وكتبت رواية «سمر الليالي».
كيف يستقي الروائي فكرة رواية ما؟ وهل يحق له وهو يكتب رواية تاريخية أن يغير حقائق تاريخية معروفة على مستوى الحدث أو الشخوص؟
ليس من نهج بعينه لاستقاء فكرة رواية ما. قد تكون قراءة في كتاب تاريخي، أو في تحقيق صحفي، أو في سفر ما، أو في شخصية ممن حولك: حبيبة أو سجّان أو انهيار سدّ.. أما حين يتعامل الروائي مع التاريخ، فله أن يتخيل ما لم يقع وأن يرمم ثغرات التاريخ، أو أن يعيد تنضيد طبقاته، أو أن يضيف شخصيات متخيلة، فالروائي ليس مؤرخاً كما أن المؤرخ ليس روائياً. وعندما يحاول الروائي أن يكون مؤرخاً فيتقفى التاريخ، لن يفلح في أن يكون روائياً ولا مؤرخاً. لذلك لا أفتأ أتحدث عن الحفر الروائي في التاريخ، وليس عن الرواية التاريخية أو التأرخة الروائية.
كيف ترى تطور كتاباتك ما بين «ينداح الطّوفان»، وحتى «ليل العالم»؟ وهل تراها تطوراً أصلاً أم تراكماً؟
أظن أن كتابتي الروائية تتطور من رواية إلى رواية أحياناً، ومن مرحلة يكون فيها عدد من الروايات، إلى مرحلة. وسأكتفي بضرب أمثلة من اللغة بين رواية «ينداح الطوفان» ورواية «جرماتي»، ومن البناء بين «جداريات الشام» و«ليل العالم»، ومن الحفر في التاريخ بين «مدارات الشرق» و«أطياف العرش» و«سمر الليالي».
يقال إن الروايات عادة ما تحمل سمات من شخصية الروائي وتعكس بعضاً من تجربته الخاصة، ما هي حدود الواقعي والمتخيل في أعمالك؟
تشتبك هذه الحدود دائماً، والحكم في هذا الاشتباك هو لفعل التخييل. فقد تكون لحظة عشق مما عشت هي الواقع، لكن الرواية قد تبدل في الواقعة/الوقائع، قد تحذف وقد تضيف، وبذلك، حتى ما هو سيري في رواية يكون رهن التخييل. وبالتالي، لست أنا حرفياً شخصية (نبيل) في رواية «المسلة» وإن كان لنا نفس الاسم والبيت وخدمة العسكرية والزوجة والشهوة والكذبة… وعلى مستوى آخر، تأتي الرواية إلى ركن من أركان جبال الساحل السوري في عشرينات القرن الماضي، فتتقرى الشفاهي، والوثيقة، وفعل الإيمان في الإنسان، والأسطورة، والتألّه.. لكن الرواية تسلم كل ما كان إلى المخيلة، وهي ترسم التمرد الاجتماعي والعشق الجارف والجنس المتفجر والتأليه والتألّه.. وإذا برواية «أطياف العرش» واقعية بدرجة ما، ومتخيلة بدرجات.
بعد هذه الرحلة الطويلة من الكتابة إلى أين تتجه كتابتك؟ وماذا تعني لك الكتابة اليوم بعد تفرغك لها منذ سنوات؟
أحياناً تتجه كتابتي الروائية إلى أن تكون تلك الثلاثينية/الأربعينية التي تتقد فتنةً، حيويةً وجمالاً وشهوةً وإلغازاً. أحياناً تتجه إلى أن تضيف إلى ذلك نفحةً من الخمسينية، بل والستينية، هي نفحة الخبرة الروحية العميقة الكنوزة، نفحة التأملات الوجودية الكاوية والشفيفة. ومرة تروم كتابتي الروائية إلى أن تتفاعل مع الموسيقى، مع اللوحة، بل لِمَ المواربة أو الخجل؟ أن تكون الرواية موسيقى ولوحة معاً: ذاك هو المرام. أما الكتابة غير الروائية فاتجاهها هو إلى أن تتنحى ما أمكن كي يكون للكتابة الروائية ما تبقى من العمر، ومن الطاقة.
بعد 21 رواية هل كتبت روايتك التي تريد؟
لا ياصديقي، لا.
كيف ترى الأدب كشهادة حية عن اللحظة التاريخية؟ وما هو دور الكاتب/الروائي؟
يمكن للأدب، كما للفنون، أن يكون تلك الشهادة الحية، لا الميتة ولا المتطوحة بين الحياة والموت أو الأكثر موتاً والأقل حياة. ويمكن للأدب أن يكون كذلك سواء أكانت اللحظة التاريخية المعنية قد انقضت أم هي في صيرورتها. وفي الأخيرة هذه تحديات كبرى للأدب، وبيان أكبر جلاءً وعسراً لدور الكاتب، إذ عليه وعلى ما يبدع أن يتلمّس نبض التاريخ، وأن يكتبه، عليه ألا يكون صدى للصيرورة التاريخية، بل مجبولاً بها وفي غمرتها، ولا أقصد أن يكون مقاتلاً مثلاً في معركة، بل أن يحفر عميقاً فيما يرى ويعيش، أن يرهن روحه لكتابته في تجددها وتجذرها ونزاهتها وطموحاتها.
يكثر اليوم في أوساط النقاد الحديث عن فقر عوالم الروايات وضحالتها وقطيعتها مع تقاليد أدبية كبرى. خاصَّة من الجيل الجديد من كُتّاب الرواية العرب، ما هو رأيك؟
آسف أن ذلك صحيح إلى درجة كبيرة أو أكبر. ففي الفورة الروائية العربية يكثر الغث ويندر الثمين، وليس في ذلك أية مفاجأة. تلك طبيعة الأمور. فإذا كان عدد الروايات العربية في السنة الواحدة مئة – لم أقل خمسمائة – وكان بينها عشر روايات ممتازة وعشر وسط، فهذا إنجاز كبير. هذا يعني أنه سيكون لدينا بعد عشر سنوات مئة رواية ممتازة ومئة وسط، وأنا لم أشك في أن تكون حصيلة عشر سنوات نصف ذلك العدد.
منذ سنوات كتبت منتقداً الاستعجال في النشر والاستسهال اللغوي. وبلا أي تنسيق وجدت الصديق سعيد يقطين (ناقد مغربي) يرسل الانتقاد نفسه، فالظاهرة جلية، وليس لواحدنا أن ينخدع ولا أن يخدع. والأمر ليس ندباً ولا تعجيزاً ولا سلبية. الأمر هو ببساطة دعوة إلى أن تكون كتابة رواية حياة بطولها، بمكابداتها وقراءاتها وأحلامها وقلقها…
أظهرت أن عدداً غير قليل من الأنواع الكتابية يمكن أن يناسبك (الرواية، القصة، المقالة الأدبية والنقدية) فهل فكرت يوماً ما بكتابة الشعر؟
في مطلع سبعينات القرن الماضي، أي في بداية المشوار، حاولت كتابة القصة القصيرة، وكان من ذلك ما ظهر مع روايتي القصيرة «قيس يبكي» في كتاب واحد. ما عدا ذلك ليس لي نصيب في القصة القصيرة ولا في النوفيلّا – الرواية القصيرة.
أما الشعر فلم أحاوله البتّة، لا في المراهقة، شأن كثيرين وكثيرات، ولا بعدها. الشعر كالموسيقى، أو اللوحة، أو الغابة، أو البحر، أو السماء المرصعة بالنجوم: مسرحاً ولحظة للفتنة والغبطة والتأمل. وإذا كانت الرواية كذلك أيضاً، ففي كتابتها، وأحياناً في قراءة فرائدها الخالدة، إضافة مختلفة. أما أيسر الكتابة فهو المقالة النقدية أو العامة، والتي لا أمارسها إلا بين كتابة رواية وأخرى.
أنت متابع لكل ما يصدر من روايات سورية في السنوات الأخيرة، فكيف انعكس اللجوء والمنفى على نتاج الأدباء السوريين، وهل يمكننا اليوم الحديث عن “أدب الثورة”، “أدب الحرب”، “أدب المنفى”، وأدب اللجوء”؟ وإلى أي حدّ باتت الثورة السورية رافداً مهماً للأدب والرواية السورية؟
على الرغم من صدور أكثر من أربعين رواية خلال خمس سنوات، وتتعلق جميعاً بما أسميه الزلزال الذي تفجر سنة 2011، وعلى الرغم من الشعر الذي كتب في هذه الفترة، لازال من المبكر الحديث عن “أدب الثورة” أو “أدب الحرب” أو “أدب اللجوء” أو “أدب المنفى”. لأن مثل هذا الحديث يقتضي مدوّنة أكبر عدداً وأكبر تميّزاً ومختلفة نوعياً. ولكن الزلزال – أو الثورة أو الانتفاضة أو الحرب… سمِّ ما تشاء – ترك أثراً عميقاً وعاجلاً في الإبداعات في سوريا. وإذا كنت سأدع الكتابات الموالية جانباً فلأن ما اطلعت عليه منها متواضع. وهذا لا يعني أن الكتابة الإبداعية المعارضة سامقة، فالكثير منها متواضع، لأن أثر الزلزال تباين وتعدد، فلهثت فصائد وروايات كثيرة خلف الحدث، ونافست البيان السياسي، وطغا السياسي على الجمالي، واحتارت الرواية أو القصيدة أو الأغنية أكثر من اللوحة بين أن تؤدي مهمة قتالية أو تكون كاميرا “ديجتال” وأحياناً “زينيت” أو أن تكون ثأراً من العدو.. وسأكتفي بأن أسرد لك هذه الحادثة التي جرت في معرض الكتاب في تونس يوم 27/3/2017 أثناء ندوة “الرواية والحرب” والتي شاركت فيها مع سوسن جميل حسن من سوريا ومع إنعام كجه جي وأحمد سعداوي من العراق. فقد قلت إن عشراً من ثلاثين رواية تتعلق بالحرب السورية، هي وسط وجيدة، والباقي رديء. وقد أغضب ذلك الروائية الصديقة مها حسن، ورأته نيلاً من “رواية الثورة”، وجاملتها ممازحاً ورفعت العدد إلى خمس عشرة من ثلاثين. والحق أنه ليس كذلك.
ما هي نظرتك لواقع الرواية الشبابية في سورية خلال سنوات الجمر الست الماضية؟
لا أظن أن ثمة رواية شبابية وأخرى للشيوخ أو الكهول، والتصنيف بمقتضى الجيل مخادعٌ غالباً.
حين يأتي كاتب أو كاتبة بروايته الأولى، ينسب إلى الشباب ولو كان عمره أو عمرها خمسين سنة. تلك هي الرواية الأولى لعتاب شبيب «موسم سقوط الفراشات» وهي مع روايات سومر شحادة وديمة ونوس والراوي بن رشيدا (هل هذا اسم مستعار؟) الأولى لأصحابها، وهي روايات جيدة لأسماء جديدة، شبابية في الثلاثين أو الأربعين؟ لا أعلم. وعلى أية حالة أحيل الجواب على هذا السؤال إلى جواب السؤال السابق.
برأيك لماذا يغيب اسم الروائي السوري عن معظم الجوائز الأدبية منذ سنوات، (نبيل سليمان، فواز حداد، سليم بركات، خالد خليفة، مها حسن، شهلا العجيلي، وغيرهم)؟ وهل تؤمن بأن الجوائز تساهم في صناعة الروائي وتطوير تجربته وترويج اسمه؟
وصلت روايات خالد خليفة وشهلا العجيلي ومها حسن وفواز حداد إلى القائمة الطويلة والقصيرة من جائزة البوكر العربية. ومع ذلك يبقى سؤالك عن الغياب مشروعاً، فما من روائي(ة) سوري(ة) نال “جائزة العويس” إلا حنا مينه في دورتها الأولى قبل دهر.
كذلك هو الأمر بالنسبة لـ”جائزة الإبداع الروائي” في القاهرة. وإذا كانت علل الجوائز العربية وافرة، فلا ريب أن سبب الغياب هو في واحدة من هذه العلل.
وقد تروج الجائزة اسم الكاتب(ة) أو تحرضه على تطوير تجربته، وتفسح له في ذلك لكنها لا تصنعه ولا تصنعها.
لكل مبدع طقوس خاصة بالكتابة، ما هي الطقوس الخاصة التي تمارسها عند الكتابة؟
العزلة، والصمت، والصحة الجيدة. بالصخب لا أستطيع الكتابة، وأعجب ممن يكتبون في المقهى. في المرض لا يطيب لي إلا النوم. لا أتناول أثناء الكتابة إلا ما ندر من القهوة أو (حليب السباع) أو ما يعادله.
ألجأ إلى قراءة الشعر أو تأمل اللوحات أثناء الإعداد للمشروع أو أثناء الكتابة. في الاستراحات أمشي وأسمع غناء أو موسيقى. والطبيعة، الطبيعة، البحر أو الجبل المطل على البحر، هذا هو طقس الكتابة الأجمل.
أخيراً، ما هو عملك الروائي القادم؟
لازال جنيناً، لذلك لا يمكنني الحديث عنه.






