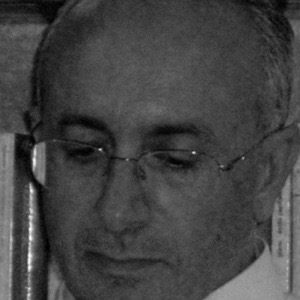الحُلمُ أو بالأحرى حُلمُ اليقظة، ليس خيالاً عابراً لتعزية المُتَخيلِ والحالِم عن واقعٍ يفلتُ من بين يديه لكي يواصل انحداراً نحو الهاوية وإنما هو “الحُلُمُ – الرؤية”، حُلُمُ التغيير بتوسط رؤية متفائلة وإيجابية. وهذا هو ما كان عليه الحلم الديمقراطي والعلماني لرفيقنا سلامة كيلة. حلماً تحررياً لبناء فلسطين كوطن جديد لأصحابها ولمن شردته منهم سياسات الكولونيالية الإحلالية الصهيونية.
هذا الوطن العلماني الذي تغنى به سلامة وناضل من أجله بدون كلل، هو الوطن الذي رفضته”حنة أرندت”، فيلسوفتنا الألمانية اليهودية والمعادية للصهيونية ولمشروعها لإقامة دولة يهودية في فلسطين ولسان حالها يقول”تختبئ وراء فكرة الوطن دولة قومية ذات طابع استبدادي بالضرورة”.
حنة أرندت (Hannah Arendt) بذلك لم تنظر إلى الوطن كقيمة إيجابية عليا وذلك لاقترانه بدولة الاستبداد القومي، ومبدؤها في ذاك إدانة مفهوم “السيادة” المُنظِم لعمل الدولة في حيزها القومي. حنة أرندت رأت في مفهوم “السيادة” نقيضاً لمفهوم “الحرية” فلا حرية حيث توجد سيادة للدولة القومية.
سلامة كيلة رغم سعيه الحثيث لاستعادة الوطن الفلسطيني، لم يكن ليخطر في باله حدوث مثل هذا التعارض الحاد وذلك لسببٍ وحيد: لن يكن هذا الوطن هو ذلك الوطن المُسيجَ بدولة قومية وإنما بوطن يُفرِزُ فيه النضال الديمقراطي دولة علمانية ومابعد قومية، دولة فلسطينية بالطبع ولكن دولة لا تمُتُ بصلةٍ لتلك الدولة القومية على الشاكلة الأوروبية: “الدولة – الأمة”، دولة النزاعات القومية والحروب.
“كم هو سعيد من لا يملكُ وطناً”
حنة أرِندت هي أكبر فلاسفة القرن العشرين وأكثرهم إنتاجاً ومقاربة لحقل السياسة من وجهة نظر فلسفية. الفيلسوفة كانت شاعرةً أيضاً وهذا هو عنوان قصيدتها: “كم هو سعيد من لا يملك وطناً”.
الفلسطيني لا يملك وطناً فهل هو سعيد بدوره؟ أليس الوطن هو مكان الأمن والراحة والشعور بالانتماء والذي لا بد وان يكون بذلك رديفاً للسعادة؟
حنة أرِدنت، تلميذة الفيلسوف الألماني الكبير مارتين هايدجر (Martin Heidegger) والمتأثرة بوالتر بنيامين (Walter Benjamin) كانت تغني نشيداً لفضاء الحرية والذي لا تحد حدوده جغرافية سياسية قومية والذي يتمثل بالوجود الفعلي في فضاء “المنفى” اللاقومي.
المنفى هو رديف “الحرية” وعدم الخضوع لاشتراطات الدولة القومية ولروح التعصب القومي الذي يُميزهُا، والذي لا بدّ وأن يكون ذَا طابع عنصري، روحاً تعصبية تُسيجُ به الدولة القومية حدود “الوطن” باسم مبدأ “السيادة”.
“وطن” حنة أرِنت هو “الحرية” والذي يمثله “المنفى”. ولذا، يمكن ان نعتبر أن المعنى الحقيقي للوطن لا يمكن اختزاله إلى “قضية الأمن” والعيش الآمن في وسطه الاجتماعي والعائلي بل هو التمتع بالحرية، فوطن لا حرية فيه، ليس بوطن وإنما هو سجن لأفراده ذكوراً واناثاً.
الحرية هنا وفي المنظور الديمقراطي والعلماني لسلامة كيلة، هي الحرية بمعناها الشمولي: حرية التحرر من احتلال استيطاني بغيض في محاولاته لإحلال المستوطنين في أرض الفلسطيني. حرية التعبير في مجتمعه المحلي دون أن يكون هناك رقابة سياسية أو اجتماعية أو ذاتية على هذا الرأي في حالة مخالفته للإجماع المُتعارف عليه حُكماً.
حرية الاختلاف كحق مقدس وكشرط أساسي للسعادة.
وهكذا، يرتبط “التحرر” من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة التمتع بـ “الحرية” بمواجهة المجتمع الفلسطيني والذي لا يتيح الكثير من الحريات لأفراده وتحديداً للنساء منهن.
التحرر من الاحتلال الاستيطاني فقط وضمن هذا المنظور لن يحمل لنا الحرية المنشودة.
وعودة إلى حنة أرِدنت، يمكننا أن نقول إن استعادة الفلسطيني لوطنه بحق هو شرط امتلاك الحرية بعد إنجاز تحرره من القيد الاستعماري وحينذاك يمكنه التغني بوطنه، أي بحريته كمعادل لهذا الوطن.
استعادة الفلسطيني لوطن الحرية وطناً لا يُكررُ بناء دولته الاستبدادية القومية حصراً يُمكنُنا من قلب معادلة فيلسوفتنا لكي نجعل من عنوان قصيدتها “كم هو سعيد من يمتلك الحرية”.
الوطن الديمقراطي العلماني هو شرط السعادة والحرية
الإنتاج النظري الكثيف لسلامة كيلة كان يهدف إلى الارتقاء بمفهوم الديمقراطية إلى آفاق العلمانية إذ أن الاقتصار على الأولى دون ربطها بالثانية إنما هو هو تقصير فاضح: الديمقراطية الأثينية كانت ديمقراطية استعباد الأثيني الحر لمن هو ليس حراً، ديمقراطية ذكورية تضع العبيد والنساء خارج حقل المواطنة في نظامٍ يدعيّ الديمقراطية. ولذا، كان تنظير سلامة كيلة محاولة جريئة للانتقال من الحقل الأول للثاني لمزجهما معاً في توليفة إنسانية رفيعة.
بناء الدولة الديمقراطية فقط هو شعار نضالي قاصر وغير كافٍ لإحداث نقلة نوعية في بحر الجمود الفكري والاستبداد السياسي المتجذر في الواقع العربي عموماً.
هناك ديمقراطية ليبرالية اقتصادياً وتنحو بقوة نحو النيوليبرالية الهمجية في ظل العولمة وسيادة علاقات السوق على السياسة التابعة لا السياسة المُحددة والضابطة لقوانين السوق الرأسمالي.
هناك ديموقراطية شعبوية ذات توجهات فاشية كما في المثالين الألماني والايطالي. وهناك ديموقراطية لنظام ثيولوجي كما في الحالة الإيرانية وديموقراطية قومية متطرفة كما الحال في تركيا حيث اجتمعت مؤخراً العوامل القومية مع الدينية بعد أن كانت العلمانية هي سند النظام القومي العسكري التركي السابق للحقبة الإسلامية.
وأخيراً، هناك المثال الفاجر في “الديمقراطية الإسرائيلية”، ديمقراطية عرقية ودينية قائمة على استبعاد الفلسطيني “الغوييم” من خانتها كما استبعدت الديمقراطية الأثينية من “الأغراب-العبيد” والنساء من جمهوريتها. هي بالفعل، ديمقراطية الرجل الأبيض الكولونيالي والفاشي معاً.
“سلامة كيلة” وحُلمُه: I have a dream
سلامة كيلة لم يكن حالماً مثالياً بل كان مناضلاً يحمل مشروعاً للتغيير ولبناء عالم أفضل ليس في فلسطين وحسب وإنما في المجالين العربي والدولي، مشروعاً يقوم على رؤية متماسكة، تقدمية وإنسانية. هذه الرؤية المتفائلة والإيجابية كانت تتناقض مع جو الهزائم والتراجعات الفلسطينية والعربية في ظلِ تغول السياسات الصهيونية والرسمية العربية.
وهنا، شتانّ ما بين الحُلُمُ – الرؤية وأضغاث الأحلام وكوابيس المنفى وجرائم أنظمة الاستبداد العربية والتي تسربت إلى “وعي” قطاعات واسعة من أحزاب ما سُمي باليسار يوماً. “الحلم-الرؤية” كان برنامجاً سياسياً مُؤسِسَاً ومُؤطراً لطاقات شابة لوضع اللبنات الأولى لحزب ثوري عربي لدحر الصهيونية والنظام العربي: سندها المتين وحليفها الأمين لتلاقي مصالح الطرفين وإشهار هذا اللقاء على شواهد الأعيان.
الحُلُمُ السياسي لسلامة كيلة لم يكن حلماً وإنما عملاً ونشاطاً “بلغَ سِنّ الحِلْمْ”.
حُلماً لن يُجهضَ ولن يُعلق على مشجب النسيان بوفاته إذ هو حلم انسيابي ينفث حنيناً للحرية وللوطن العلماني.