نُشرت قبل أيام في “ذا غارديان” بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٩
من الأمور التي تُثيرُ حيرتي هذه الأيام هي الصدمات التي نستمر في التعرّض لها بسبب الانتخابات، مثل مودي في الهند والانتخابات الأسترالية، فهؤلاء اليمينون المتطرفون لا يفوزون مرّةً واحدة فحسب، بل يستمرون في الفوز مجدداً. قد نشهدُ فوز ترامب مرةً أخرى، وقد يصبحُ بوريس جونسون رئيساً للحكومة البريطانية، بينما نستمر نحن في تلقي الصدمات.
كنتُ في الولايات المتحدة مؤخراً، وقد أثار الاحتمال الحقيقي بفوز ترامب مرة أخرى اهتمامي بصورة كبيرة، خاصةً وأنني ممن تعرضوا للسخرية التي تعرّض لها ترامب. لكنني أرى فرقاً كبيراً بينه وبين مودي المدعوم من قِبل مؤسسة عمرها 95 عاماً، ولديها 600 ألف متطوع. فلقد عمل كثيرون ولسنوات طويلة ليتمكن من الفوز.
لكن بالرغم من أساليبنا في المقاومة ومن قدرة اليسار على حشد أعداد كبيرة في الشوارع، لا يبدو أننا قادرون على تحويل ذلك إلى عمل فعّال متّسق. هناك لغز كبير الآن حول قدرة الأمريكيين على تنظيم أكبر أربع تظاهرات في تاريخهم خلال السنتين الأخيرتين، فيما لا يزال ترامب قادراً على الاستمرار على الصعيد السياسي.
عندما نتحدث عن اليسار في الهند فإننا نعني بذلك الأحزاب الشيوعية. وهنا، طالما كان أكبر أسباب فشل اليسار هو عدم قدرتهم على التعامل مع النظام الطبقي، فيما أفترضُ أن الفشل في الولايات المتحدة يعود لعدم القدرة على التعامل مع التعدد العِرْقي. تحدثتُ عن ذلك في كتاباتي منذ رواية “إله الأشياء الصغيرة” وحتى الآن. فالنظام الطبقي هو المُحرّك الذي يسيّر الهند المعاصرة، ولا يمكنك أن تدّعي بأنه مجرد تباين في الحالة الاجتماعية، فهذا غير صحيح.
بمعنى ما، وبالرغم من اختلاف الأوضاع باختلاف أماكنها، بإمكاننا أن نلحظ تكرار النموذج نفسه، فلقد خلَف ترامب أوباما، فيما وصل بولسونارو للحكم بعد حزب العمال. نحن نصنع هذه المساحة ونؤسسها على نحو سيء، حتى يأتي أحدهم جالباً معه الكثير من الدمار. هل يُعدّ هذا فشلاً للتوعية السياسية أم أنه فشل للخطاب السياسي؟ ما الذي نقوم به على نحو خاطئ؟
تعلمتُ درساً قيماً بُعَيد مذبحة المسلمين التي وقعت في العام 2002 والتي قُتل خلالها ألفي شخص في الشوارع، فقد كتبتُ عنها واعتقدتُ أن مجرد وصف ما حدث كان رسالة سياسية. مجرد التحدث عن أن شيئاً ما قد حدث وأن عدداً من الأشخاص قد قُتلوا. لكن الناس يديرون ظهورهم لك ويقولون: “وماذا في ذلك؟ فلقد استحقوا ما حدث لهم.” تدرك في تلك اللحظة أن التعاطف لن يتمكن أبداً من أن يسود الأجواء في موقف كهذا. كذلك الأمر عندما أتابع الزخم المرافق للمخاوف المتزايدة من المهاجرين، فكيف يمكنك أن تتحكم في ذلك؟
لكن هناك رد فعل بين حين وآخر، أليس كذلك؟ من التقدميين ومن قطاعات واسعة ممن يجدون صعوبة في التعامل مع هذه الأوقات التي تجرنا إلى الوراء. فنحن نشهد تعبيرات قوية عن التعاطف إنْ كان من خلال التظاهرات المناهضة للحرب، أو عندما اصطفّ الكثيرون لتقديم ماء الشرب للاجئين السوريين عقب وصولهم إلى ألمانيا، إضافة إلى حركات Occupy Wall Street وBlack Lives Matter.
نعم، هناك الكثير من التضامن. أعتقد أن حراك Occupy Wall Street في الولايات المتحدة نجح في إحداث تغيير كبير على مستوى اللغة، فالناس اليوم يتحدثون عن الـ 99% و الـ 1% من الشعب. أصبح بالإمكان التحدث عمّا لم يكن مسموحاً. لديك الآن بيرني ساندرز، وهو ما لم يكن ليحدث قبل فترة وجيزة. لقد بزغ فجر عصر جديد من التفهم حتى في الولايات المتحدة، حيث لم يكن متوقعاً. بوسعي أن أقول أن هناك مقاومة حكيمة عميقة ورائعة في الهند، وهي وإن لم تتمكن من الفوز في الانتخابات، فقد صنعت فارقاً مذهلاً.

كيف تفسرين ذلك، بصفتكِ أحد الأشخاص الذين كرّسوا جزءاً كبيراً من حياتهم لتغيير وجهة الأحداث؟ فمِن ناحية، يزداد المال والفساد قوة فيما تزداد المقاومة تعقيداً، وربما تحليلاً. هل يجعلكِ هذا متفائلة أم متشائمة؟
يتغير ذلك بين دقيقة وأخرى وبين يوم وآخر، إن كان على صعيد كلّي أو إن كان لحظياً. أشعر بالكثير من التخوّف، وليس لهذا علاقة بالانتخابات الأخيرة، إذ تُعدّ حدثاً ثانوياً بالمقارنة مع الأحداث التي أراها، فهناك الكثير من الناس والقليل من الموارد، سواء تحدثنا عن الماء أو الأرض، بوسعك أن ترى قلة الوظائف وما يصحبها من يأس. إنّ الصراع الظاهر بين طبقتين اجتماعيتين أو طائفتين أو مجتمعين ما هو إلا السطح الذي يغطي أزمة وشيكة. ثم تصُبّ اهتمامك على العصفور الذي يبني عشاً في الشجرة ساعياً لنسيان كل أمر آخر. أُحدّث نفسي فأقول لها، مهما حدث، فلنترك أمر كل ما حدث لنا لعقولنا ولإبداعنا.
يحتوي كتابكِ الجديد على مقالات كُتب بعضها قبل عشرين عاماً، كما تتحدثين في مقدمة الكتاب عن المرحلة التي نَشرتِ خلالها روايتكِ “إله الأشياء الصغيرة”، وعن كل الأموال التي انهالت عليكِ حينها، وكيف تم الاحتفاء بكِ لكونكِ مثالاً على ما يمكن أن تقدمه الهند الجديدة، في حين تعبّرين عن رغبتك في أن لا يتم الربط بينك وبين الهند الجديدة من حيث مسارها السياسي. ثم يبدو أن هناك تغيراً في المهمة التي ينبغي على كتاباتكِ أن تؤديها. لذا وددتُ أن أطرح هذا السؤال: برأيكِ، ما الذي قدّمَته هذه المقالات؟ ما الذي ينبغي على هذا الكتاب تحقيقه؟
أنا أؤمن بقوة السّرد، فأنا روائية بطبيعتي. لذا، ففور وصولي إلى وادي نارمادا (حيث تم تشريد أكثر من 250 ألف شخص بهدف إقامة سدّ مائي) أدركتُ أن لديّ قصة. كان لذلك الوادي قصة بحاجة لمن يرويها بطريقة تختلف عن تلك التي تُقَصّ من خلالها حكايات الطفولة والهوية والطبقات الاجتماعية.
لم يجرؤ معظم الكُتّاب، خصوصاً كُتّاب الأدب، على القيام بهذه الخطوة. فهل هذا مريحٌ أكثر؟ خصوصاً وقد تحدثتِ في كتابكِ عن تلقيكِ تهديدات بالقتل وعن الدعاوى القضائية التي اُتخذت بحقك. كنتِ تعيشين حياة أسهل من ذلك؟
لا أعتقد أن هذا مرتبط بكون المرء كاتب أدب أو غيره، الأمر متعلق بالسياسة. بالنسبة لي كوني أعيش في هذا البلد، أشعر بشيء من الإهانة في عدم محاولة الفهم. أعتقد أن لهذا علاقة أيضاً بشيء من غياب الطموح عندي. عندما كتبتُ “إله الأشياء الصغيرة”، لم أتوقع أن تُحقق هذا النجاح، بل كنتُ سعيدة لكوني حققتُ استقلالاً مالياً يُمكّنني من القيام بما يحلو لي، فجرفتني طبيعتي بعيداً عن عالم الأدب. تحدثتُ مراراً عن الكتابة غير الأدبية، لأنها بحاجة لمن يتحدث عنها، كما أنها لا تتمحور حولي فقط. بل هي عن الكثيرين الذين يخوضون المعارك التي هي بحد ذاتها ذات أهمية.
تتحدثُ العديد من أعمالكِ عن واقع الهند، لكن الكثير منها قادر على محاكاة ما هو أبعد من ذلك، كالبيئة والمناخ والفساد الحكومي والفاشية والطائفية. هل تجدين سهولة في الربط بين أعمالكِ وبين الأماكن التي تزورينها أثناء تجوالك حول العالم؟
هذا سؤال مثير للاهتمام إلى حد كبير. فروايتي “إله الأشياء الصغيرة” تتحدثُ عن القرية الصغيرة التي نشأتُ فيها في جنوب الهند والتي تنتمي إلى ثقافة محلية معينة، لكن الرواية تُرجمت إلى 42 لغة مختلفة. بإمكاني أن أذهب إلى إستونيا ليخبرني أحدهم أن الرواية ذكّرته بطفولته، ويسألني: “كيف عرفتِ بكل هذا؟”
راسلَني كثيرون من مجلات وصّحف أجنبية قائلين: “هل ستكتبين لنا؟” كنتُ متأكدةً من شيء واحد: أني لا أرغب في تفسير الشرق للغرب. لا أريد أن يُجري أحد تعديلات على لغتي لتتناسب مع قوالبهم، بل أريد أن أكتب بالطريقة التي أريد، فإن كانت مناسبة لك هذا جيد، وإن لم تجدها كذلك فهذا جيد أيضاً. أنا أكتبُ لأجل المكان هنا. فالجدل يحدث هنا، والمعركة مفتوحة هنا. أنا حقاً لا أرى حاجة للشرح، فالقُرّاء غامضون تماماً كما الكُتّاب، وبوسعهم فهم المقصود دون أن تضطر لصياغته بشكل خاص بقصد إيصاله لهم.
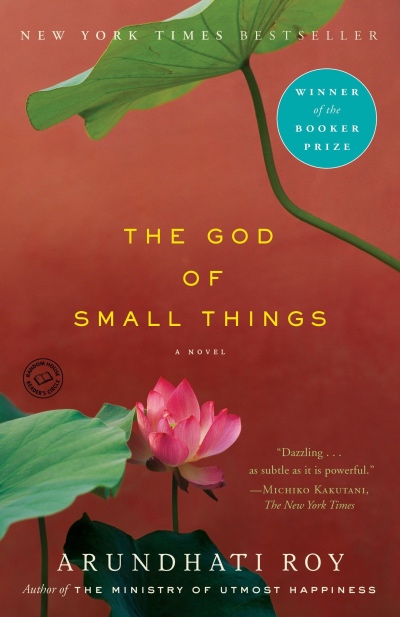
أردتُ أن أسألكِ عن مقالة “الطبيب والقدّيس”، إذ تقولين فيها إن محاولات بيمراو رامجي أمبيدكار لتحدي المكانة شبه الإلهية التي تمتع بها غاندي عانت من قمع النخبة، في مسعاهم لفرض فكرة معينة عن الهند، لفرض النظام الطبقي على وجه الخصوص. كيف بوسعنا اليوم أن نفهم التبجيل الذي حصل عليه غاندي في ظل الحجب الذي تعرض له أمبيدكار على مدار التاريخ؟
في الحقيقة، تم حجب أمبيدكار عن الغرب تماماً، لكنه لا طالما كان حاضراً ومؤثراً في الهند. عندما يأتي الناس إلى هنا، أقول لهم: إذا ذهبتم إلى أفقر منزل في الهند، لن تجدوا صورة لغاندي، لكنكم ستجدون صور أمبيدكار. شهدنا جميعاً التزييف الذي تعرض له تاريخنا، وهو ما تسبب بأشكال من الحزن والغضب.
يبدو أن هذه صفة مميزة لليمين، فهم يتمتعون بقدرة على إقناع الناس بأن أحداثاً لا وجود لها قد وقعت بالفعل، ويشجعون الناس على القيام بما قد يضرهم. أنا مهتم فعلاً في فهم هذه القدرة على حمل الناس على التصرف ضد مصالحهم.
أعتقد أن أحد أكبر عيوب اليسار، وهنا أعنى كل أطيافه بما فيها الشيوعيون، يكمن في تحديدهم لكل شيء بالمادية، إضافة إلى عدم قدرتهم على فهم نفسيات الناس المعقدة. في الهند، يُقْدِم مئات الآلات من المزارعين على الانتحار بسبب الديون المتراكمة عليهم، لكن الأمر ليس ببساطة أن الناس جوعى ما يعني أن ثورة لا بُدّ أن تقوم. لا تسير الأمور على هذا النحو.
برأيك، كم من الوقت يحتاج أيّ من أطياف اليسار ليدرك هذه الحقيقة؟
أعتقد أن الأزمات القادمة، وبذلك أعني الهجمة المشتركة لأزمة المناخ والذكاء الآلي ستتسبب في إعادة النظر بما نقصده باليمين وباليسار، فهاتان الفئتان لن تحافظا على المكانة التي نمنحهما إياها اليوم. فعندما تتقلص الموارد وترتفع مستويات مياه البحر سوف ترى الناس يجتمعون كقبائل أو كطبقات اجتماعية أو كأعراق أو كأمم ساعين للمطالبة بهذه الموارد، فيما سيكون اليمين جاهزاً للدفع بمزيد من الكراهية.
ألن يتعين علينا أن نتصدى لذلك؟
علينا أن نتصدى لذلك بالفعل، لكن المغزى يكمن في السؤال التالي: كيف يمكننا أن نطالب بالعدالة، إذا ما كان هذا فعلاً ما نطالب به، إذا لم تكن هي سلاحنا؟ بل إن الظلم هو السلاح الآن. لا يجب علينا أن نرهق أنفسنا بسبب عدم جدوانا، لأنني لا أعتقد أن هذا صحيح بالضرورة. بل علينا التفكير بكمّ السوء الذي كنا لنصل إليه لولا هذه القوى التعويضية.
في نهاية مقدمتك لـ “قلبي المشاغب” تقولين أن السؤال الذي نواجهه الآن يتمحور حول مَن وما سيحكم العالم. هل يمكنك أن تشرحي هذا؟
بالنسبة إليّ، تتلخص المشكلة في مقالة “حرب السيد تشيدامبارام”، فأنا أبدأها بجبل مسطّح القمة في ولاية أوديشا، إذ يعثر فيه علماء الجيولوجيا على مادة البوكسيت ويدركون الحاجة إلى استخراجها. فيما يعتقد غيرهم من الناظرين إلى الجبل أنه جبل سهل الاختراق، كما أنه خزان لمياه الأمطار الموسمية ومياه الحقول على مدار قرون. بالنسبة لشركات التنقيب والتعدين، فإن ثمن الجبل يُقدّر بمقدار مادة البوكسيت التي يمكن استخراجها منه، أما بالنسبة لسكان المناطق المجاورة فلا قيمة للبوكسيت طالما أنه خارج الجبل. تنتهي المقالة بالسؤال: هل بوسعنا ترك البوكسيت في الجبل؟ تعتمد الإجابة على المخيلة التي لا يمتلكها اليمين ولا اليسار. أنت بحاجة للتفكير بطريقة تُمكّنك من اتخاذ قرار إدارة الموقف دون الحصول على البوكسيت.
هل تعتقدين أن بإمكاننا ترك البوكسيت في الجبل؟ هل لدينا القدرات الخلاقة التي تمكننا من ذلك؟
يتمتع البعض بهذه القدرات بخلاف البعض الآخر. ما أقوله هو أن علينا نحن المتمتعون بهذه القدرة الحصول على الدعم أثناء خوض المعركة، والخطوة الأولى في الطريق إلى لذلك هي في الاحتفاظ بتصوّراتنا، حينها يمكننا المضيّ قدُماً.







