-1-
الرواية السينمائيّة والسينما الروائيّة مصطلحان يتوازيان ويتقاطعان في نقطة تماسّ حساسة هي النقطة الفارقة التي تجيب عن أكثر الأسئلة الحرجة في هذه العلاقة الإشكاليّة: أيّهما أهمّ وأقوى وأبقى، السينما أم الأدب؟ هل يمكن للنصّ الأدبيّ أن يحتوي في مزرعته الغضّة والشاسعة ضيفًا يهدّد كيانه دون أن يُحدثَ خللاً في معماريّته أم أن السينما هي نصّ سرديّ فرجويّ والبديل الأمثل بالنسبة للكائن الرأسماليّ الذي صار يضيق ذرعًا بالعين المتبصرة بالورق، منحازًا إلى الكتارزيس -التطهير- الذي يحدثه الفعل السينمائي البصري ولا يصل إليه النص السردي، ولن يتغير الأمر مهما بذلت الرواية، عابرة الأجناس والحدود، من مجهود؟
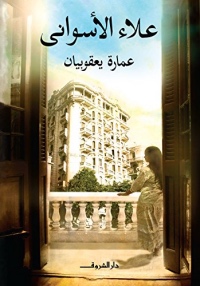
في عام 1971 كتب الروائيّ والمسرحيّ والسيناريست الأمريكيّ هنري دنكر روايته “المخرج”، التي يروي فيها حكاية الشاب جوك فنلي مخرج أفلام يحاول أن يرمّم حياته المهنيّة كمخرج من خلال الاستعانة بنجمين سينمائيّين يرمزان إلى مارلين مونرو وجون واين. وفي عام 2014 نشرت الروائيّة الأمريكية إمي سون عملها الروائيّ “الممثلة” والتي تروي حكاية ممثّلة شابة تقع في حبّ أحد نجوم السينما، لتتزوّج منه على الرغم من الشكوك حول هويّته الجنسيّة.
لم يتمّ إخراجُ العَمَلين الروائيّين سينمائيًا حتى هذه اللحظة، مع أنّهما يشكّلان مادّة خامّ نظيفة لعملين سينمائيّين ناجحين، ففيهما نجد فيضًا من المشاعر المربكة، ومعالجة مكانيّة وزمنيّة وإيقاعًا سينمائيًا يخوّلهما الدخول بسلاسة إلى عالم السينما، ناهيك عن طبيعة السّرد الرّشيق الذي يتيح التعامل معه سينمائيًا ليعالج عبر الوسائط المتاحة معالجته فنيًا. إنّها الخصوبة الكتابيّة المفصّلة وفق مقاييس سينمائيّة يطيب للسينما أن تلبسها أو أن تكون أداة فاعلة في تمثيلها بصريًا… الخفّة المحتملة التي تتيحُ فعل الالتحام بينهما محافظةً على فحولة البصريّ إلى درجة أنّه، فيما لو أخرجت هذه الروايات سينمائيًا، ستمحو معالم الكتابة وتنتصر للذة الفرجة. باختصار شديد: خصاء الرواية لصالح خصوبة السينما… وأمثلة هذا النوع من الكتابة الأدبيّة، عربيًا وعالميًا، كثيرة منها “في بيتنا رجل” لإحسان عبد القدوس، و”عمارة يعقوبيان” لعلاء الأسواني، و”كائن لا تحتمل خفّته” لميلان كونديرا و”العراب” لماريو بوزو.

-2-
في عام 2013، عُرض على شاشات السينما فيلم “إثنا عشر عاما من العبوديّة” والذي قام بإخراجه ستيف ماكوين، وكتب نصّ السيناريو له جون ريدلي، إلى جانب الدعم الإنتاجيّ الهائل الذي تمتّع به الفيلم شارك فيه المخرج ماكوين والممثل الشهير براد بيت. الفيلم الذي حقّق نجاحاً كبيراً نقدياً وشعبياً وحصد ثلاث جوائز أوسكار، مقتبس عن رواية تحمل نفس العنوان للكاتب الأفرو-أمريكيّ سولومون نورثب، ألّفها الكاتب عام 1853. وقتَها قررت، خطأً، أن أشاهد الفيلم قبل أن أقرأ الكتاب. عالج الفيلم حكاية رجل حرّ يقع في أسر العبوديّة 12 عاماً في أعقاب اختطافه وبيعه لتجّار عبيد يقومون بتهريبه إلى الجنوب الأمريكيّ.
كان الامتلاء الذي أصابني نتيجة سحر الصورة وحدّة الزوايا وبوليفونيّة العمل الذي تداخلت فيه الأصوات والرؤى والأداء، قد أفسد متعة القراءة وسحر السّرد ومنعاني طويلاً من قراءة الرواية.
واضح هنا أنّ العمل السينمائيّ هو عمل بوليفونيّ-بوليغيميّ بامتياز. يسعى إلى الامتلاء والاكتمال، لا سيّما لحظة انطلاق العصر الحداثيّ حيث الافتتان بالصّورة والحركة، والمقصود أنّه عمل يشارك فيه أكثر من قطاع أو وسيط، وعلى الجَميع أن يعمل في هارمونيا واحدة لتخرج الصّورة مُبهرة للعَين المفتونة أساسًا بها، بدءاً بكتابة السيناريو ومبنى الحبكة والحوارات، مرورًا بمواقع التصوير، واختيار الكاميرا وشكل الإضاءة ومنتجة المشاهد، واختيار الممثّلين، والهندسة الصّوتية، والمؤثرات الصوتيّة.

الحركة الثنائيّة، من السينما إلى الأدب، من الأدب إلى السينما هي متباينة تنتصر للثانية أكثر من الأولى.
هذه التقنيات والقوى تنجح إلى حدّ كبير في تمكين تأصيل السّرد سينمائيًا، ولكَي نفهم العلاقة التبادليّة، الراكدة، التفاعليّة، الرخوة بين السينما والأدب أضع تصوّري الخاصّ لهذه العلاقة:
– إمّا أن ترتحل الكتابة باتجاه الصورة، وتنتصر لهذا الفضاء التقنيّ الهائل فاقدةً هويّتها ومتحوّلة إلى شيء آخر بينيّ، تنصهر في مساحته عن طيب خاطر. أو تظهر إخفاقًا كبيرًا في الانصهار والتحوّل، من نوابع جماليّة تارة ونرجسيّة/أوتوفيليّة تارة أخرى حيث تكافحُ في أن يبقى النصّ الأدبيّ نصًا له خصوصيّته وجوهريّته وهويّته. نصّ يعاني من رهاب امحاء الأثر وهذا ما نراه من خلال تصريحات كتّاب تحوّلت أعمالهم الأدبيّة إلى أعمال سينمائيّة حظيت بشهرة شعبيّة ونقدية كبيرة لكنّها أخصت العمل الأدبيّ ومحت أثر الكتّاب من العمل، كما هو حال “فوريست غامب” لوينستون غروم، أو “البرتقالة الآلية” لأنتوني بورجس، أو “شايننغ” لستيفن كينغ.
– أو ارتحال النصّ السرديّ بكامل كيانه وبلاغته باتجاه الجسد السينمائيّ، وإثقال الأخير بعناصر السّرد وبالتالي ضياع ثيمة الخفّة الفيلميّة وذوبان عنصر المتعة بسبب خطأ الدمج بين تلقي المشاهد وتلقي القارىء، مثل ما حدث مع رواية “نادي القتال” للكاتب الأمريكيّ تشاك بولانيك.
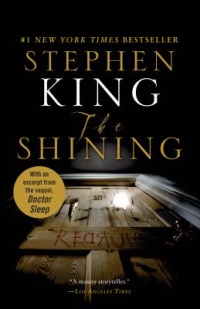
هناك حالات تغتصب فيها السينما النصّ الأدبيّ وتثقله برؤية سينمائيّة لا دخل له بها، فيُحكم على العمل بالفشل دون أن يضرّ باسم العمل السرديّ كما هو الحال مع النسخة السينمائيّة/الفيلميّة لرواية “جين إير” للكاتبة برونتي وقصّة جي دي سالنجر “العمّ ويغيلي في كونيكتيكت” (“قلبي الغبيّ” بصيغتها السينمائيّة) و”لوليتا” لنابوكوف. فالصيغة الفيلميّة تمحو توقيع خيال الكاتب وتشوّه وتطمس معالم الأثر الأدبيّ ويخلق منتوجًا بينيًا هجنيًا في حيّز سينمائيّ غريب يُحدث قطيعة تامّة بين الكتابة والصورة. من هنا، فإنّ غضب الكتّاب أو الإحساس بالغربة عن العمل الأدبيّ يصبحُ مبرّرًا لأنّ الصّورة قد فاضَت على المشاهد من كل صوب وسدّت كل الثغرات المفتوحة قصدًا على الورق حتى يبقى الإحساس بالدهشة والفراغ قائمًا، ويبقى النقصان عنوانًا للجميل والسّامي، سلاح الكاتب أمام القرّاء، السلاح الذي تكسره تجربة الفرجة بتقنياتها الصوريّة الهائلة وتحوّلها إلى تجربة اكتمال وفيضان واستنفاذ… أو بكلمات أخرى إفساد النّقصان الذي هو عقد أساسي بين الكاتب والقارئ.
– أن تذهب السينما باتجاه الأدب، وهي حركة إقحام الفيل الرأسماليّ في صندوق كرتونيّ. لقد ملأت الصّورة وجودنا، في العصر الرأسماليّ الحداثيّ الصناعيّ، وأثقلت عيوننا بالمثاليّة، إلى درجة أنّها أفقدتنا الإحساس بالنقصان، النقصان الذي تعبّر عنه الرّواية والذي يمدّنا بالإحساس بالدهشة والانفعال المتواصلين. إنّ حركة السينما باتجاه الأدب حركة امتلاء باتجاه النقصان، أو حركة التقنيّ باتجاه الجماليّ أو شبق النظر باتجاه شبق الصّمت. نجد وكلاء من عالم السينما دخلوا عالم الأدب ومارسوا الكتابة الروائيّة، منهم المخرجون والممثلون وكتّاب السيناريوهات وموسيقيّون وغيرهم، نذكر منهم أوليفير ستون، وبوب ديلن وتوم هانكس وجيمس فرانكو وباميلا أندرسون… اتّجهوا إلى السرد وإلى النّقصان بعد الامتلاء… أو إلى لذة الصّمت ولذة التوجّه إلى القراء لا المشاهدين، لأنّها حركة يكتنفها سحر الغموض المطلوب الذي يحقّق المتعة ويُبعد التجسيد/المفسد عن الروحيّ.

على الرغم من ذلك، لا يمكن أن نعرّف هؤلاء بالكتّاب، لأن الصورة/العين/الجسد/التقنيّة أفسدت كليًا الطريق إلى الكتابة الأدبيّة الصامتة/الفرديّة/الناقصة/الجمالية.
إنّ ذهاب السينما باتجاه الأدب لا بدّ أن يسبق فيه الأدبيّ السينمائيّ والتخييليّ الحركيّ ليظلّ الانتصار للعمل الأدبيّ بعيدًا عن السينما، كما هو الحال، على سبيل المثال لا الحصر، في رواية “شقراء” للكاتبة جويس كارول أوتس التي روت قصة حياة مارلين مونرو، وكما هو الحال مع كتاب “الأوهام” لبول أوستر، و”موت اللورد ادجوير” لأغاثا كريتسي. هذه حركة تحافظ فيها الكتابة على خصوبتها كشرط أساسيّ لبقائها وهي تحتضن الرؤية السينمائية داخلها.
-3-
في مجموعته القصصيّة “أجمل نساء المدينة”، يكتب الروائيّ الأمريكيّ تشارلز بوكوفسكي ثلاثين نصًا قصصيًا قصيرًا، يحقق بوكوفسكي إحدى المعادلات الجبريّة المستحيلة التي توازن بدقّة بين السينما والسرد، إذ ينجح في جميعها في إقحام العناصر السينمائيّة من حوارات، وبورنوغرافيا مشهديّة، وكوميديا شعبيّة، وفكاهة سوداء أدبية عالية الجودة، وبحرفيّة الحرفيّ يلعب في ساحات الجموديّة والحركيّة دون أن يُفسد لذّة الصّمت. المصاهرة المثلى بين الثيمات السينمائيّة/البصريّة والمهارة السرديّة تظهر بوضوح في نصوصه آلة النّيك، مقتل ريمون فاسكويز، والحياة في أحد مواخير تكساس، إذ يتيح النصّ الأدبيّ هنا إقحام النصّ السينمائيّ مع الحفاظ على بلاغة السرد وسلطة القصّ مع الحفاظ على خطّ النقصان الذي يميّز الكينونة السرديّة عن الكينونة الفيلميّة لكنّها بلا شكّ ستنجح كنصّ سينمائيّ تنفيذيّ.

-4-
يمر ارتحال المفاهيم والأفكار والخيالات عبر عمليّات تحوّل ومسوخات للسّلب وللإيجاب، والتي تطالها نتيجة الأرضنة والأقلمة والانتقال من بيئة إلى أخرى. من هنا، فإنّ المفاهيم والأفكار وحتّى الخيال يرتدي زيًا مغايرًا وفقًا لهذا الارتحال ووفقًا لدرجة تحمّل وسعة دفيئة المستقبِل على الاحتواء والدمج وتأصيل المستنبت فيه، والتكتيكات التي يتبناها لخلق منتج هجين مهجّن له خصوصيّاته بعيدًا عن أصله. يستخدم جيل دولوز وفيليكس غتاري في كتابهما “ما هي الفلسفة؟” الأرضنة لتصوير فكرة “تحليق” المفهوم، أي عدم ثباته في مكان واحد، وانتقاله من تربة إلى تربة كجزء من عملية “لا توطينه”، بحيث تصبح عملية تأصيل المفهوم عمليّة غير سويّة لأنّها تعتمد توطين المفهوم، وهو ما يجعل المفهوم يكف عن التّحليق والأرضنة. وهذا ما ينطبق تماماً على حالة معالجة السرد سينمائيًا ومعالجة السينما سرديًا: وجود معايير وشروط وظروف انتقال المفهومين من بنية ونسيج إلى بنية ونسيج مغايرين ومرورهما بعمليّة تأسيس ترتهن بنسيج وبنية ومركّبات الإقليم الجديد وبهذا يكتسب المفهوم بنية ومكوّنات جديدة. ولا يوجد دليل أكبر على هذا التصور من أعمال نجيب محفوظ الروائيّة التي تحوّلت إلى أفلام سينمائيّة انسلخت عن أصلها واستوطنت جغرافيا مغايرة ونتج عن هذا التهجين منتج جديد لا يقلل من أصله ولا يُستخَفّ به في نفس الآن.
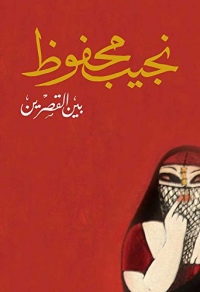
لكنّ سعة الدّفيئة السينمائيّة تنتصر لموقعها النافذ بصريًا بسبب قدرتها على المصاهرة والاحتواء ومعادلتها السّحريّة في جذب القارئ بفعل الكتارزيس البصريّ وكتارزيس العصف الانفعاليّ. إنها ببساطة ذات سمات حركيّة متململة ونشطة ومتهيّجة ومتوتّرة وقد تصل إلى حدّ الذهان، تُحدث لدى المتلقّي الفرجويّ شبقيّ النظر ردّ الفعل المباشر والمطلوب إلى حدّ الارتياح والاكتفاء والامتلاء. فيما الرواية تمتلكُ قدرتها على المصاهرة “الباردة” الجموديّة، تلك الحركة التي تروح يمينا ويسارًا دون أن تنفذ بصريًا إلى حدود الكتارزيس… تلك الحركة الأفقيّة التي تحافظ على مسافة بينها وبين عين القارئ وتثير القلق والإحساس بالنقصان.
وهذا ما نراه مثلاً عندما نشاهد رواية “بين القصرين” سينمائيًا، أو “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ، أو “عمارة يعقوبيان” لعلاء الأسواني أو “الفيل الأزرق” لأحمد مراد أو “الحب في زمن الكوليرا” لغابرييل غارثيا ماركيز أو “قصّة عن الحب والظلام” لعاموس عوز، وغيرها المئات من النصوص العربية والعالميّة التي اختزنت داخلها عناصر سينمائيّة أو رؤية سينمائيّة مقصود أحيانًا وغير مقصودة في أحيان أخرى. هذه النصوص نجحت في نسج علاقة النسب الشرعي مع السينما عن طيب خاطر وحوّلت أصحابها إلى نجوم ساطعة وأكسبتهم شعبيّة لذيذة وشرعيّة إلى جانب رأس المال الثقافيّ النخبويّ. في هذه الحالات لا يمكن إلا أن ننظر بعين التعادل بواحد مقابل واحد للطرفين.

-5-
للكتابة ذاكرة مثل البصر تماماً، لكنّ الأول ذاكرته ضعيفة إلى حدّ النساوة وتحتاج إلى نفض الغبار والتدوير والعودة إليها لتثبيتها والارتباط بها، فيما ذاكرة البصر ذاكرة حيّة في الدماغ وتثير الانفعال… من هنا، فإننا في الغالب، لا نقرأ الكتاب مرّتين، بينما نشاهد الفيلم مرّات إلى أن يُزيل تكرار الرؤية صدمة الانفعال. وقد أردّ هذا التناقض إلى الرغبة في الابتعاد عن الألم، فالأدب يوثّق الكثير من الألم البشريّ، وعدم رغبتنا في قراءة الكتاب مرّتين، ليس فقط لأنّنا مصابون بالوهن حيال الذاكرة الورقيّة بل لأننا نعاني كبشر من رهاب الألم، الرهبة من العودة إلى اختزان الألم، بينما بصريًا، نميل إلى رغاب هذا الألم لأنّه ينتقل إلينا عبر الانفعالات ليخرج مرة أخرى عبر الكتارزيس والتفريغ في نفس اللحظة.
للنصّ هويّة ورقيّة تُصبحُ شيئًا آخر لحظة تناولها بصريًا… فهِيَ تُلقى في رحم العوالم الماديّة للسينما ومن هناك تفقد أصولها وتنقطع خيوطها المتجذّرة في الورق لتواجه وحشيّة البصريّ وسلطته من جهة، وانكشاف المتلقّي على مكامن الجمال الدّفين في جسد هذا النصّ المسرود بصريًا فلا يعودُ عصيًا على فهمه ولا يعود صعب المنال. من هنا، ترى المشاهدين، على اختلاف مشاربهم الثقافيّة وتمايزاتهم ينفعلون من تجسيد نصّ “معلّمة البيانو” للنمساوية ألفريدا يلينيك أكثر من انفعالهم كقرّاء وهم يواجهونه كنصّ بورنوغرافيّ سرديّ، فالأدب في هذه الحالة يحتاج إلى مُعين يمتلك سلطة بصريّة ورأسماليّة هائلة ليُجسّد في صورة متحرّكة الأدب البورنوغرافيّ، وليطمئن المتلقّي إلى أنّه هو أيضًا يمكنه أن يستهلك الأفكار والمفاهيم ويُدرك كنهها من خلال معونة ومساندة الصّورة للذهن. الصورة السينمائيّة مجاز لبنية سمعيّة وبصريّة تطبطب على انتلجنسيا الجميع وتمكّن الجميع من دخول أبوابها دون قيد أو شرط. ومن هنا فهي، فوتوغرافيًا، تتيح لنا إمكانيّة استيعاب الوجود، على حدّ رؤية سوزان سونتاغ للصورة في كتابها “حول الفوتوغراف” وتقطع الشكوك بيقين العين. على عكس النص الأدبيّ الذي يقطع اليقين بالشّكوك ويستعيض عن الصّورة بالكلمات والشعريّة والجماليّة السرديّة التي تتمدّد على صفحات عريضة ويُفقد المتلقّي قدرة السيطرة على هذه المساحات المفتوحة. نحن في مواجهة مع سلطة العمل الفرديّ/الكاتب أمام جماعة القراء، مقابل سلطة العمل الجماعيّ السينمائيّ أمام جماعة المشاهدين… وبينهما تحدّي الانفعال والمتابعة وفتور الشعور واختبار لياقة المتلقّي في تجربة المشاهدة/القراءة.
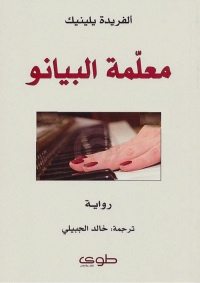
ثمّة طرق مختلفة لفهم هذه العلاقة التي تربط بين هذين الوجودين. هناك معالجة فنيّة للسرد تعبّر عنه الصورة، وأخرى يفعلها السّرد للجوانب السينمائيّة. كلاهما داخل متباينة جبريّة متبدّلة تنتصر أحيانا كثيرة للّذة النظر وشهوته، ففي السينما -البصريّة/الجسديّة- ثمّة قوة كهرومغناطيسيّة تشفط المتلقّي شفطًا، والمتلقّي هنا كائن بصريّ لا ورقيّ. لكنّ هذه اللذة قد تُخفق أحياناً أخرى، لا سيّما اليوم حيث لم تعد السينما في عصرها الذهبيّ وقد أكلت نفسها، وتعيدنا إلى رحاب الورقيّ. قد نفهم هذه العلاقة بعدوانيّة وفظاظة وفحولة الصّورة التي من خلالها نستولي على الشيء المصوَر، كما ترى سونتاغ، نشعر أننا نمتلكه وبالتالي قد نفقد الاهتمام به بعد مدّة. وقد نفهمها على أنّها مصاهرة أحيانا تنجح وأحيانا تخفق، ويمكننا أن نراها كعلاقة تلعب في مساحات البينيّة وتمثّل ولادة ثانيةً جديدة لمخلوق مهجن له سماته وتطوّره أو قبحه وجماله وعلينا أن نتعامل معه على أساس هجنيّته.
ليس بالضرورة أن يكون كلّ فيلم سينمائيّ أقلّ جماليةً من النصّ المكتوب أدبيًا، ولعلّ أفلام المخرج كوينتن تارانتينو الفظة برهان على نقطة التقاء السينما مع الأدب في تقويضها للإنسان العصريّ والعالَم في مرحلة ما بعد الحداثة. في كلّ الأحوال، يبقى القاسم المشترك الأقوى بين الأدب والسينما أنّهما للجميع دون قيد أو شرط، وكلاهما عمارتا منحنياتٍ مركّبتان، يواجهان مآزق ومطبّات عديدة اليوم مع الوصول إلى حالة ابتذال الخيال وابتذال التقنيّة، وعليهما يتوقّف مستقبل المعماريّة الفنية السينمائيّة والبنيان الروائيّ للأجيال القادمة، لإعادة تعريف وتحديد مهمّة كلّ منهما ومدى مطاطيّة العلاقة بينهما.
في الملف كذلك:
الرّوائي في السينما… ٥ أفلام أحبّها لسليم البيك
أسئلة الاقتباس العربي: صعوبة إنتاج أو سينما مؤلّف؟ لنديم جرجوره
النهاية الحقيقة لـ «دعاء الكروان» لعدي الزعبي
السينما في الرواية… اللعنة والغنيمة لكمال الرياحي
القرف… محاولات لفهم عضو جسديّ مفاهيمي بلا حدود (كلمةً وصورة) لعمار المأمون






