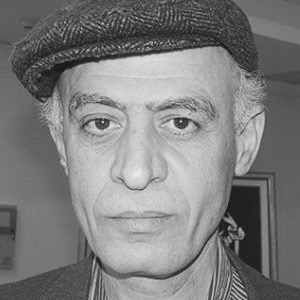للناقد والشاعر العراقي علي جعفر العلاق مقال عنوانه “دوافع الكتابة الشعرية ” (العرب اللندنية 22/8/2016) يورد فيه آراء شعراء ونقاد في دوافع كتابة القصيدة، ومن هذه الآراء ما قاله العرب قديما: “امرؤ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا شرب”.
وفي كتاب ديفيد ديتشس “مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق” (ترجمة د.محمد يوسف نجم) رأيٌ للناقد إدموند ولسون يعتمد فيه على الشاعر وردزورث، خلاصته أن الأديب إنسان يتحدث إلى أناسي وهو شديد الاهتمام بالمشمولات الإنسانية في الأدب ونشأته، ينشأ الأدب في أحضان الرجاء والخوف والرغبة والهيبة. ويرى ولسون أن مهمة الناقد الأدبي هي أن يوسع الوحدة التي يراها القارئ حتى تحتوي نظام السبب والنتيجة والفعل ورد الفعل والقوى النفسية والاجتماعية التي يكون الأثر محوراً لها.
السؤال الذي يراودني وأنا أقرأ أشعار الشاعر أحمد دحبور، في مسيرته الشعرية، هو: ما سر هذا التفاوت ما بين مجموعة وأخرى؟ ولماذا تروق لي بعض قصائده ولا تروق لي قصائد أخرى؟
في تبيان الحالة الشعرية التي يكون عليها أحمد دحبور يجيب الكاتب وحيد تاجا على سؤاله: “هل تكتب القصيدة بقرار؟” الإجابة التالية: “هذا وذاك، فلحظة انبثاق القصيدة هي لحظة إشكالية يتداخل فيها الوعي واللاوعي وكثيراً ما يكدّ الشاعر ليستجيب لمناسبة ما فلا يفلح. وقد تفاجئه القصيدة وهو في الطريق، ولكني على المستوى الشخصي ما إن أبدأ بكتابة القصيدة حتى أشهر القلم، فأنا لا أطيق الارتجال، مع أن بعض النصوص قد تأتي عفو الخاطر. هل كتبت قصيدة بقرار؟ هذا بالنسبة لي سؤال محير ولكنني أكتب لأنني أحيا، وتلك هي الحياة ” (عن “أشرعة ” 2017 5/26 وقد نشرت المقابلة في جريدة الأيام الفلسطينية في نيسان 2017) .
إجابة الشاعر إذن لا تفصح لنا إن كان يكتب في حالة محددة: إذا ركب أو إذا رغب أو إذا رهب أو إذا شرب، أي في أحضان الرجاء أو الخوف أو الرغبة أو الخيبة. وإذا جاز لي أن أبدي رأياً فإنني أرى أن كثيراً من قصائد دحبور كتبت بسبب الرغبة -الرغبة في تحرير فلسطين- وأن كثيراً من قصائده التي كتبت بعد أوسلو كتبت لتعبر عن الخيبة التي ألمت به من الحل السياسي المنجز الذي لم يعده إلى حيفا المدينة التي ولد فيها. وهناك قصائد كتبها لأنه يحيا، أي ليست قصائد أنجزت بدافع الرغبة أو الخيبة. وإذا جاز لي أن أبدي رأياً فإنني أرى أن القصائد التي كتبت بدافع الرغبة أو بسبب الشعور بالخيبة هي القصائد الأجمل، وهي القصائد التي تلفت الانتباه إليها، وقد أتيت على هذا في مقال لي كتبته في حزيران 2000 تحت عنوان: “أحمد دحبور: هل يهدم القصيدة أم يبنيها؟” (الأيام الفلسطينية 2000/ 6/3).
ولأنه يكتب لأنه يحيا فقد كتب قصائد كان الحضور فيها أولاً للموضوع أو الفكرة، وكتب قصائد أخرى لأنه أراد أن يجرب، وفكرة التجريب والتنوع التفت إليها مبكراً حين كان طالباً في المدرسة، وتحديداً في حصة الرسم، ومن لفت نظره إليها هو معلم الفن، وقد أورد هذا في مقدمة الأعمال الشعرية الكاملة (1983)، وظلت فكرة التجريب والتنوع تلازمه، وبلغت ذروتها في العروض الذي حاول أن يجدد فيه، فأصدر ديواناً عنوانه “واحد و عشرون بحراً”(1980) ولم يتخلص منها -أي فكرة التجريب- فحين أصدر ديوانه “جيل الذبيحة” (1999) أشار في فهرس القصائد إلى أوزانها، وفي الفهرس أشار إلى قصائد تخلط الشعر بالنثر، وأخرى كتبت خارج البحور (دوبيت) وثالثة تجمع بين مجزوء البسيط ومخلع البسيط.
هل التفت النقاد والقراء إلى ظاهرة التجديد والتجريب في شعر الشاعر أم أنهم التفتوا أول ما التفتوا إلى الموضوعات التي كتب فيها وعبرت عن تجارب معيشة؟
حين أعيد النظر في ما كتبت عن الشاعر أراني واحداً من النقاد الذين التفتوا إلى الموضوع وإلى دراسة النص والظروف المحيطة به، وهذا ما لم يرق للشاعر، وقد عبر عن هذا في المقدمة التي كتبها لكتابي “أدب المقاومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات” (غزة 1998)، ورأى أنني أتوغل في الشخصي، وأنني أتابع الشاعر وحياته ومواقفه السياسية. ولم أكن شخصياً لأنزعج مما كتبه، تماماً كما أنه هو شخصياً لم ينزعج مما كتبته عنه، وغالباً ما كان يشيد بالعلاقة بيني وبينه، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
وكما تعلّم أحمد دحبور النزوع نحو التجريب والتنوع من معلمه في المدرسة، فقد تعلم من معلمه موريس قبق -الذي كتب عنه مراراً وخصه بقصيدة في “جيل الذبيحة”- فقبل الاختلاف: “كيف وسعت أعيننا لترانا ونقبل أنا اختلفنا ونبقى صديقين” (موريس قبق، وردة الاختلاف).
يدرك الشاعر نفسه أن هناك دوافع لكتابة القصيدة، وأن هذه الدوافع إذا غابت تؤثر على الكتابة “وهكذا تهدأ الحركة ويتساوى المديح والعسل ويذوب حبر الكلام في مرق الهواء، وتتساوى الجمل.” (من قصيدة “بنكهة المستحيل”).