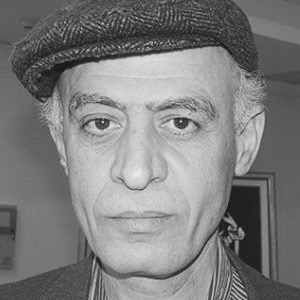في العام ١٩٩٩ صدر كتاب الناقد المصري جابر عصفور “زمن الرواية” وعنوانه يفصح عن محتواه عموما، وجاء العقدان اللاحقان ليعززا وجهة نظره، وهي عموما وجهة نظر تتفق ووجهة نظر شاعت في ثمانينيات القرن العشرين تقول إنهم في فرنسا يدقون آخر مسمار في نعش الشعر، ووجهة نظر أصحاب الرأيين أن الرواية تطبع وتوزع وتقرأ وتعاد طباعتها بالآلاف في حين أن أشهر الشعراء ما عاد يطبع من دواوينهم إلا ألف نسخة أو بضعة آلاف من النسخ، والأخيرون محظوظون عموما وهم قلة قليلة جدا، ومن يتابع المشهد الثقافي العربي والمشهد الثقافي الفلسطيني يلحظ إقبال دور النشر على طباعة الرواية وعزوفها عن طباعة الدواوين الشعرية، بل ويلحظ أن كثيرا من الشعراء أخذوا يميلون إلى كتابة الرواية، ما دفعني ذات نهار إلى اقتراح الموضوع على أحد طلاب الماجستير ليكتب فيه أطروحته، وهو ما أنجزه عمر القزق في جامعة النجاح الوطنية “الشعراء الروائيون”. وأنا أتابع بدايات كتابة الشعراء للرواية توقفت أمام تجربة الشاعر محمد العدناني، وهو من الشعراء الفلسطينيين الذين ينتمون إلى الرعيل الأول، أي شعراء فلسطين قبل العام ١٩٤٨.
كان محمد العدناني شاعرا بالدرجة الأولى، ولكنه في العام ١٩٤٦ كتب روايته الوحيدة ” في السرير”، وهي سيرة روائية كاتبها وساردها وشخصيتها معا، هم المؤلف نفسه الذي اتخذ لنفسه الاسم “طريف” ليقص لنا جزءا من سيرته هي فترة مرضه وسفره إلى ألمانيا إبان الحكم النازي. وفي حدود ما أعرف فإن هذه الظاهرة غابت عن الأدب الفلسطيني ولم تتكرر مدة عشرين عاما، إذ بعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ كتب أمين شنار روايته “الكابوس” (١٩٦٨) ذات المنحى الرمزي التي عالج فيها هزيمة حزيران، وبعدها بفترة قليلة كتب الشاعر هارون هاشم رشيد روايته الأولى “سنوات العذاب” (١٩٧٠) وقد صدرت بعد إصداره مجموعات شعرية عديدة كتبها عن اللجوء والغربة والاغتراب والعودة والحلم بها، وقد أهداها إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وفيها قص حكاية طفلة فلسطينية من حي المنشية في يافا تشردت عن مدينتها في العام ١٩٤٨.
هذه الكتابات وغيرها أثارت أسئلة عديدة عن الشعر والشعراء وكتابتهم الرواية في فترة ربما لم تخطر فيها في أذهانهم فكرة أن الزمن هو زمن الرواية، فما الذي دفعهم إلى كتابة رواية؟ هل رأوا أن القصيدة لا تستوعب أحداثا كبيرة فيها من التفاصيل ما فيها، فالشعر، بخاصة الغنائي، يوجز ولا يطنب ويتمحور حول شخصية واحدة هي ذات الشاعر بالدرجة الأولى، والحياة تحفل بشخصيات ونماذج بشرية لها تجاربها المختلفة عن تجربة الشاعر؟
في نهاية سبعينيات القرن العشرين كتب الشاعر سميح القاسم حكاية أوتوبوغرافية “إلى الجحيم أيها الليلك” ( ١٩٧٧) أتبعها بعد عامين بقصة طويلة “الصورة الأخيرة في الألبوم” (١٩٧٩)، ولم يصنف أيا من العملين على أنه رواية، ويبدو أنه لم يكن مهتما بالتجنيس الأدبي قدر اهتمامه بالتعبير عن أفكار آمن بها بقوة في تلك المرحلة التي كان فيها منضويا تحت لواء الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح)، مع أنه كتب عنوانا فرعيا للأولى هو “حكاية أوتوبوغرافية”. حكاية أوتوبوغرافية لا رواية مخرجا بذلك عمله من جنس الرواية.
في الحكاية التي كتب حولها الكثير من المقالات والدراسات واحتفل بها احتفالا لافتا يكتب سميح القاسم النثر بروح الشاعر، ما أضفى على الكتابة قدرا من جماليات الكتابة، وهذا الاحتفال بالحكاية شجعه على تكرار التجربة ثانية، فبعد عامين من صدورها أصدر “الصورة الأخيرة في الألبوم” وأتى فيها على واقع الفلسطينيين الباقين ومعاناتهم في التعليم الجامعي والحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التي يحصلون عليها، ما يجعلهم يعانون من البطالة فيضطرون إلى العمل في المطاعم والمقاهي وأماكن العمل التي يترفع اليهود الغربيون بالدرجة الأولى على العمل فيها، ولا يقتصر الأمر على هذا، فلكي يستمروا في عملهم وجب عليهم إخفاء هويتهم القومية واستبدال أسمائهم العربية بأسماء عبرية. هكذا يصبح يوسف يوسي وداوود ديفيد وما شابه. ولأن سميح كان ينطلق من منطلق ماركسي، ولأن إسرائيل كانت تتكون من ثلاث “إسرائيليات”؛ إسرائيل الاشكناز وإسرائيل السفارديم وإسرائيل العرب، فإن إسرائيل الأولى تتعالى على الثانية والثالثة، وهو ما يحدث مع أمير الذي يحصل على ماجستير في العلوم السياسية ويعمل نادلا في مطعم يتردد عليه اليهود الغربيون، ظانين أنه يهودي شرقي.
روتي تدرس الآداب وتتردد مع والدها الضابط على مطعم يعمل فيه أمير نادلا، ويتعالى الضابط الاشكنازي على العمال، وتنشأ علاقة حب بين روتي وأمير يرفضها الأب الذي يظن أن أمير يهودي شرقي . يبدي الأب اشمئزازه من اليهود الشرقيين ويعنف ابنته، وتنتهي القصة الطويلة بانتحار روتي. حبكة بسيطة أقرب إلى النوفيلا يطرح فيها الكاتب رؤية فكرية سياسية للصراع، ولكنها مع الحكاية ورواية العدناني ورواية شنار تشكل معا خطوة في مسيرة الأدب الفلسطيني. لم تكن الأعمال السابقة المذكورة الوحيدة في هذا، ففي العام ١٩٧٩ صدرت رواية الشاعر الفلسطيني الشهيد في بيروت في١٩٨٢ علي فودة، وعنوانها “الفلسطيني الطيب”، وقد صدرت في بيروت.
عرف علي فودة بعد هزيمة حزيران شاعرا غنائيا، وعانى في أثناء وجوده في الأردن، ما دفعه إلى مغادرتها والالتحاق بالثورة الفلسطينية في بيروت، وهناك استرجع تجربته المرة القاسية مع الجهات السياسية ومع بعض المثقفين الفلسطينيين الذين عدهم متعاونين مع النظام الأردني، وفرغ هذا كله في روايته التي لم يكتب رواية أخرى يلحقها بها، ولا ندري إن كان يفكر في كتابة غيرها لو امتد به العمر.
الرواية أيضا سيرة روائية مثلها مثل رواية العدناني، إذ يقص علي فودة تجربة حياته في الأردن، فيتخذ من شخصية الشاعر صابر مطر قناعا، ليكون هو المؤلف والشخصية. وعلى غرار رواية نجيب محفوظ “الكرنك” يبني روايته التي يقص فيها قصة أربع شخصيات؛ صابر مطر وعبد التواب الفواعرة ومروان الراعي وعثمان الأعرج، ويخصص لكل شخصية قسما، فتتكون الرواية من أربعة أقسام وقسم خامس عنوانه “نهايات” يفصح لنا فيه نهاية كل شخصية من الشخصيات الأربعة.
صابر شاعر يعاني أسريا من زوجة أبيه، كما يعاني من النظام الذي يلاحقه بسبب قصائده، وينتهي به الأمر إلى مغادرة الأردن والالتحاق بالثورة الفلسطينية في لبنان. أما عبد التواب الفواعرة فهو فلسطيني من رام الله أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن بعد هزيمة حزيران، وهناك نشط أدبيا وصار يعمل لصالح النظام الأردني بعد أن تساقط، وفي النهاية يقدم على الانتحار. مروان الراعي هو شاب مثقف صديق لصابر مطر، ومروان ابن أسرة برجوازية لا تعجبه حياة أبيه الثري الذي يملك سيارات وكسارة والكثير من المال شغله الشاغل. يضرب العمال ويضطهدهم وعلاقته بابنه ليست على ما يرام. أما عثمان الأعرج فهو مناضل طبقي يعمل عاملا في كسارة تعود إلى والد مروان الراعي وتكون علاقته مع والد مروان متوترة، لدفاع عثمان عن العمال وحقوقهم، وينتهي عثمان في السجن حيث يعذب إلى أن يلقى نهايته تحت التعذيب.
والملاحظ أن أكثر الروايات التي كتبها المذكورة أسماؤهم هي سير روائية بالدرجة الأولى، ويلاحظ أيضا أن كتابها لم يصبحوا روائيين محترفين، فلم يكتب أي منهم أكثر من رواية، باستثناء سميح الذي أصدر بعد حوالي عشرين عاما من إصدار روايتيه جزءها الثالث وعنوانه “ملعقة سم ثلاث مرات يوميا بعد الأكل”، وما يلاحظ أيضا هو الكتابة عن الصراع الوطني والصراع الطبقي جنبا إلى جنب، بخاصة لدى سميح القاسم وعلي فودة، إذ تأثر خطابهما بالخطاب الذي أخذ يسود في ستينيات القرن العشرين وهو الخطاب الماركسي، وهو خطاب لم يتأثر به كل من محمد العدناني وأمين شنار المتأثرين بالخطاب الديني، بخاصة الثاني، فالأول على الرغم من توجهه العروبي الإسلامي بدا في روايته مزاجيا متأثرا في أثناء الكتابة باللحظة الآنية للكتابة وبمزاجه المتقلب الطريف، وليس عجبا أن اختار لبطله/شخصيته/قناعه الاسم طريف. إنه طريف حقا.
عموما ان هذه الظاهرة تكررت في ثمانينيات القرن العشرين، فقد كتب بعض الشعراء أيضا روايات هي في النهاية أشبه بسير روائية، وأبرز هؤلاء علي الخليلي في روايته الأولى “المفاتيح تدور في الأقفال” وغسان زقطان وزكريا محمد وأسعد الأسعد وإبراهيم نصر الله، ويختلف الأخيران، إذ أصدرا العديد من الروايات؛ واصل نصرالله كتابة الرواية إلى جانب كتابته الشعر، وتحول أسعد الأسعد إلى الرواية متجاهلا نشر أعمال شعرية إن كتب الشعر، ولمن يرغب في القراءة التفصيلية وتحولها من كتابة الشعر إلى كتابة الرواية، فعليه أن يقرأ دراسة عمر القزق التي أعدها رسالة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية.