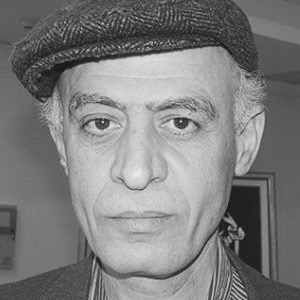مر وقت ساد فيه مصطلح “أدب النكبة” إلى حين، ولم تنته النكبة ولم تتوقف ذيولها عن التوسع والانتشار، ولكن المصطلح الذي ساد وطغى فيما بين ١٩٤٨ و١٩٦٧ تراجع استخدامه إلى حد كبير، إذ إثر هزيمة حزيران حل مصطلح جديد محل المصطلح القديم وهو “أدب حزيران” أو “أدب الهزيمة” وما عدنا نقرأ عن النكبة وتأثيرها في الأدب أو حضور قضية فلسطين في الشعر العربي أو القصة القصيرة العربية أو في الرواية العربية، وكان حضورها في الجنسين الأخيرين عموماً حضوراً قليلاً.
لم يعد مصطلح “أدب النكبة” إذن مستخدما إلا لدى دارسين قليلين، وصار أكثر الدارسين يهتمون بالأدب الذي كتب بعد الخامس من حزيران ١٩٦٧، وهناك من رأى في الهزيمة الخطر الأكبر الذي أصاب الأمة العربية كلها، فالنكبة لم تؤثر على العرب قدر ما أثرت على الفلسطينيين. وإذا ما قارنا حجم الأدب الذي كتب بين ١٩٤٨ و ١٩٦٧ بحجم ما كتب بعد الهزيمة عرفنا سببا آخر لمقاربة “أدب الهزيمة” أكثر.
مع ما سبق لم يختف حضور النكبة في الأدب العربي؛ الفلسطيني وغير الفلسطيني، وإن خفت إلى حين، ويبدو أنه بعد أوسلو اشتعل من جديد في الرواية ولدى شعراء قليلين ممن عادوا وأبرزهم محمود درويش وأحمد دحبور، فقد أشعلت عودتهما فيهما الذكريات وعلاقتهما وعلاقة أهلهما بالمكان، وليس هذا الرأي ضربا من إطلاق القول بلا دليل.
ولو تتبعنا ما كتب في فلسطين المحتلة قبل حزيران وبعده، فإننا نعثر على التفات الأدباء إلى الكتابة عن حياتهم بعد العام ١٩٤٨ وإن كان حاضرهم هو نتاج ماضيهم. كانت النكبة تلامس في النصوص ولكن ما كان يلامس أكثر هو الكتابة عن معاناة الفلسطيني في الظروف الجديدة. إن “متشائل” حبيبي تأتي على النكبة، ولكنها تأتي على حياة العرب تحت الحكم الإسرائيلي أكثر، ومثلها كتابات سميح القاسم النثرية “إلى الجحيم أيها الليلك” و”الصورة الأخيرة في الألبوم” و “ملعقة سم ثلاث مرات يوميا بعد الأكل”، وظل الأمر كذلك إلى أن فطن الكاتب سلمان ناطور في العام ١٩٧٩ إلى الأمر، فنشر سلسلة حلقات تحت عنوان “وما نسينا” وواصل الكتابة حتى أصدر كتابه “ستون : رحلة الصحراء” في الذكرى الستين للخروج الفلسطيني الكبير من فلسطين.
في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكن هناك أصوات أدبية محترفة والكتاب الشباب انشغلوا بالكتابة عن حياتهم تحت الاحتلال فسحر خليفة لم تقارب موضوع النكبة في رواياتها كلها وهي أبرز صوت روائي في الضفة الغربية، وظل الأمر كذلك إلى أن فطن الكتاب بعد أوسلو إلى مدن آبائهم وقراهم التي خرجوا منها فبدأت سلسلة من كتابات أدب الحنين والفقدان بلغت ذروتها في روايتي عاطف أبو سيف “حياة معلقة” و “الحاجة كريستينا”.
مع أن ما كتبه غسان كنفاني قارب النكبة إلا أنه لم يكتب في رواياته تفاصيلها، وكانت تفاصيلها أكثر حضورا في قصصه القصيرة وفي قصص سميرة عزام أيضا، ولم يقارب جبرا ابراهيم جبرا النكبة إلا قليلاً جداً، ولذلك ما إن كتب الياس خوري روايته “باب الشمس” حتى عدها بعض الفلسطينيين رواية النكبة وذهب إلى أن من كتبها هو لبناني، وعموما فقد واصل الياس كتابتها في روايته “أولاد الغيتو : اسمي آدم”.
وأنا أفكر في “أدب النكبة” خطرت ببالي مقولات نظرية التلقي ومن أهمها قراءة النصوص الأدبية في أزمنة مختلفة، وتساءلت ماذا لو تتبع دارس كتابة موضوع واحد، مثل أدب النكبة، في أزمنة مختلفة؟
أصدر ناصر الدين النشاشيبي، وهو ليس روائيا محترفا، بعد ١٩٤٨ روايتين هما “حفنة رمال” و”أرض البرتقال” وقارب فيهما الواقع الفلسطيني قبل النكبة، ولم يكتب أية رواية عن النكبة التي أكثر الشعراء في الكتابة فيها، وأصدر كنفاني بين ١٩٦٣ و١٩٧٢ العديد من الروايات وترك لنا مسودات روايات أخرى، وقارب فيها النكبة أكثر من مقاربة النشاشيبي لها والسبب هو أن غسان كاتب محترف فيما لم يكن الأدب محور اهتمام النشاشيبي الأول، وعبر جبرا عن حياته في العراق وعن البيئة العراقية أكثر مما كتب عن فلسطين، فكان الحضور الأوسع للبيئة العراقية ومشاكلها ولم يكتب أية رواية عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وهو ما أنجزه الشاعر محمد الأسعد في روايته “أطفال الندى” وهي نص روائي متميز في هذا الجانب، ويعد إبراهيم نصرالله أكثر روائي فلسطيني في المنفى بعد العام ٢٠٠٠ انشغالا بالنكبة وتلاه رشاد أبو شاور ومن العائدين يحيى يخلف. لقد حضرت النكبة في الرواية الفلسطينية لا في زمن حدوثها وإنما بعد مرور عقود عليها، وهنا أعود إلى نظرية التلقي الألمانية ثانية. كيف حضرت النكبة في النصوص التي كتبت مباشرة بعد حدوثها، وكيف حضرت في النصوص التي كتبت بعد عقود على مرورها ؟
كيف صاغها وعبر عنها من عاشها وكيف كتبها وعبر عنها من عاش ذيولها وصاغ تجارب غيره بالدرجة الأولى ولم يكتب مشاهداته هو ؟
ولد ابراهيم نصرالله في مخيم الوحدات ولم يكتب حتى العام ١٩٨٠ أية رواية وكتب روايات النكبة بعد العام ٢٠٠٠ – أي بعد مرور حوالي خمسين عاما، وكتب رشاد أبو شاور قبل العام ٢٠٠٠ عن المنفى والثورة وأتى إتيانا على واقع اللجوء الفلسطيني وكتب أكثر عن الثورة وإن خص مجزرة الدوايمة برواية، ولكن كتابته عن نكبة ١٩٤٨ وطفولته فيها جاءت متأخرة، كما في “وداعا يا زكرين” و”ليالي الحب والبوم”، وما كتبه يحيى يخلف قبل العام ٢٠٠٠ في موضوع النكبة لا يكاد يذكر وهو ما برز في “بحيرة وراء الريح”، وما كتبه عن ذيول النكبة وحياة المنفى واللجوء حضر في روايتيه “ماء السماء” و “جنة ونار”.
ليس القصد من وراء هذه الكتابة رصد رواية النكبة رصداً دقيقاً قدر ما هو إثارة سؤال ولفت انتباه، أما السؤال فهو :
– كيف حضرت النكبة في النصوص الأدبية في مراحل مختلفة؟
ويليه سؤال آخر هو:
– هل من تشابه أو اختلاف وما سبب ذلك؟
وأما لفت الانتباه فيرمي إلى مقاربة موضوع يستحق المقاربة لأن ما كتب فيه قليل.
النكبة لم تنته وهي مستمرة وهذا ما كتبه الياس خوري، وهنا أشير إلى روايتي سامية عيسى “حليب التين” و “خلسة في كوبنهاجن”، وفيهما وصلت ذيول النكبة إلى الدول الإسكندنافية، وكتب سليم البيك روايته “تذكرتان إلى صفورية” وأثار فيهما سؤال هوية اللاجئ الفلسطيني الذي ولد في ثمانينيات القرن الماضي في المنفى، وكتب ربعي المدهون في “السيدة من تل أبيب” عن طفولته. لقد طالت نباتات البعيد وزرعنا التين في كوبنهاجن وفي برلين أيضا، واتسعت رقعة الشتات الفلسطيني وما زالت تتسع واتسع المخيم الفلسطيني وفاض سكانه على المكان وساءت أحواله.