نسأل في هذا التحقيق عدداً من شعراء سوريا عن نظرتهم للشعر في عالم مضطرب كالذي نعيش فيه، وعن مهمة الشعر اليوم تحت سقف الخراب السوري، ودرجة تأثير الثورة/الحرب في سنتها السابعة على التجربة الشعرية، وما يمكن أن يُكتب في اللّحظة الرّاهنة… فسجلنا شهادات كل من عيسى الشيخ حسن (يقيم في قطر)، ومحمد علاء الدين عبد المولى، ومحمد المطرود (يقيمان في ألمانيا)، ومروان علي (مقيم في هولندا)، والشاعرة هنادي زرقه، ابنة مدينة اللاذقية الساحلية، والتي ما زالت تعيش في الداخل السوريّ رغم ويلات الحرب والدمار.
الشاعر عيسى الشيخ حسن: القصيدة كاميرا شعرية تصوّر الخراب..
كتب صديق عراقي قبل عشر سنوات وأكثر: “لم يعد لنا غير مديح الجمال”، كانت بغداد قد سقطت، أو تحرّرت على لغة “أكلوني البراغيث”، وفي المشهد التالي (أقصد المشهد السوريّ) هل تغيّر الأمر كثيراً؟ كنت أسأل نفسي، إذ لم يعد لنا غير مديح الجمال، والبحث عنه في التفاصيل المهمّشة والغائبة عن الخطاب المؤسّس للهوية والوعي، والمستبدّ بالمتن. أستعيد روح أبي العلاء الذي وقف على خراب المشهد قبل قرون، وأبصر جماليات الليل والموت وزاد نغماً في إيقاع القصيدة بلزوم ما يلزم.
من جهتي؛ وجدت أدواتي السابقة في قصيدة التفعيلة قاصرة عن متابعة الحدث السوريّ الساخن والمتبدّل وغامض النهايات، وباتت الأرض اليباب حقيقة، وليست عبارة شعرية يرطن بها المثقفون. أضافت الثورة وما تبعها مفردات جديدة إلى القصيدة: من مثل “مجزرة- خبر عاجل- سكود- ساطور- ميلشيات- طوائف- أقلّيّات- مناطق محرّرة- نظام- معارضة- شبّيحة- مندسّون- جنيف- أستانة…الخ”. كنا في حاجة إلى أرض جديدة لاستيعاب حجارة البناء الجديدة، كانت الثورة/الحرب قد مدّت يدها إلى القصيدة، فأخذتها من رتابة الإيقاع والتهويم في فضاء المصطلحات التي يسهل معرفة “وسمها” ولأي شاعر مكرّس تتبع، كقطعان البدو. وباتت القصيدة البعيدة عن هيمنة منبر السلطة ومنابر الأحزاب وبعيدة حتى عن هيمنة محرّري الصفحات الثقافية، باتت في متناول أضعاف أضعاف الجماهير السابقة عبر الفضاء المفتوح ووسائط التواصل الاجتماعي، وفي لحظة الدم والخبر العاجل باتت القصيدة كاميرا شعرية تصوّر الخراب بعين القصيدة، تصوّر البيوت التي تنحني حزناً على سكّانها كما يقول الشاعر السوريّ فايز العباس.

الشاعر محمد علاء الدين عبد المولى: اللعب في مساحات الحلم والحب..
سؤال مكرور وتقليدي هو سؤال مهمة الشعر. ولا أجد له إجابة إلا السؤال نفسه: مهمة الشعر هي الشعر. مثلما مهمة الحرب هي الحرب ومهمة الثورة هي الثورة ومهمة الفيلسوف هي الفلسفة. يقول الشعرُ كل الموضوعات والأفكار أو اللاأفكار، في إطار مهمته كشعر. من هنا كانت علاقتي بسوريا منذ آذار 2011 حتى الآن. هي بلا شكّ مرحلة من أصعب وأدقّ مراحل “وجود سوريا” برمّته. لذلك كانت الكتابة في هذا الأفق تجد نفسها -أو كان يجب أن تجد نفسها- أمام مأزق أكبر وأشمل. كان على الشعر البحث عن الأمل والفرح، وعن القيم الكبرى في كيان الإنسان. ليست رسالة اليأس والموت الروحي والرمزي من رسائل الشعر الأساسية. ربما هي رسائل تمر به مرور الكرام، لكن البقاء فيها خيانة كبرى. مهما كانت طبائع الواقع فظيعة ومدمرة. بعض الشعر في هذه الفترة كان يفعل ذلك. وبعضه كان يزيد الروح كآبة وإحباطًا. شخصيًا لعبتُ في مساحات الحلم والحب بل وحتى اختلاق آفاق إيروتيكية! وهذا بالنسبة لي نوع من أشدّ أنواع التحدي الفني للموت والخراب الشامل. فكان ذلك يشبه أن يقيم سوريون عرساً ويرقصون في وسط الخراب الواقعي. فما بالك بالشعر؟ لماذا لا يختلق؟ طبعاً اختلاق الفرح والعشق ليس تجاهلاً لمأساوية الواقع، بل هو مراوغة مطلوبة لتخفف على المتلقي من أثر مخالب التاريخ الأسود.
لدي عدة مخطوطات شعرية ونثرية حول سوريا الآن، واحد منها قيد الطباعة بعنوان «المدفن السوريّ واحد» يضم عدداً كبيراً من نصوصي الشعرية المتعلقة بالأمر. وما زلت أكتب وأمزجُ القلق بالعطر، ما زلتُ أبتكر شمساً لقارئ مثقل بالفظاعات والرماد. عليّ أن أكون رفيقه، أحمل معه ألمه، أشيع معه قتيله وأرجع به في نهاية المطاف لأذكره بأن هناك حياة سوف تستمر بكل ما فيها. ربما يسخر مني، ربما يهرب، ربما يتهمني بتزوير الواقع، لكنه في لحظة تأمل سوف يرى أنني مُخرّبٌ ومستهدَف من وحش التاريخ أيضاً، لكنه سوف يكتشف أنني كشاعر حاولت الوفاء بمهام الشعر الكبرى التي لا تلغي الإنسان والمستقبل من حساباتها.
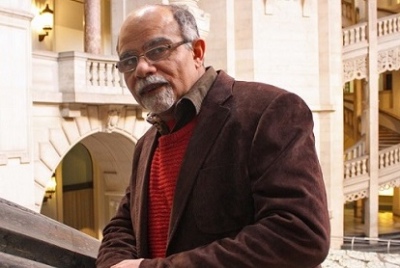
ثمة حذر لديّ من مفهوم “الثورة” لتوصيف واقع سوريا الآن، أدرك أن هذا ليس مرحّباً به في أوساط “المعارضة”، لكنها قناعتي ورؤيتي التي جاهرت بها مبكراً. لهذا لا أحبذ أوصاف شعر الثورة وشعر الحرية… لأنها أوصاف تحيل على وظائف سياسية واجتماعية للشعر، وأنا أعتقد جازماً أن وظيفة الشعر هي الشعر!
في حيثيات واقع النصوص الغزيرة التي تُكتب الآن، منها ما يركب الموجة كتغيير موديل، أو كاستثمار في سوق الثورة والثورية. ولكن منها -وهو ليس بالقليل- ما يشتغل في حقل الإبداع والفن بكل جدارة خاصة من الأصوات الجديدة داخل وخارج سوريا.
أدرب نفسي وأفكاري على عادة التفاؤل، وسوف أبقى!
الشاعر محمد المطرود: كتابةُ الحرب حصتي من مشهد القتل..
لو كان الشعر باقياً على حاله، لكنا نحن الشعراء أشبهُ بالذي يحترق بيته وهو يغني بلامبالاة، حالة الخراب الكبيرة والهدم والعدم في أيامنا هذه، جعلت هذا الكائن الشعري رائياً ومحاكماً ومتجاوزاً، ولهذا صرنا أمام تقنيات جديدة في الكتابة، تخلص لها إلى حد كبير وفي الوقت ذاته تتفلتُ من صرامتها نحو خلقٍ جديد للفكرة وكذلك للشكل الحامل لها، وهذه العلاقة بالضرورة منفتحة على اللحظة الدقيقة الراهنة، وهي تعيد تشكيلها من زاوية أخرى، بالتأكيد ليست زاوية ضيقة تحاكي صورة مايحدث، إنّما تحاكي ماورائيات الحدث والصورة.

لا أنظرُ للشعر بوصفهِ نبوءة، أنا ميّال للنظر إليه بوصفه كائناً يمكن تهذيبه والاشتغال عليه، ذلك أن التفجرّات الحاصلة اليوم تطول التقنية والنفسية والعلاقة بين البشرية والأشياء، ولهذا الشاعر بحكم علاقته الوثقى مع الجماليات وإعادة صياغتها هو يصوع رؤيته لتقانات كتابتهِ عموماً، برأي ما يتم من تزاوج بين السردية والشعرية ما هو إلّا اجتراح للمعنى بعموميته ولمعنى الشعر تحديداً.
ومهمة الشعر اليوم تكون خارج وظيفته الجمالية، ليس بتغييب الجمالية كأساس طبعاً، إنّما محاولةُ الجانب الفطري والبكر والفهم العميق للقصيدة التي كانت تصطاد من وادي عبقر، واعتبارها كائناً له الحق في المعيشةِ ومخالطةِ الناس كواحد منهم وليس بالتعالي عليهم، وهنا أيضاً أنا معني بالتوضيح، فالمعنى هنا أنني أطمحُ بكتابة تقول الكثير، وتحقق شرطَي المتعة والفكرة الدفينة والمموهة ضمنَ وحدة تتكامل وتتعاضدُ أجزاؤها، دون أن يطغى شرط على الآخر بالحضور.
بالنسبة لنا كسوريين عموماً وكمنتجين إبداعيين خصوصاً نحن أمام كارثة مروّعة، أصابتنا بالذهول، قد لا يكون الشكل الذي نكتبه اليوم شكلاً نهائياً يصوّر الحدث من زاويته الماورائية والتي تتمايز عن الآخرين، أو يفترض أنها متمايزة، لكنها محاولة تروم إطلاق تسمية الظاهرة على الكارثة ليتم تشييد جسر، ولو جسراً ضيقاً ورجراجاً للدخول عليها، قد يكون الدخول محفوفاً بالمغامرة، وربّما المغامرة التي عنيتها هنا هي ما ستؤسس للغة أخرى أكثر دقة وأكثر فهماً كيف تكون الحرب وكيف تكون الكتابة عنها، بحيث نكتبُ كما لو أننا في سلوكنا المعيشي اليومي، أي الكتابة غير المقتولة بكثرة التفكّر بها، تفكر يصلُ حدّ المسخ.
الحرب/الثورة، كسوري أخذتني هذه الثنائية من يدي نحو مراميها وأوجاعها وسلوكياتها، كتبت الحربَ بطريقتي، دخلت المفردةُ بقوة في نصي وإنْ كانت من قبل موجودة، غير أني اليوم أستخدمها كشخص له حصة من مشهد القتل والنيران، انتمائي لمنطقة ملتبسة بدوره جعل نصي أيضاً ملتبساً، إذ صرتُ أعمل على نصين يتداخلان فيما بينهما، نص شعري وآخر سردي، وأعللُ هذا النوسان لضيقِ الهامش الذي يمنحهُ الشعر لروحي المثقلةِ بآلاف الصور والحكايات والشخوص وهم بالضروة أشخاص مهزومون ومبتلون. أزعمُ أن كتابتي ليست ردة فعل مباشرة، فهمي لها هو أنها نججت بأنْ تُقرأ كأدب خاضع للنقد والتقييم وليس كمادة خبرية محكوم عليها بالموت بعد الانتهاء من الغرض الذي كُتبت لأجله.
الشاعر مروان علي: الحلم أن نكتب قصيدة جميلة لسوريا..
يقيناً العالم غير مضطرب بل يمضي نحو الهاوية. لم يتوقع أحد أن يتفرج العالم على موت السوريّين كما نرى الآن، ينتظرون بفارغ الصبر صور غرق السوريّين وموتهم.. للحصول على سبق إعلامي في هذا العالم المضطرب والذي يمضي نحو الهاوية الشعر وحيد تماماً مثل السوريّين وهم يواجهون خراب حياتهم ودمار وطنهم.. يقف الشعر وحيداً ولا يعرف ماذا يفعل مثل السوريّين الذين تحاصرهم الحرب والموت والجوع والتشرد. في هذا العالم أدير ظهري للشعر إذ لا جدوى منه ولا جدوى من الكتابة أمام الألم السوريّ العظيم. لم أتوقع حين كتبت الشعر قبل أكثر من عقدين.. أن أكتب الحرب، كنت أظن أن العالم ودّع الحروب والخراب نهائياً وفجأة وجدنا الحرب أمام باب البيت. لا يمكن لشاعر سوري أن يكون بعيداً عن هول ما يحدث وكارثيته، ومع ذلك حاولت أن أبحث بين حطام قلبي الصغير عن الشِعر والأمل، ركضت خلف ما قاله جورج شحادة: “كيف نموت ونحن نستطيع أن نحلم”، والحلم هناك أن نكتب قصيدة جميلة لسوريا الجميلة والبعيدة. أن تكون شاعراً وسورياً اليوم.. لا أقسى من ذلك، تموت كل يوم وأنت ترى كل هذا الدمار حولك. تموت وأنت تحاول الكتابة عن هذا الألم والموت.. عن موت الأمل. أن تكون شاعراً.. تكتشف بسهولة.. عدم جدوى اللغة أمام هول الفاجعة.. كيف ستحوّل هذه الصرخات التي تصل إليك من تحت أنقاض البيوت في حلب ودرعا والرقة ودير الزور إلى كلمات.. لتصف الألم. أن تكون سورياً اليوم لا بد أن تكون شاعراً.. وأنت ترى كل هذا الموت وتحاول يائساً البحث عن الأمل. الأمل الميت واللغة الميتة والنصوص الميتة. أن تكون شاعراً سورياً يعني أن تغمض عينك وتلقي برأسك بين يديك.. وسترى كل شيء، المهاجرين.. النازحين.. الأشلاء المتناثرة.. الكل يحاول أن يهرب ويركض بعيداً عن هذه البلاد التي كان اسمها ذات يوم سوريا.. أن تكون شاعراً سورياً.. عليك أن ترى بعيني قلبك وتركض خلف الهاربين من بعضهم.. بقدمي قلبك.. وتمد للأطفال تحت الأنقاض يد قلبك الصغير. أن تكون شاعراً سورياً عليك أولاً أن تبحث عن صرختك التي ضاعت في صحراء الرصاص. ربما تجدك هي وتعود إليك.

قلت: حقيبتي الصغيرة معي وميرا في حضني ولأن الأرض تدور سنصل يوماً إلى سوريا. قلت: أصبحت غريباً في بلادي لولا قبور الأصدقاء لما وجدت الطريق إلى البيت.
قلت: الذي أطلق الرصاص عليّ كان أخي وسيعود يوماً لرشده ولن يجد مكاناً يضع رأسه عليه سوى شاهدة قبري.
قلت: الحرب ليست خدعة من لم يمت برصاصة سيموت من الشوق.
قلت: لا أريد شيئاً من هذه البلاد سوى أن تعود بلاداً ونعود بشراً نحب ونرقص ونغني وننسى أن نموت.
قلت: أمضيت عمري في البحث عن الذئاب ولم أكن أعرف أنني أحيا بينهم.
قلت: سنتقاسم الحرب أنت تدفن الأصدقاء وأنا أبكي عليهم.
ونحن نكتب نرى هذه البلاد كلها.. البيوت والأشجار والسماء.. تهرب وتركض ولا تلتفت خلفها.. وتبقى وحيداً وأنت تحاول الكتابة لكن اللغة أيضاً تتركك وتمضي بعيداً.. خلفهم. نقطة أخيرة تركت الحرب أثراً وحيداً في علاقتي مع الشعر والكتابة، أن أكتب عن سوريا بألم كما لو أنني لن أراها ثانية.. وأكتب عنها بحب وأمل كما لو سأعود إليها غداً صباحاً.
الشاعرة هنادي زرقه: زراعة الأمل في أرض القصيدة..
لطالما كان الشعر مرآة عصره، وللعرب علاقة تاريخية بالشعر، وقد حفل القرن العشرين بانقلابات شتى في جميع الفنون ومنها الشعر العربي.

أعتقد أنه من الصعب النظر إلى الشعر ودوره في هذا العالم المضطرب من دون الفنون الأخرى، هذا العالم الذي يشهد حروباً وصراعاتٍ إقليمية وتغيرات في الجغرافيا، حتى تكاد تضيع هوية الأفراد. والشعر مثل غيره يخضع لاختبارات صعبة كي يبقى تلك المرآة التي تعبر عن حال المجتمع، وهنا، علينا ألا نغفل دور المؤسسات التي ترعى الشعراء وتمكّنهم من نشر شعرهم. وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي في القرن الحالي دوراً مهماً في إبراز أصوات شعرية لم تكن لتنالَ فرصتها في الظهور لولا هذه الوسائل، بمعنى آخر فقد غدا للشاعر منبراً يستطيع فيه نشر شعره من دون تسوّل دور النشر، ولا يحتاج الشعر جواز سفر أو إذن لعبور القارات.
ما هو الشعر؟ هل هو النبوءة وحدها؟ الشعر هو ثورة على صعيد اللغة تخرج من صميم الحياة اليومية التي يعيشها الشاعر ومن تحليله العميق للأحداث. يضطلع الشعر اليوم بمهماتٍ جسيمة، منها أن ينكأ الجراح… وأن يكون صادماً لا مهادناً، ويواكب الحركات المدنية، ويوعّي الضمائر، وأن يزرع الأمل في نفوس البشر، وليس بإمكانه أن يقوم بهذه المهمات من دون أن يشارك البشر وجعهم وموتهم… أن يكون لصيقاً بجراحهم، ومن هذه الجراح ينبثق الأمل، فالشعر في صميمه يحمل بوق النبوءة على حدّ تعبير شيلّي في «قصيدة إلى الريح الغربية»: “أيتها الريح، إذا ما حلّ الشتاء، فهل سيكون الربيع بعيداً؟”
كان متوقّعاً أن تقوم الانتفاضة السوريّة في عام 2011، فقد عاش المجتمع قمعاً للحريات، وعاش الشعراء العزلة والوحشة… فكانت تلك جذوة كامنة للتغيير. غير أن الأمل الذي اجتاحنا في بداية الانتفاضة وتغلغل في نصوصنا الشعرية ما لبث أن تحول إلى خيبة مريرة بعد تحوّل هذه الانتفاضة المباركة إلى حرب لا تبقي ولا تذر.
أعتقد أنني لم أنجُ ولن أنجو مما حصل في سوريا، وحين أصدرتُ مجموعة شعرية «الحياة هادئة في الفيترين»، في 2016، اعتقدتُ أنني دفنتُ الحرب ومفردات الحرب، ولن أزيد بعدها، فنصوص المجموعة حافلة بالألم والموت والقهر، غير أن هذه الحرب مازالت ممسكة بلغتي، تغتصب مفرداتي كل يوم… لم أنجُ من الدم المسفوح في شتى أنحاء بلدي الحبيب، ومع هذا كلّه، علينا مراراً وتكراراً أن نصرّ على زراعة الأمل قبل القمح.






