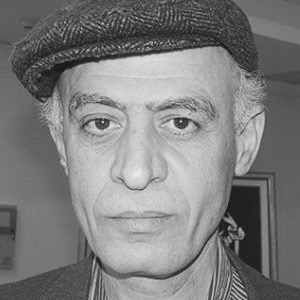بدأ اليهود في المنفى يكتبون عن القدس كما لو أنهم متأكدون من العودة إليها. “السنة القادمة في القدس” و”لتنسني يميني إذا نسيتك يا قدس“، ورسموا لها في قصائدهم صورة مستمدة من الصورة المرسومة لها في العهد القديم. بدت مدينة الملك داوود وكانت مدينة من ذهب. وهكذا تخيلها ثيودور هرتسل المؤسس الحقيقي للصهيونية وصاحب كتاب «الدولة اليهودية» (judenstaat)، وحين زارها لم يرها كما تخيلها، فقد رأى مدينة كئيبة شوارعها بائسة وقذرة يكثر فيها الذباب ويكثر فيها المتسولون أيضاً، ما جعله يتحسر إذ رأى مدينة غير مدينة الأجداد التي قرأ عنها في العهد القديم.
أبرز هرتسل من خلال الصورة التي رأى القدس عليها في نهاية القرن التاسع عشر الصورة المتخيلة للمدينة في الماضي، ولكنه لم يكتف بهذا فقد أشعل مخيلته ورسم صورة أخرى للقدس كما ستصبح عليه بعد سيطرة الحركة الصهيونية عليها. ستغدو القدس المتخيلة مدينة على غرار المدن الأوروبية التي عرفها، بل وأفضل منها. ستغدو مدينة يتطلع إليها سكان المعمورة ففيها الهيكل المنشود.
حتى 1917 وربما حتى اندلاع الثورات الفلسطينية بعد صدور وعد بلفور، لم يكن للقدس حضور لافت في الأدب الفلسطيني، ويمكن القول إنه لم يكن للمكان أيضاً حضور لافت وقد يشذ أدب الرحلات عن الشعر والقصة القصيرة والرواية وربما أيضاً المسرح. كانت الأجناس الأدبية النثرية في الأدب الفلسطيني والعربي في طور النشأة وهي الأكثر استيعاباً لإبراز المكان، خلافاً للشعر الغنائي وهو الغالب في الشعر العربي.
نادراً ما يقرأ قارئ الأدب الفلسطيني قصائد عن القدس في الشعر الذي كتب في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
في الأدب العربي في العصر الوسيط، زمن الحروب الصليبية، حضرت القدس في الشعر وحضرت أوضح في بعض الخطب التي وصلتنا مثل خطبة محي الدين ابن الزكي التي ألقاها في حضرة صلاح الدين الأيوبي يوم حرر هذا المدينة التي مكثت تسعين عاماً بأيدي الصليبيين.
أبرز صورة للقدس تبرز في تلك الخطبة وتفوق صورتها فيها الصورة التي برزت لها في قصائد ”القدسيات” .في قصائد “القدسيات” ذكرت القدس ذكراً عابراً باستثناء القصيدة التي رثيت فيها المدينة حين خربها سكانها بعد تحريرها خوفاً من أن يحتلها الصليبيون، بعد موت صلاح الدين، ثانية.
كتب ابن المجاور قصيدته وأتى فيها على مكانة القدس وبيّن صورتها بعد تخريبها مقارنة بصورتها قبل ذلك. كما لو أن ابن المجاور سار على خطى قصائد رثاء المدن في الشعر العربي مثل قصيدة ابن الرومي في رثاء البصرة، مع أن قصيدته لم تبرز للمدينة صورة ترتقي إلى الصورة التي أظهرها ابن الرومي للبصرة حين دمرها الزنج.
ظلت القدس تسعين عاماً بأيدي الصليبيين وحين فتحها صلاح الدين لم يصدق المسلمون الخبر:
أترى مناماً ما بعيني أبصر
القدس تفتح والفرنجة تكسر.
وبعد استرجاع المسلمين لها لم يعد للمدينة في الشعر ذلك الحضور اللافت. ولم يلتفت الشعراء لها وهي تحت الحكم العثماني التفاتهم لها بعد احتلالها في العام 1967.
قبل العام 1948 ركز الشعراء على الأحداث ولم يركزوا كثيراً على المكان. كتبوا عن الأرض وبيعها وعن السماسرة وعن الشهداء وعن الزعماء المتناحرين أكثر مما كتبوا عن المكان.
ثمة بيت شعري هو الأبرز في ما كتب عن القدس. بيت لا يغيب عن البال إطلاقا. بيت كما لو أنه قصيدة. كما لو أنه ديوان. بيت يختصر حكاية مدينة القدس منذ الاستيطان الصهيوني حتى الآن. منذ صدور وعد بلفور حتى خطوة ترامب الأخيرة. إنه بيت الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود. كما لو أن الشاعر حقاً صاحب نبوءة. كما لو أنه كان يقرأ الغيب أو يستشرف المستقبل.
لعبد الرحيم محمود قصيدة عنوانها “نجم السعود” قالها في حضرة أمير سعودي زار فلسطين والتقى به الشاعر في مدينة نابلس، فكتب له شعراً يعبّر فيه عن خوفه من قادم الأيام ومن ضياع القدس وفلسطين:
يا ذا الأمير أمام عينك شاعر
ضمت على الشكوى المريرة أضلعه
المسجد الأقصى أجئت تزوره
أم جئت من قبل الضياع تودعه.
هل كان الشاعر يرى ما نحن عليه الآن؟ هل كان يأمل ويرجو أم كان يدرك أن آل سعود ضليعون في ضياع الأقصى والقدس وفلسطين؟ يقول أصحاب نظرية التلقي (هانز روبرت ياوس) إن المنعطفات التاريخية تؤدي إلى قراءة النصوص القديمة قراءة جديدة. وهذه قراءة.
وستتواصل النبوءة لدى كتاب آخرين.
في العام 1979 كتب القاص أكرم هنية قصة قصيرة عنوانها “بعد الحصار… قبل الشمس بقليل” وفيها صحا أهل القدس ذات صباح ولم يجدوا الأقصى والصخرة وتساءلوا عما سيفعله الحكام العرب من أنور السادات إلى ملك السعودية في حينه، الملك فهد أظن، وأدركوا أن انتظار الحاكم العربي لن يأتي بالخير.
الكتابة عن القدس تطول طول تاريخ المدينة نفسها، المدينة التي دمرت ثماني عشرة مرة وليس لنا إلا أن نردد مع توفيق زياد “هنا باقون” ومع تميم البرغوثي “في القدس من في القدس، لكني لا أرى في القدس إلا أنت”.