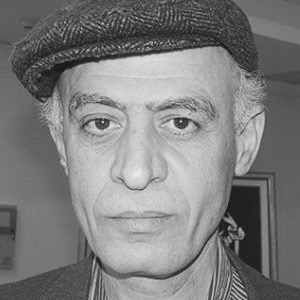خطر ببالي في ذكرى رحيل الشاعر سميح القاسم السؤال الآتي: ماذا تبقى من الشاعر بعد ثلاثة أعوام من الرحيل؟
لا يخطر السؤال السابق في ذهني في ذكرى غسان كنفاني أو في ذكرى محمود درويش أو في ذكرى ناجي العلي. ربما أثيره في ذكرى معين بسيسو أو عبد اللطيف عقل أوجبرا ابراهيم جبرا أو علي الخليلي أو فدوى طوقان والسبب يعود بالتأكيد إلى الالتفات إلى هؤلاء الأدباء في ذكرى رحيلهم، أو عدم الالتفات.
تحظى ذكرى كنفاني ودرويش والعلي باهتمام لافت، فيما تمر ذكرى الباقين مروراً عادياً، وتقع ذكرى إميل حبيبي بين الذكريين.
أحاول شخصياً أن أحتفي بالرموز كلها، فقد قرأت هؤلاء كلهم وعشت مع نتاجهم، وأحاول أن أكون دارساً وباحثاً ومنتمياً إلى فلسطين لا إلى شخوصها أو فصائلها. أحاول يحدوني بيتا امرئ القيس:
“بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه/
وأيقن أنا لاحقان بقيصرا/
فقلت له: لا تبك عينك إنما/
نحاول ملكا أو نموت فنعذرا“
وأنا أحاول.
في أيار زرت حيفا ورأيت البحر الأبيض المتوسط من أعلى الكرمل، فرددت سطري سميح “من قمت (؟) جبل الجرمق، أعلى جبل في وطن الأسماء/
صار كلام الرب إلي أنا المنبوذ سميح القاسم“
و.. وتذكرت قصته “ملعقة سم صغيرة ثلاث مرات يومياً” وبطلتها اليهودية (نوريت) وعلاقة مأمون/سميح بها، وتساءلت: لماذا شاعت قصة علاقة درويش بريتا ولم تشع قصة علاقة سميح ببطلات ثلاثيته “إلى الجحيم أيها الليلك“ و “الصورة الأخيرة في الألبوم ” و “ملعقة سم صغيرة…”؟ ألأن الشعر أسهل انتشاراً وأسرع أم لأن درويش عبر عن تجربته بضمير المتكلم ولم يختف وراء قناع، كما فعل سميح الذي كتب عن سميح و(إيلانة) وأمير و( روتي) ومأمون و(نوريت)؟ أم لأن الأول سبق الثاني في الكتابة؟
كتب درويش قصيدته في 1966 وكتب سميح حكاياته وقصصه في 1977 و1980 و2011. هل ربح الأول لأنه تقدم وخسر الثاني لأنه تأخر؟
وأنا أقرأ ثلاثية سميح لا أتوقف أمام المرأة اليهودية من حيث هي محبوبة في الأدب الفلسطيني أو الأدب العربي وحسب، وإنما أتوقف أيضاً أمام الأدب الأيديولوجي وما آل إليه، وما كتبه سميح في ثلاثيته يعد أدباً أيديولوجياً بامتياز، تخلص الشاعر نفسه من بعض أشعاره التي حفلت بالشعار السياسي والحزبي والأيديولوجي. وفعل درويش الشيء نفسه مبكراً، وتحديداً حين لم تعد قصيدة “بطاقة هوية” تروق له قراءتها في العالم العربي. ولطالما عبر عن عدم رضاه عن كثير من أشعاره الأولى.
تحفل ثلاثية سميح النثرية بالخطاب الأيديولوجي وتعبّر عن آراء فكرية وسياسية تبناها وطغت في مرحلة، وخفت بريقها لاحقاً. هل يمكن أن نقرأ اليوم تلك النصوص كما كنا نقرؤها في سبعينيات القرن العشرين؟ وكم طبعة صدر منها بعد التسعينيات؟
وإذا انتقلنا إلى أشعار سميح لنسأل السؤال نفسه: ماذا تبقى منها أيضاً؟
شغل الشاعر وشعره القراء العرب، وكتبَ الدارسون عنه الكثير، فمن يقرأ اليوم أشعاره وما كتب عنها؟
طبعاً قد لا يتعلق الإحجام بشعر سميح نفسه، فالإحجام يخص جنس الشعر في فلسطين وفي العالم العربي وفي العالم. هذا مؤكد.
حقاً ماذا بقي من قصائد الشاعر؟ “خطاب من سوق البطالة“ أو ”تقدموا.. تقدموا” أو “إليك هناك حيث تموت“ أو “برسونا نن غروتا“ أو “رسالة إلى غزاة لا يقرؤون” أو “منتصب القامة أمشي“ أو “ليد ظلت تقاوم”؟
من يقرأ اليوم القصائد السابقة سوى من تبقى من مقاومين ؟ وهل مازال تأثيرها كما كان؟
الأسئلة التي أثيرها أثارها شعراء عرب من قبل. أثاروها بعد اتفاق أوسلو، وتحديداً يوم أصدر درويش “سرير الغريبة“، إذ تساءلت الشاعرة ظبية خميس عن اختلاف درويش بعد إصداره الديوان المذكور؟ ومؤخراً قرأت رأياً أكثر جرأة عما آل إليه أدب المقاومة الفلسطينية بشكل عام.
الكاتب السوري خالد خليفة سئل عن مصير الأدب السوري منذ 2011، حيث يركز على الأحداث في سورية، فأجاب بأن مصيره مثل مصير أدب المقاومة الفلسطينية، وهو يرى أنه لم يبق من أدب المقاومة الذي كتب في أثناء صعود المقاومة شيء، فقد خفت بريقه.
هل كان سميح القاسم نفسه أدرك مبكراً أن الشعر التعبوي الأيديولوجي لن يعمر طويلاً؟
دافع الشاعر في مقدمة الجزء الأول من ديوان “الحماسة” عن شعره الحزبي وعن طغيان الشعارية والتقريرية والمنبرية فيه، ولكنه عاد وحذف قصائد كثيرة من ديوان ”الحماسة”، وبعد أن هجا غالي شكري هجاء قاسياً عاد في سيرته “إنها مجرد منفضة” ومدحه.
في العقدين الأخيرين من حياته عاد سميح وكتب قصائد كلاسيكية مطولة أطلق على قسم منها لفظ ”المعلقة”. كتب المعلقة “البغدادية/ معلقة سميح القاسم“ وكتب القصيدة العمانية والقصيدة الدمشقية و.. و… وكتب شعراً عمودياً دلّ على تمكنه من القصيدة التراثية؛ صورة وبناء ولفظاً وتعابير، فهل بقيت هذه القصائد وعمرت أم نظر إليها على أنها قصائد لا تختلف عن قصائد الجواهري والبردوني ولا ترقى إلى قصائد المتنبي الذي خصه سميح ببعض قصائده ورأى فيه قريباً له.
في ذكرى رحيل الشاعر سميح القاسم نتساءل عما آل إليه نتاج صوت شعري شغل الناس في حياته، ومن حقنا أن نسأل، كما أنه من حقه علينا أن نتذكره ونتذكر نتاجه.
كانت فكرة سؤال الـ “ما تبقى” وردت في رواية غسان كنفاني “ما تبقى لكم” وقد راودت ذهن حامد بطل الرواية الذي فقد أباه في حرب 1948 وفقد أمه إثر الحرب وفقد شرف أخته حين أقامت علاقة مع زكريا وحملت منه قبل زفافها، وفقد يافا مدينته و 79٪ من فلسطين “لقد حملت أمي السر معها وتركتنا. ما تبقى لها. ما تبقى لكم. ما تبقى لي. حساب البقايا. حساب الخسارة. حساب الموت. ما تبقى لي في العالم كله: ممر من الرمال السوداء. عبارة بين خسارتين، نفق مسدود من طرفيه. كله مؤجل، كله مؤجل، ثم صفق الباب وخلع نعليه وجلس، كأن البيت بيته، ولو كنت أملك خشبة وشبر أرض لأعدمته، ولكنها لم تقل شيئا، وتركتني أمضي دون كلمة نداء واحدة ” (ص 216).
ضاع الوطن ولم يبق منه إلا بقاياه، فهل يحق لنا أن نتساءل ماذا بقي منا؟
في 1990 أو قبلها بقليل كتب سميح في مجلة “الناقد” اللندنية إنه لن يواصل كتابة الشعر لأنه نذر حياته لثلاثة مشاريع أخفقت: الوحدة العربية وتحرير فلسطين وانتصار الاشتراكية، ولكنه واصل الكتابة.
كانت أحلامنا كبيرة و”كم أصبحت أحلامنا صغيرة ” على رأي شخصية “شارع فرعي في رام الله ” للقاص أكرم هنية وكما ورد على لسان حامد في 1966 :”ما تبقى لي في العالم كله: ممر من الرمال السوداء، عبارة بين خسارتين، نفق مسدود من طرفيه، كله مؤجل، كله مؤجل”.