ترسم الروائية السورية لينا هويان الحسن في روايتها الأخيرة «ليست رصاصة طائشة تلك التي قتلت بيلّا»، الصادرة عن “دار الآداب” ببيروت 2019، ملامح سورية من خلال “الغرباء” الذين وَفَدوا إليها في مطلع القرن العشرين، في نصٍّ يصفه الناشر بـ”المشوِّق”، والذي “يؤشِّر على ألم (الانتماء) ويضغط على مَواطنه، مدوِّناً أحداثاً تاريخيَّة تخصُّ الأفراد، وأهملتْها كتبُ التاريخ”.
جديد صاحبة «سلطانات الرمل» كان مدخل حديثنا معها، فكان هذا الحوار..
أسألك بداية عن روايتك الأخيرة «ليست رصاصة طائشة تلك التي قتلت بيلّا». حدثينا عنها وعن ظروف كتابتها والمختلف فيها عما سبق من رواياتك، وهل هناك حدث معين حفزك لكتابتها؟
وُجدَ الأدب ليغتال النسيان، لا نكتب إلا ونحن ممسوسون بماضينا، بتلك الخزانات المتوارية في العمق. مرة أخرى تحفزني ذاكرتي المترعة بتنويعات تغري كاتبة من أبناء المكان المتاخم لريف حلب الجنوبي والريف الشرقي لحماة والشمالي لحمص وتدمر. تشكيلة من القرى التي يقطنها البدو والأرمن والشركس والتركمان والأكراد، كيف لا تفتنني سيرة شابة أرمنية عشقت شاباً شركسياً. ولا تثير شهوة الكتابة حكايات أولئك الغرباء الفاتنون الذين شكلوا ملامح سورية الحديثة وفي ذات الوقت تسبب هذا الجمال الرهيب بفتنة مرعبة بين الهويات المتنافرة.
تقفز حكاية تلك المرأة الآذرية من خلال صورة معلقة على الجدار، صبية مهاجرة من باكو عقب ثورة البلاشفة.. وأرمنية هاربة من المذبحة الكبرى.. مثل هؤلاء المهاجرين، المنفيين، المهملين، الحزينين المأزومين بانتمائهم المرير، وهم يغادرون أوطانهم ويجردون من هوياتهم بسبب معتقداتهم، بينما ينجبون أبناءهم في المهجر، ليكبر هؤلاء وهم يعيشون شقاء الانتماء إلى أكثر من ثقافة.
كتبت هذه الرواية بروح من اقتنع بخرافة “سارتر” التي تقول إنَّ الكلمات هي أفعال، أننا يمكن أن نغير شيئاً ولو طفيفاً في هذا العالم المكتظ بالظلم.
لماذا أخترت أن يكون مسرح الرواية مدينة حلب، ما دلالات ذلك؟
إنها سُلطة الذاكرة، وزعت الرواية على ثلاثة أجزاء: “حلب، دمشق، وخُناصرة الأحصّ”. لعله، ذلك الخيط الخفي الذي يربطني بهذه المدينة، ففي منتصف السبعينيات كان أبي ضابطاً شاباً يدرب في كليتها العسكرية، ويقطن مع عروسه في أحد منازل حي الجابرية حيث تلك الدور العثمانية الطراز التي قسمت إلى غرف تؤجر لعائلات صغيرة ومن ديانات مختلفة.
ولدتُ في أحد هذه البيوتات الرائعة، حيث تتشارك تلك العائلات مطبخاً واحداً وقصصاً كثيرة. كثير من الروايات هي إضاءات عفوية. لربما كتبت عن حلب لخاطر استعادة رونقها الفريد أدبياً في ظل الدمار الذي طال أهم معالمها؟!
كيف تحضر المدن في ذاكرتك وأنت تكتبين نصوصك الإبداعية؟
الأمكنة ورطة رائعة، في «ليست رصاصة طائشة تلك التي قتلت بيلّا» وضعتُ ما يشبه خاتمة، شخصية جداً، تتعلق بحياتي الغريبة والنادرة التي عشتها متنقلة بين مدن مختلفة وأمكنة متعددة، شكلت الفسيفساء الملونة التي استثمرتها كثيراً في كتاباتي.

لعناوين الأعمال الإبداعية وعتباتها، منطق خاص. كيف تختارين عناوين رواياتك، وهل يكون العنوان هو المدخل للعمل عندك؟
إنها لحظة درامية بامتياز تلك التي يختار فيها الكاتب عنوانه. العنوان هو قطعة الأثاث الأساسية التي تشي بزمن ومكان وأشخاص الرواية على نحو غير مباشر. العنوان هو عتبة لك أن تزخرفها بذائقتك الخاصة، أن تختار إيقاعه، نغمته، كلماته، إنه طقس بحد ذاته، لا بد أن يكون طقساً مستقلاً عن الرواية في لحظة ما ليستطيع أن يستقيم دونها. هذه المرّة اخترتُ عنواناً طويلاً، أردته أن يتكلم، ينطق بشيء ملغز ومحير، أردته فخّاً وديّاً تجاه القارئ.
من أين تستمد شخصيات رواياتك حيويتها وحضورها المؤثّر؟
كتبت تحت تأثير فتنة العوالم التي عشت فيها وتنقلت بينها. عشت حياة مبكرة مشبعة ومتخمة بالخرافات والثقافات الشفهية غير المدونة، حكايات الأسلاف.
تشكلت كشوفاتي الأولى وخياراتي وفق إرث منسي ومهمل وثري. تخيل طفلة تعيش في المدينة، تذهب إلى مدرستها في حافلة مع بقية زملائها، ثم فجأة تنتقل لتعيش في بناء طيني مدور أو خيمة بدوية مصنوعة من شعر الماعز، وتصبح تسليتها البحث عن بقايا جلود الأفاعي التي تسلخها تلك الزواحف الرهيبة لتكبر وتنمو، نلتقطها لأن هنالك نساء ماكرات يرسلن الصغيرات لجلب أدوات “السحر” لصنع التمائم تلك التي تحمي أو تقتل. علمت مبكراً أنَّ المرأة أذكى مخلوقات هذا الكوكب، وهي تروض الأشياء والكلمات والحروف والكائنات الخفية لتحقيق مآربها، لتحب، وتنتقم.
أتعلم، كبرت ودرست الفلسفة في جامعة دمشق التي منحتني الكثير المثير لأشقّ دربي في هذه الحياة. لكن النساء الخطيرات اللواتي عرفتهنّ في طفولتي كان لهنّ الفضل الكبير بتلوين مخيلتي وتوسيع أرضي، منحتني أمكنتي الأولى بهارات فريدة المذاق.

تقولين: “ستكون كل حياتك انعكاس ضوء كتاب قرأته ذات يوم”. سؤالي: ما هو الكتاب، أو الكتب، الأكثر تأثيراً في حياتك؟
درست الفلسفة في جامعة دمشق. وبدأت قصة غرامياتي مع الفلاسفة، فيلسوفاً تلو الآخر، وعند «متمرد» ألبير كامو توقفت طويلاً، تركت عاصفة أفكاره تجتاح قناعاتي وأفكاري. نشأت بيننا علاقة: هوية، تحوّل، انتماء. عثرت على وصفة الحياة، والحضور، وكل تلك الأفكار التي كانت تعشش في رأسي، خرجت إلى النور بثقة كبيرة بفضل كلماته، فمشروعي في الحياة بكامل تفاصيله لم يكن قط مشروعاً للموافقة، إنما للرفض والاعتراض والشجب.
ما الكتاب الذي يحضر في حياتك: “كرحمة مباغتة”، على حد تعبيرك؟
رواية «بطل من هذا الزمان» لليرمنتوف. إنها شخصية “بتشورين”، شخصية احتلّت المشهد الأساسي في قراءاتي. جعلتني أتصالح مع عيوبي، مع “نرجسي” الذي يراه غيري غروراً ولؤماً وأنانيةً. تفهمت أن الأدب يتغذى على العيوب. عقدت حلفاً حميماً ووثيقاً مع “بتشورين”، قرأته وقلت أهلاً يا صديقي.
يقول الشاعر العراقي سعدي يوسف “عش في الهامش واكتب في الواجهة”، كيف تنعكس هذه المقولة على لينا هويان الحسن الإنسانة والكاتبة؟
هامشي هو حياتي اليومية الحالية في بيروت. أفرّط كثيراً بحياتي الاجتماعية لأجل عالمي الروائي. إنه هامشي الأثير الذي يعيش ويتنفس باسترخاء في شقتي التي أثثتها وفق مزاجي. هنالك ذلك الجدار الذي ألصق عليه صوراً غير متجانسة، متنافرة، متناقضة، غريبة، تشبه تماماً أفكاري التي تتلبد كغيم السماء لتمطر.
أحتفي بالعدة الكلاسيكية للأدب: استيقاظ مبكر، قهوة، صوت فيروز، كتابة، عزلة اختيارية، لا أعرف ما هو الشعور بالملل، بصحبة كائناتي الورقية، أتمنى أن تتضاعف ساعات النهار لأنجز ما أحلم به، أقدّس الوقت، ولدي قلّة من الأصدقاء الرائعين الذين يلائم حضورهم أمسيات العشاء والشموع والموسيقى والضحك. ذلك يكفي، لن تكون الحياة أكثر مما قالته “سيدوري” صاحبة الحان لجلجامش المتعب من رحلته في البحث عن عشبة الخلود، ومختصر ذلك أنّ الحياة “أكل لذيذ، وحبّ، وصداقات” وأنا كتبت، لأني شغفت بعالم الكلمة قبل أي مأرب آخر.
كيف أثّرت أو تؤثّر الحرب في بلدك في كتاباتك بشكل عام؟
لم تؤثر فحسب، إنما غيرتني، صلبتني أمام “سفينكس” متوحش يطرح الأسئلة. ولا أعثر على إجابات. وجدت أني أمام خطاب تراجيدي. عندما تعيش حرباً، إذن أنت فقدت “المحايدة”، لهذا كتبت «الذئاب لا تنسى» وأنا مشحونة بحزني ونقمتي وموقفي الشخصي. عندما تكون حزيناً مقهوراً ستكتب لتبحث عن ملاذ لجرحك، لنزيفك، تتوهم أنك ستبرأ، فيغدو الأدب انفعالاً صرفاً..

صدر لكِ عام 2011 مجموعة شعرية بعنوان «نمور صريحة في شاعرية الافتراس». ما الذي كنت تبحثين عنه في انتقالك من السرد إلى الشعر، ولماذا بقيت المجموعة يتيمة؟
لم أزعم قط أنّ ما كتبته في «نمور صريحة..» “شعراً” خالصاً، يا لهذه الكذبة الرهيبة فكيف لأحد لا يعرف بحور الشعر جيداً ولا يكتب الشعر العمودي والتفعيلة أن يسمي نفسه شاعراً! اسمح لي أن انتزع اسمي من قائمة الشعر والشعراء كما غدا يُفهم هذا الكائن المجنح الفريد الذي اسمه “شعر” وتحول إلى مسخ تعيس مشوه مرضوض مشتت، مطية سهلة، خانعة، لكتّاب الخواطر ومتصيدي الألقاب.
انظر حولك ودقق في لقب “شاعر، شاعرة” الذي غدا يستخدم باستخفاف واستسهال واستهتار؟! إذن ما كتبته في «نمور صريحة..» ليس شعراً إنما كلمات مكثفة مختصرة لها إيقاعها الخاص ومضمونها “المفترس”.
أحبّ أبناء الطبيعة الآخرين غيرنا نحن البشر. آخرون متوحشون، ببراثن وأنياب سامة، فكتبت نصوصي متكئة على إعجابي بالوحوش، رضخت لغواية حالة “التوحش” بحد ذاتها، إنها لحظتنا الفريدة والقصوى التي نكونها لأجل أن تحيا “الأنا”، كما نريد لا كما يريدنا غيرنا.
بعد عشر روايات هل كتبتِ الرواية التي تريدين، من ثم ما نوع الكتابة التي تطمحين إليها في سن الستين؟
بدأت الكتابة في عام ١٩٩٨ والآن في رصيدي ١٧ مؤلف غالبها روايات. كلما بدأت بكتابة نصّ جديد أعيش الحالة ذاتها: ثمّة حالات وأشخاص وأشياء وأفكار، كلها شاردة، بينما أستمتع بحالة “الصياد” الذي يركض في بريته اللامرئية، في خارطته اللامحدودة، كتبت دائماً باستمتاع كبير. كلما أرسلت المخطوط النهائي للطبع أعيش لحظة “فراق” حقيقية لأبطالي وأمكنتي ومدني وكل تلك العوالم التي خلقتها، لأقول شيئاً.
في كل عمل جديد أطمح إلى ترسيخ دعائم وطن خاص بي، أملكه وحدي. لا أفكر مطلقاً بعمر الستين، ولا بما يمكن أن أكتبه بعد سنتين أو ثلاث.

كيف تنظرين إلى الجوائز الأدبية؟ وهل ترينها مؤشراً إيجابياً لتقييم النصّ، ورافعة للإنتاج الادبي العربي؟
الجوائز، دليل صحة وعافية، حتى لو اختلفنا حول نتائجها، وظروف منحها، وأسباب منعها. وأكرر ما قلته على صفحتي في “الفيسبوك”: الجوائز كأي عملة لها وجهان حفزت المبدع على الاجتهاد وجرأت عديم الموهبة على الادعاء ولا ذنب للجائزة في ذلك. للجوائز فضل على الكاتب فزيادة على قيمتها المادية تسهم في انتشاره؛ وفضل على الناشر فهي تزيد مبيعاته، ولن يحدث وأن يتفق الجميع بشأن الشخص الذي مُنح الجائزة.
بصراحة، كيف تابعتِ نتائج جائزة البوكر 2019، وما هو رأيك بما حدث في اليوم الأخير، الذي انتهى بمنح الجائزة كـ “ترضية” للروائية اللبنانية هدى بركات؟
هدى بركات صاحبة تجربة مهمة، لعلها لو حصلت على الجائزة بسبب عمل آخر غير «بريد الليل» لما ثارت عاصفة الانتقادات التي طالت الجائزة نفسها، لكن في النهاية لم تحصل هدى على جائزة لم تستحقها فيما لو نظرنا إلى تجربتها. ولو حصلت عليها إنعام كجه جي أيضاً كانت تستحقها بجدارة كبيرة.
اعتدنا سنوياً على عاصفة انتقادات توجه لخيارات لجان التحكيم في البوكر تحديداً، لأنها جائزة ترسخ حضور من يصل إلى قائمتها القصيرة فما بالك أن يأخذها.
معظم الأصوات المعترضة تأتي من كتّاب رشحوا أعمالهم ولم تصل للقائمة الطويلة. ذلك ما اختبرته بنفسي على مدار أربع سنوات. حالما يلمع اسمك تُشهر عليك السكاكين بذريعة النقد. حسناً هذا أمر طبيعي ويحدث في كل جوائز العالم. مثلاً أتابع سنوياً جائزة الأوسكار وكثيراً ما احبطتني النتيجة لكن هل يعني هذا أنَّ الجائزة بحد ذاتها سيئة؟! يا ليت لو يتريث الأدباء والنقاد قليلاً فمعظم الآراء تأتي نتيجة مواقف شخصية.
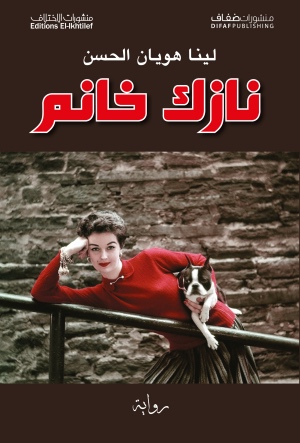
كان أن وصلت رواياتك إلى “القائمة القصيرة” أربعة أعوام متتالية (٢٠١٥ و٢٠١٦و٢٠١٧ و٢٠١٨)، ثلاث مرات في قائمة جائزة الشيخ زايد (فئة أدب الفتيان). كيف تقيمين هذه التجربة وما الذي تعلمته منها، وما هو تفسيرك لغياب الرواية السورية عن منصة تتويج البوكر؟
تجربة مهمة وثرية، على كل الأصعدة. خلالها تعلمت الوقوف لوحدي في مرمى النيران، فتجربة انتظار النتيجة لسنوات أربع أنضجتني تماماً حول عدة حقائق تجاهلتها لأحافظ على طبعي المتفائل. وحظيت بعداوات رهيبة من أبناء الكار، أعتز بأني أشعل في الأوردة كل هذا الغضب، لا مانع أبداً، فما من سيرة كاتب تخلو من هذا الطراز من العداوات، التي تشكّل أيضاً حافزاً للإبداع.
أخيراً، ما الذي تعملين عليه الآن، وهل هناك مشروع روائي قادم؟
الأدب سلاسل، متصلة، ومنفصلة. إنه نهر يتغذى من روافد كثيرة، يستمر طالما هنالك كلمات، فاللغة لا تذوي. منذ طفولتي الغريبة الموزعة بين مدن وأرياف وصحاري وأنا أحمل انتماءات ملتبسة، لعل الكتابة شكلت لي هويتي و”أناي”، وجعلتني معجبة بالتعددية ومؤمنة بالاختلاف. كل ما أكتبه وسأكتبه سيكون في صالح تقديس حق “الاختلاف” وحق “الوجود” مهما كان انتماؤك وعرقك وجنسك.






