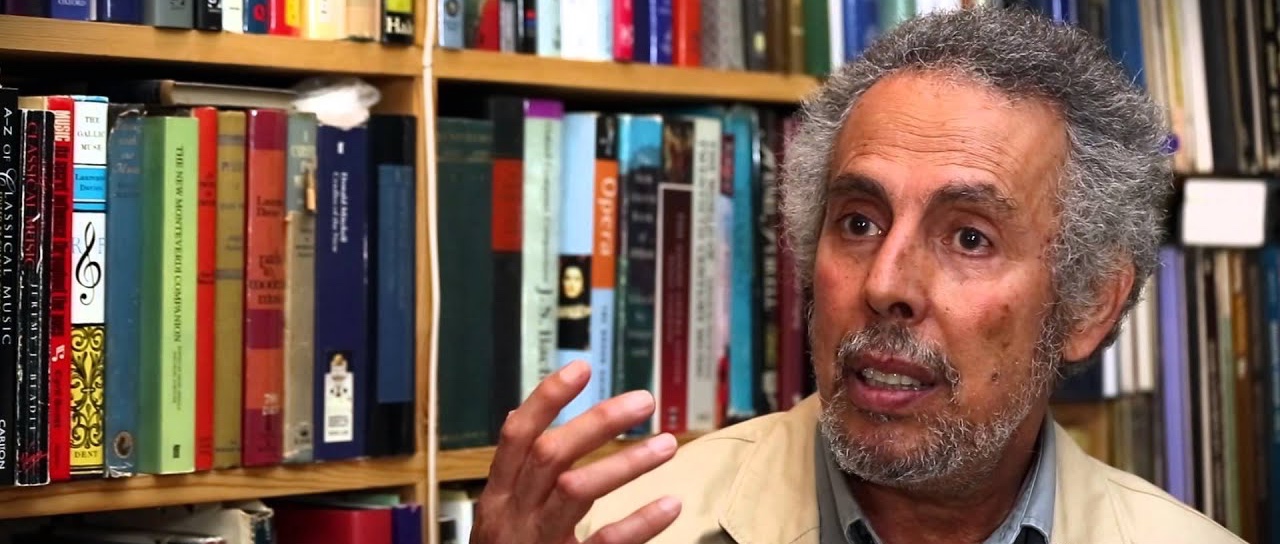بابتسامة ساحرة بريئة، أهداني فوزي كريم مجموعة من كتبه. قال إنها النسخة الأخيرة المتبقية، وكان يريد حملها معه من كوبنهاغن إلى لندن. لم يوقعها لي. طلب مني أن أراسله بعد قراءة الكتب.
“لا أهتم بكثرة القرّاء. يكفيني عشرة يقرؤوني بجدية، ويتابعون ما أقول كي أكون سعيداً”.
ابتسم بسعادة صادقة أصيلة حين أخبرته أن كتابه “ثياب الامبراطور” جعلني أعيد النظر في كل علاقتي مع الكتابة، وجعلني أكثر حذراً من الموضة السائدة ومن الألعاب اللغوية الفارغة.
“أحمل معي لزوميات المعري، وأعيد قراءتها باستمرار. وأقرأ أبا نواس طبعاً. لا أحتمل قراءة أبي تمام والمتنبي.” يقول بشغف، وتلمع عيناه.
“الزواج مؤسسة معقدة، مشروع معقد وصعب جداً. تبدو لي سعيداً به. أحسدك على ذلك. البعض لا يصلح له، والبعض يرى فيه مكانه الطبيعي.”
يقرأ في الفلسفة كثيراً. يرشح لي كتباً لم أسمع بها. قرأت لوكريتوس بناءً على نصيحته. تعجبه أعمال شوبنهاور.
ينصت كثيراً، ويناقش بدقة فيلسوف إنكليزي تحليلي. يضحك برقة.
“خفف من حماستك السياسية يا بني. وتفرّغ للأدب. آه، بالطبع، ستعيش فقيراً مهزوماً. لا مشكلة في ذلك، حقيقةً، لا مشكلة. ستكون سعيداً مع الكتب.”
“أهرب من لقاء السياسيين وأصحاب النفوذ. تخنقني ربطات عنقهم.”
“اختنقتُ في باريس. مدينة مريبة، وثقافتها فارغة مدعية.”
يتوقف عن المشي فجأة، مراقباً عجوزاً يلعب مع حفيده. يتابع بعد دقائق مشيه الوئيد.
“اقرأ لتتعلم. لا عيب في هذا. لم أتعلم الكثير في الخمسين سنة الماضية، ما زلت أقرأ لأتعلم.”
ينفر من الماركسيين واليساريين، ومن تطويعهم للأدب خدمة لقضاياهم. يميل إلى الليبراليين، ولكنه ليس يمينياً. سخر من فوضويتي بلطف، وتفهّم بعض جوانبها. يخشى الثورات، ويفضل الإصلاحات البطيئة؛ ولكنه يدرك أنها مستحيلة مع أنظمتنا المنحطة.
أخبرته أنني لا أقرأ الكثير من الشعر العربي الحديث. كلهم تقريباً يكتبون في السياسة فقط. ضحك بعمق، قال لي جرّب قراءة ما كتبوه. “عليك أن تفهم ما الذي كانوا يحاولون قوله، ولماذا؛ حتى لو لم تحب أعمالهم، أنا لا أحب معظم ما كتبوه.”
يأكل على مهل، لا يكثر من الطعام. يحب الخمر.
“تركت العراق قبل خمسين سنة. تجولت في بلاد الله. دمشق وبيروت من أجمل المدن؛ دمشق أكثر حناناً وعطفاً. بيروت كانت قبلة الشعراء. جعتُ فيها وتشردتُ. ولكنني وجدت نفسي في لندن. خمسون سنة، وأنا أكتب باستمرار عن نفس الشيء: العراق، العراق. لم أعرفه حين عدت إليه بعد الغزو الأمريكي والتخلص من الطاغية، فساد في فساد. ولكنني شعرت بأنني لم أغادره على الإطلاق. خمسون سنة مضت وأنا مازلت طفلاً في العراق، أقرض الشعر كمراهق يتعرف على نفسه وعلى شعره للمرة الأولى”.
لم يهتم بأنني لم أقرأ له كثيراً، ربما أربعة كتب بالمجمل، من مجموعة ضخمة في الشعر والنقد والموسيقا. يفرح عندما أستفسر منه عن شيء ما كتبه، ولكنه لا يفرض أعماله علينا، كما يفعل معظم الكتّاب. لا يعرّف نفسه بكتبه، على الرغم من أنه يرى فيها، بشكل ما، حياته. ندردش بدون حواجز، بدون أجساد، بدون نتائج. يتكلم فوزي، عندما يكون مرتاحاً، كأنه كونفوشيوس العظيم: متواضع هادئ، بحكمة قديس.
“الإنسان أهم من الفنان. الفن ثانوي، بمعنى ما؛ ما يبقى هو ما تعلمتُه من الآخرين، وما عشتُه معهم”.
أرسل لي مقالين ( العزلة وقرينها 1 و2) يميز فيهما بين الوحدة والعزلة. الأولى تفرضها الظروف، الثانية يختارها المرء. أبرز عوامل الوحدة المنفى. أما العزلة فتعزز “مناعات الإنسان ضد لوثات الوحدة… وتنصرف للحوار الدائب مع النفس، ومع الكتاب، ومع الطبيعة، ثم مع الإنسان الخلاق الذي هو مثيلك، أو الصديق المنتخب، الذي تكتمل به.”
آمن فوزي، بصدق أبيقوري نادر، بالصداقة كفضيلة أولى، لفهم الذات، وفهم الآخر، وكسر الوحدة، وقبول العزلة.
أخبرني أنني أنا المخاطَب في المقالين؛ كنت اشتكيت له من الوحدة، ومن الاكتئاب. نصحني بتفهم العزلة الاختيارية، وبالجهاد ضد الوحدة.
” هل ترى؟ حتى الموت، فكرةً أو حقيقةً، يُقبل في هذه العزلة كـ “مناجاة للجسد..”. إن رحابتها تتسع للحياة والموت معاً.”
أشعر بعد موته بنقصان المعنى، وبفقدان من كان سنداً في وجه الوحدة.
ولكنني، لسبب غامض، لا أشعر بحزن الغياب: أتذكر فوزي بابتسامته الهادئة البسيطة اليوم، وأبتسم.
لا يحزنُ من أنعمت عليه السماء بمثل هذه الصداقة.