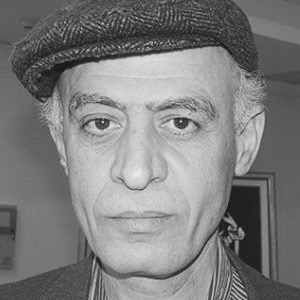لاحظنا أن الياس خوري في “الوجوه البيضاء” أسطرَ فدائي مرحلة الستينيات وجعل منه نموذجاً إيجابياً في المطلق، وفي الوقت نفسه رصد التحولات التي طرأت عليه في مرحلة السبعينيات، وهي تحولات لم تكن لصالحه. (انظر مقالي في جريدة الأيام الفلسطينية بتاريخ ٢٢و٢٩ آذار ٢٠٢٠)
أخذ فدائي السبعينيات، بحكم ملاحقته وانشغاله -مجبراً- في شؤون البلد الذي انطلق منه، وتدفق أموال الدول النفطية على المنظمة، وتحول العمل الفدائي من السر إلى العلن، أخذ فدائي حقبة السبعينيات يهتم بالمظاهر والتظاهر وإبراز العضلات والانشغال في أمور اجتماعية وما شابه، وتخلى نسبياً عن الأهداف الرئيسة أو أشغل بغيرها عنها.
تركت منظمة التحرير الفلسطينية بيروت مكرهة وخلفت وراءها شعباً ارتُكبت بحقه مجزرة مرعبة، وأوضاعاً فلسطينية مأساوية أدت إلى حرب بين الفلسطينيين أنفسهم هي حرب المخيمات التي استمرت ثلاثة أعوام تقريباً.
أصدر الياس خوري في هذه الأثناء مجموعة قصص “المبتدأ والخبر” ١٩٨٤ ورواية “رحلة غاندي الصغير”، وفي العام ١٩٩٣ أصدر روايته “مملكة الغرباء” وفيها كتب عن غرباء هذا العالم؛ كتب عن فئات اجتماعية في المجتمع اللبناني متعددة الجذور والديانات والأصول، من المسيح فالشركس إلى اليهود اللبنانيين والرهبان المسيحيين والمسيحيين فالفلسطينيين، وبدا أكثر هؤلاء -إن لم يكونوا كلهم- غرباء في هذا العالم، وهو ما يقوله عموماً العنوان.
كان حضور الفلسطينيين في الرواية لافتاً وبدوا مثل غيرهم، في لبنان، غرباء.
تحفل الرواية بشخصيات فلسطينية حقيقية لها تاريخها الشخصي الخاص وملامحها الفردية الخاصة أيضا مثل علي أبو طوق وأنيس صايغ ونبيلة سلباق وحنة شاهين.
استشهد علي أبو طوق في حرب المخيمات، وقتلت نبيلة، مع أنها مسيحية، لأنها فلسطينية، واستشهدت حنة إثر نسف مركز الأبحاث الفلسطيني حيث كانت موظفة هناك، وفيصل مات قبل أن تكتمل قصته هو الذي نجا من مجزرة شاتيلا التي قتلت فيها عائلته.
إن الموت غير الطبيعي هو مصير هؤلاء الفلسطينيين الأربعة، ولقد قتلوا بأيدي جهات مختلفة؛ بأيدي الكتائب -وقتل قسم من أهلهم بطائرات الإسرائيليين- وبمسدسات مقنعين أغلب الظن أنهم عنصريون من القوات اللبنانية، وبأيد فلسطينية تدعمها جهات لبنانية وربما سورية في أثناء حرب المخيمات.
فما هو التاريخ الشخصي لكل شخصية من هؤلاء؟
أول هذه الشخصيات شخصية علي أبو طوق وهو فلسطيني حقيقي من لحم ودم قاتل في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وكان قائد قواتها في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات. كان شجاعاً ومحبوباً، أحبه من عرفه ومنهم الطبيب اليوناني الذي مات علي بين يديه “كان هذا الرجل أقرب إنسان إلي . كنت وحدي في هذا المخيم المحاصر بالدمار والخوف. كنت وحدي، ولولاه لمت خوفا من الوحدة.”
وكانت تربطه بالراوي علاقة صداقة، فقد قضيا معا، في الخنادق والبرد والموت وتحت مطر القذائف، سنوات الحرب الأهلية، ثم افترقت خطاهما:
“علي تحول إلى فدائي في كتيبة “الجرمق”، وأنا صرت ما أنا. وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢، غاب علي في السفن اليونانية التي نقلت الفدائيين إلى منافيهم الجديدة. عام ١٩٨٤، بعد انتفاضة ٦ شباط، وانسحاب المارينز الأمريكيين، عاد إلى بيروت، بلحيته القصيرة، وعصاه، ليتحول إلى القائد العسكري لمخيم شاتيلا. عاد ليصير رجل الحصار، ثلاث سنوات من الحصار والدمار، والمخيم يضيق ببيوته المدمرة، حتى تحول إلى كمشة من البيوت التي يسند دمار واحدها دمار الآخر.
ومات علي”.
فيصل هو الفلسطيني الثاني الذي يحضر في الرواية، وفيصل كما ذكرت لاجئ فلسطيني من مخيم شاتيلا رأى المجزرة التي قتلت فيها عائلته ونجا بأعجوبة، مع أنه أصيب بثلاث رصاصات في خاصرته ويده.
يعيش فيصل، في المنفى، واقع اللجوء المأساوي ويظل يحلم بالعودة إلى فلسطين بلده الذي ظل أبوه يحدثه عنها الكثير وصار يحلم بأنه عاد إليها، وما كان يؤرقه هو مستقبل علاقته، بعد العودة، مع أصدقائه، فإن عاد كل إلى مدينته وقريته الأصلية فكيف سيجتمعون؟ ويقترح فيصل، أيضا في الحلم، على أصحابه أن يعمروا في فلسطين بلدا صغيرا “بلد أو قرية أو مخيم، شي زي شاتيلا يللي كنا عايشين فيه. رحت دغري أدور على أصحابي تقول لهم، تعالوا نعمر بلد بقلب فلسطين، تجمعنا مع بعض، وتكون زي المخيم، بس لحظتها فقت”.
ومثل علي أبو طوق فعندما رجع إلى شاتيلا ليقاتل في حرب المخيمات التي دامت ثلاث سنوات، وليعيش الحصار الطويل في مخيم شاتيلا، كان يبحث عن طريقة للذهاب إلى فلسطين. “فلسطين جاءته على شكل طلقة في الرأس ، وقبر في جامع”.
يتساءل الراوي وهو يحكي عن فيصل السؤال الآتي:
“- كيف أصفه ؟”
ويصفه على النحو الآتي، وأعتقد أن هذا الوصف ينطبق على فيصل في العام ١٩٨٢، وحين استشهد بعد خمس سنوات كان في السادسة عشرة:
“فتى في الحادية عشرة، أسمر مثل الفلسطينيين، أو كما نتخيل الفلسطينيين، يشبه هؤلاء الفتيان الذين يرمون الحجارة في شوارع غزة ونابلس. لكنه كان مهدما. هل سبق لكم أن رأيتم فتى مهدما؟ عادة نستخدم كلمة مهدم لنصف رجلا كهلا أصيب بكارثة. وأما هذا الفتى فكان مهدما ولم يكن يشبه الكهول. وجه أسمر ناصع، عينان صغيرتان ترقصان في الوجه، أنف مستقيم، شفة ممتلئة تتدلى، وكلام”.
ليس لحنة شاهين حضور لافت، فلا هي شخصية رئيسة ولا هي شخصية ثانوية بالمعنى المتعارف عليه لمفهوم الشخصيات في العمل الروائي، وما حدث معها حدث مع جموع عديدة من الشعب الفلسطيني والفرق بينها وبين الجموع يكمن في ذكر اسمها وفي كونها مثقفة عاملة. وكما أوردت سابقا فإنه يؤتى على ذكرها حين يقص السارد عما جرى لمركز الأبحاث الفلسطيني الذي نسف بسيارة مفخخة، وحول بعد الاجتياح الإسرائيلي عام ١٩٨٢ إلى مقبرة “فماتت حنة شاهين القادمة من “فسوطة” في الجليل، وصارت سعاد كسيحة، ودخل ثلاثون من العاملين فيه المستشفيات، وبقيت أشلاء الموتى في شارع “كولومباني” ثلاثة أيام قبل أن يأتي عمال التنظيفات ويرشوا الحي بالماء والمبيدات”.
وبعد السرد السابق يتساءل الراوي تساؤلاً افتراضياً حول علي لو كتبت له الحياة وعاش الكهولة وروى ذكرياته، فماذا سيروي؟
“هل سيجد متسعا في الذاكرة ليميز بين معارك أيلول ١٩٧٠ في الأردن، وبين حصار مخيم شاتيلا في بيروت عام ١٩٨٥؟”.
ثمة هجرة لا تنتهي يعيشها الفلسطينيون منذ ١٩٤٨ وثمة مجازر ترتكب بحقهم يتكرر حدوثها هنا وهناك.
هل يمكن أن نقول شيئاً مختلفاً عن الفلسطينية المسيحية نبيلة سلباق عما قلناه عن حنة شاهين؟
ليست نبيلة شخصية رئيسة أو حتى شخصية ثانوية، ولكنها صفيت على انفراد ولم تقتل قتلاً جماعياً.
في العام ١٩٦٢ كانت نبيلة في الصف الثانوي الخامس وكانت تروي للراوي وصحبه عن فلسطين، وقد أهدته كتابا لنقولا الدر عنوانه: “هكذا ضاعت وهكذا تعود”، وحين ينجح الراوي، وتنجح، في التوجيهي يزورها في منزلها في عين الرمانة” وهناك التقيت بشقيقتها الصغرى التي سحرني جمال عينيها”.
وفي العام ١٩٧٦ “دخلت الميليشيا الكتائبية المنزل في عين الرمانة، وكان فيه الأب والأم والأخت الصغرى الجميلة العينين، وقتلوهم. وجدت جثة الفتاة الصغيرة مختبئة قرب السرير، وهي مذبوحة بالبلطة.
وفي العام ١٩٨٦ وهي عائدة من عملها “اليونسيف” بسيارة أجرة، حيث كانت مسؤولة عن برامج المساعدات الإنسانية والطبية للمخيمات الفلسطينية، إلى بيتها في محلة “البربير”، أوقف ثلاثة مسلحين السيارة وأفرغوا في نبيلة بنادقهم الرشاشة. “أقول لك إنهم قتلوك لأنك فلسطينية” ولم يشفع لها كونها مسيحية.
هنا نسأل: من هو الراوي؟
الراوي هو دارس لبناني يدرس الحكاية الشعبية الفلسطينية في جامعة نيويورك، وكان التحق بالمقاومة الفلسطينية بعد هزبمة حزيران ١٩٦٧، وتعرف إلى الفلسطينيين وربطته بهم صداقة قبل العام ١٩٦٧. تقدم للتوجيهي في العام ١٩٦٦ وزار نبيلة سلباق في بيتها في عين الرمانة، وعمل أيضا في مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت، وأكثر المعلومات السابقة إن قابلناها بما قرأناه عن المؤلف الحقيقي -أي الياس خوري – تقول لنا إن هناك تطابقا بين المؤلفين؛ الحقيقي والضمني.
وإذا ما نظرنا في الشخصيات الروائية الأخرى؛ اللبنانية وغير اللبنانية واليهودية والمسيحية والشركسية، فإننا نلحظ أن الراوي لا يكتب عن غربة الفلسطينيين وحسب، بل عن غربة شخوصه كلهم، ولذلك اختار لروايته عنوانها “مملكة الغرباء” وكان أول الغرباء هو السيد المسيح، ولا يختلف عنه الراهب المسيحي في الرواية.
وعموماً فإن الياس خوري في روايته هذه لا ينتقد ممارسات الفدائيين وسلوكاتهم في لبنان، كما في روايته الأسبق “الوجوه البيضاء”، وتكاد صورة علي أبو طوق تقترب من صورة أبو جاسم في روايته المذكورة.
تنتهي الرواية في حديثها عن الفلسطينيين بعبارة لافتة لا بأس من تكرارها في نهاية هذه الكتابة وهي:
“هل هذه الأرض التي اسمها فلسطين هي مجرد حكاية تسحرنا بأسرارها وطلاسمها؟
ولماذا حين نستمع إلى هذه الحكاية لا ننام … بل نموت”.
هل كان غريباً أن تموت الشخصيات الفلسطينية الأربعة في الرواية، هذا إذا غضضنا النظر عن مجزرة صبرا وشاتيلا والموت الجماعي فيها.