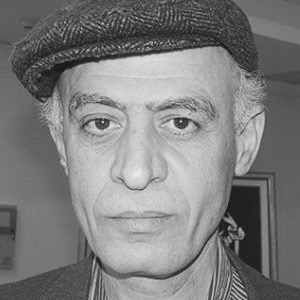من هو أول أديب فلسطيني أثار سؤال الهوية؟
أهو ابراهيم طوقان أم عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) أم سميرة عزام أم آخرون غير هؤلاء؟
هل كان هذا السؤال حاضراً في ذهن ابراهيم طوقان حين كتب “موطني”؟ وماذا عنى بهذا الدال؟ هل قصره على بقعة جغرافية محددة هي التي حددتها اتفاقية “سايكس-بيكو”؟
مات الشاعر في ١٩٤١، وكان يمعن النظر فيما حوله ويبصر وطناً في طريقه إلى الضياع. ولطالما حذر من ضياعه صارخا:
وطن يباع ويشترى
وتصيح فليحيا الوطن
لو كنت تبغي حفظه
لدفعت من دمك الثمن
وهناك من دفع دمه ليحافظ على وطنه، كما في قصيدة “الفدائي” الذي كان يتلظى حرقة على بلاد أحبها؛ لأن ركنها قد تهدما، فثمة خصوم ضجت ببغيهم الأرض والسما.
لم يهاجم طوقان الزعماء العرب، بل هاجم زعماء شعبه الذين انشغلوا بصراعات على المناصب، فضاع أكثر الوطن، ولم يبق من البلاد إلا أقلها، وستؤول البقية إلى الضياع إذا ما بقي الزعماء زعماء.
رحل الشاعر وهو يكتب عن بلاد فيها فدائي وسمسار وزعيم لا تهمه إلا الزعامة. لم يعش الشاعر حياة اللجوء وهكذا لم يكتب عن فلسطيني مشرد يعاني من الغربة خارج الوطن، بل ويعاني من الاضطهاد والتمييز. وهذا ما عاشه عبد الكريم الكرمي وعبر عنه في أكثر أشعاره. وسيغدو دال فلسطين في أشعار الكرمي حاضراً حضوراً لافتاً.
سيمر أبو سلمى بالتجربة ذاتها التي مر بها شعبه، وسيشعر بما يشعرون به من غربة واضطهاد.
ومع أن أبا سلمى عاش في دمشق التي عاملت اللاجئين الفلسطينيين معاملة أفضل من تلك التي عوملوا بها في لبنان، إلا أنه شعر بأن لا شفيع له يوم الحساب، وبأن دمشق التي استقبلته طالباً في بدايات القرن العشرين، أنكرته حين عاد إليها لاجئاً سيلحظ أبو سلمى اختلاف المعاملة وسيتساءل بمرارة:
اتنكرني دمشق وكان عهدي
بها ألا تلوح بالسراب
اتنكرني.. وفي قلبي سناها
وأعراف العروبة في اهابي؟
وإذا كان الشاعر اختار لديوانه الأول عنوان “المشرد” وأهداه في طبعته الأولى “إلى أخي المشرد تحت كل كوكب” (١٩٥٣) ثم” إلى أجمل واقدس وطن، وطني فلسطين ” (١٩٦٣) – في طبعته الثانية- فإنه عاد واختار اسم فلسطين لتحتل جزءاً من عنوان ديوانه الثاني” من فلسطين ريشتي” ليكتب عن فلسطين ، مواصلا ما كان بدأه في ديوانه الأول.
هل بدأ أبو سلمى يؤسس لهوية فلسطينية؟ وهل فلسطين في أشعاره هي فلسطين التي احتلت وظلت الأعين تتطلع إليها؟
تعد قصة “فلسطيني” من القصص المهمة التي أظهرت سؤال الهوية. لقد نظر إلى الفلسطيني على أنه غريب، ولهذا جهد، من استطاع، أن يتلبنن، حتى لا يظل الآخرون ينظرون إليه بارتياب وبعين الشك وبالرفض وعدم القبول.
سميرة عزام: سؤال الهوية
ربما تعزز سؤال الهوية وتوطد في قصة سميرة عزام “فلسطيني” من مجموعة “الساعة والإنسان”، فسميرة التي عاشت في لبنان شاهدت معاناة اللاجئين هناك ولاحظت أن من لم يتلبنن منهم غدا كالأرمني الذي عاش في الحي عشرات السنين دون أن ينادى باسمه ودون أن تعرف له ملامح. لقد غدا الفلسطيني فرداً في قطيع: فلسطيني.
هل اختار الفلسطيني فلسطينيته أم أنها فرضت عليه؟ وهل كان يؤثر الهوية الفلسطينية؟ هل كان يفضلها على الهوية العربية؛ اللبنانية أو الأردنية أو السورية، حتى يعيش حياة عادية طبيعية؟
ضاعت فلسطين وغدا اللجوء عبئاً على اللاجئ، وعبئاً على الأرض التي لجأ إليها وعلى شعبها.
ولكي يمارس الفلسطيني حياته العادية، إلى أن يعود، فإنه آثر الانخراط في الحياة العامة للبلد الذي لجأ إليه، فهل نجح في هذا؟
تعد قصة “فلسطيني” من القصص المهمة التي أظهرت سؤال الهوية. لقد نظر إلى الفلسطيني على أنه غريب، ولهذا جهد، من استطاع، أن يتلبنن، حتى لا يظل الآخرون ينظرون إليه بارتياب وبعين الشك وبالرفض وعدم القبول.
ثمة في قصة ” فلسطيني” دالان مهمان: فلسطيني وأن يتلبنن. اختيرت مفردة فلسطيني لتكون عنواناً للقصة، بل وتكررت فيها، وأما جملة “أن يتلبنن” فإنها تعني هنا هوية أخرى على الفلسطيني أن يسعى وراءها حتى يتخلص من ذل اللجوء ويمارس حياة عادية. يهرب الفلسطيني من فلسطينيته، لأنها غدت عبئاً عليه. إنها تسبب له العزلة والحصار والاحتقار والاستصغار، وهي كلمة لم يختلف مدلولها إلا بعد حزيران ١٩٦٧ حين قويت الثورة الفلسطينية واشتد عودها.
في السؤال عن الهوية في الأدب الفلسطيني يجدر التوقف أمام أبي سلمى وسميرة عزام قبل غيرهما.