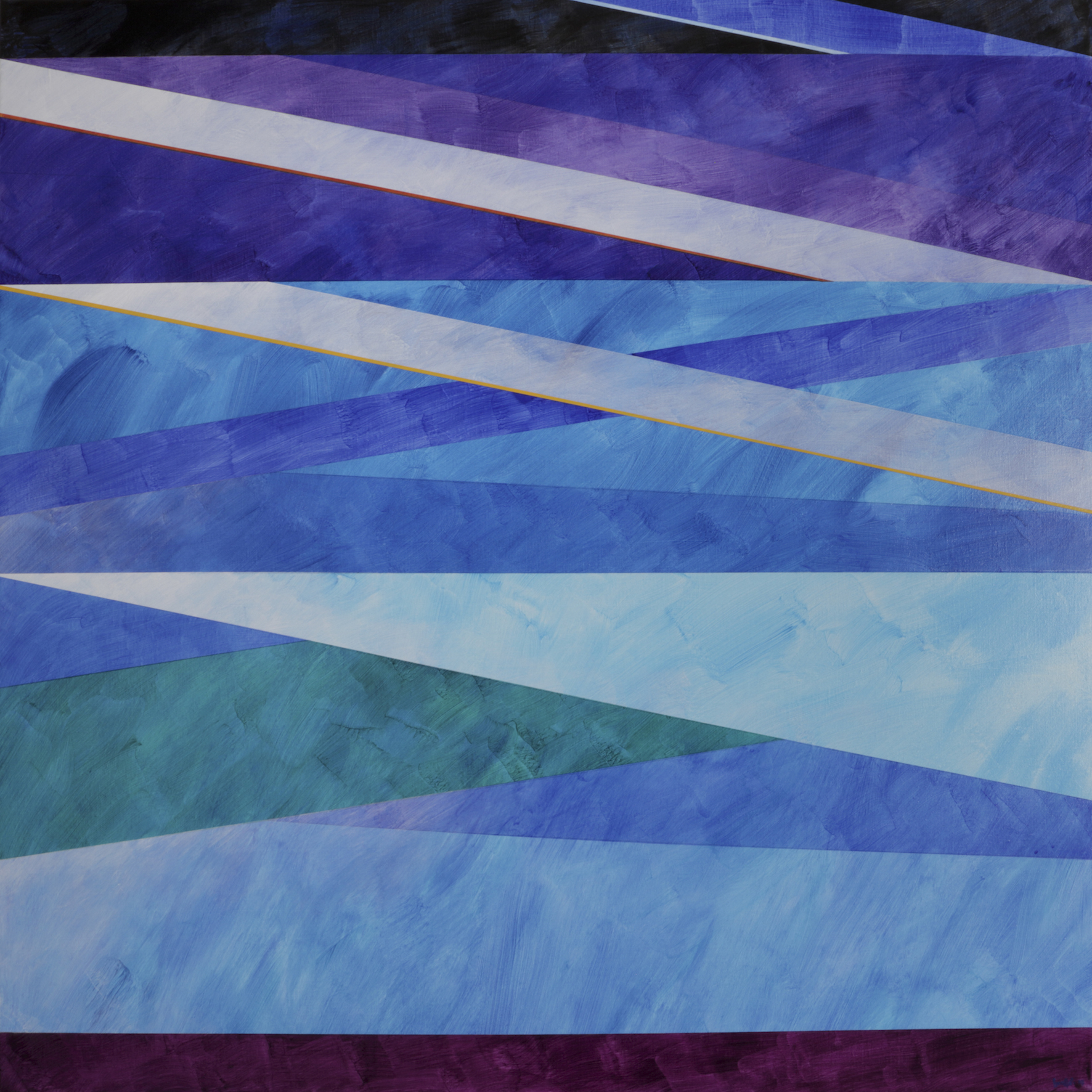تتكرر ملاحظات على تضمين الدولة الواحدة تعبير علمانية، ويكمن خلف ذلك أسباب متعددة، يمكن حصرها في اثنين، الأول يشير إلى الوعي الشعبي، والموقف من العلمانية، حيث هناك نفور ورفض لها، والثاني ينطلق من أن هدف الدولة الواحدة يضم فئات أوسع، وتجري الإشارة هنا إلى “الإسلاميين” الذين لا يقبلون العلمانية بينما يقبلون الدولة الواحدة. لهذا تجري الدعوة إلى دولة ديمقراطية واحدة تجاوزاً للإشكالين، أو الالتباسين.
بالتأكيد أنه كلما جرّدنا الهدف أكثر سيبدو أنه قادر على جمع عدد أكبر. لكن هذا يعتمد على الفئات المنظور إليها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون موافقاً للصراع الواقعي. فهذا التجريد (أو تعميم الهدف) ينطلق من النظر إلى السياسة، وبالتالي يتلمس الهدف الأعم الذي يجمع العدد الأكبر، فالدولة الواحدة تجمع تيارات متعددة بما فيها “الإسلاميين”، وهذا يعني “تشكيل جبهة واسعة”. لكن ذلك يهمّش الاختلافات الأخرى، رغم أهميتها، وتأثير تهميشها على الفئات التي يجب أن تحملها. وعندما يكون طرف منها طارحاً بديلاً يصبح هو مركز الاستقطاب. هنا يمكن الإشارة إلى “الإسلاميين” الذين يطرحون الدولة الإسلامية كبديل، بينما لا يجب على العلمانيين أن يطرحوا الدولة العلمانية، تحت عنوان “الجبهة الواسعة”، الأمر الذي يخدم “الإسلاميين” حتماً.
في هذا إشكال تاريخي يتعلق بفهم معنى الجبهة، حيث تعني أن يقزّم طرف برنامجه لكي يناسب التحالف. وهو بذلك يخسر كل إمكانية لأن يصبح ذا قاعدة شعبية، بينما يكسب الطرف الذي يعلن بديله. لهذا كان اليسار يسير غالباً في ذيل اليمين، ويتلبّس برنامجاً لا يعبّر عن الطبقة التي يدعي أنه يعمل على تمثيلها، الأمر الذي يفقده كل إمكانية لتنظيمها بالضبط لأنها ستنفضّ عنه، وحيث يسهّل على ضوء هذا التحالف تغلغل وعي تيار آخر فيها. فالتحالف، أي تحالف، إذا كان ضرورياً يجب أن يرافقه صراع أيديولوجي ضد الأفكار التي يطرحها الطرف الآخر في التحالف. وأساساً يجب أن يكون الطرف المعني بالتحالف ممتلكاً رؤية وبنية فكرية، ووضوح في الموقف من التيارات الأخرى، التي هي بالضرورة تعبّر عن طبقات مصالحها مختلفة تماماً من مصالح الطبقة التي يعبّر عنها هو. بمعنى أن “اليسار” يجب أن يكون واضح الرؤية، ومتماسك البنية الفكرية، ولديه القدرة النقدية لكشف زيف أيديولوجية الطبقات الأخرى. وحين يضطرّ إلى التحالف معها يجب أن يزيد النقد لا أن يوقفه.
الآن، “الإسلاميون” يطرحون بديلهم بشكل واضح، وعلى التيارات الأخرى أن تطرح بديلها بشكل واضح. لا أن تجبجب وتخفت الصوت، وتوقف النقد والصراع الفكري بحجة الخوف على التحالف، أو خشية رفض التحالف. فأصلاً التحالف ليس اختياراً ذاتياً، بل أنه نتاج صراع واقعي في لحظة يفرض التنسيق بين أطراف تخوضه رغم اختلافها، وحتى تناقضها أحياناً. هو ممارسة لا يجب أن توقف تنظير الواقع، وطرح الأيديولوجية المعبّرة عن “اليسار”. وكذلك لا توقف النقد والصراع الفكري، بل يجب أن تزيد هذا الصراع خشية تسرّب وعيها إلى ”بنيتنا”.
بالتالي سيكون الانطلاق من هدف الدولة الواحدة، هكذا حاف، تجريد فارغ يخدم “الإسلاميين”، و”المحافظين”، وكل الذين يرفضون البديل الحقيقي. وهدف العلمانية هو تعبير عن هدف تيار يجب أن ينشأ، لأنها بديل ضروري في مستوى بنية الدولة الجديدة. وإذا كان هناك ضرورة للتحالف فتطرح بعد إذ، ودون التخلي عن هذا الهدف، رغم أن منظور التحالف وتشكيل الجبهات يحتاج إلى مراجعة جذرية لأن ما كان يمارس لم يكن تحالفاً بل استتباعاً، وتبعية. فهو خطوة يتوافق عليها طرفان وهما يتصارعان. وهي خطوة، بمعنى ممارسة تخص مسألة عملية ولا تتعلق بالأفكار والمنظورات والخيارات.
هنا، لا يجب التحجج بالحاجة إلى ضم تيارات ترفض العلمانية، لأن في ذلك تجريد من هوية لطرف، دون تجريد الطرف الآخر من هويته. فالإسلامي يريد الدولة الواحدة، لكنه يريدها إسلامية. من ثم يجب أن يكون للدولة الواحدة هوية نطرحها نحن. وأصلاً إن ما نهدف إليه هو ليس تيارات سياسية، بل نهدف إلى كسب فئات شعبية، كسب طبقات شعبية. هنا يُطرح السبب الآخر، أي الذي ينطلق من رفض الوعي الشعبي للعلمانية. من قال ذلك؟ وهل الشعب يعرف معنى العلمانية؟ لا شك في أن التيارات “الإسلامية” صارعت ضد العلمانية وربطتها بالإلحاد، وربما أقنعت فئات شعبية ذلك. لكن أليس دورنا أن نخوض الصراع الأيديولوجي ضد التيارات “الإسلامية” ذاتها بالأساس، وبالتالي أن نشرح معنى العلمانية للفئات الشعبية؟ ليس لدى الفئات الشعبية تعصباً أصولياً، بل إن ما لديها هو وعي شعبي يحمل قيماً “تقليدية”. وفي حدود ذلك لا يعرف العلمانية، وبالتالي ليس لديها موقف منها. فقط ينشأ الموقف نتيجة تحريض التيارات “الإسلامية” (الإسلام السياسي، وإسلام النظم) كجزء من صراعها ضد التطور والحداثة، وتغيير البنى القائمة. ومع هذه التيارات نحن في حالة صراع طبقي وأيديولوجي أصلاً، لأنها تطرح ما يخدم السيطرة الرأسمالية، وإنْ كانت تلفّ ذلك في إهاب “إسلامي”. وبهذا يكون فضح منطقها المناهض للعلمانية جزءاً من هذا الصراع، وكشفاً لتناقض مصالحها مع مصالح الطبقات الشعبية.
لقد قبلت فئات شعبية ليست قليلة (بل يمكن أن أقول واسعة) الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية، بالضبط لأن الأحزاب الشيوعية طرحت مطالب الطبقات الشعبية، في مرحلة كانت الوعي التقليدي أكثر رسوخاً من الآن. وبالتالي لن يكون صعباً أن تقبل العلمنة حين توضع في سياق برنامجي يحقق مصالحها. وحين يكون هناك قدرة على فهم العلمانية، وعلى توضيحها بما هي. فهي ليست ضد الدين، بل تفصل الدين عن الدولة، وتقرر احترام الدولة لكل المعتقدات بما فيها المعتقد الديني. بمعنى أنها تمنع التدخل في معتقد المتدين ما دام لا يطرح الدين كمشروع مجتمعي. وهذا هو سرّ صراع الإسلام السياسي مع العلمانية، بالضبط لأنه يطرح مشروعاً مجتمعياً يخدم مصالح طبقة تجارية، وحتى مافياوية. فهو يرفض تغيير النمط الاقتصادي القائم لأنه يريد الحفاظ على سيطرة الرأسمال، التجاري والريعي والمافياوي، وليس معنياً بالحل الجذري لمشاكل الفقر والبطالة والتهميش.
بالتالي يجب القول أن المسألة لا تتعلق بهذين السببين بل تتعلق بالنخب التي تسكنها المحافظة، وبالتالي ترفض العلمانية هي. أو التي لم تفهم معنى العلمانية وموقعها في التطور التاريخي للشعوب، ولهذا لا تستطيع الدفاع عنها وإقناع الفئات الشعبية بضرورتها، والحاجة الماسّة إليها. هنا يكمن جوهر الأمر بغض النظر عن أي تبرير أو سبب. الوعي “المفوت” (كما أسماه ياسين الحافظ) لا زال هو المسيطر، والمحافظة لا زالت تسكن العقل، وإنْ تغطى كل ذلك بكلمات ومصطلحات حداثية. الحداثة التي تفترض العلمنة ومبدأ المواطنة، لا زالت بعيدة عن الوعي الرائج، ولهذا يجري تجاهل كل قيم الحداثة. بالتالي فإن هذا الوعي هو الذي يحتاج إلى صراع حقيقي، وتفكيك، لأنه يكرّس البنى القائمة.
ليس طرح العلمانية مسألة تتعلق بالتميّز، بل هي جزء جوهري في بناء مشروع بديل يمكنه الانتصار. لا يتعلق ذلك في فلسطين فقط، رغم حساسية الوضع نتيجة وجود “دولة يهودية”، وتكتيل بشر من قوميات متعددة على أساس الدين، بل هو البديل الضروري في كل مشروع يهدف إلى التحرر والاستقلال والتطور، حيث أن العلمنة في صلب ذلك. لهذا بات أمراً ملحاً طرحها، وتوضيحها، وتحديد سبب ضرورتها. ولا شك في أن سيطرة الإسلام السياسي على بعض النظم، ودور تيارات سلفية وجهادية” قد دفع إلى حدّ التطرف المقابل، أي الإلحاد، كما يظهر ذلك عند قطاعات من الشباب الذي يعتبر أن الحرب ضد الدين هي حربه الراهنة، وهو بذلك يهرب من معركة الواقع إلى معركة السماء. وبهذا لن يستطيع الحسم لأنها معركة تقوم على الوهم. فالمعركة في الواقع بهدف تغييره.