“إن المقاومة الفلسطينية كانت إحدى المبادئ الأساسية في تاريخنا وتصوراتنا وقد أنتجت الطاقة والإبداع والحياة وأثبت الفلسطينيون أنهم أقوى من الاحتلال بما يملكون من أرض وشعب وتاريخ.” بهذه الكلمات خاطب الطبيب الجراح والروائي السوري خليل النعيمي، الحاصل على جائزة محمود درويش للحرية والإبداع 2018، الحاضرين في مقر جمعية نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، مؤكداً بعد تبرعه بقيمة الجائزة (25 ألف دولار) للنادي، أن “المعتقلين الفلسطينيين هم أبهى صور هذا النضال الفلسطيني للتمرد على المصير وإنهاء الاحتلال.”
التقينا بصاحب «قصاص الأثر» للحديث معه حول ما عنى له حصوله هذا العام على جائزة تحمل اسم الشاعر الفلسطيني الراحل، فكان هذا الحوار:
بداية ماذا عنى لك حصولك على جائزة محمود درويش للإبداع 2018؟
كنتُ سعيداً، أنا الذي أنشُطُ ضد الجوائز الأدبية العربية لأسباب كثيرة، أن أُختار لجائزة فلسطينية، تحمل اسم محمود درويش. ولهذه السعادة أيضاً أسباب كثيرة. مكانة محمود درويش في نفسي وفي قلبي، أولاً. والمكان الأسطورة التي تُعطى فيه الجائزة: رام الله، ثانياً: هل تعرف ماذا تعني “رام الله”، لعربي محروم من بلده منذ أكثر من ثلاثين عاماً؟
لا أتصوّر أن أحداً يحس بإحساس مثل هذا إلاّ مَنْ كابَد مثلي فَقدْ المكان الأول الذي تكَوّن فيه. أنا لم أذهب إلى “أيّ مكان” لأستلم الجائزة. ذهبتُ إلى الأرض التي مشى فوقها يسوع الناصري. وقبّلت البقعة التي ولد فيها في “بيت لحم”. واجتزت الأغوار الأسطوريّة. وباجتيازي الآسر لهذه الأمكنة التي لا تُنسى أدركت لماذا يصرّ الصهاينة على ابتلاع هذه الأرض التي لا مثيل لها. ثمّة ما لا يُقاوَم في هذه الجائزة، خارج نطاق القيمة المادية، وبعيداً عن الإشهار. أنت تعرف أن الجوائز ليست بقيمتها المادية، وإنما بالمكانة التاريخية لمن يعطيها. فنحن لا نغدو أثرياء بالمنحة، وإنما بالموهبة.

ما معنى أن يكون هناك جائزة فلسطينية عالمية باسم الشاعر الراحل محمود درويش؟
محمود درويش شاعر تاريخيّ. له مواقف ذات بعد إنساني عميق. ومقامه في الشعر العربي المعاصر عالٍ. فهو لم يكن عابراً. لقد ساهم بشكل فعّال في نضال الشعب الفلسطيني الذي يعدّ نضالاً أساسياً في سياق الحركات الإنسانية التقدمية في العصر الحديث. وهذا النضال المستمر منذ عقود هو الذي أنقذ العالم العربي القَنوع من السكون والمهادنة. إذ وَجَد العرب أنفسهم مضطرين لمقاومة الاستيلاء الصهيوني على أرض فلسطين بالرغم من بعضهم، ومع قبول بعضهم الآخر الخفيّ ولكن المعروف. ولولا هذا النضال المجيد لظل العرب القانعين بوضعهم المزري، والخارجين للتوّ من الإمبراطورية العثمانية، قابعين في سبات العصور الوسطى دون أن يواجهوا مصيرهم البائس، أو الذي يبدو لنا الآن كذلك. و”ما يبدو لنا الآن كذلك” هو الذي يقول لنا الحقيقة. وفي النهاية، محمود درويش بإبداعه المميّز سلوكاً وشعراً ونثراً، وتَوْقه للحرية وللحياة، يستحق، بلا ريب، أن يكون له جائزة تحمل اسمه، وتكرّم ذكراه.
تبرعت بالقيمة المادية للجائزة (25000 دولار) لنادي الأسير الفلسطيني. لماذا هذه الجهة تحديداً، وما هي دلالات ذلك بالنسبة لك؟
أن أتبرّع بالقيمة المادية للجائزة لـجمعية “نادي الأسير الفلسطيني” هو أقلّ ما كان لي أن أفعله، اعترافاً عميقاً مني بالدور الكبير الذي يقوم به “الأسرى الأحرار” في مواجهة العنف الصهيوني. فهم الدليل الصارخ على أن حيوية الشعب الفلسطيني الخلاّقة لن يقهرها العنف، ولن تتوقف عن التمرد على ظروفها القاسية، وستظل تُبدع الأوضاع المناهضة للاستيطان القسري إلى أن تحقق ما تريده.
الجوائز الأدبية التي ترى أنها “تنتشر كالفطر السامّ على أرض الثقافة العربية”، تدفعني لسؤالك عن رأيك بالضجة التي تثار حولها كل عام، وهل هي فعلاً “معول هدم” أم هي -كما يرى كتّاب آخرون- حجر بناء للإبداع والابتكار بالنسبة للكاتب؟
الإبداع ليس جائزة. إنه موقف في الحياة وسلوك. والجوائز الأدبية العربية من هذا المنظور خارج إطار الإبداع. إنها “جوائز سلطة” أيّاً كانت الجهة التي تمنحها، وأياً كانت اللجان التي تشرف عليها، بدءاً بجوائز الدول التقديرية، وانتهاءً بجوائز بلدان الخليج المستحدثة لأغراض الدعاية والإشهار. وأنت لا تجهل أن إحدى هذه الجوائز المتبَهْوِرة صارت تدّعي بأنها “عالمية”، فقط بسبب “تزاوجها الاسميّ” الذي اشترته بالمال من جائزة أخرى باعتْه بثمن باهظ ولا بد. لكأننا لا زلنا في العصور الوسطى عندما كان الأثرياء يتزوّجون من أمراء موشكين على الإفلاس ليحصلوا على لقب الإمارة الفارغ. لكن الإبداع لا ينتقل بالإرث، ولا بالزواج، ولا يمكن شراؤه. وإضافة صفة “العالمية” إلى جائزة محلية معروفة المصدر والمحتوى، مدعاة للسخرية أكثر منها للفخر. أهمية الجوائز تمكن في فتح الباب للتحرر والإبداع والتغيير، والجوائز العربية بحكم مصادر تمويلها، والبيئة التي نشأتْ فيها، تقوم على العكس بلَجْم الإبداع، وابتذال الفكر، وتحجيم التمرّد، وتعميم الإنصياع، مهما كانت الألاعيب الشكلية التي يحاولها المتسابقون، والمشرفون عليها، ولجانها المدفوعة الثمن والمسَيّرَة. وعلى العكس مما يعتقد أهل الجوائز العربية، لا أحد يجهل الدور الخطير واللامبدع، إنْ لم يكن المتخلّف كثيراً عن روح العصر، الذي تلعبه “جوائزنا الثمينة”.
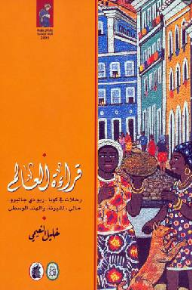
أنت طبيب جراح، درست الفلسفة في السوربون، ما الذي جاء بك إلى أرض الكتابة؟
الكتابة والجراحة كلاهما نشاط حيويّ مرموق. ويمكن اعتبارهما قنوات إنسانية تصب في محيط الكائن. وبالتأكيد فهما مصدرا غنى نفسي وأخلاقي ومعرفيّ كبير عندما مَنْ يمارسهما. وللجراحة، بالخصوص دور في الاستقلال المادي الذي يجعل الفكر منفتحاً، ويحرر الكائن من أعباء الإلتجاء إلى “استيعاب محتَمَل” من أجل “لقمة العيش”. وتلك ميزة، أو حظ كبير، إذا شئنا، دون أن تكون “حكم قيمة” تجاه الآخرين. إنه الظرف التاريخي المناسب الذي صدف وكنتُ فيه بكامل عاطفتي وعقلي ولا تنْسَ، إضافة إلى ذلك، أنني درست الطب والعلوم في جامعة دمشق بالعربية. وهذا أكبر فضل لهذه الجامعة عليّ. والكُتّاب العرب، في الغالب، لم يدرسوا إلا الأدب، أو ما يماثله، وهو ما يعني أن “لغتهم عَرْجاء” تمشي على قَدَم واحدة، دون بُعْد علميّ. وهو ما قد يشرح اللّغْو الكثير في كتاباتهم.
كيف ترى مغامرة الكتابة التي منحتك العديد من الروايات ونصوص أدب الرحلة؟
أرى أن الكتابة فعلاً مغامرة إنسانية. لكنها تستحق العناء. الكاتب لا يعرف غالباً سبب “مجيئه إلى الكتابة” كما تقول أنت. من جهتي كان البدء منذ أن كنت طالباً في ثانوية “الحسكة”، وقد كانت هي الثانوية الوحيدة في محافظة الجزيرة السورية. في هذه الأثناء كنتُ شاعراً. وفي “دمشق” أثناء دراستي الجامعية صرتُ روائياً، وفي “باريس”، من بعد، كتبتُ «موت الشِعْر». لماذا كل هذا التبدّل والتغيّر والانحياز؟ إسأل الحياة. الحياة هي التي تعطي الكائن وعيه الإبداعي، وتنقله من طور إلى طور. وهي التي تبتذل الكائن كذلك. لا شيء يوجد في عراء الوجود. كل ما نتمتّع به، أو نتحلّى به، أو نفتقده، أو نتخلّى عنه، يأتي بقوة الحياة عندما نمتلك الوعي المناسب الذي يؤهلنا لأن نتطوّر. ويذهب بقوتها، أيضاً، عندما نظلّ بُلَداء. هذا من حيث درب المجيء أو اللامجيء، الذي يسلكه المرء نحو الإبداع. لكن هذا المسلك مجرد حكاية باهتة. الأمر الذي أراه أنا أساسياً هو أية “انقلابات جوهرية في الوجود” نكتسبتها خلال تحوّلات الحياة التي نعانيها، أو نعيشها، وأية حوافز أو مناقب نتبَنّاها، أو نتخلّى عنها؟ وما هو دور الكتابة في تشْذيب فكرنا، وتحفيز وعينا؟ هناك الكثير الذي يمكن أن يُقال. ولكن، مَنْ يملك حق القول؟
إلى أي مدى كانت السيرة الذاتية حاضرة في كتاباتك؟ وكيف تختار عناوين أعمالك، وبالتالي هل يكون العنوان هو المدخل للنصّ عندك؟
كل ما أكتبه هو نوع من السيرة الذاتية. ولستُ الوحيد في هذا. كل الكتّاب، أو أغلبهم يعانون من تسلط السيرة الذاتية على الإبداع. المشكلة، إذن، كيف يستطيع الكاتب أن يلعب بالسيرة الذاتية لتغدو سيرة اجتماعية؟ وبأية طريقة مبدعة يتحوّل الكاتب من “البُعْد الذاتي إلى البُعْد الموضوعي” كما كتب ذات يوم محمود أمين العالم، المفكر والناقد الكبير؟ وخارج هذا السياق يصبح القول مجرد اعترافات مبتذلة.

لك رؤية خاصّة تجاه ما يحدث في بلدك منذ أكثر من سبع سنوات، كيف تقرأ الوضع الحاضر، وما الذي تراه في الأفق، وهنا أسأل عن دور للكاتب في استشراف المستقبل من خلال تجربتك الذاتية؟
الكاتب ليس متنبّئاً، ولا هو عرّاف المدائن. ومن هذه النقطة لا يمكن له أن يستشرف الأوضاع، وبخاصة تلك التي لا يشارك فيها فيزيائياً، أقصد بشكل مباشر وفعّال. يبقى أننا في العالم العربي نحب التنبّؤ والاستشراف والتخيّل والتَكَذّب والزَعْم، وهذه كلها لا علاقة بالأدب والكتابة. ويمكن لأي سياسيّ أحمق أن يمارسها بشكل أفضل من كاتب متهوّر. لكن ذلك لا يعنى ألاّ يكون للكاتب موقف ممّا يحدث في محيطه. على العكس، الشأن الوحيد الذي يقع ضمن حقل إبداعه هو الاهتمام الحميمي بمشاكل المحيط الذي يعيش فيه، أو الذي يعنيه أمره حتى ولو كان بعيداً عنه.
يُشار إلى أن خليل النعيمي روائي سوري يشتغل في مجالات متعددة، فإلى جانب عمله كجرّاح في أحد المستشفيات الباريسية يمارس الكتابة في مجالات متعددة، من بينها الرواية وكتابة الرحلات والنقد، أحياناً.
وُلد النعيمي في بادية الشام، وعاش طفولته وصباه مترحلاً مع قبيلته في سهوب البادية السورية. درس الطب والفلسفة في دمشق، وفي باريس تخصص في الجراحة، ودرس الفلسفة المقارنة. يقيم في باريس منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث يعمل طبيباً، وهو أيضاً عضو الجمعية الجراحية الفرنسية، ومتزوج من الروائية السورية سلوى النعيمي. وهو معنيّ بالمكان وسرد تفاصيله من خلال مجموعة من الأعمال السردية منها: «قصاص الأثر»، و«الرجل الذي يأكل نفسه»، و«الشيء والقطيعة»، و«تفريغ الكائن»، و«مديح الهرب»، و«دمشق ٦٧»، وله أيضاً مؤلفات في أدب الرحلة مثل: «قراءة العالم»، و«من نواكشط إلى استنبول، مخيلة الأمكنة»، و«كتاب الهند: الحج إلى هاري-دورا»، و«الطريق إلى قونية».







