تحملنا رواية «الضفة الثالثة لنهر الأردن» للشاعر الفلسطيني الراحل حسين البرغوثي (1954-2002) على التساؤل حيال طبيعة الضفة التي قصدها؛ إذ تستطيع العبقرية ابتكار مفاهيم خاصّة بها؛ بوسع الشاعر أن يَصطلحَ مكان إقامة حبيبتهِ بــالجهة خامسة. والنهر الذي نعرف له ضفتان، بوسِعهِ أن يصطلحَ له ضفة ثالثة.
تُجمِع كثيرٌ من القراءات على اعتبار الضفة الثالثة التي يعنيها البرغوثي، هي الغربة. وهذا رأي لهُ جدارتهُ، لا سيما أنّ الكتاب جزءٌ من سيرته عن فترة دراسته في هنغاريا؛ حيثُ يذكر أماكن عاش فيها، وأشخاص خاض معهم تجارب عديدة. حتى أنّ الرواية برمتها، رسالة إلى حبيبتهِ “دانا”، وهي فتاة مضت إلى مصيرها، فيما انتهت سيرة البرغوثي في السجن، بما لذلك من رمزية.
لدى الشّاعر الفلسطيني كلّ ما يصنع فرادة المنفى، وأكثر ما يصنع تلك الفرادة هي وطنه؛ الفردوس المفقود، الذي تسبّب فقدانهُ بشتاتٍ مترامٍ. فلسطين بلدٌ محتل، يصارع أبناؤه من أجل حق العيش والتنقّل، وتشير رواية السيرة الصادرة في الطبعة الأولى سنة 1984 (صدرت بطبعة جديدة عن الدار الأهلية في عمّان، ٢٠١٧) إلى ما يخصُّ الأفراد، لا في شؤون نجاتهم، فهذهِ متعذرة تعذّر الوطن. وإنّما في التشرّد، في الابتعاد الذي لا يلبثُ أن يصير قيوداً صلبةً غير مرئية، تربطهم بالأرض الأولى، وبالنسبة إلى الفلسطيني، إلى الأرض الضائعة المحتلة. بذلك في الوقت الذي تصيرُ فيهِ كلّ أرضٍ احتمال انتماء، يُعلَّق الفلسطيني إلى انتماءٍ ينازعهُ الفراغ. إنّه معلّق إلى مكان، أكثر ما يكون حرّاً بالتعاطي معهُ، في الذاكرة. وهو بذلك شخص لا يريدُ، ولا يستطيع أن ينسى.
يرى مدنهُ، كأنّها مدنٌ لا يعرفها. إذ إنّه حبيسُ واقعين؛ أحدهما يطلقهُ إلى العالم، والآخر يقيدهُ بسلاسلِ الحنين إلى أرضٍ لم تعد موجودة، وفقَ تصوّرهِ لها، سوى في ذاكرتهِ. ماذا بوسعِ شاعرٍ، وهو يفكّرُ في غربتهِ، حيال مكان يستطيعُ فيهِ أن يكون حرّاً وأن يعيش كما لأيّ إنسان آخر أن يعيش وأن يحبّ ويتأمّل وينجح في دراستهِ وأعمالهِ. ماذا بوسعِه، وهو يبحث عن مكان يستطيع عبرهُ أن يقول إنّه ضائعٌ يبحثُ عن فردوسٍ مفقود. ماذا بوسعهِ أن يفعل سوى أن يتيح لعبقرية الشعر في كتابٍ سردي، بأن تقدّم لهُ وطناً لا يُنتَزع، ولا يجاريهُ أحدٌ فيهِ، إنّ الضفة الثالثة التي وصل إليها الشاعر؛ هي اللغة.
وفرادةُ الكتاب، لا التجربة التي يحكي عنها، ولا المقولات التي تُعنَى بأن تجعل الحياة أكثر بساطة بالنسبة إلى من لا يملك من أمرهِ شيئاً، لكنّ الفرادة التي يقع عليها كتاب البرغوثي هي سيلهُ المتدّفق العذب، الذي يضمّ فنوناً كثيرة إلى ضفافهِ البليغة، فالرواية أشبه بشريط سينمائي لمشهدٍ واحدٍ طويل، يدورُ الشريط ويدور، يمتدُ العرض ويشمل صور الغربة العميقة عن المكان وعن الذات. لكن أيشكلُ فرقاً بالفعل، أن تكون الضفة الثالثة هي اللغة لا الغربة؟
الغربة قد تصير وطناً بديلاً، لكنّ اللغة تحفر عميقاً في الوطن الأم؛ تبحثُ عنه، تناديهِ، تنشد عودته، وتعيدُ ابتكارهُ، مثل من يستعيدُ حقاً. بذلك فالبرغوثي يستجير باللغة، وقد استنزف ممكناتها، حتى لا يفقد صورةَ بلده، إنّه يكتبُ عن بلدٍ، يفترضهُ، كي لا يصير منسيّاً، كما في هذا المقطع: “وصلتُ حيفا، مدينة لم أرها في حياتي. شوارعها الخالية أذكرها جيداً والأوراق المرمية في الساحات أذكرها جيداً ولكن لا أعرف المدينة ولا الشارع ولا البيوت. أزقة مضيئة بمصابيح صفراء من القلق في ساحات تتفرّغ منها الأزقة مثل متاهات صمّمها مهندس خاص لمشردين من نوع خاص”
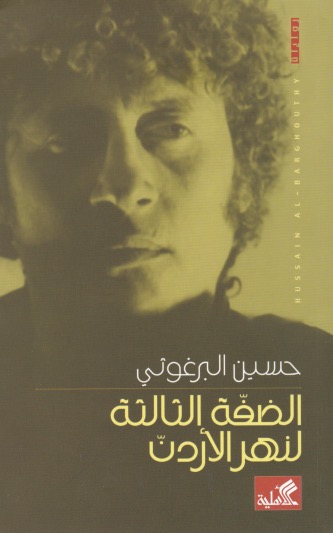
ليسَ مثل اللغة وطناً للهاربين، للذين يشتكون غياب المستقبل وفرار الماضي، وهم عرضة للطرد والاعتقال والتفتيش. وما يلبثُ العالم الذي يعيشون فيهِ أن يتحوّل إلى مجرد ذكرى لقصص مبتورة، لإقامات غير آمنة، وتشرّد غير منتهٍ بين البلدان، كما لا يلبثُ العالم الداخلي يعبرُ بهم متاهات الوحدة والخوف والحنين والحبّ القصيّ. مسوّغات كثيرة للشخصيات التي رافقت حياة البرغوثي، تجعلُ اللغة هي الضفة الثالثة التي كان يرومها دائماً. لا لتمكّنهِ وحساسيته اللغوية، وإنّما لأنّه يتحدّث عن أناسٍ لم يتح لهم أن يعثروا على أنفسهم في غمرة البحثِ عن أوطان رحيمة. تبتكرُ لغة البرغوثي مفاهيمها، ويحمل السرد فكرهُ الخاص، ومهما بدا الواقع ملحاً إلا أنّ الشاعر أبقى على تحفظاتهِ، وفكر في حلولٍ حملها إلى متتالية، تكادُ تنشقّ عنها اللغة، تولّدها، بقدر ما يولّدها الواقع، هنا يتحدّث عن الثورة في متتالية تنجبها لغة متداعية سببية: “الشرط الأول للتقدم هو أن نتقزّز من أنفسنا حتى نهرب منها! مسألة بسيطة! العالم الثالث يعبد أوروبا وأوروبا تعبد أمريكا وأمريكا لا تعبد شيئاً ما عدا حرباً عالمية ثالثة. فلنحوّل عقد النقص إلى تقزّز والتقزّز إلى ثورة والثورة إلى احترام الذات”.
في سعيه الحثيث الذي ينتهي بهِ غريباً بين ناسٍ غرباء في شوارع يألفها، بدا البرغوثي وكأنّه يختبر مجدداً اغترابهُ. يقول “لكلّ شعب فردوسه المفقود الخاص به، ولكلّ واحد منا فردوسه المفقود الخاص بهِ، ولكلّ فردوسٍ أساطيره الخاصة” وما إن نعرف أنّ الرواية رسالة إلى حبيبةٍ غائبة، ندرك أنّ الفردوس المفقود؛ هو الحبّ. والأسطورة التي لجأ إليها للتعبير؛ هي اللغة. الوطن ليس غائباً البتّة، غير أنّه ينوس بين هاتين القيمتين، يَشغلُ هذين الفضاءين مهدوراً ومستحيلاً.






