كتبها إدوارد ثورنتون في aeon ونشرت في الأول من مارس ٢٠١٨.
في صيف عام 1969 في فرنسا، كان ثمّة محلّل نفسيّ راديكاليّ في طريقه للقاء فيلسوف شهير، وبعد القيادة لمدّة ثلاث ساعات جنوبًا إلى منطقة “ليموزين” المشهورة بغاباتها ومزارع الماشية، وجد الرجل طريده متمدّدًا في السرير، حيث كان يتعافى من جراحة لإزالة الرئة السلّيّة.
ذاك كان لقاء المعالج النفسيّ العُصابيّ والاجتماعيّ فيليكس غواتاري، بالأستاذ المتوحّد في عزلته جيل دولوز. وفي ذاك اللقاء كان تآلفهُما فوريًّا، وسيُصبحان صديقين مدى الحياة، وشريكين فكريًّا ومؤلّفين لأشدّ الأعمال الفلسفيّة إثارةً للجدل في عصرهما.
لم يتوقّع كثيرون ذاك الانسجام الشخصيّ القويّ بينهُما قبل لقائهما الأوّل؛ في ذلك الوقت كان دولوز في الرابعة والأربعين من العمر، ويبدو أكبر بكثير من ذلك. لم تكن صحّته جيّدة، إذ عانى من صعوبات في التنفّس جعلت تنقّله صعبًا ودفعته ليكون حبيس مكتبه الجامعيّ في جامعة ليون.
بينما كان غواتاري في تلك الفترة ناشطًا ملتزمًا، وكان قد انفصَل عن معلّمه السابق جاك لاكان، بعد رفضه الالتزام بالخطّ الفكريّ الخاصّ بمجموعة لاكان النفسيّة. كان في التاسعة والثلاثين من العمر، ويعمل في عيادة «لا بورد» النفسيّة غير التقليديّة في «لوار فالي»، حيث كان يشتغل على مجموعة تخيّل أثارت اهتمام دولوز. كان غواتاري يُعاني آنذاك من قفلة الكاتب Writer’s Block، ويأمل أن يساعده الفيلسوف على تجاوزها.
“كيف أمكن هذان الرجلان شديدا الاختلاف، بحساسيّاتهما ونمطيهما شديدا الاختلاف، أن يشتغلا على مجموعة من الانشغالات الفكريّة لما يزيد عن عشرين عامًا؟” هذا كان سؤال فرانسوا دوسيه في سيرته الذاتيّة لهما الصادرة عام 2007. أمّا إجابة السؤال، والسرّ وراء حلفهِما، يكمنُ في انعدام ثقتهما المشترك في الهويّة. كلاهُما، دولوز وغواتاري، كانا صارمين في عدائهما للفرديّة؛ سواءً في الحقل السياسيّ، أو العلاج النفسيّ، أو الفلسفة؛ وقد كافحَا ليُثبِتا أنّ الفرديّة مُجرّد خُدعة استُحْضِرَتْ للتشويش على طبيعة الواقع.
سيمضِيا، منذ تعاونهما الأوّل، ليطوّرا خطوطًا فكريّة مُضادّة للهويّاتيّة Anti-identitarian، وليتصوّرا مستقبلًا لا يتربّع فيه الفرد على العرشِ سيِّدًا أعلى. لم يكن هذا مبدأ واضحًا في ما قالاه فحسب، بل في كيف قالاه أيضًا؛ حيثُ كتَبا، حرّرا وأعادا الكتابة بطريقة حواريّة تعايشيّة غريبة وغير مسبوقة. لقد اشتغل الثنائيّ بطريقة افترضت وجود “مجتمع من تفكير، من وجود، ومن تفاعل مع العالم”، على حدّ تعبير دوس. فبدلًا من الدفع نحو استعادة الهويّات المقهورة تاريخيًّا، حاول دولوز وغواتاري تفكيك الفُروق الّتي عرّفت وحدّدت الذات الفرديّة في حدّ ذاتها. وكانت النتيجة الخروج بسياسات مُتعةٍ تقدميّة مستوحاة من الماركسيّة ومُضادّة للرأسماليّة؛ وهي سياسات تتعارض مع بعض أشكال سياسات الهويّة السائدة في عصرنا.
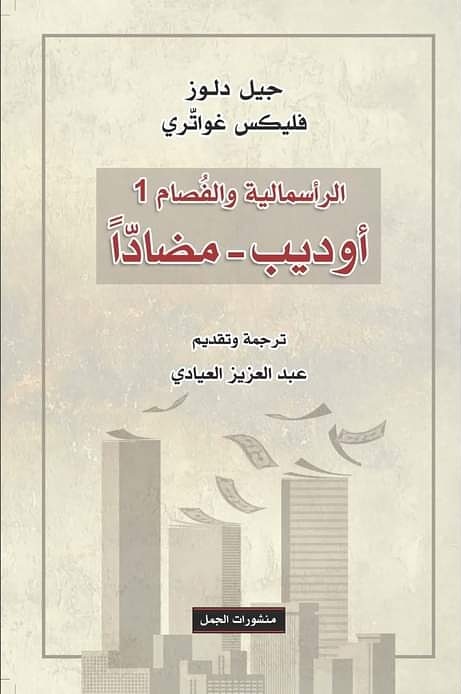
ضدّ الفردانيّة
تعود مُشكلة غواتاري مع الفرديّة إلى تجربته المبكّرة في التنظيم السياسيّ؛ فعندما انتهت الحرب العالميّة الثانية عام 1945، كان غواتاري يبلغ خمسة عشر عامًا، ومع ذلك كان نَشِطًا في اجتماعات الحزب الشيوعيّ الفرنسيّ وعضوًا في حركة سكن الطلّاب الّتي كانت على علاقة وثيقة مع المقاومة الفرنسيّة. أمضى وقته خلال تلك التجربة كميليشيويّ يضغط من أجل الخروج عن البرامج السياسيّة الراسخة، ومؤسِّسًا لمجموعات تروتسكيّة منشقّة، ومحرِّرًا لصحف كَتَبَتْ ضدّ قيادة الحزب الشيوعيّ الفرنسيّ.
يمكن إرجاع هياج غواتاري وتمرّده الدائم إلى شيء واحد:”تهديد الستالينيّة”؛ فقد رأى غواتاري كيف سقطت إرادة الثورة الروسيّة في هيكيليّة السلطة الهرميّة لبيروقراطيّة الدولة الشيوعيّة. وفي ذلك الوقت رأى الأمر يتكرّر، بصورة مصغرة، في كلّ مجموعة انضمّ إليها؛ فبغضّ النظر عن جمعيّة النضال الأوّليّ، عاجِلًا أم آجلًا، تنحلُّ الإرادة الجمعيّة إلى مُنافسات رغباتٍ فرديّة، ويترافق ذلك مع ظهور شخص معيّن في النهاية على أنّه القائد الّذي تأتي قيادته على حساب الآخرين. وكان سؤاله لنفسه: لماذا ما ينحلُّ التعاون دائمًا ويتحوّل إلى هيكليّة هرميّة، ولماذا تتفتّت المجموعة ولا تستمرُّ في الحفاظ على صوت موحّد؟
عمل غواتاري بداية من العام 1953 كمعالج نفسيّ، ومرّة أخرى وجد نفسه غير قادر على احتمال هوس حقل العلاج النفسيّ بالأفراد. كان قد أنهى تدريبه مع جاك لاكان، أحد أكثر المحلّلين النفسيّين تأثيرًا منذ سيغموند فرويد، ولكن بدلًا من ممارسته للعلاج النفسيّ الخاصّ، فضّل ممارسة العلاج النفسيّ في مستشفى عامّ كبير، حيث عمل مع مرضى ذُهانٍ محتجزين في المشفى. كان مشفى «لا بورد» مؤسّسة تجريبيّة تعمل وفق خطوط عمل شيوعيّة؛ إذ كان الأطبّاء يُساعدون في الأعمال اليدويّة، بينما يعمل الموظّفون والمرضى معًا للإبقاء والحفاظ على المشفى في حالة عمل جيّدة. هناك بدأ غواتاري يعتقد أنّ ما يجعل المرضى مرضًى ليس خلَلًا مرضيًّا معيّنًا، بل هو شكل من أشكال الاغتراب الاجتماعيّ، وهي مُشكلة تزيدُها سوءًا السلوكيّات التّتي تجرّد المرضى من إنسانيّتهم، والّتي يُنتِجُها نظام الطبّ التقليديّ ويُمارسها الأطبّاء، والممرّضين، والممرّضات.
تعارضت رؤية غواتاري مع السائد في حقل العلاج النفسيّ؛ فتقليديًّا، كانت تقنيّات العلاج النفسيّ قد صُمِّمت لتتمحور حول محادثات ثُنائيّة بين المُعالِجِ والمُعالَجْ. لذلك اعتُبِرَ الذُهان بشكل أساسيّ مرض غير قابل للعلاج؛ لأنّ أولئك الّذين واللّواتي يُعانينه لا يمكنهم الحفاظ على العلاقة التعاقديّة الثنائيّة الضروريّة بينهنّ وبين المعالج. ولمواجهة هذه المشكلة، ابتكر غواتاري طُرُقًا علاجيّة تقوم على المجموعات؛ من خلال تحويل المشفى بأكمله إلى أداة علاجيّة. فإن كان الذُهان فعلًا شكلًا من أشكال الاغتراب، إذن، كما رأى، فلن يكون علاجه ممكنًا إلّا من خلال التواصل الاجتماعيّ الّذي لا يعتمدُ على تكوين حسّ قويّ بالفرديّة، بل على قدرة مجموعة من الناس على العمل معًا.
بصفته مُعالِجًا ومُنظِّمًا سياسيًّا، ركّز غواتاري جهوده في اتّجاه خلق بيئة حاضنة للتعاون؛ إذ تضمّنت تقنياته في «لا بورد» تشجيع المرضة على المشاركة في «أندية علاجيّة» فنّيّة ومسرحيّة، تُمكّنهم من تكوين علاقات دائمة. اعتقَدَ غواتاري أنّه عند محاولة منح الناس الأدوات اللازمة لتمكينهم من إعادة الاندماج بالمجتمع، يتوجّب أوًّلا “بناء شكل جديد من الذاتيّة الّتي لا تستندُ إلى الفرديّة”. في المجال السياسيّ، ادّعى غواتاري أنّ “مرض الأحزاب الشيوعيّة المركزيّة لا يتعلّق بسوء نوايا قادتها بقدر ما يتعلّق بالعلاقات المُزيّفة الّتي أنشِئَتْ مع الحركات الجماهيريّة”. لم تكن مُشكلة غواتاري تتعلّق بشخصٍ مُعيّن؛ سواءًا كان ستالينيًّا أم فُصاميًّا، بل هي العمليّة نفسُها هي المشكلة الّتي تنقسم من خلالها المجموعات إلى وِحْدَاتٍ مُنفصلة كلّ واحدة عن الأخرى، وعن حيواتها الخاصّة.
دولوز: ضدّ التمثيل، وضدّ الهويّة
بعيدًا عن «لا بورد»، كان ثمّة هيجان ثوريّ يجتاح فرنسا صيف عام 1968؛ إذ نظّم الطلبة وعمّال المصانع إضرابات عامّة ضخمة وتظاهرات ردًّا على القوى الرأسماليّة الاستهلاكيّة المدمّرة. كانت انتفاضة عفويّة ولم تكن مدعومة لا من مؤسّسات عمّاليّة نقابيّة ولا من قبل الحزب الشيوعيّ الفرنسيّ. كان غواتاري شخصيّة مركزيّة في القلب من الانتفاضة إضافةً إلى كونه منظِّمًا، لكنّ معلّمه جاك لاكان رفَضَ التظاهرات معتبرًا إيّاها مجرّد هستيريا. كانت تلك لحظة خيانة بالنسبة لغواتاري؛ فإن لم يكن الحزب الشيوعيّ قادرًا على إدراك الثورة عندما تحدث تحت أنفه، وإن كان لاكان يرفُضُ استيعاب قوّة الرغبة الجمعيّة عندما فاضَتْ وسالَتْ عبر الشوارع؛ فإذن لا بدّ من فعل شيءٍ ما.
قريبًا من ذلك الوقت صادف غواتاري للمرّة الأولى أعمال دولوز، واقتنع أخيرًا أنّه وجَدْ رَديفهُ الفكريّ الّذي سيمكّنه من تحقيق غاياته العلاجيّة والسياسيّة. حتّى ذلك الوقت كان دولوز قد اشتغل على بعض الأسماء الأساسيّة في الفلسفة الغربيّة مثل ديفيد هيوم، باروخ سبينوزا، إيمانويل كانط، وفريدريك نيتشه. وكان قد كتب أيضًا عملان «أصليّان» وهُما: «الاختلاف والتكرار» (1968)، و«منطق الحواسّ» (1969). اعتقد دولوز أنّ تاريخ الفكر الغربيّ، على الأقلّ منذ أفلاطون، كان قد تجمّد عند عدد من الأوهام المتعلّقة بطبيعة الفكر نفسه؛ فأوًّلا وخِلافات لافتراضات معظم الفلاسفة، فالفكر عند دولوز ليس تمثيليًّا؛ إي أنّه لا يشتغل على بناء صور للعالم يمكن الحكم عليها إمّا خاطئة أو صحيحة بناءًا على درجة دقّتها، بل النقيض من ذلك، فالفكر إبداعيّ، ودائمًا على اتّصال مع الشيء المُفكَّر فيه.
ثانيًا، ادّعى دولوز أنّه ونظرًا لأنّ تقليد الفلسفة الغربيّة قد حَكَمَ على الفكر من خلال قدرته على تمثيل العالم، إذن فقد اتّخذ من التماثل Sameness ومن الدقّة Accuracy معاييرًا أساسيّة لحكمه. ويُمثّل أفلاطون وديكار مثالين جيّدين على ذلك؛ في فلسفته للأشكال Forms، زعَمَ أفلاطون أنّ اكتساب أيّ كينونة معيّنة لصفاتها يأتي من كونها انعكاسًا لشكلها المثاليّ، لشكلها المجرّد. وهذا الشكل، الّذي يتطابق مع نفسه فقط، يُؤخَذُ أساسًا للمعرفة. الإنسانُ إنسانٌ طالما يمثّل شكله المثاليّ، وأن يُعرَفَ الإنسان، يعني أن يُعرَفَ ما هو شكل «الإنسان». وبالمثل، شدّدت مقولة ديكارت: “أنا أفكّر إذن أنا موجود”، على مركزيّة الهويّة والفرد. فالقدرة على معرفة النفس تُسهّل القدرة على أيّ معرفة أخرى، وهكذا. في كلتا الحالتين؛ يكون ثمّة شيء خاصّ بوصفه أساسًا للفهم، شيء فرديّ ثابت ولا يتغيّر؛ بكلمات أخرى، يكون الفرد/الفرديّ نموذج الحقيقة.
لكنّ دولوز اعتقد غير ذلك؛ فقد ادّعى أنّ الفكر ليس مُتجذِّرًا في الهويّة، بل يتناتجُ عن الاختلاف. “لا يمكن للتمثيل التقاط عالم الاختلاف البديهيّ”، كتَبَ، ولذلك علينا إيجاد طريقة جديدة للتفكير في الأشياء، طريقة جديدة للتفلسُف لا تتّخذ من الهويّة أساسًا لها. في الواقع، فإنّ ما يظهر لنا من خلال التجربة على أنّه مُتفرّد، سواءً كان حجرًا مُفرَدًا أو شخصًا مُفرَدًا، فإنّه يكتسب هويّته فقط نتيجة للصراع الدائم ما بين عدد من القوى المتنوّعة. ليس ثمّة ما يمكن وصفه بالفكرة المجرّدة عن “حجر” ما، بل ثمّة عدد من الحجارة تختلف عن بعضها البعض مثلما يختلف طائر ما عن الشجرة. فالعالم مؤلّف من الاختلافات، لا المُفرَدات/الأفراد، حتّى وإن تمكّن الفكر التمثيليّ من جعله يبدو غير ذلك.
لماذا تفشل الثورات؟
في عام 1968، وبتأثير من أحداث أيّار 1968، كتَبَ غواتاري مقالته: “الآلة والبنية”، Machine and Structure ،1971، والّتي تناول فيها أعمال دولوز، واستخدم فيها حُجَجهُ ضدّ لاكان، في محاولة لوصف ما كان يحدُثُ فعلًا في الشوارع. فبينما حدّدَ لاكان مجموعة من القواعد البنيويّة الّتي تحدّد ظاهريًّا العلاقة ما بين أيّ شخصيّة فرديّة وموضوع رغبتها، أراد غواتاري أن يُظهِرَ أنّ الرغبة هي قوّة جمعيّة وإنتاجيّة. وبدلًا من التزام لاكان باللاوعي كشكل من أشكال المسرح الّذي عليه تُستعرَضُ الرغبات، اعتقد غواتاري أنّ ثمّة بدلًا من ذلك ما يمكن وصفه بالآلة أو المصنع الّذي يُنتِجُ الرغبة بشكل دائم. اعتبَرَ لاكان مقالة غواتاري تهديدًا لسلطته، وحاول منع نشرها، ولكن، غير آبه بازدراء أستاذه، أرسل غواتاري المقالة إلى دولوز، وكانت المحفّزة للقاء المصيريّ بينهُما.
أنتجت الشهور الأولى من صداقتهما مجموعة جامحة من الأفكار الأصليّة. اقترح دولوز روتينًا صارمًا على غواتاري؛ أن يستيقظ صباحًا ويشرع في الكتابة على الفور، ويُرسل إليه المسودّات الّتي يكتبها دون أيّ تعديل أو تنقيح عليها. اعتاد دولوز أن يقول أنّ “غواتاري كان حفّار الألماس، بينما كان هو صاقله”. في طابعه الأعمّ، كان تعاونهما يتمّ عبر التراسل، رغم لقائهما الدائم مساء كلّ ثلاثاء لمناقشة وفحص عملهيما.
شكّلت الملاحظات الّتي دُوِّنَت خلال نقاشاتهما الأوّليّة المحمومة أساسَ كتابهما الأوّل «أوديب مُضادًّا» (1972)، وفيه شَرَعا في توضيح العلاقة ما بين الرغبة والواقع، وتسييق مأزق الفلسفة والتحليل النفسيّ في إطار الحالة السياسيّة القائمة. بكلمات أخرى، كانا يُريدان توضيح كيف تتفاعل الرغبة مع العالم المادّيّ، وفحص كيفيّة اشتباكها مع السياسيّ.
وكان سؤالهما الأكثر خصوصيّة؛ لماذا تفشل الثورات؟ لماذا يُقاتل البشر من أجل عبوديّتهم كما لو أنّها حرّيّتهم؟ لماذا تنتهي الحركات الجماهيريّة إلى الإضرار بمصالح الجماهير نفسها؟ لقد وصل كلّ من هتلر وموسوليني إلى السلطة من خلال حركة شعبويّة، فإذن، كان استنتاجهما أنّه لفهم الفاشيّة يجب أوّلًا تفسير رغبة الناس بالفاشيّة. “لقد تمكّن هتلر من إثارة الفاشيّين جنسيًّا، والأعلام، والقوميّات، والجيوش، والبنوك جعلت الكثيرين مُثارين جنسيًّا”؛ هكذا كَتَبا في «أوديب مُضادًّا».
إنّ الرغبة ليست فرديّة؛ ذلك ما كان مركزيًّا في أطروحتهما، فالرغبة تمرّ عبر الناس، تقودهُم، ولكنّها ليست بالضرورة في تلاق دائم مع المصلحة الشخصيّة المجرّدة. فعند محاولة تحليل طريقة عمل الرغبة في المجموعات الكبيرة، سيجد المرء أنّها ليست كُتلة واحدة ولا هي مُجزّأة؛ فالرغبة في جوهرها هي “نوع من البديهيّ الّذي لا يمكن اختزاله في أيّ نوع من الوحدة”، ولا يمكن أن تُفهَمَ إلّا من خلال ما أسمياه بـ «التعدّد»، التعدّد غير الممكن تجزيئه إلى كينونات مُكوِّنة.
ولكن، في حين أنّ الرغبة ليست في تلاق دائم مع الفرديّ، فإنّ المجتمع الرأسماليّ يفعل ما بُوسعه لجعل كلّ الرغبات تمرُّ من خلال الفرديّ. كان فرويد من بين الأوائل الّذين اشتغلوا على تشريح الرغبة، لكنّ عمله ركّز على أمراض مرضاه الفرديّة، ولم يتفحّص بشكل مُلائم هذه الأمراض من خلال عدسات الفحص التاريخيّة. فالعُصابيّة الّتي شخّصها فرويد، والّتي تستمرُّ في الانتشار كوباء في القرن الواحد والعشرين، لم تكن تفتقر إلى سياقات تاريخيّة؛ بل على النقيض، فهي كانت نِتاج تطوّر الرأسماليّة في اتّجاهات تقييد، وتنظيم الرغبة، وتأديبها داخل أنماط ظهور محدّدة.
لنفكّر بالعائلة النووية على سبيل المثال، وهي، بالنسبة لدولوز وغواتاري، بناء تاريخيّ يُنمْذِجُ الناس من خلال عمليّة أودَبة Oedipalisation [من العقدة الأوديبيّة]. فالأطفال يُربّون على توجيه رغبتهم نحو موضوع عاطفيّ، الأمّ، يُمنَعُ عليهم الوصول إليه عاطفيًّا من خلال قانون صارم يتجسّد بالأب. ونِتاج هذه العمليّة تتكوّن الذات الفرديّة السلبيّة، الّتي ستذهبُ إلى العمل لتُطيع المُدير/ة، وتتنافس مع جيرانها، وتستهلك سيلًا لا نهائيًّا من السلع. وهنا، يتقمّص التحليل النفسيّ دور شرطيّ الرأسماليّة؛ إذ يتعقّب ظهور أيّ انحرافات نفسيّة ويعمل على تقويمها مُستخدمًا صورتا العامل الجيّد والطفل الجيّد.
بطريقة ما، يمكن قراءة «أوديب مضادًّا» كنقد فرويديّ لكارل ماركس؛ فقد فشل الخطاب الماركسيّ في تفسير دوافع لحظات من العمل الجمعيّ لأنّه لم يفهم آليّات عمل الرغبة، ولكن من الممكن إعادة تنشيطه من خلال استدخال المفهوم الفرويديّ للرغبة. لكن، في الوقت نفسه، يذهب الكتاب في اتّجاه أن يكون أيضًا نقدًا ماركسيًّا معاكِسًا لفرويد، لغاية تجديد التحليل النفسيّ من خلال استدخال الفهم الماركسيّ التاريخيّ للعمل. فكان نتاج الخليط الماركسيّ – الفرويديّ التحليل النفسيّ الأنثروبولوجيّ الّذي أسمياه بـ «التحليل الفُصاميّ – Shizoanalysis» والممكن التّفكير فيه بوصفه سرديّة لتاريخ الرغبة كقوّة إنتاجيّة، وكقوّة لا شخصانيّة ذات قدرة على خلق العالم.
يقع التحليل الفصاميّ في مكان ما بين التحليل النفسيّ والتحريض السياسيّ؛ إذ يتمحور دور شخصيّة المحلّل الفصاميّ حول تفكيك عمليّات الرغبة اللاواعية وتحديد إمكانيّاتها الثوريّة. وقد حدّدا دولوز وغواتاري ثلاث مراحل يمكن من خلالها إحداث التغيير السياسيّ باستخدام التحليل الفصاميّ؛ أوًّلًا، إيجاد عمليّات الرغبة المخالفة للرأسماليّة، ومن ثمّ تتبّع كلّ منها إلى أقصى منابعها لتمكينها من الهرب من التقييدات الرأسماليّة، وأخيرًا، تنظيم هذه العمليّة المختلفة لخلق “حالة ثوريّة جنينيّة”، على المستوى الجزيئيّ منها.
ما الّذي يعنيه ذلك؟ اعتَقَد دولوز وغواتاري أنّه من المستحيل معرفة شكل الثورة مقدّمًا، ولذلك، وبدلًا من الدعوة إلى ثورة وفقًا لخطّة معدّة سلفًا، اقترحا سياسات تجريبيّة. وقد شكّلت المحن الجسديّة في «مسرح القسوة» للمسرحيّ الفرنسيّ أنتونين أرتود، ومغامرات الكاتب الأمريكيّ ويليام إس بوروز المحفّزة بالمخدّرات، أمثلة مفضّلة لدولوز وغواتاري عن كيفيّة استكشاف التنظيمات البديلة للرغبة.
كان ثمّة طيفًا واسعًا من الفئات الّتي بإمكانها أن تكون جزءًا من هذا المشروع بالنسبة لدولوز وغواتاري، اللّذات رفضا الفكرة الماركسيّة التقليديّة القائلة بأنّ الطبقات العاملة هي أساس التغيير، وأراد نصب مظلّة أوسع يمكن تحتها توحيد كلّ المجموعات المهمّشة. لقد اعتقدا أنّ أولئك المُضطهدين من البطريركيّة (النساء)، ومن العنصريّة (غير البيض)، ومن المعياريّة الجنسيّة المغايرة Heteronormativity (المجموعات المثليّة ومجموعات الـ LGBTQ)؛ اعتقَدَا أنّ جميع هذه المجموعات تعاني من آلة الطغيان الإمبرياليّة الرأسماليّة ذاتها. ولا يمكن لثورة مضادّة للرأسماليّة أن تنجح إلّا من خلال جمع هذه الأقلّيات مع بعضها؛ ذلك أنّ الصورة الفلسفيّة للفرد تستند على شكل الذات الذكوريّة البيضاء، ولا يمكن إلّا من خلال عمليّات صيرورة التحوّل إلى «امرأة»، أو «أقلّويّ» الوصول إلى نفي شبح الفرديّة نهائيًّا.
ضدّ «أوديب مُضادًّا»
أثار “أوديب مُضادًّا” الكثير من العداء؛ فقد كان لاكان غاضبًا ومنع أيّ مناقشات تتناول الكتاب في محاضرات، وفي حين كان العديد من السياسيّين اليساريّين متعاطفين مع غايات دولوز وغواتاري، إلّا أنّهم حذّروا من تهوّرهم وهرطقاتهم. وعلى الرغم من، أو ربّما بسبب هذه الانتقادات، حقّق الكتاب نجاحًا فوريًّا، فنفذت طبعاته خلال أيّام واستجلب مراجعة من صفحتين في مجلّة “لو موند – Le Monde”.
لكنّ اللا اعتياديّة لم تتعلّق فقط بالمحتوى، بل أيضًا بشكل تعاونهما ونموذجه الّذي شكّل خروجًا عن التقليديّ؛ فكُتُبُهما احتوت على حشد من الأصوات الّتي يصعب تمييز أيّ منها على أنّها صوت دولوز أو غواتاري. “بما أنّ كلّا منّا كان متعدِّدًا، فقد كان ثمّة حشد بالفعل منّا”؛ هكذا كتبا في «ألف بساط» (1980) A Thousand Plateaus، وهو الجزء الثاني من «أوديب مضادًّا»، وقد تردّد صدى هذه العاطفة لاحقًا في كلمات غواتاري:”كلانا كان مختلفًا جدًّا… أنا أكثر انجذابًا للمغامرات، ولنقل أنّي كنت كالكوماندوز المفاهيميّ الّذي يحبّ الترحال في الأراضي الأجنبيّة، أمّا جيل [دولوز]، فقد كان الثقل الفلسفيّ، والإدارة الببليوغرافيّة المكتملة”.
من خلال العمل بهذه الطريقة، كان يحاولان مقاومة النزوع نحو الفردانيّة العقيمة والمميتة على المستوى العمليّ مثلما فعلا على المستوى النظريّ. يحتوي كتاب «ألف بساط» على خمسة عشر فصلًا تغطّي عددًا متنوّعًا من المواضيع؛ من الجيولوجيا إلى اللغويّات، والبيولوجيا الجزيئيّة إلى الرسم، والشعر إلى الاقتصاد السياسيّ. وهنا يتشظّى نقدهم للهويّة إلى ألف مُقايَسَةٍ صغيرة؛ فبدلًا من التعامل مع كلّ حقل بانفصال عن الحقول الأخرى، حاول دولوز وغواتاري إظهار أين وكيف يتداخل حقل مع آخر، متحدِّيان بذلك مركزيّة كلّ منها. وفي النهاية سعَيا إلى فتح الفكر على خارجه، وليدفعا ضدّ انغلاق العمل النظريّ على ذاته.
تعاون دولوز وغواتاري في أعمال أخرى غير «أوديب مضادًّا» و«ألف بساط»، واستمرّ كلّ منهما في عمله على مشاريعه الخاصّة. كتب دولوز بكثافة عن إمكانيّات السينما، وكذلك عن فلسفة ميشيل فوكو، وغوتفريد ليبنيز وآخرين. أمّا غواتاري فدَعَا إلى ابتداع تفكير إيكولوجيّ [بيئيّ] جديد يمكّن من شرح التفاعلات ما بين بيئتنا النفسيّة، والسياسيّة وبيئة كوكبنا. وكان تعاونهما الأخير هو كتاب «ما الفلسفة؟» (1991).
بعد عام من تعاونهما الأخير مات غواتاري بذبحة قلبيّة، وكان دولوز أشدّ مرضًا من أن يحضر الجنازة. فكان يعاني من مشاكل تنفّسيّة وبسببها لم يتمكّن من العمل، وفي النهاية قرّر إنهاء حياته بالقفز من شقّته في باريس بعد ثلاثة أعوام من موت غواتاري.
“نحن لم نتعاون كشخصين مختلفين؛ بل كنّا أقرب ما نكون إلى تيّارين سائلين يمتزجان ليصنعا تيّارًا ثالثًا شكّلنا؛ نحنُ، أفترضُ، ذلك التيّار الثالث”، هكذا وصف دولوز تعاونه مع غواتاري. أو كما قال غواتاري، “كان ثمّة سياسة اختلاف حقيقيّة بيننا، ليست طقسًا، بل ثقافة عدم تجانس جعلت كلّا منّا يعرف بتفرّد الآخر ويقبل تفرّده”. لقد اشتغلا لا من خلال تأكيد هويّتيهما عبر صراع الواحدة مع الأخرى، بل من خلال إدراك نفسيهما بوصفهما فضاءات يمكن لاختلافاتهما أن تزدهر في هذه الفضاءات. من نواة ذلك الاجتماع الأوّل في “ليموزين”؛ ولدت التعدّدية.






