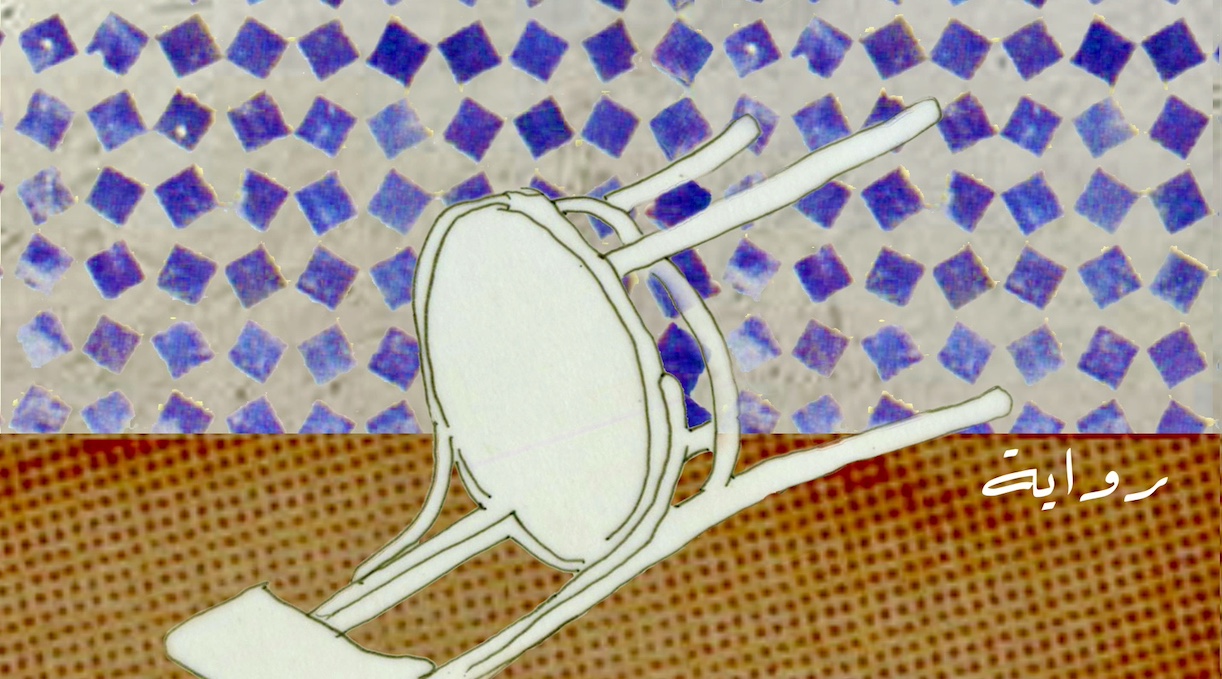مقطع من رواية “وحيدة كغرفة مزدحمة” الصادرة أخيراً عن دار الآداب.
كان الجميع يشبهني بسعاد، كأنها بنتك، ربما محاولة منهم لإشعارها بأنها أم وليست فقط زوج أب. كانت سعاد ترد بابتسامة، وكأنها سعيدة بهذا الشبه. ولكني لم أر أبداً هذا الشبه. ولم أرغب به. لم أشبه والدتي أو والدي. كنت شيئاً ما بينهما، تَليل هي نسخة أخرى عن والدتي، هكذا كان يقول بابا، ثم ينظر إلي ويقول مازحاً: “أنتي ما بعرف على مين طالعة”. وهو السؤال الذي كنت أطرحه على نفسي كذلك. كل ما أردته هو أن أشبه ماما. واعتبرت أن كوني لا أشبهها فشلاً شخصياً. حاولت في فترة إطالة شعري وقص غُرة شعر تشبه تلك الصورة المتخيلة عن والدتي. ولكن يجب أن تكون شخصاً عقلانياً قبل أن تفكر بقص غرة. بعد أسبوع كنت قد تعبت منها وقمت بقص شعري كله بنفسي بمقص المطبخ، وعندما رأتني نور، صرخت بي “ليه هيك عاملة بحالك” وأصرت على أخذي لكوافير شعر. وطبعاً قصة الشعر القصير الوحيدة التي يعرفها كل حلاقين الشعر في رام الله تشبه قَصة شعر سعاد. كيف تحولت من التشبه لوالدتي للتشبه بسعاد لا يزال حادثاً غير مفهوم.
لم أر نفسي أبداً شخصاً جميلاً، تيتا كانت ترانا حلوات، ولكني كنت أعلم أنها دائماً تستخدم حلوات، وتجمعنا معاً لأنها كانت تقصد تَليل. وفي كل الأحوال، كان من الصعب أن أصدقها، فهي ببساطة لم تكن حيادية، كانت منحازة تماماً. كانت تدعي أننا (تليل وأنا) أجمل فتاتين في رام الله كلها، وفي حين أن تليل تعاملت مع ذلك كحقيقة طوال حياتها، فإنني تعاملت مع هذا الادعاء بتشكك منذ البداية. كنت أعيش وكأنني أطفو، لم أكن أر الأشياء كما هي، كنت أراها كما أنا. لم ارتد حمالة صدر حتى بعد أن بدأ ثدياي بالتشكل، لم ارتد تلك الملابس الداخلية القطنية البيضاء تحت ملابسي كما كانت سعاد تطلب مني. كنت أرتدي تيشيرت مباشرة لا شيء تحته.
في المدرسة، كانت الفتيات يسخرن من عدم ارتدائي حمالة صدر، كيف طالعة هيك، عيب! لم أفهم أبداً معنى العيب، ولا أزال حتى الآن أجد صعوبة في فهم ما هو العيب في عدم ارتداء حمالة أو حتى عدم ارتداء ملابس من أصله. كن يسخرن من زي المدرسة الطويل والواسع كسطل غسيل، فيما كن يتفنن باختيار الزي الأقصر والأضيق. لم أر نفسي كامرأة، هذه كانت المشكلة الأولى. رأيت نفسي كشيء، لا اختلف عن الكرسي سوى بأنني يمكنني أن أتحرك لوحدي، لا أحتاج لأحد لأن يحركني من مكاني – وإن كنت أحياناً أشعر أنني لا أتحرك سوى لأن شخصاً ما قام بتحريكي.
كنت أحب ارتداء قمصان والدي الفضفاضة، وأحذية ليل القديمة الأكبر نمرتين من رجلي، ولم يكن لدي مشكلة في ارتداء قلادة تحمل حرف z مثلاً، فهو مجرد حرف، ولم افهم استغراب الآخرين من كل ذلك. لم أكن أنتبه لآراء الآخرين وتعليقاتهم، كنت أتصرف وكأنني خارج حدود العالم، عندما وقعت في غرام ذلك الشاب بعيونه السوداء الكبيرة الذي يعمل كميكانيكي، في دكان تصليح سيارات الذي كنت أمر به في ذهابي ورجوعي من المدرسة، كان يترك كل شيء ويتوقف عن العمل عندما أمر من الشارع ويتابعني بنظراته وعلى وجهه ابتسامة خفيفة، لم يتحدث معي أبداً، لم يعرف اسمي ولم أعرف اسمه، ولكن كان ذلك كافياً لأقترب منه بعد انتهائي من امتحانات الثانوية، وهو ينظر إلي بينما يمسح يديه من زيت السيارات وترتسم ابتسامة صغيرة على شفتيه، وأقول له بحبك.
بدت تلك الكلمة وكأنها أكثر شيء طبيعي في العالم. لم أنتظر رده ولم أره بعد ذلك. لم أعد أبداً للمرور من طريق المدرسة ذاك، توسعت الطرق وقُصفت وتم اجتياحها مراراً وتكراراً. تغيرت الشوارع والمحلات، وتغيرت معها. ومنذ أن بدأت أفكر قبل أن اتصرف، أصبحت شخصاً قلقاً، الحياة لم تناسبني يوماً، لم أفهمها، وعندما وجدت نفسي أفكر بردة فعل الآخرين، لم أعد كرسياً ولكني تحولت إلى قفص.
مجدل الشمس، كان هادي يحب أن يناديني، وبسببه فقط بدأت أحب اسمي. ومعه بدأت أشعر أنني امرأة، ولست كرسياً. كان قلبي يرتجف فرحاً عندما أراه، وكنت أقضي الأيام والليالي وأنا أسمع كل أغاني الحب وأفكر بعينيه، ومشيته، وشفتيه. كانت المرة الأولى التي شعرت بها أنني أدركت الهدف من الحياة، الوقوع في الحب، لا شيء آخر. لم أرغب بشيء في العالم سوى بجعله يبتسم، تلك الابتسامة التي تُلون تعابيره الهادئة وكأنه monk.
حفظت كل قصائد رياض الصالح الحسين لأجله “غدًا من الممكن أن ننتحر، الآن علينا أن نحب” وإن كنت لم أملك الجرأة يوماً لأقرأها له. منذ رأيته، أصبح كل شيء له طَعم، الشوارع، رائحة المطر، لون الطعام، شكل الغيوم، حتى الأغاني، كل الأغاني التي أرددها واحفظها عن ظهر قلب أصبح لها معنى آخر، وأجد نفسي أطلق آه بعد أخرى وكأنني أسمع الأغنية لأول مرة في حياتي. حتى أم كلثوم التي كانت تصيبني بالملل الشديد وأغير قناة الراديو مباشرة عندما يبدأون فقرتها، كيف أصبحت أتمايل على أغانيها، وأعيد غناء نفس الدوبليه معها مرة بعد أخرى. كيف يفعل الحب كل هذا؟ كيف يتحول كل شيء حولي لمجرد خلفية معتمة فقط، وفي اللحظة التي يظهر فيها تسطع الأضواء كالدر المتلألىء. لم أعد أكره الاستيقاظ مبكراً لأن هناك فرصة لرؤيته، توقفت عن التفكير بالموت لأن موتي قد يُوجعه، ما كل هذه الفوضى التي يسببها الحب وكيف سمحت له بذلك؟
عندما أخبرني هادي خلال واحدة من تدريبات نادي الدبكة أنني حلوة، صدقته بدون تفكير، وتعاملت مع ذلك كحقيقة، بدأت بالنظر إلى نفسي في المرآة وأرى نفسي في عينيه وأحب ما أراه، وعندما ألمح انعكاس صورتي على واجهة المحلات الزجاجية لا أشعر بالغرابة، بل قد أتوقف لحظات أتأمل هذا الانعكاس، في محاولة لاكتشاف ما الذي يُعجبه في.
كنت الأسوأ بين ١٦ شاب وشابة ضمن فريق تدريب الدبكة، كان الجميع يتجنب التدرب معي إلا هادي، فقد أصبحت جملة المدرب “مجدل اجرك الشمال مش اليمين، الشمال” علامتي التجارية الخاصة بين الفريق. أدركت بعد المحاولة السابعة أن الدبكة ليست لي، وكان هادي الوحيد الذي حاول إقناعي بالبقاء والمحاولة مجدداً، في الوقت الذي كان رأي مدرب الدبكة أنه “ما في أمل.”
أخبرت هادي يوماً أنني لا أعلم أين قبر والدتي وأنني لا أستطيع سؤال والدي خوفاً من تَسببي بوجعه، قام بتفتيش مقبرة البيرة قبراً قبراً حتى وجد قبر والدتي وأخبرني أين أجده، رسم لي خريطة كاملة من مدخل المقبرة، لكيف أصل إلى قبرها. لا أعلم لماذا لم أطلب منه المجيء معي، ولماذا لم يقترح ذلك، ولكنه كان دوماً يتحدث عن الموت وكأنه عالم مقدس، وهو يؤمن من قلبه بأننا سنعود ونلتقي بمن نحب في حياة أخرى. عندما سألته ماذا أفعل عندما أصل إلى قبرها، قال لي بدون تفكير: “اقرأي الفاتحة أو سورة الرحمن” وعندما شاهد تَرددي، قال “ممكن كمان تقرأي شِعر.”
لم أقرأ أي شيء عندما وصلت لقبرها الذي كان نظيفاً ومليئاً بسعف النخيل الذي وضعه والدي من العيد الماضي، فقد كان يزور قبرها مرتين في السنة: عيد الفطر وعيد الأضحى. عندما وصلت القبر، تمنيت لو كان هادي معي، فهو أفضل ما حدث معي بعد موتها وبالتالي هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن أخبرها عنه. ولكني وجدت أن التحدث مع قبر حجري أمر غريب. جلست هناك، بجانب قبرها بسلام غير مفهوم وبلا أدنى صوت في رأسي، فراغ مريح لم أشعر بأي شيء مثله قبل ذلك، ووقعت بحب المقابر منذ تلك اللحظة.
أحببت هادي من أول مرة شفته ولكن عندما حانت لحظة الاعتراف بالحب، اللحظة التي تخيلتها وحلمت بها، قلت لّه أننا أصدقاء فقط، كذبت أمام وساع عينيه وقلت له أنني لا أحبه. ألوم ماجدة الرومي وأغنية “كن صديقي” على ذلك، وأكره صوتها وأغانيها منذ تلك اللحظة. ماذا لو قلت أنني أحبه أيضاً، ما الذي كان سيحدث، ماذا عن كل تلك المرات التي تقابلنا فيها ومنعت نفسي من تقبيل عينيه. ألوم محمد عبد الوهاب وأغنية بلاش تبوسني في عينيَّ، الفراق كان وارداً دوماً. ولكن لا يمكنني لوم الأغاني. ليس ذنب الأغاني أنني صدقتها، وليس ذنب الحب أنني شككت به. الشك بأنني استحق الحب كان أقوى.
ولأن ميزان الحياة كان دوماً مائلاً ضدي لم يكن لدي رفاهية التراجع والاعتراف بالحقيقة، بأنني أحبه، فبعد أيام فقط، سيشارك هادي في عملية فدائية وسيتم سجنه ثمان سنوات في سجن إسرائيلي، وستمر الشهور الأولى بدون أي وسيلة للتواصل، كونه مسجون انفرادي، بعدما تجرأت واتصلت بوالدته لأسأل عنه. كنت كالمجنونة وقتها، لم استطع النوم لأيام، لم أتوقف عن لوم نفسي، لم أتوقف عن لعن إسرائيل بكل المسبات التي أعرفها وهي قليلة للأسف. بعد أشهر من اللوعة، تواصل معي أحد أصدقائه من خارج السجن، وأخبرني بأنه يمكنني أن أكتب له رسالة وأنه سيرتب توصيلها له في داخل السجن.
قلت له أنني سأفعل، بالتأكيد سأكتب له مئات، آلاف الرسائل، سأجفف له زهوراً كثيرة من شجرة البرتقال التي يحبها داخل كل رسالة. سأقول له أنني أحببته وأحبه وأنني سأنتظره العمر كله، وأنني لن أتوقف عن المحاولة لتقديم طلب زيارة مدعية أنني خطيبته، سأكون عينه وقلبه خارج السجن، سأخبره في رسائلي عن كل ما يحدث في رام الله، عن المكان الوحيد العادل في كل حياتي.. قلبه.
سأكتب له عن روايات إبراهيم نصرالله الأخيرة، دواوين شعر محمود درويش الجديدة، آخر أغاني عمرو دياب، آخر الأفلام الأكثر رومانسية، الشوارع التي تم توسعتها أو تدميرها (يعتمد)، عدد البنايات التي تضخمت عرضاً وطولاً، المطاعم الفاخرة التي لا يأكل فيها أحد، عن كل تلك البنوك التي أصبحت تنافس الجوامع بأعدادها ومواعظها. عن تلك المظاهرات التي ستخرج يومياً لأجله، لأجل الأسرى. سأكتب له عن كل تلك القُبل التي سأطبعها على شفتيه وعينيه عند خروجه.
فكرت بكل ذلك. ولكني لم أفعل أياً منها. توقفت عن الرد على اتصالات الصديق، ولم أرسل له رسالة واحدة.
من أين تأتي القسوة.