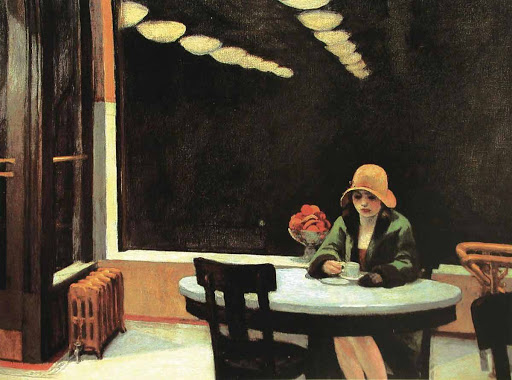أراقب نفسي من داخلها، كأنّي أعيش بين مرايا مُكبّرة، أواجهها يومياً… أحدّثها… ألومها… أكرهها… أشفق عليها، أغلبها وتغلبني، أداوي جروحها، تتكبّر علي، فأعود لأداويها، تهزمني، فأكرهها ثم أشفق عليها.
أشعر كأنّي سيارةٌ قديمةٌ تحتاج إلى تصليح، إلّا أنّ الميكانيكيّ مفقودٌ وسط الصحراء، منزلي صحراء، لا يوجد حولي مجلى وفرن وغسالة وتلفزيون، وأمامي سلطة أفوكادو وعصير تفاح، حواسك تلخص لك الكون في هذه اللحظة، وحواسي معزولة فلا أرى سوى رمال صفراء، معزولة بالحزن وليس بالكورونا، معزولة عن العائلة والحب والأصدقاء الحقيقيين، إلّا أنّ هذه أيضاً صفات الغربة وليس الحجر المنزليّ فقط… أليس كذلك؟
كيف تفرق الغربة عن الحجر المنزلي؟ إنّها مجرد غربة داخل غربة، ربما كنت ألقي التحيّة بالسابق هنا أو هناك، أقابل أحد المعارف صدفةً في مهرجان أو حافلة، لكنّي اليوم أمام غربتي وجهاً لوجه، قلباً لقلب، ولا شيء ينتج عن ذلك سوى مزيد من الغوص داخلك، مزيد من استرجاع الماضي دون بكاءٍ على الأطلال.
إنّي أحسد العائلات التي تتواصل مع بعضها البعض كل يوم، أحسد أعياد الميلاد، أحسد الفرنسيين الذين يخرجون إلى الحديقة القريبة ليلعبوا معاً، أحسد المنازل الممتلئة بأفرادها، أحسد شجاراتهم، ضحكاتهم، أحسد الأصوات الحقيقيّة، لا يحتاجون لرفع صوت التلفاز خلال مسلسل تافه كي يشعروا أنّ حياة تجري حولهم.
هل تنقصني الحياة أكثر ما كانت تنقصني؟، كيف غدوت وحيدة إلى هذه الدرجة؟، معزولة حد نبذ ذاتي باختيارها.
ابني يلعب بلاي ستيشن أغلب الوقت، لأول مرة لا ألومه فمنظمة الصحة العالميّة بنفسها نصحت بذلك، كي يشعر الأطفال أنّهم يتواصلون مع آخرين، ابنتي ترسم أو تلعب بغرفتها، أحضّر الوجبات وأنقلها إلى غرفهم، أشعر كأنّني أعمل في فندق بخدمة الغرف، مع فارق أنّي أتلقى عناقاً وابتسامة حب بين الحين والآخر.
يجب أن يكون اسمها “العودة” وليس العزلة، عودة للأصدقاء القدامى، للأغاني التي كنت تحبها، عودة لنفسك، هي عودة أكثر منها اكتشاف أشياء جديدة، ما فتحته فترة الحجر المنزليّ عوالم قديمة كنا تركناها منذ زمن بعيد.
والدتي عادت تحيك الصوف خلال إقامتها في تركيا، وتصنع لنا القبعات واللفحات على أمل اللقاء، صديقتي تبحث عن أرقام زملائها الذين كانوا يعملون معها في أول الصحف التي تعيّنت بها، أمّا صديقي الباريسي فقد تفرغ أخيراً لكتابه كي ينهيه هذه المرة، وأنا استمع إلى “حلف القمر” بصوت جورج وسوف في صباه.
إنّ الحياة فجأة تسير ببطء بل أكثر بطئاً من بطء ميلان كونديرا، كنت في خضم تحركاتي بين الحافلة والدراجة والمترو كي ألحق بمواعيدي اليوميّة بين مدرسة ابنتي وكورس اللغة وقهوة الصباح أتساءل كثيراً متى ستهدأ هذه البلاد؟ أشتاق إلى تسيّب بلادنا والإضرابات وكسل الناس وعدم أخذ الأمور بجديّة، ثم فجأة توقف كلُّ شيء.
لم أكن أتخيل أنّي سأشتاق إلى الصباح البارد حين أصحب ابنتي إلى المدرسة، أو إلى ربيع العام الماضي، فالربيع الحالي يفصل بيني وبينه باب، بل أكثر من ذلك أن تتخيله ملوثاً بالكورونا بمجرد خروجك إلى الشوارع يجعلك لا تفكر بأيّ فصل أنت.
لا ألبث أتذكر الشاب مورسو من رواية “الغريب” لكامو حين جعلته عزلته في السجن يراقب كل التفاصيل في الجدران والأرضيّة ويصفها بدقة واهتمام لم يفعله من قبل، كما يسترجع لوم الآخرين له على أنّه لم يبكِ على وفاة أمّه، بل ربّما لم يحزن، ورفض رؤيتها قبل الدّفن، وفي اليوم التالي تعرّف على فتاة وذهب معها وشاهدا فيلمًا ساخرًا وبعدها ذهبا إلى البحر، واتخذت المحكمة كل هذه التفاصيل لإثبات إدانته بقتل أحدهم على الشاطئ، ولن تسمع لحظة ندم واحدة من مورسو، فهو يعتبر ما قام به طبيعيّاً.
لكن ما يفعله معنا الحجر أنّ اللوم يتضخم داخلنا وليس كما حدث مع مورسو، ولا أدري كيف..! من الصعب فصل الكتابة اليوميّة عن الحياة الحقيقيّة، قالت لي صديقة أنها لامت حبيبها على فتاة يحدّثها كل يوم، يعرفها منذ طفولته، لامته بشدة وكان رده أن عندها خمسة آلاف صديقٍ على الفيسبوك لكن منذ متى الفيسبوك يمنحنا أصدقاء؟، منذ متى كان بينك وبين أصدقاء الفيسبوك ماضي مشترك وذكريات تضحكان عليها؟.
هل فعلاً صديقتي الوحيدة مثلي، تغار عليه أم تغار منهما بسبب عزلتها، هل فعلاً يهمها ذاك الحبيب أم أنّها تحتاج أن تصب اهتمامها نحو شيء ما، وربما أنّ الأرواح المجروحة تتجاذب لتزيد بأسها بأساً فتشعر أنّها بحالة جيدة وتنكل ببعضها بعضاً.
أترون مثل هذه الأفكار ما يفعله بك الحجر المنزليّ، إنّ النظر إلى اللاشيء في سقف المترو أو التورط داخل ازدحام ما لهو أفضل لك من أن تقف أمام نفسك وتعاتبها.