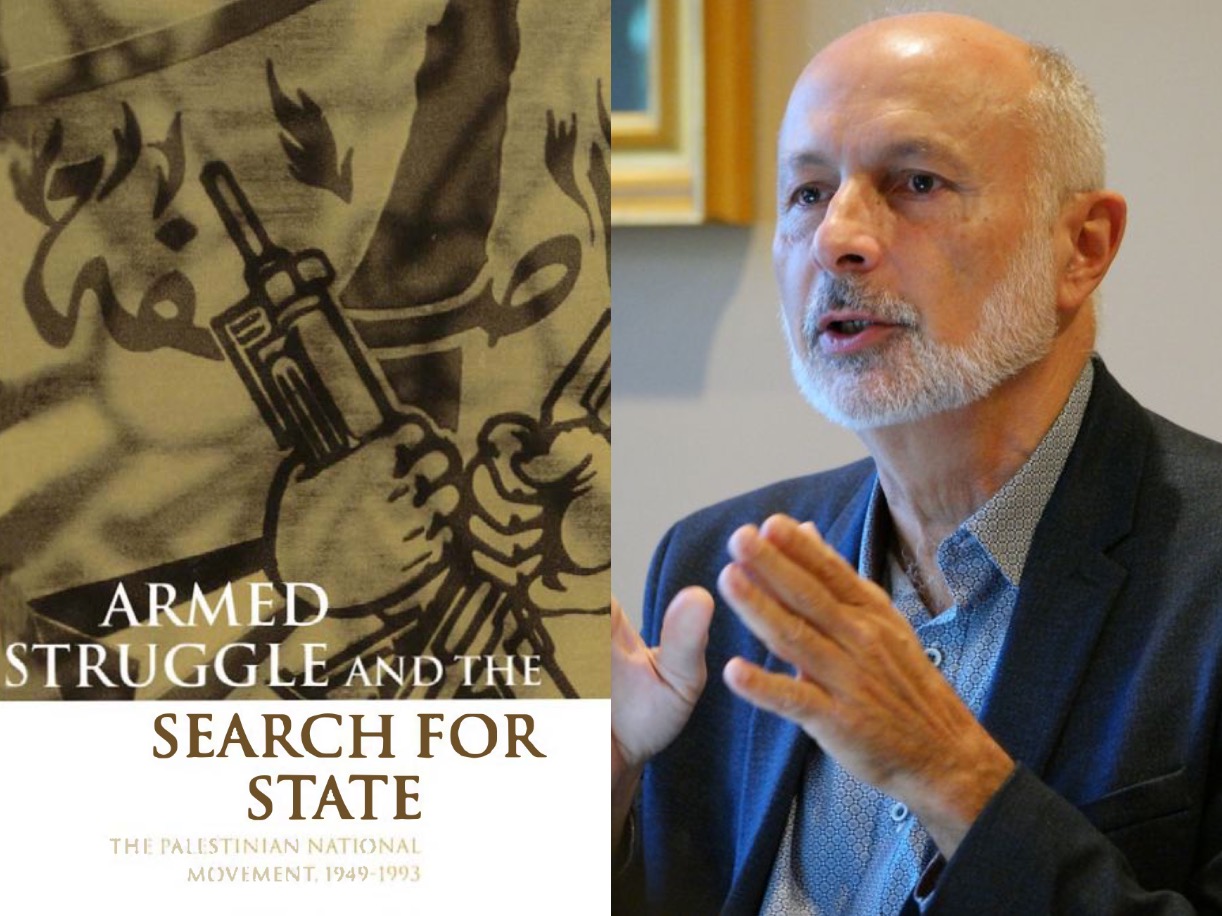الانتفاضة الأولى كانت نقطة تحوّل جديدة غير متوقعة لقيادة منظمة التحرير في الخارج، وبإمكاننا اعتبارها طوق نجاة لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية، لكن تعامل قيادات المنظمة وحركة فتح معها كان ملتبسًا إلى حدٍ ما، كيف لنا أن ننظر إلى الطريقة التي تم تجيير فيها الانتفاضة وأخذها نحو مؤتمرات سلام وما نتج عن هذه المؤتمرات بعدها؟
أريد الانطلاق من حيث أنهيت إجابتي على السؤال السابق، وهو أنه ما بعد الاجتياح الإسرائيلي وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، فقد أغلق فعليًا فصل كامل في التاريخ الفلسطيني المرتبط بشكل مركزي بفكرة وشعار وممارسة الكفاح المسلح، الظواهر العسكرية لم تنته، لكن فعليًا الكفاح المسلّح انتهى عام 1982.
كل الحروب والعمليات والمعارك وماشابه التي تمت في أي ساحة ومن قبل أي جهة، كانت صراعات مختلفة تمامًا، صراعات فلسطينية – فلسطينية، فلسطينية – عربية، عربية – عربية.
بالطبع كانت هناك عمليات فدائية هنا وهناك، لكنها كانت بسيطة ولم تعد هي الطابع الغالب للعمل، ولم تعد تستحوذ على حصة كبيرة من جهود الكادر الفلسطيني في الفصائل، أي لم يعد العمل العسكري والكفاح المسلح هو الشغل الشاغل للقيادات الفلسطينية رغم تمسكهم اللفظي به مثلًا أو الإصرار على بقاء السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، أو الشعارات عن البندقية وما شابه.
فعليًا، الكفاح المسلح انتهى، كانت هناك عمليات استعراضية هنا وهناك، وأخرى بحرية من الخارج إلى الداخل، وكذلك عملية ديمونة عام 1988 التي حكمت على خليل الوزير أبو جهاد بالاغتيال، (كانت بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى الإسرائيليين)، كل هذه العمليات كانت بسيطة. ومن الملفت بالمناسبة في هذا السياق، بما أني ذكرت خليل الوزير، ففي الأسابيع الأولى من اندلاع الانتفاضة الشعبية في داخل الأرض المحتلة، في كانون الأول / ديسمبر عام 1987، فقد فهم بأن هناك نمط وأداة جديدة لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي وأن هذا الشيء ليس الكفاح المسلح. وكونه براغماتيًا، فإنه إن أتيحت له فرصة القيام بعمل عسكري فسيقوم به، لكنه فهم أن العمل العسكري لم يعد الأول والأهم، وأن كافة الاشكال النضالية الأخرى القاعدية الشعبية الجماهيرية السلمية وأيضًا السياسية والإعلامية، هي واردة، وشرعية، وضرورية وهي الأهم، إلى حد فهمه أنه لا بد من الحوار مع الإسرائيليين.
أنا لا أتكلم عن قناعة بالتحليل فقط، بل عن معرفة بأن هذا الموضوع كان واردًا عنده.
كان هناك ربط بين الأداة وهي أسلوب العمل الانتفاضي وما بين إمكانية التفاوض مع إسرائيل، أي ربط ما بين الهدف السياسي والعمل الميداني، حيث لم يكن العمل الميداني هدفًا بحد ذاته بل هو أداة، وهذا ما نسيه الكثير من الكادر الفلسطيني فصار الكفاح المسلح وكأنه هو الغرض والهدف، وهذا خطأ فادح.
الانتفاضة الأولى خلقت أشياء إيجابية جدًا على كل المستويات، ولكن أيضًا ألقت بتحدي ومعضلة بالنسبة إلى قيادة منظمة التحرير في الخارج. أمثال خليل الوزير، لم يكن لديهم أي مشكلة، بل على العكس، قاموا بدعم الانتفاضة بكل الأشكال وتعاملوا وتفاعلوا معها بكل إيجابية، وكان أبو جهاد تحديدًا لديه حلم أن تكبر الانتفاضة من ثم ينتقل إلى الداخل ليقودها من هناك. فهذا شخص كقيادي واضح يعتبر أن الميدان الأساسي هو هناك، وعليه الانتقال إليه وليس العكس. هنا فعليا صرنا نرى اختلاف المسار عند ياسر عرفات بشكل مهم، فقد كان أهم شيء بالنسبة لعرفات هو التأكيد على الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادتها المعترف فيها والذي كان هو على رأسها، كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين أينما كانوا. وكان يعتبر الاعتراف بهذا الشيء هو المصدر الأهم للقوة السياسية، وأن أي شيء من الداخل يجب أن يدعم هذا الاعتراف وليس أن يُنقص منه.
من هنا، كان لدى عرفات خوف كبير من أي ظهور في داخل الأرض المحتلة قد يؤدي عمدًا أو بغير عمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الانتقاص من تمثيلية المنظمة، أو الصفة التمثيلية الشخصية له.
حروب المخيمات في لبنان هي مثال واضح على ذلك، حيث كان يستخدم هذه المعارك ليحرج الجهات الفلسطينية الأخرى وخاصة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والذين كان مقرهما في دمشق، وليحرج الجزائر وليبيا واليمن الجنوبي لدعمهم لتحالف الصقور المعادي له على الساحة الفلسطينية. أي انّه استخدم موت الآلاف في المخيمات في لبنان ليحرج حلفاء الأمس وليفرض عليهم التراجع وليعزل نظام حافظ الأسد، وهذا ما نجح في القيام به بالنهاية. وحين اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، كانت سَبقًا بالنسبة له، فهو يملك هذه النظرة، وإلى حد كبير فقد نظر إلى الانتفاضة من ذات المنظور أو العدسة.
صراع عرفات الأهم كان أن يستغل الانتفاضة من جهة لكن أن يمنعها من أن تخرج عن سقف معين أيضًا.
هناك خيط يربط بين ياسر عرفات في تلك اللحظة -فقد كان من المهم له أن يسيطر على هذه الظاهرة الجديدة في الداخل، وبالتالي ضمان سيطرته عليها وعدم خروجها عن سقف معين كيلا تشكل تحدياً أو بديلاً لقيادة المنظمة- وبين حملات تشهير وتأويل تجاه الوفد المفاوض الفلسطيني بقيادة حيدر عبد الشافي ووجوه هامة مثل حنان عشراوي وفيصل الحسيني. فهم لم يذهبوا إلى مدريد وواشنطن إلاّ بتفويض من ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لكنهم واجهوا أيضًا التشهير والاشاعات المغرضة والتي كانت موجهة بالنهاية أيضًا من عرفات نفسه وبعض القيادات الأخرى في تونس التي كانت تشعر بالغيرة. وكنا نسمع كلاماً تافهاً وبشع مثل انتقاد حنان عشراوي كونها امرأة وبرجوازية، وليس فقط عن حنان، بل عن أي شخص اتخذ دور تخشى القيادة الفلسطينية أن يحرمها من وجودها ودورها.
وهنا أريد أن أشير إلى شيء لم أذكره بالماضي لأي شخص آخر، وقليلون فقط من يعرفونه، فقد كان والدي يقود مشروعاً قامت به المؤسسة الاقتصادية لمنظمة التحرير المعروفة بــ”صامد” برئاسة أحمد قريع أبو علاء، والذي كان يمثل مشروعاً كبيراً يضم حوالي 70-80 خبيراً اقتصادياً فلسطينياً برئاسة والدي يوسف صايغ، وذلك لإعداد خطة تنموية لإعادة البناء والتنمية في فلسطين، وأقصد الكيان الفلسطيني الذي سينشأ عن المفاوضات مع إسرائيل التي انطلقت بعد مؤتمر مدريد وبعد أوسلو. كان والدي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية مباشرة كرئيس الوفد الذي تفاوض مع الجانب الإسرائيلي بعد اتفاق أوسلو حول العلاقات الاقتصادية وتحديدًا حول المعونة الدولية، وهو الذي تفاوض مع البنك الدولي ونجح في رفع سقف المعونة الدولية من 1.8 مليار إلى 2.4 مليار دولار، ولكن، لأنه -والدي- كان حريصًا بكل صراحة على منع ياسر عرفات من أن يضع يده على هذه الأموال لكي لا يستخدمها بالأسلوب الزبائني الإرضائي الذي شاهدناه لعشرين أو ثلاثين عامًا في لبنان وغير لبنان، فقام بالتفسير مباشرة لأبو عمّار أن هذه الأموال لن تكون على شكل نقد يحول للحساب الخاص برئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بل ستأتي بشكل مختلف تمامًا ولن تمر من خلاله. وقد رافق هذه الأحداث أيضًا تحريض داخلي من قبل بعض الموسوسين في محيط ياسر عرفات، وانتهى الأمر بأن أبو عمّار اقتنع أنه كان بإمكانه أن يأخذ هذه الأموال كنقد لولا يوسف صايغ، وحدثت حملة تشهير وصلتني أنا من قبل بعض الأشخاص قائلين؛ “انتبه، هناك كلام عنّك وعن والدك، وأن أبو عمار التقي ببعض رجال الأعمال أو بعض الجهات السياسية في القاهرة أو في تونس، وراء أبواب مغلقة ويقولون عن يوسف صايغ أنه عميل إسرائيلي”. وإن دلّنا هذا الأمر على شيء، فهو يدلنا على العقلية التي كانت تلك الأيام وإلى أين وصل بها التفكير.
هذا يعني أن أسلوب عرفات انتقل معه إلى الداخل بعد أوسلو، ولم يختلف شيء؟
إن الفكرة الأساسية التي حكمت أسلوب ياسر عرفات في التعامل مع الميدان الفلسطيني منذ لحظة الانتفاضة الأولى وما بعدها، فمع دخوله إلى الأرض المحتلة، وتأسيس السلطة الوطنية وترأسه لها، استهدف بناء السيطرة الداخلية القوية في داخل الساحة الفلسطينية من خلال الأدوات المتعددة وأهمها الأداة المالية. فاستخدم التوظيف كما عهدناه في لبنان في السبعينيات والثمانينيات حيث كان يستخدم أسلوب “التفريغ”، أي وضع الشخص على ملاك إمّا فتح أو الجبهة الشعبية أو منظمة التحرير الفلسطينية كمتفرغ يقبض راتباً شهرياً وله تقاعد وما إلى ذلك. أي كان العنصر الأول للولاء بالنسبة له هو أن يرتبط الجميع ماليًا بقيادة المنظمة أو قيادة فتح، وهناك جانب معقول في ذلك، حيث لا يمكن أن تقوم بحركة شعبية فيها عشرات الآلاف وتهمل الاحتياجات المعيشية للمناضلين والكادر والأسرى وغيرهم. لكن بالمقابل أصبح نمط التفريغ والتوظيف هو نمط زبائني، أي أن المنتفعين هم الذين يدخلون على الملاك. وقد اتسع النمط أضعافًا مضاعفة فور قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أي أصبح كل شخص مر على السجن وقضى أسبوعًا أو عشر سنوات، أو أي مناضل حقيقي أم غير ذلك، أصبح يشعر باستحقاقه للوظيفة، أو الرتبة له ولعائلته وأقاربه.
كان ياسر عرفات يشجع هذا الشيء، حيث كان عوضًا أن يكون معتمدًا على بعض الاستثمارات ومنها استثمارات فاشلة في الخارج، وبعض المعونات العربية وخاصة الخليجية منها، أصبح لديه قاعدة ضريبية في الداخل من خلال القيمة المضافة وضريبة الدخل والجمركية تقدر بمئات الملايين من الدولارات بدل العشرات منها، وهذا الشيء استخدم لانتقال الادارة المدنية التي ورثها من الإسرائيلين من حوالي 8-12 ألف موظف أن وصلوا حوالي 180 ألف موظف، وهذا منح كل من هو قائم على هذه السلطة قدرة هائلة على ممارسة السيطرة الاجتماعية والسياسية.
هذا النمط هو الذي كان سائدًا بين العام 1994 وعام 2000. وعوضًا عن أن يكون هناك بناء مؤسساتي حقيقي من الداخل، أصبح هناك بناء زبائني ونفعي وشللي من جهة. وكان هناك كفاءات ومهارات هائلة في الداخل وهذا ما جعل البناء المؤسسي الأول ناجحًا إلى حد كبير، ويجب علينا ألا ننسى ذلك، لكن في ذات الوقت أصبح هناك إضعاف تدريجي وتقويض للبناء المؤسسي وتقوية للبناء الأمني الزبائني الشللي وكلّه بهدف السيطرة الداخلية.
للأسف الشديد، وبصراحة شديدة، المسألة ليست فقط ياسر عرفات، فلم يبق طرف ربما إلا الجهاد الاسلامي وحركة حماس، وليس بالكامل حتى هؤلاء، لكن كل الفصائل الأخرى الفدائية وغير الفدائية مثل الحزب الشيوعي الفلسطيني، أصبحوا جزءاً من هذه السلطة وبالتالي جزءاً من “الكوتا” ونظام المحاصصة وما زلنا نرى ذلك حتى اليوم.
ماذا عن الانتفاضة الثانية، لماذا لم تكن نقطة انطلاق من جديد؟
انتقادي الشديد للانتفاضة الثانية، والتي لا اعتبرها انتفاضة، بل اعتبرها همروجة مسلّحة، فقد همّشت الشعب والدور الجماهيري، وهمشت كل الأساليب غير العسكرية في النضال. وهي ما أعتبره المحطة الرابعة والأهم بعد الحرب العالمية الأولى ونكبة عام 1948، هزيمة عام 1967، وثم الانتفاضة الثانية التي حكمت بإغلاق كل الأبواب، وأعتبرها جريمة في رقبة ياسر عرفات بشكل خاص وأيضًا في رقبة آلاف الآخرين الذين اندفعوا بشكل غير منظم في هذه الهمروجة.
العبرة الأهم هنا أن هذه الانتفاضة لم تُبن على تراث الكفاح المسلح، وأهم ما فيه ليس إطلاق النار، بل التنظيم والادارة والتدريب والتخطيط والإمداد. وعلى الرغم من أن هذا الإرث لم يكن عظيمًا، لكنه وضع جانبًا تمامًا منذ عام 2000 فصاعدًا وكأنه لم يكن. وثانيًا لا توجد ثورة أو حركة تحرر ناجحة في العالم انطلقت بعمل عسكري من دون إعداد قاعدي منظم وبناء حقيقي واستخدام واستنفاد لكل الأساليب النضالية الأخرى قبل الانتقال إلى العمل العسكري، ودون أن تكون هناك بناء قاعدة كبيرة من الخبرات والتجارب والأساليب والأدوات النضالية الأخرى الموازية والمساعدة.
كانت فترة 1994-2000 هي التي قدمت فرصة فريدة من نوعها، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية بكامل فصائلها وحتى الفصائل غير المنضوية مثل حركة حماس، كان متاحًا لها أن تعمل في العَلن خلال هذه السنوات الست، وأن تقارع الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الممارسات الاستيطانية بشكل سلمي وبشكل مفهوم عالميًا، دوليًا، وحتى إسرائيليًا من خلال معسكر السلام الذي كان في حينه يمثل نصف الناخبين الإسرائيليين. أي مع كل المآخذ على تلك الفترة، لكن كان هناك فرصة سياسية ذهبية لبناء عمل قاعدي وسأعطي مثالين على ذلك:
أولًا: لم أشاهد في أي يوم حركة اعتصام من كادر مدني فلسطيني مقدسي أو غير مقدسي، للقيام بوقفات احتجاجية في شارع صلاح الدين في وسط القدس الشرقية مثلًا وإغلاقه لنصف ساعة لإيصال رسالة مفادها أن الشارع لنا وليس لكم، أي أبسط الأشياء لم يقم بها أحد.
وثانياً وهو المثال الأخطر على ذلك، حين تم تدشين مستوطنة “هار حوما” أبو غنيم، ما بين القدس وبيت لحم، من تصدى له؟ تصدى له فيصل الحسيني، وصلاح التعمري، ولجنة الدفاع عن حقوق الأراضي، فقاموا بنصب خيمتين أو ثلاث أو أربع في منطقة على الجبل، واعتصم عدد لا يتجاوز 100 شخص لفترة اسبوعين. فأتساءل هنا، لماذا لم يكن هناك حشد جماهيري؟ أين كانت التعبئة؟ سمعنا إدانات من مختلف المسؤولين والقادة الفلسطينيين في داخل السلطة وخارجها، من مؤيديها ومعارضيها، أين كان الحشد الجماهيري؟
حركة فتح التي تباهت بعدد أعضائها حيث كنت اسمعهم يقولون لدينا 600-700 ألف عضو. إذن، على الأقل قوموا بإحضار واحد على الألف منهم، 700 شخص فقط، أحضروهم إلى جبل أبو غنيم. فإذا كان شغلكم الشاغل بناء كيان مستقل ومقارعة الاحتلال والاستعداد للمجابهة (ليس بالضرورة العسكرية أبدًا)، فقد كان واجبًا الإعداد لها جيدًا، مقارعة الاحتلال بشكل يومي على كل جبهة. ففي تلك اللحظة كان ممكناً لأي شخص فلسطيني وأي مسؤول فلسطيني أن يدخل إلى أي مكان في إسرائيل، وأن يذهب إلى مدرسة أو جامعة أو أن يستضاف في القنوات التلفزيونية، تلك كانت فرصة مذهلة لمقارعة سياسية وإعلامية مباشرة، لا أعني فقط أن تقنع العالم بالإعلام فقط، بل أقول أن هناك صراع، لكن الصراع المادي أو العسكري على الأرض دون صراع سياسي لا يعني شيء.
الهبّة الأخيرة التي شهدناها صيف 2021، كانت مؤثرة وفعّالة على مستوى عالمي، لماذا لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب من قبل القيادة الفلسطينية؟
لازالت فلسطين تعاني من مشكلة، وهي أن الجميع يريد أن يُلقي عبء تحرير فلسطين على أي حراك أو هبّة، أو إثبات صحة مقولاته، مقولات عدم الاعتراف، أو التحرير الكامل، أو غيرها، سواء فتح أو حماس أو غيرهما. فإنهم يريدون تحميل هذه الهبّات كل شيء، وهذا خطأ كبير وفيه انتهازية عالية بنظري، وكلفته موت الكثير من الناس الذين من المفترض ألاّ يموتوا، أو ألاّ يموتوا بهذا الشكل أو لهذه الأسباب.
بالنظر إلى هذه الهبّات فإنها تدلّنا على شيءٍ واحد فقط، ألا وهو فقدان القيادة، والتخطيط، والحلول.
أنا لا أقول إنها خطأ من حيث البعد التاريخي أو الاخلاقي، لكن هناك مشكلة حقيقية أننا بعد حوالي ستين عامًا من النضال أصبح العمل العفوي، أو العمل الهبّاتي هو النمط، فهل يعقل أن ننتقل من آخر التاريخ إلى أوله وليس العكس؟ أي أن نبدأ بالأشكال الجنينية والتي تعتبر جيدة جدًا، لكنها، بالنهاية إن كانت هي السقف، فسوف نبقى مهزومين.
وهنا أقصد مرة أخرى أنه لا يوجد فصيل فلسطيني بالمطلق، وبالأخص سأذكر حركة حماس وربما الجهاد الاسلامي، لكن حماس هي الأهم قطعًا، فحالياً لا يوجد أي فصيل قفز عن سقف الأداء السياسي الاستراتيجي الذي رسمته حركة فتح خلال آخر ستين عامًا، الأمر الذي يعني بالنهاية أنه مهما يقال عن “أننا لن نعترف، ولن نصالح ولن نفاوض ولن ولن”، ومهما يقال عن حق المقاومة، فهو لن يتجاوز السقف.
حركة حماس يمكن أن تكون جدّية أكثر من فتح، فهي تملك منهجية أكثر وضوحًا، لكن التحسينات في الأداء هي جزئية وتفصيلية، فهم مثلًا يطلقون الأسلحة بشكل أدق، لكن ليس هذا فقط ما يهم. الأهم هو استخدامهم للأداة العسكرية هو استخدام تفاوضي، تستخدم كأداة في الصراع والحوار السياسي، لا يوجد لديهم مشروع أكبر. فمثلًا نسمعهم يقولون إنهم سيحررون فلسطين بعد مائتي عام، لكن هذه ليست استراتيجية. وللذكر، فإن حماس صادقة أكثر من فتح بأنها مستعدة أن تقوم بهدنة لمائتي عام ويصبح هناك تعايش مع إسرائيل، الأمر الذي يعني أنهم معترفين بهذا الشيء كواقع. فإذا كانوا مستعدين لذلك وبإمكانهم أن يضعوا خطة التحرير الكامل على بُعد مائتي عام، فلا توجد مشكلة بينهم وبين إسرائيل، لأنهم فعليًا يتعاملون مع واقع يعرفون سقفه. إذن، فليتصرفوا على أساسه، وكل التهويشات الأخرى التي تحدث ويقع فيها موت وقتل وإطلاق نار أو تلقي نيران هو لعب على الهوامش. فلنكن واضحين وصريحين، أنه لا أحد خارج عن هذا السقف، لا أحد بالمطلق.
أخيرًا، هل بإمكاننا أن نحلم بإصلاح وإعادة هيكلة منظمة التحرير؟
الإجابة المختصرة هي كلا.
إن منظمة التحرير الفلسطينية ككيان ظهرت وأخذت كينونتها ووقعها على الفكر الفلسطيني والمخيلة الفلسطينية بظرف تاريخي معين ومحدد والتقت فيه ظروف داخلية وذاتية فلسطينية وأخرى عربية إقليمية ودولية لم تعد موجودة اليوم.
هذا لا يمنع أن يكون هناك بناء من الداخل، لكن إن كان الهدف هو أن تنشأ منظمة تحرير فلسطينية لها تمثيل حقيقي لكل الفلسطينيين سنبقى نصطدم بذات الجدار، وهو كيفية تمثيل الفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن وأمريكا وبريطانيا وكل مكان، فلا يوجد إمكانية لتجاوز هذه النقطة، وإن كان هناك فرصة لتحويل السلطة الفلسطينية كممثل للجميع وليس فقط للفلسطينيين المقيمين في الداخل، وهي مسألة خلافية، لكن ذلك ليس حلّا سهلًا.
طالما لا يوجد مشروع تحرري أو نضالي متفق عليه فلسطينيًا، فكيف يمكننا مأسسة هذا الشيء وأن تكون له كينونة وصفة قانونية أو سيادية أو دولية؟ أظن أن هذا الحوار المتعلق باعادة بناء المنظمة مفيد ومهم لأنه يقودنا إلى السؤال الأهم وهو ماذا نريد؟ كيف نصل إلى ذلك؟
وإن كانت الفكرة أساسًا هي الحفاظ على هوية موحدة فهذا شيء، أما أن تكون كأداة نضالية فهذا شيء آخر، لكن أن يتم جمع كل هذه الجوانب والأبعاد في كيان جديد يقدم الحد الأدنى المشترك أو القاسم المشترك كما فعلت منظمة التحرير في الماضي، فإن هذا الطرح فيه تجاهل بأن منظمة التحرير كان لديها قاعدة في لبنان، أي في بلد مضيف اضطر لتقويض سيادة الآخر أو وحدة البلدان المضيفة لكي يخلق كياناً في الداخل وهو أمر خلافي وانقسامي أيضًا. وهذا بالطبع غير ما نعيشه من انقسام بين الضفة والقطاع الحالي، فأنا لا أرى أن إصلاح المنظمة أمر جائز اليوم، حيث أننا في مرحلة تاريخية لن تُجيز هذا الشيء، وأعتقد أن الحوار لن يؤدي إلى أي حلول.
بالإضافة إلى ذلك فأن واقعنا العربي المحيط مليء بالمشاكل، ونحن لا نختلف عنه أيضًا، ولا أرى أي طريقة لحلها. نحن نمر في مرحلة تاريخية تشهد تراجع فكرة الدولة القطرية في لبنان وسورية والعراق وعدة دول عربية أخرى خاصة تلك التي عانت حروب. فهي عمليًا، تتخلى عن دولانيتها، يعني مثلا لا تنظم الأسواق، ولا المعاملات في داخل المجتمع بين الجهات أو الأطراف أو المستهلكين والمنتجين، هناك تخلّي حتى عن العملة الوطنية وتخلّي عن توفير الأمن وتوفير السلع الأساسية، مثل الكهرباء والوقود والغذاء والدواء والماء. فالدولة اللبنانية والسورية والعراقية والليبية وحتى الجزائر اليوم ليس باستطاعتها توفير عملة جزائرية للمواطن الجزائري، والسودان كذلك.
إذًا هناك مشكلة حقيقية عربية اليوم، ومن هذه النقطة سأختم بأن الفلسطينيين اليوم يحاولون بناء كيان في زمن اللاكيانية.