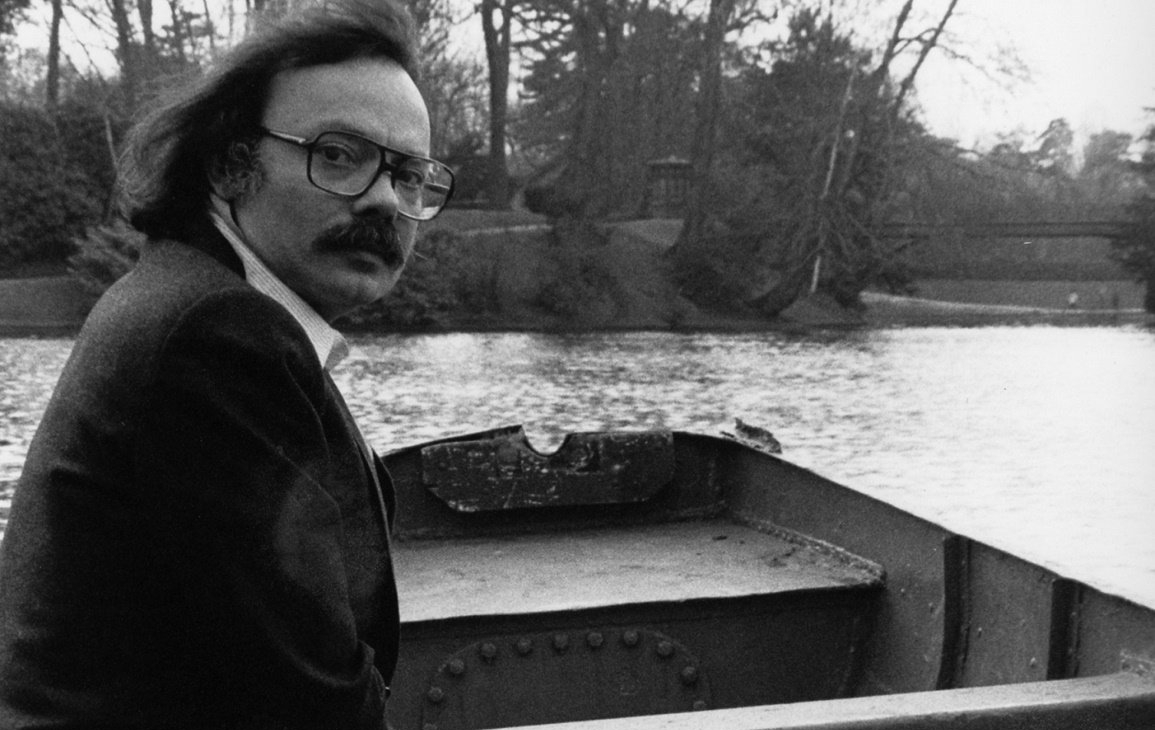حين قرأت للمرة الأولى اسم غادة السمان كان عام 1995 في حوار مع مجلة “كل الأسرة”، وكنا نقيم بالإمارات، أحببت إجاباتها على الأسئلة، وكنت في الفترة ذاتها اقرأ للكاتبة أنعام كجه جي، وأديبات أخريات ومرت علي كغيرهن، ولكن صورتها الغريبة في المجلة ضلت عالقة في ذهني بحدقتيّ عينيها اللتين كانتا كأنهما محفورتين على ورق المجلة.
في صيف العام ذاته ذهبنا زيارة إلى قطاع غزة، لبيت جدي في مخيم رفح، وهناك كنت أبحث عن ذاكرة طفولتي خلال الانتفاضة عبر التأمل بكل الأشياء حولي، ولكن كان أوسلو قد غير كل شيء، وترك علاماته على الناس إلى الأبد.
عزائي الوحيد وقتها كان يكمن في زيارة مكتبة خالي أحمد عبدالله الغول، هذا الشاب الصغير حينها، الذي كان يعيش عالما في مكتبته مختلف تماماً عما يحيط به من قسوة الحياة، وكان قد درس آداب اللغة العربية في جامعة الناصر في ليبيا، فكانت مكتبته ثمينة وفريدة بكل ما فيها من كتب اجتماعية ونفسية وشعرية ومراجع وروايات كلاسيكية؛ طاغور، وتولستوي، وهمنجواي، ونابوكوف، ولوركا، وديكنز، وغوتة، وهوجو، وفرويد، وابن المقفع، والشهرستاني، والجاحظ، وكنفاني، وجبرا، وجبران، وسحر خليفة، ودرويش، حوالي ثلاثمائة مؤلف يقبعون هناك، كأن أحداً لن يزحزحهم يوماً.
ووسط كل هؤلاء الأدباء العظام، كانت غادة السمان تبدو كملكة، تستوطن رفين كاملين. كان خالي يحب قلمها، فقد كان هناك أكثر من عشرين كتاباً لها، لم أسأله يوماً لماذا هي؟ يبدو أنه لا محل لهذا السؤال، فغادة كانت لها سطوتها بجرأتها وسردها ولغتها، على النساء والرجال.
كما كان لها سطوة عاطفية أيضاً، فقد كانت فائقة الجمال، وهذا لا يعيبها بشيء، كانت تقول عن جمالها “إنه صدفة، ليس لي يد به”، كما كانت تقول عن شهرتها بسخرية “ماذا يعني؟ المكنسة الكهربائية مشهورة أيضاً”.
ربما لم تكن رواياتها تتمتع بالموهبة ذاتها كما في مقالاتها الأدبية والسياسية وتحقيقاتها الصحافية، وإجاباتها على أسئلة المقابلات التي أُجريت معها ونشرتها في أكثر من كتاب؛ أحدهم “القبيلة تستجوب القتيلة”، وكان من ضمن الصحافيين أذكر جيداً اسم أحلام مستغانمي، يأخذ دوره في قائمة الحوارات.
بدأت ذلك الصيف أقرأ أحد كتبها، ولكن سرعان ما عدنا إلى الإمارات لأعود إلى المعتاد من مكتبتنا التي اعتبرتها عادية نسبة إلى مكتبة خالي؛ رجعت إلى نجيب محفوظ ويوسف إدريس وموجز مقدمة ابن خلدون ونظرات المنفلوطي، وليس هذا لأن مكتبتنا كلاسيكية أو محافظة بل لأنه ببساطة لم نجد كتب غادة السمان وجبران وكنفاني، على الأقل في المكتبات المحيطة بنا.
في نهاية عام 1996 عدنا نهائياً إلى المخيم، وحينذاك انتظمت في قراءة بقية كتبها، وكانت كلها معنونة ضمن سلسلة أعمالها غير الكاملة عن دار نشر “منشورات غادة السمان” التي تتخذ البومة شعارها، فغادة لا تعتبرها تشاؤمية كما هو دارج.
لقد أثرت بي، واكتشفت لاحقاً أنها أثرت بالكثيرين من عمري ولا تزال، فهي مرحلة من أعمارنا لا بد منها، نقرأها، نتأثر بها، كما لا بد من تجاوزها أيضاً.
قرأت مجموعاتها القصصية منها “عيناك قدري، لا بحر في بيروت”، رواياتها ومنها “ليلة المليار، كوابيس بيروت”، ولم أحبها كما أحببت روايات سحر خليفة وجبرا ابراهيم جبرا، ووليام غولدنغ، ولكني عشقت مقالاتها الأدبية التي تتخيل فيها حوارا مع الأدباء والفلاسفة، أحببت نقدها للعادات الاجتماعية الكاذبة في لبنان والعالم العربي، اعترافها بالحب، تمردها، نقدها لمجتمعها، حديثها عن والدها الشيخ وعائلتها في سورية، سباحتها في نهر بردى وذكريات طفولتها هناك.
لماذا الأمر يختلف مع غادة السمان؟ فيتجدد الهجوم الآن وبقوة مع نشرها لرسائل الشاعر اللبناني أنسي الحاج إليها، ومن المؤكد أنها تعتبر هذه الرسائل إرثاً شخصياً، لكنها أيضا تدرك أهمية تخليد كلماته وحالاته ومشاعره، كما من المؤكد أنها تدرك كم سيساء إليها حين تنشر هذه الرسائل؟ كما حدث في تسعينات القرن الماضي حين نشرت رسائل كنفاني.
حين أرى كتبها الآن بتلك الطبعة القديمة؛ أشتم رائحة تلك المرحلة، ليست غادة في بردى أو على كورنيش بيروت أو في مقاهي شارع الحمرا أو تائهة في لندن، بل أنا في حيرتي ذلك الزمن، ورائحة بيت جدي الذي تتوسطه شجرة الكولونيا، وصوت صرصار الليل… لقد دلتني في حيرتي الصغيرة تلك، وكم من المهم أن يدلك أحد ما كاتب أو فنان أو موسيقي أو شيخ في حيرتك عند عتبة أولى خطوات الوعي، لأنك حتماً ستكون بعدها في حيرة أكبر لن تجد فيها من يدلك على الإطلاق..
ولقد بقيت أقرأ لها حتى السنة الأولى في جامعتي، وكنت ختمت القراءة مع كتاب “رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان”، ولم أشعر أبداً أنه يختلف عن السياق العام لكتب هذه المتمردة الجميلة، ولكن حبي لغسان ازداد وقتها، فقد كنت أحمل تلك الفكرة الكلاسيكية عنه؛ الكاتب الوطني الثائر الذي حافظ في كتبه على بطولة المهمشين والفقراء من أبناء المخيم، لكن حين التقى عالمه بعالم غادة الفكري الذي يتحدث عن مشاكل لبنان والمجتمعات المنفتحة على الحداثة، كان الأمر مثل السحر، كأنها أعطتنا الإذن لدخول مناطق لم نكن أبدا لنكتشفها في غسان لولا هذه الرسائل.
إنه ذلك المُحب الشغوف المرهف، فتكتمل أسطورة الوطني المقاوم الذي استشهد في تفجير سيارته بالحازمية في بيروت عام 1972، مع جانبه المحب العطوف الذي كشفته رسائله. وكانت غادة أوضحت أنه كان بينهما اتفاق “من يموت أولاً ينشر رسائل الآخر”.
الغريب في الأمر أنه بعد كل هذه السنوات على نشر رسائل كنفاني، يتغير توجه النقد والنقاش، فقد كتب كثيرون وقتها عن أنانية السمان بنشر رسائل كنفاني وأنها شوهت ذلك الجانب الأسطوري منه، ليتحول اليوم في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الرجل الذي خان زوجته وأساء إليها، ونصبوا أنفسهم أوصياء على زوجته التي لم تتحدث يوما بالسوء عن غادة أو رسائل زوجها.
إنه تضييق الخناق على الأدب، ومحاكمته بمنظور عائلي وقبلي متعالي، لتبدأ المحاكمات العلنية لهذا الثلاثي دون خجل؛ غسان خائن، غادة أنانية بكشفها لخيانته، زوجته المحبة آني تستحق الشفقة.
كيف تواءمت نظرة هؤلاء وغالبيتهم من المثقفين الليبراليين واليساريين مع نظرة أعداء الانفتاح والأدب والحب، ألا يوجد كاتبات وكُتاب وقعوا في الحب خلال علاقاتهم الرسمية، وحولوا هذا الحب إلى روايات وشعر وأحيانا سيرة ذاتية؟
لماذا الأمر يختلف مع غادة السمان؟ فيتجدد الهجوم الآن وبقوة مع نشرها لرسائل الشاعر اللبناني أنسي الحاج إليها، ومن المؤكد أنها تعتبر هذه الرسائل إرثاً شخصياً، لكنها أيضا تدرك أهمية تخليد كلماته وحالاته ومشاعره، كما من المؤكد أنها تدرك كم سيساء إليها حين تنشر هذه الرسائل؟ كما حدث في تسعينات القرن الماضي حين نشرت رسائل كنفاني.
أين الخطأ في تحويل الشخصي إلى العام؟ وهل تفعل الكتابة غير ذلك، سواء في الأدب عموماً أم في أدب الرسائل والسيرة الذاتية خصوصاً؟
ألم تشكل رسائل كنفاني جزءاً مهماً من وعينا العاطفي؟ كم مرة راسلنا مُحبينا ونحن نحمل في ذاكرتنا رسائل غسان، ونعتني بكل حرف كأن رسائلنا ستخلد يوماً لتصبح ملكاً للبشر والأدب؟
أليس نحن الآن في عصر مشاع اختفت منه الخصوصية بسطوة التكنولوجيا و”السوشيال ميديا”، فيومياً هناك ملايين صور السكرين-شوت والفيديوهات التي تنشر بإذن أو دون إذن، مستبيحة تفاصيلنا بفداحة لا يمكن التراجع عنها؟!
لماذا الآن نعترض على كتاب هو فعل أدبي بكليته، هل لأن امرأة نشرته، أم لأننا أصبحنا أبناء زماننا المحافظ، فلم نعد نقبل باعترافات الحب الصريحة خاصة من رجل؟ ليصبح هذا الحب والتحرر وتلك الرسائل وغادة ذاتها أبناء بيئة أخرى لم نعد ننتمي إليها ولا تنتمي إلينا. فيبقى الخفاء أفضل من العلن.. وما يحدث من فيضان الخصوصية اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الالكترونية ما هو إلا تسلية وأشياء ليست جدية، بينما فعل الكتابة الأدبي دائما له دوي الفضيحة، والقلم كأن به مس من الشيطان ممنوع عليه التعبير والاعتراف، ويبقى أقل تورطاً لو كان ذلك الاعتراف يبث في تدوينة عابرة، أو في فيلم وثائقي أو روائي.
يعتبرون أن المرأة إذا نشرت رسائل الرجل تبحث عن الشهرة، وتريد أن تستعرض أمجاد أنوثتها، أما إذا فعلها الرجل فهو غير شريف، لأنه يفضحها، هل من المعقول أننا نفكر بالأدب والأدباء بهذه الطريقة أم أنها سطوة العيب والعار والشك التي طغت على كل شيء حقيقي وصادق في حياتنا؟ من الغريب أنه كلما زادت هذه المشاعية الإلكترونية الحداثية يزداد معها التخوين والاتهام وفقدان الثقة والتصنيف الأخلاقي.
حين كتب محمد شكري سيرته العبقرية “الخبز الحافي”، وبقيت عشرة أعوام حبيسة الأدراج، بينما نشرت بالفرنسية والانجليزية، لتنشر عام 1982، أول مرة باللغة العربية، ويذاع صيتها في التسعينات، لم يسلم شكري من أقلام هؤلاء الذين لا يتذكر أحد أسماءهم اليوم، لقد عابوا عليه صراحته، وسرده لتفاصيل عائلته، وفضحه لقسوة الحياة على الفقراء، كما فعلوا الشيء ذاته مع ادوارد سعيد حين كتب عن طفولته وتيه الشباب، وعلاقته بوالده في سيرته “خارج المكان”.
الكتابة غالباً هي فعل خيانة لكل ما حولنا ومن حولنا، إننا نستحضرهم دائما سواء بأسمائهم الحقيقة أو غير الحقيقية، فنكتبهم ونستوحي منهم، وتكون قصصهم مصدر الإلهام الحي.
إن الأسرة التي بها كاتب تظل تدفع ثمن ذلك سواء أرادت أم لم ترد. لا أعتقد أن إيزابيل الليندي حين كتبت “حصيلة الأيام” استأذنت كل فرد في أسرتها كي تكتب عن حياته وأخطائه وعيوبه ومآلاته. إنها صيرورة الأدب، وفعل الخيانة المستمر كي نشارك العالم تلك العبارات والجمل ونعيش تلك الحيوات فلا يكونوا وحدهم حين يحزنون ويتألمون ويندمون.
إن غادة السمان تعود إلى الواجهة اليوم، وهي تستقبل عقدها الثامن، ومن يتهمها أن ذلك كان مقصدها منذ البداية هو ذاته من أعاد وضعها هناك، حين سخر وشتم، وقليل منهم من نقد.
إن الفخر في الجهل وتعميمه أمر عجيب، ولكن لا أحد يستطيع السيطرة على التكنولوجيا، أو يضع محاذير لها، إنه سوق الأداء الحر والشتم الحر والمعرفة الحرة، وليس عليك سوى مضغ الحزن وابتلاع الألم لأن كل ما كان يوماً مؤثراً لديك، وكل ما كان في أجيال سابقة علامة.. يجب أن نستعد اليوم كي يتحطم ويتقزم وتتم السخرية منه بأحط العبارات.
كيف لا ونحن في عصر “الآن” إذ يبدأ كل شيء وينتهي فقط في اللحظة التي نفكر بها بالمنشور “البوست” إلى أن نضغط زر النشر، فنستقبل اللايكات والتعليقات، ثم لا شيء قبل النشر أو بعده، لا ماضي لهذه الفكرة، ولا مستقبل يرجى منها.
إنه استعباد التكنولوجيا للحشد، فتردد الجماهير عبارات الكورال ذاتها، إن غادة السمان ولدت فقط قبل يومين.. شتمها هذا الجمع، ثم أماتها، إنه المجتمع المرآوي المهووس برؤية ذاته تتضخم مع كل منشور يحمل اسمه وصورته.
الآن ليست معي كتب غادة.. زادي في ذلك الزمن، لم يعد لمكتبة خالي العزيز وجود، احترقت مع الاجتياح الإسرائيلي لرفح عام 2003، ولم يستطع أحد الذهاب إلى هناك وإنقاذها، حين ذهبنا إلى البيت بعد أن انتهى الاجتياح كانت شجرة الكولونيا، و”اسبست” سقف البيت، والكتب كلها كأنها عجينة “طينة حرة” قديمة.
خالي اليوم أستاذ لغة عربية، وحصل مؤخراً على ماجستير في النقد الأدبي، والأهم أن عنده ابن اسمه غسان، وابنة اسمها غادة، فهذا خلود آخر، وأتذكر أنني قلت يوماً ممازحة: “لكنهما لم يكونا إخوة يا خالي.. بل كانا حبيبين”.