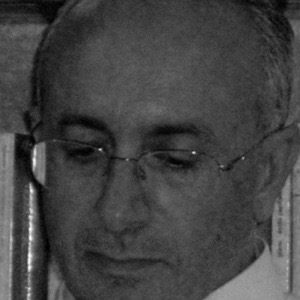تقديم
للوهلة الأولى، قد يكون الحديث عن “المدينة الفاضلة” مثاراً للاستغراب في زمن “الرذيلة” والجريمة والذي تتحول فيه المدن العربية في أيامنا هذه لمسرح مأساوي لممارسة التدمير والقمع والقتل المنظم والعشوائي من قِبلِ أنظمة العسكر والطائفية والقوى الجهادية والظلامية ومن قبل الدولة الصهيونية في فلسطين.
هل مدن الفوضى ومدن العطش ومدن العنف المُعَمَم والعنف الموجه ضد النساء تحديداً، يمكن أن تتحول إلى مدن فاضلة؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن “الفضيلة” في مدنٍ محكومة بعصابات الميليشيات الطائفية وبعسس أجهزة الاستخبارات و”الزعران” و”البلطجية” و”الشبيحة” و”الفلول” وما شابه.
ألا تستدعي الفضيلة نقيضها والذي يلخصه واقع عربي معاش لا يمتُ إلى الفضيلة بصلة؟
وهل “الفضيلة” بالمطلق، ودون الارتباط بهذا السياق العربي والإسلامي، ممكنة التحقق والتجسد في الممارسة؟
St. Augustin كان من أوائل من تميز في النقاش حول “الـ مدينة الـ فاضلة” ولكن فيلسوفنا اللاهوتي ذاك، قدّم المدينة الفاضلة بصفتها “مدينة الله” السماوية مُلقياً بذلك شكوكاً ضمنية حول إمكانية تحقُقِها كـ ”مدينة الإنسان” الأرضية والدنيوية، مدينة الشرور والغلبة والمآثم.
وقبل ذلك بكثير، قدم لنا “أفلاطون” جمهوريته التي لا بدّ وأن تكونَ فاضلةٍ بدورها. “جمهورية أفلاطون” وإن لم تكن تُمثّل مدينة سماوية، كانت ترسم ملامح مدينة فاضلة و”مِثالية” مُنتمية إلى حقلٍ مُتَخَيل خارجِ الممارسة الإنسانية بواقعيتها المُريعة وبدمويتها الفظة.
هل مثالية وطوباوية الفضيلة يُخرِجُها من حقل الممارسة إلى حقل المُتَخَيل مُجَرِداً لها بذلكَ من البُعد “السياسي”؟ بكلمات أخرى، هل يمكن أن نقارب الفضيلة سياسياً؟ وهل “المدينة الفاضلة” تشترِطُ “سياسة فاضلة”؟ وإن كان الجوابُ بِـ “نعم”، فما هي السياسة الفاضلة؟
الجذر الإغريقي ـ اللاتيني للديمقراطية المنقوصة
من المؤكد أن التراث الفلسفي الغربي المعاصر ارتكزَ في نظرته للفضيلة على الإرث الإغريقي ـ اللاتيني وذلك منذُ أن أكدَ “أرسطو” على أن الفضيلة هي الفضيلة الأخلاقية بامتياز وتحديداً في حقل التنفيذ والتطبيق والممارسة (الشجاعة، الشهامة، العفو، الاستقامة). “أفلاطون” من جهته، أضاف إلى الفضيلة بُعداً معرفياً إذ قدّمَ الثقافة والمعرفة كعناصر ضرورية لبناء “الجمهورية” الفاضلة، جمهوريةٍ تسودها المعرفة والحكمة والعدالة و”السعادة” أيضاً. لقد كان هذا التراث الفلسفي هو المرجعية التأسيسية لِرجال الفكر والفلسفة واللاهوت في أوروبا العصور الوسطى كَـ “توماس الإيكويني“ (القرن الثالث عشر) والذي عَبّر بقوة عن حالة التواصل والاستمرارية هذه ما بين الماضي الإغريقي ـ اللاتيني وأوروبا ـ عصر النهضة وصولاً لمرحلة “ما بعد الحداثة” في زمننا الراهن.
St. Thomas d’Aquin الأرسطي واللاهوتي الكاثوليكي معاً، منحَ الفضيلة بعداً سياسياً عمومياً وذلك لربطه إياها بمفهوم “العدالة” إذ أن “العدالة” هي الفضيلة الوحيدة من بين الفضائل المتعددة والتي لا يمكن أن نمارسها بمفردنا إذ أن ممارستها ترتبطُ وتشترطُ حضور “الآخر” وهذا الحضور هو “جوهر السياسة” المُنَظّمة لحياة الفرد ضمن الجماعة. وعدالة السياسة، أو بكلمات أخرى، “السياسة العادلة” هي السياسة الوحيدة الكفيلة بضمان الأمن الاجتماعي وهي أكثر أنواع السياسات فعالية لتحقيق التوازن الضروري للحياة المجتمعية.
السياسة العادلة إذن، هي السياسة البناءة في سبيل بناء المدينة الفاضلة والمدنية الراقية وذلك عبر فرضِ الأمن الضروري للحياة في مجتمع إنساني، أمناً يكفلُ دحرَ الشرور والعدوانية والقلاقل المُتَرَتبة على طموحات الغلبة والقهر والتي قد يمارِسها فريق (طبقة اجتماعية، نخبة متعلمة، نخبة عسكرية، فئة طائفية أو جهوية) ضد الفريق الآخر (و/أو ضد المجتمع الكلي) في سبيل فرض هيمنته وتحكمه واستئثاره بمقاليد الحكم والثروة.
السياسة العادلة ضمن هذا المنظور هي سياسة الاعتدال والتأني والتَفَكّر وقبول الآخر المُختلِف والمُتمايِز وهي سياسة السلوك التفاوضي كبديلٍ للسلوك العنفي لحل الصراعات ولتهميشِ التناقضات المُتَرَتِبة عن تضارب المصالح المادية والرؤى الدينية والفلسفية لهذا ولِذاك.
في هذا السياق، تبرزُ السياسة الفاضلة كسياسة العدل الاجتماعي (العدلُ السياسي والاقتصادي) والتصالح والتقاسم والتحكم بالغرائز الفردية والجماعية وتحكيم العقل ضد سيطرة العواطف الفردية والدينية والقومية بما هي عواطف أنانية جوهرها التعالي والتكبر والاستئثار والتحيُز والمحاباة.
أما تحكيم العقل فمن شأنه “أنسنة” السياسة ورفع مستواها الحضاري وذلك عبر تكريس قيم الرصانة والحكمة لمقاومة حُمى الجنوح “الغريزي” نحو الحرب والثأر والانتقام والتعصب مما يجعلُ من السياسة الفاضلة بالجوهر تكريساً لحضور “أناً عليا” جماعية وفردية في صلبِ العملية الاجتماعية. حضور “الأنا الأعلى” كجوهر ٍ للممارسة السياسية هو رديف حالةٍ من “الوعي الأخلاقي” الضروري للاعتراف بالآخر وبحقه بالاختلاف، وعياً ـ مُحَرّكاً لقيمٍ رفيعة من التسامح والتواؤم والتفكير الحر والسليم والمُعافى كحاجزِ فعّال ضد الأمراض الأخلاقية والعقلية لأجهزة القمع الرسمية وللمتطرفين والقتلة على اختلاف مشاربهم ممن لا يكترثون بأي فضيلة.
فرضُ وتطبيق الفضيلة يبرز هنا كمعركة مستمرة لإقرار إنسانيةٍ غيرُ ناجزة. معركةٌ ضد القوى الغاشمة والنزعات التسلطية القوية الكامنة في النفس الإنسانية إذ أن هذه القوى والنزعات شديدة المراس لرسوخها في أعماقٍ دفينة. مواجهة ومُحاربةِ هذه النزعات المُعرقلة لبلوغ الكمال الأخلاقي لإنسانيةٍ حقة هي جوهر هذه “الثورة المستمرة” ضد الذات وجنوحها وانحرافاتها التدميرية.
في هذا السياق، كان Stendhal (القرن التاسع عشر) مُحِقاً عندما قدّم الفضيلة كموقفِ تَقَبُلِ مكابدة العناء والقيامِ بجهدٍ يحملُ فائدةُ للآخر وذلك على تضادٍ مع الجهد الفردي الهادف إلى تحقيق المصلحة الذاتية لمن من يقوم به. جوهر التضحية كقيمة فاضلة هو التضحية من أجل الآخر بناءً على حكمٍ عقلاني وإرادي وواع، وارتباطُ “الوعي” و”الإرادة” والاختيار” و”العقل” بالفضيلة هو ما أكد عليه “سبينوزا” Spinoza (القرن السابع عشر) بتعريفه للفضيلة بما هي “طُرق العيش والسلوك المتطابق مع العقل واشتراطاته”.
Montesquieu (القرن السابع عشر) في كتابه “روح القانون” أحدثَ نقلة نوعية في مفهوم الفضيلة وذلك عبر القيام بـِ “تسييسه” بِشكلٍ أكثر خصوصية مما قامَ به “توماس الإكويني”، ناقلاً إياه من الحقل الثيولوجي إلى الحقل السياسي الحداثي إذ اعتبرَ أن أكثر الفضائل أهمية هي فضيلة ” حب الوطن والعمل على تحقيق المصلحة العامة”، ولذا، فإن الفضيلة بصيغتها هذه هي المبدأ الناظم للديموقراطية.
Emanuel Kant من جهته، اعتبر أن الفضيلة هي ثمرة للتفكير السليم بينما نقيضتها من الرذيلة فهي ثمرة للتفكير الآثم، ورغم انتماء “كانط” لحقبة عصر النهضة (القرن الثامن عشر) فقد سار على خطى “توماس الإكويني”، اللاهوتي الكاثوليكي سابق الذكرِ وتأثرَ بعمق بالفلسفة “الأرسطية” والتي أكدت على أن الفضيلة هي تجسيدٌ لعنصري “الاعتدال” و”الرصانة” في مواجهة فقدان السيطرة والتطرف والسعي نحو الغلبة والنفوذ. وهكذا، يمكن اعتبار الفضيلة كجوهر للمنظومة الأخلاقية وكحاجزٍ فعّال ضد الانحراف نحو البربرية الكامنة في أعماق الإنسان. التفكير السليم والرزين والمعتدل قد يلجمَ تلك الغرائز البدائية في بحثها عن إشباع آنيّ لاحتياجاتها دون اعتبار “الآخر” ومصالحه وحقوقه المتضررة جراء هذا اللهاث المستميت والقاتل. “الآخر” وحقه بالوجود وبالحياة هو ما تحميه وتضمنه أخلاقيات “الأنا الأعلى” ضد طغيان علاقات القوة المتغولة في الغابة “اللا ـ إنسانية”.
أخلاقيات الفضيلة هذه هي تشذيب للنفوس وللسلوك لكي يتم أنسنَتَها عبر إخضاعها لقوانين الأديان والفلسفة والأخلاق والثقافة، ولذا، فهي أداة تربوية لبناء الإنسان السليم في مجتمع الوئام والتسامح والحكم الراشد.
وهكذا، مثلت فكرة “الفضيلة” نوعاً من الاستمرارية ما بين الفكر التنويري لعصر النهضة الأوروبية والفكر الكنسي وذلك على الرغم من حالات “القطيعة المعرفية” ما بينهما وهذا التقاطع وهذه الاستمرارية جعلت من “الفضيلة” ذات دلالاتٍ لاهوتية وقُدُسية وحداثية ٍ علمانية معاً.
بالمقابل، كانت الممارسات الاجتماعية والسياسية للكنيسة والتي لم تتطابق بالغالب مع “الأخلاق المسيحية” التي تبثها والتي تُؤكِد على أهمية الفضيلة، سبباً لأفول وبهوت مفهوم الفضيلة المسيحي دون أن توجه له الحداثة التنويرية هذه ضربة قاصمة لاجتثاثه من الجذور.
جملة التطورات الحداثية لمفهوم الفضيلة على يد فلسفة التنوير أضعفت من هالات القداسة المسيحية والدلالات الدينية التي ترتبط به (الإيمان والإحسان والرأفة وعفة النساء وعذريتهن) دون أن تعملَ على نقضه وإزاحته بالكامل من مجالات تنظيراتها وكأن علاقة حميمة ومتينة تربط ما بينه وبين الخطاب الديني اللاهوتي الآفل بالوجود مما جعلَ مِن “مأسسةِ” مفهوم الفضيلة الحديث عنصراً سياسياً مركزياً في النظام “الديموقراطي” المُتَخَلِص من شوائب الأيديولوجيا اللاهوتية ولكنه أيضاً عنصراً مضطرباً ومتناقضاً بِفِعلِ حبل السرة الرابط ما بينهما.
هذا الاضطراب والتناقض في مفهوم “الفضيلة” عززه حضورِ “عيبٍ تكويني ” في الفكر الأوروبي مرده ذلك الجذر الإغريقي ـ اللاتيني ذاته، ذلك الجذر المُساهم بقوة في إحداث وتحفيز النهضة والحداثة الأوروبية. ألم تكن “الديموقراطية الإغريقية” ديموقراطية منقوصة وذلك لكونها “ديموقراطية” مُقتصرة على الذكور “الأحرار” مُسُتَبعِدة بذلك للنساء من حقلها؟

مدينة ومدنية “الديموقراطية” الذكورية الـ “لا ـ فاضلة”
معاداة النساء في “الديموقراطية” الأثينية تواصلت في اللغة وفي الحضارة اللاتينية اللاحقة لها ولم تكن قضية “الفضيلة” إلا إحدى تمظهراتها. طردُ النساء من جنة الديموقراطية اليونانية أعقبه طردهن من “الفضيلة” اللاتينية والتي يحتكرها جنس الرجال حصرياً. الجذر الاشتقاقي لمفردة “الفضيلة” vertu يعودُ إلى vir، أي الرجل والصفة vertutem هي صفة القوة الذكورية وما يُصاحِبها من ملامح “الشجاعة” و”الإقدام” و”الاستقامة” وهي صفاتٌ لا تتمتعُ بها النساء. أما الفضيلة نسوياً فهي تُختَصَرُ بفضيلة “العفة”، عفة المرأة وامتناعها الإرادي عن التمتع بالجنس “المُحَرم” إخلاصاً للرجل شريك حياتها وهذه العفة النسوية لا يقابلها عفة رجالية مُتَبادَلة تجاه المرأة. فضيلة العفة المُجَنسنة (sexed, sexué) هذه هي عفةٌ ذات اتجاهٍ واحد إذ لا تشترطُ على الرجال ممارسة الزهد والتقشف الأخلاقي تجاه المُتع الجنسية “المُحَرَمة”. فضيلة العفة افتقدت بذلك لصفة الشمولية وافتقادها لهذه الصفة ينتقضُ من مبدأ “العدالة” الناظم لكلِ فضيلة (العدالة كمبدأ شمولي لا يؤخذ بعين الاعتبار تمايز الأصل والجنس البيولوجي والدين).
فضيلة العفة بالمنظور الذكوري اللاتيني لا تلبي شرط العدالة في مدينة “العدل” الفاضلة ملتقية بذلك مع “لا ـ عدالة” مدينة الفضيلة للديموقراطية الأثينية المُعادية للنساء والمُستَبعِدة لهنّ من الحقل العام للمواطنة. وهكذا، اتفق الإرث اليوناني مع وريثه اللاتيني على صعيد اللغة والممارسة السياسية لبناء “مدينة فاضلة” و”ديموقراطية” ذات جوهرٍ ذكوري بامتياز.
التحليلُ الفذ الذي قدمته المناضلة النسوية الفرنسية” أنطوانيت فووك” حول “لا ـ ديموقراطية” النظام السياسي الغربي المُدعي للديموقراطية والرافع لراياتها والداعي لشعوب المعمورة باقتداء نموذجها يصلحُ هنا لمقاربة هذه الفضيلة الكبرى للمبدأ العلماني في الديموقراطية الغربية الناجزة. هذا التحليل الذي قدمته Antoinette Fouque يكشف لنا زور هذا الادعاء إذ لا يمكن أن تقوم قائمة للديمقراطية الحقة في نظامٍ لا يمنح النساء مساواة فعلية وجذرية في الممارسة وفي التطبيق على أرض الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. شعارُ النضال النسوي الذي رفعته هذه المناضلة نحو “العملِ على دمقرطة” “الديموقراطيات” المُدّعاة يتعارضُ مع الإعجاب النرجسي بالذات الغربية وبعلمانية وديموقراطية الحضارة الغربية “الرفيعة” “التقدمية” و”المُتقدِمة”.
وهكذا، فإنَ “المدينة الفاضلة” كنسخة عن المدينة والمدنية الغربية بجذورها الاغريقية واللاتينية والمسيحية والعلمانية الحديثة ليست ولن تكون “فاضلة” بفعل غياب العدالة ما بين الجنسين فلا فضيلة بدون عدالة مطلقة وشمولية. غياب العدالة هو رديف الفساد الأخلاقي وسيادة منطق علاقات القوة والغلبة والنفوذ واغتصاب حقوق الضعفاء من الجنسين ومن جميع الشعوب وسلب النساء حقوقهن واخضاعهن للديكتاتورية الذكورية.
على ضوء هذا الاستعراض التاريخي، التحليلي ـ التفكيكي لإشكاليات الفضيلة “المستحيلة” في الحقل الأوروبي والغربي والتي صاحَبَها استخدام ذلك الكم الهائل من الإنتاج الفلسفي لتحليلها ولتجميلها وتزويق و”تسويق” محاسنها، هل يمكن للحضارة العربية ـ الإسلامية الادعاء بوجود نوعٍ آخر من الفضيلة، نوع لا تشوبه إشكاليات نظيراتها الغربية؟ وهل “الفارابي” ومدينته الفاضلة يمكن أن يُشكل مرجعاً فلسفياً لفضيلةٍ خصوصية و”نموذجية” بنكهةٍ عربية وإسلامية؟
“أبي نصر الفارابي” وتقديم الفلسفة على الشريعة في «المدينة الفاضلة”
من المؤكدِ هنا أن العودة إلى هذا الفيلسوف الفذ (القرن العاشر الميلادي) لن تكون حنيناً لماضٍ عربي ـ إسلامي ذهبي لبناء حاضر يُحاكي هذا الماضي المُتَخَيَل إذ أن فيلسوفنا هذا كان له السبق في مساءلة “النبوة” و “الشريعة” عن مرتكزاتهما العقلانية وذلك اعتماداً على هضمه للفلسفة اليونانية، هضماً واستيعاباً دَفَعَ بـِ “ابن سينا” للاعتراف علناً بأنه لم يفهم “أرسطو” والذي قرأه أربعين مرة إلا بعدَ قراءته للفارابي. ولكن، من الضروري هنا أيضاً عدم الاندفاع في إعجابنا بهذا الفيلسوف لكي نُحَمِله ما لا يحتَمِل كما سبق وأن عُومِل “ابن خلدون” والذي حمّلنا فكره السوسيولوجي ما لا يطيق من إسقاطاتٍ حداثية مُتَسرِعة.
الفارابي كان فيلسوفاً متشبعاً بالفكر الإغريقي وقد كان شديد التأثر بمنطق أرسطو، ذلك المنطق الناظم والمولد للقوانين “التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يُغلَطُ فيه من المعقولات… وهي القوانين التي تحفظه وتحوطه من الخطأ والزلل في المعقولات”. ولكن، تجاور “المنطق” و”العقل” وقوانينه في تنظير الفارابي لم يكن دافعاً كافياً لإحداث قطيعة ما بين “العقل” و”التأملات الروحانية” في فلسفته. وهكذا، كانت مقولات العقل الفلسفي لدى الفارابي تتعايش ومقولات العالم الروحي مما يؤدي كنتيجةٍ حتمية إلى الجمعِ ما بين “النبوة” و”الفلسفة” واستطراداً على ذلك الجمعُ ما بين “الحكمة” و”الشريعة”.
ملامح هذه الفلسفة الفارابية تشي بالتناقض بفعلِ طابعها “التوفيقي”، فمن جهة، أكدّ الفارابي على أن مرتبة “الفيلسوف” هي أعلى من مرتبة “النبي” (يا للهول، سوف يصرخُ إسلاميونا المعاصرين وسوفَ يستلُ السياف الإيراني والوهابي ونظيره الداعشي سيوفهم لجز الأعناق) وبأنَ مرتبة “الفلسفة” أعلى من مرتبة “الشريعة” والتي يجبُ أن تَخضعَ فيها الثانية للأولى في السعي نحو بلوغ الكمال والسعادة.
جرأة الفيلسوف هذه والتي قد تدفعُ بنا لتمجيده كفيلسوف عقلاني وعلماني بامتياز وسابق لزمانه قد تجدُ في مواقف أخرى للفارابي تدعيماً للقيامِ بمحاولة إسقاطٍ حداثيٍ على فكره وفلسفته، ألم يتعارض والخطاب الديني السائد في زمنه من قضية “الخلقِ من عدم”؟ الفارابي اعتبرَ أن “الموجودات الطبيعية تبتدأ ناقصة ثم تترقى شيئاً فشيئاً إلى أن تبلغ مرحلة الكمال”. بكلمات أخرى، يمكن القول بأن هذا التنظير يتعارض مع الخطاب الديني حول خلق الكون من عدم، فالخلقُ من عدم يعني أن الخلق حدثَ مرة واحدة ونهائية مُنتِجاً مخلوقات متمتعة بالكمال والاكتمال منذ بداياتها الأولى وليس كمالُها نتاجاً لِحركةٍ من النمو والتطور والرقي.
وهكذا، هل إقرار الفارابي بأن مرتبة الفيلسوف هي أعلى من مرتبة النبي، وبأن الفلسفة أعلى مرتبة من الشريعة وبخلق الكون وتطوره على الشاكلة الداروينية (رغم التسعة قرون التي تفصل ما بينهما)، بأسباب كافية لوصفه بفيلسوف العقلانية الإسلامية؟ بالتأكيد، تحدث الفارابي عن بلوغ الكمال بما هو جوهر السعادة والتي هي “المعرفة العقلية”. بلوغ الكمال هذا، أي تحصيل السعادة بما هي “غاية روحية خالصة” و”كمال عقلاني” إنما هو فعلٌ إنساني “إرادي” و”اختياري” (الملكات الإرادية للإنسان) وليس بفعلٍ تقعُ أسبابه وعلله خارج إرادة الإنسان (تطبيقاً لإرادة ربانية وانقياداً لقوانين سماوية). في تصريح “خطير” منسوب للفارابي قوله فيه بأن “السعادة في هذه الحياة وفي هذه الدار وكلّ من يذكر غير ذلك فهو هذيان وخرافات عجائز”.
لقد “تمادى” الفارابي في علمانيته عبر الفصل ما بين “السياسة” و”الدين” وفي عقلانيته الفذة ولكن، هل شعر بالخوف من هذا التمادي؟ خوفاً دَفَعَ به إلى تخفيف حدة العقلانية في فلسفته والتي عبر عنها لاحقاً بمحاولاتٍ توفيقية على شاكلة المساواة ما بين الفيلسوف والنبي بعد أن كان وسبق أن وضع الفيلسوف في مكانةٍ أعلى من النبي؟
بالطبع، لا نملك جواباً لهكذا سؤال افتراضي ولكن يمكننا القول بأنَ تناقضات الفارابي ما بين التفضيل أحياناً والمساواة أحياناً أخرى ما بين النبوة والفلسفة وما بين الشريعة والحكمة قد تعكس بصورة واضحة هذا التثاقف الفلسفي ما بين الحضارة الإسلامية والإغريقية.
عبقرية الفلسفة الفارابية تكمنُ في التأكيدِ على إمكانية التحقق الفعلي الناجز للسعادة الإنسانية وذلك عن طريق “العقل” و”الفضيلة” في “الحياة الدنيا” وليس في “الآخرة” فقط. إحكامُ العقل في الموجودات واتباع طرق الفضيلة في الممارسات هي نشاطات إنسانية واعية واختيارية.
جوهر النشاط الإنساني الاختياري الواعي هو جوهرٌ “سياسي” فالمدينة الفاضلة لا يمكن أن تقوم لها قائمة بمعزلِ عن هذا العامل السياسي إذ أن المدينة الفاضلة هي تلك المدينة المرؤوسة من رئيس يُجَسّد في ذاته شخصية “النبي” و”الفيلسوف” معاً. حضور “الحاكم ـ النبي ـ الفيلسوف” هو الشرط التكويني للمدينة الفاضلة بما هي قمة الكمال الإنساني وأعلى درجات الحضارة.
وقد عَدَدَ الفارابي خصال الرئيس الإثنتا عشر كالتالي:
- أن يكون تام الأعضاء
- أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور، جيد الحفظ لما يفهمه ويدركه
- جيد الفطنة ذكياً
- حسن العبارة
- محباً للتعليم والاستفادة
- غير شره في المأكول والمشروب والمنكوح
- محباً للصدق وأهله مبغضاً للكذب وأهله
- كبير النفس محباً للكرامة
- أن يكون الدرهم والدينار وسائر أغراض الدنيا هينة عنده
- أن يكون بالطبع محباً للعدل وأهله مبغضاً للجور والظلم وأهله
- أن يكون عدلاً غير صعب القيادة ولا جموحاً ولا لجوجاً
- قوى العزيمة جسوراً غير خائف ولا ضعيف النفس
خصال “الفيلسوف ـ النبي ـ الحاكم” للفارابي رغم تقدمها على زمنها تظلّ خصال “الحاكم ـ الذكر” على غرار الديموقراطية الإغريقية “العادلة” ذكورياً والمُستبعِدةِ للنساء من حقل ممارستها السياسية. وهكذا، فإن “تقدمية” الطرح الفارابي في مدينته الفاضلة لا تصلح لزمننا كما لم تكن صالحة لزمانه. عقلانيته هذه تبقى عقلانية ذكورية تتجاهل وجود النساء في الحقل المنظور وكأنّ أهل المدينة الفاضلة هم من جنس الرجال فقط. الرئيس الفاضل للمدينة الفاضلة هو رئيس ونبي وفيلسوف لعالم الرجال كما هي الديموقراطية الأثينية الـ “لا ـ عادلة“. هل مدينتنا العربية المستقبلية “الفاضلة” هي “مدينة الذكورةـ الفائضة”؟ مدينة التحرش الجنسي وبرقعة النساء وقمع حريتهن بالعيش وبالوجود وبتقاسم الحقل العام مع الجنس “الفاضل” من الرجال؟
خلاصة
بهذه الإطلالة على جذور “الهيمنة السياسية للذكورة” يمكن لنا أن نستشرف تناقضات الخطاب “الديمقراطي” والتي تحملُ في رحمها جذوراً تتنافى مع مبادئ الديمقراطية الحقة ومع اشتراطات العلمانية السياسية الفاصلة ما بين الدين والدولة إذ ليس هناك من ديمقراطية حقة في ظل استثناء النساء من حقلها وليس هناك من ديمقراطية حقة دون علمانية فاصلة ما بين النظام السياسي (الذي تُجسده الدولة) و”الشريعة” الدينية المُدَعية بأحقيتها في تنظيم شؤون الدولة والمجتمع (نظرية “الإسلام هو الحل” الصالح لكل زمان ومكان كدين ودنيا).
بكلمات أخرى، ليس هناك من ديمقراطية بدون الحقوق النسوية وبدون العلمانية. ديمقراطية لا سيادة فيها للذكور ولا سيادة لرجال الدين فيها على السياسة وعلى الدولة. دولة المواطنة للرجال والنساء دون تمييزٍ يُذكَر ودولة المواطنة الحيادية بمواجهة الدين والمؤسسة الدينية فالدولة لا دين لها وليس لها جنس ذكوري أو أنثوي.
تراجع “الفارابي” عن مبدأ “الفيلسوف ـ الحاكم” إلى مبدأ “الفيلسوف ـ النبي ـ الحاكم” كان بمثابة “الهزيمة” لهذه المحاولة الفلسفية الرائدة في التاريخ العربي ـ الإسلامي، هزيمة لا نزال ندفع ثمنها الباهظ ليومنا هذا.
نعم، يمكننا التأكيد على أن المدينة العربية الفاضلة قابلة للتحقق في ظل نظام سياسي علماني ديمقراطي: مدينةٌ خالية من آثام الجرائم الصهيونية والطائفية والذكورية ومن جرائم أنظمة العسكر. مدينة “ولاية المواطن” بدلاً من “ولاية الفقيه” شيعياً كانَ أم سنياً. مدينة ـ دولة المواطنة العلمانية الديمقراطية وليس مدينة ـ الدولة الإسلامية (بنسختيها الإيرانية والداعشية) أو اليهودية في فلسطين وفي المنطقة العربية عموماً.