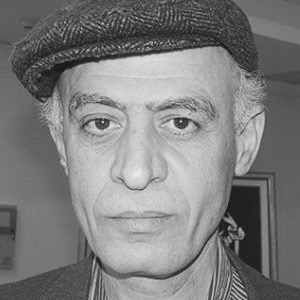ينتمي سليم البيك صاحب رواية «تذكرتان إلى صفورية»، 2017، إلى الجيل الروائي الفلسطيني الجديد الذي ولد في المنفى. وتعد روايته -مثل روايات فلسطينية عديدة أخرى كتبت في المنفى- استمراراً لكتابات الرعيل الأول من روائيي المنفى الذين عبروا عن تجاربهم وتجارب شعبهم، مثل غسان كنفاني وجبرا ابراهيم جبرا، وفيما بعد رشاد أبو شاور ويحيى يخلف وأحمد عمر شاهين ومحمد الأسعد وابراهيم نصر الله وليلى الأطرش وآخرين.
ولد سليم البيك لأبوين فلسطينيين من مخيمات سوريا -ومثله بطل روايته يوسف الذي ولد في دولة الإمارات، وتعلم في مدارسها، ثم أكمل دراسته في جامعة دمشق حيث درس الأدب الفرنسي، وعاد إلى دبي ليغدو موظفاً في شركة تأمين لم يستمر عمله فيها طويلاً، فقد اختلف مع إحدى الزبائن، لتقرر الشركة، في وقت لاحق، إنهاء عمله.
في أثناء قراءة الرواية يتذكر القارئ روايات عديدة لكتاب عرب معروفين؛ فلسطينيين وغير فلسطينيين.
يتذكر القارئ روايات مثل «موسم الهجرة إلى الشمال»، 1966، للطيب صالح، و«رجال في الشمس»، 1963، لغسان كنفاني.
حين يقرأ المرء عن حياة يوسف في باريس يتذكر مصطفى سعيد في لندن وعلاقته بالمرأة، مع اختلاف بين التجربتين بالتأكيد، على الرغم من أن كلتا الشخصيتين كانتا محكومتين بمعاناة بلديهما من الاستعمار، ودفعتا ثمناً له، يمكن القول إنه كان أفدح بما لا يقاس في حالة يوسف الفلسطيني.
ولكن المرء مع تقدم قراءته ينسى «موسم الهجرة إلى الشمال» ليوازي بين تجربة يوسف وتجربة شخصيات رواية «رجال في الشمس» التي يستحضرها يوسف لأنه مر بتجربة مشابهة لتجربة إحدى شخصياتها، وهي شخصية أسعد .
كان أسعد نشيطاً سياسياً فلوحق من النظام الأردني واضطر إلى مغادرة البلاد إلى الكويت، وشارك يوسف في أحداث سورية التي اندلعت في 2011 وعرف أنه مطلوب، فغادر مخيم اليرموك.
وكما اختبأ رجال كنفاني في الخزان ليعبروا الحدود إلى الكويت، اختبأ يوسف في بطن الشاحنة ليقطع حدود بعض البلدان إلى هولندا التي يستقر فيها عمه المقاتل السابق في الجبهة الشعبية، وفي فرنسا يقرر يوسف أن يقيم فيها لأنه يتقن لغتها، ويتعرف إلى الفرنسية ”ليا“ التي تصبح وطناً له.
في 1979 اختلف محمود درويش مع قيادة المنظمة وغادر بيروت إلى باريس وكتب قصيدته “رحلة المتنبي إلى مصر“ وصارت قصيدته وطنه، وتصبح ”ليا“ وطن يوسف.
في المنفى يؤرق يوسف سؤال الهوية، وهو سؤال أثير مبكراً، منذ رواية غسان كنفاني «عائد إلى حيفا»، 1969، ورواية إميل حبيبي «الوقائع الغريبة … »، 1974، وسوف يستمر السؤال بالحضور وسيحضر في رواية سامية عيسى «خلسة في كوبنهاجن»، 2013، وفي رواية سليم البيك، وفي الأخيرة سيثار كما لم يثر في أية رواية من قبل.
“من أي بلد أنت ؟”و”من أي أصل أنت؟” وثمة معان ومغاز للصيغتين.

في دبي ينظر إلى يوسف على أنه سوري، وفي سورية ينظر إليه على أنه فلسطيني، وفي قسم الأدب الفرنسي يكون الطالب الفلسطيني، وحين يستقر في باريس ويحصل على جواز سفر فرنسي يقرر زيارة قرية جده صفورية، ويتخيل يوسف أنه سينظر إليه هناك على أنه الفرنسي الذي يزور إسرائيل .
والرواية تقول بخصوص سؤال الهوية أكثر مما اختزلته في أسطر.
وكما هُجّر جد يوسف من قريته صفورية وقاده القطار إلى دمشق يهاجر يوسف ويعاني الويلات ويركب بعد 63 عاماً قطاراً آخر.
شتات العائلة يتواصل ويتخذ شكلا أوسع، فالعائلة التي أقامت في 1948 مع عائلات من منطقتها المهجرة منها تتفرق وتسيح في هذه الدنيا، وهكذا تتسع رقعة المنفى.
والرواية مثل روايات عديدة أولى لكتاب عديدين غدوا معروفين. إنها رواية سيرية يقص فيها سليم البيك عن تجربة لاجئ فلسطيني تشابهت تجربته مع تجربته. ويستطيع المرء أن يعقد موازنة بين سليم ويوسف، بين المؤلف وبطله ليرى مقدار التشابه بينهما، بل ويمكن القول إن الرواية التي كتبت بالضمير الثالث/الهو هي رواية يلتقي فيها المؤلف والسارد وبطله الذي يقص عنه، فليس هناك ما يحدد ملامح خاصة للسارد تقول إنه مختلف تماماً عن المؤلف أو عن بطله، وهذا لاحظناه لدى إميل حبيبي في «خرافية سرايا بنت الغول»، 1990، بل ولاحظناه في رواية عبد الرحمن منيف الأولى التي لم ينشرها في حياته «أم النذور».
ثمة جانب آخر يلفت نظر قارئ رواية «تذكرتان إلى صفورية» هو أنها تأتي على حياة الفلسطينيين في أوروبا، فجزء من أحداثها يجري في فرنسا، وهذا يفتح الباب لمناقشة واقع الفلسطينيين في أوروبا في الرواية الفلسطينية.
ومع أن الكتابة عن الذات تبدو غير مستحبة إلا أنني أشير إلى روايتي «تداعيات ضمير المخاطب»، 1993، وإلى روايات لاحقة لسامية عيسى وتوفيق عزام أبو السعود وعيسى القواسمي وآخرين، على الرغم من أن المقاربات مختلفة.
إن الثنائية الأساسية في الرواية هي ثنائية المنفى/الوطن، وهي الثنائية التي تتحكم في حياة يوسف/سليم (كلاهما لاجئ ولد في المنفى وعاش أهله في مخيمات سوريا وعمل في الإمارات ودرس في جامعة سورية وهاجر إلى فرنسا واستقر فيها ومغرم بالسينما بشكل لافت، وكلاهما قريب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهمه فلسطين والعودة إليها…إلخ) وتحضر ثنائية ثانية حضوراً لافتاً هي ثنائية الشرق/الغرب، فسليم المهاجر إلى فرنسا يقارن في مواطن كثيرة بين الحياة في الشرق والحياة في الغرب: الطعام والعلاقات الاجتماعية والجنسية ولون الأعلام ودلالاتها في مخيم اليرموك وتشابه الألوان واختلاف دلالاتها في فرنسا، وهنا يتحدث عن العلاقات الجنسية المثلية في الغرب بانفتاح إلى حد لم نقرؤه في روايات عربية سابقة عالجت هذا الموضوع وأتت عليه.
وأستطيع شخصياً أن أوازن بين روايتي «تداعيات ضمير المخاطب» ورواية سليم، فما عبرت عنه بالإيحاء عبر عنه بلغة مباشرة وبدوال لا تلمح وإنما تصرح، وهذا ما قد لا يروق لبعض القراء. إنه يترك بطله يستخدم مفردات يستخدمها في الواقع كثيرون، لكن استخدامها في النصوص الأدبية موضع حذر من كتاب كثر، مع أن الشعر العربي ليس خلواً منها منذ زمن شعراء النقائض حتى مظفر النواب.
وأعتقد أن «تذكرتان إلى صفورية» قد تثير، حين تقرأ على نطاق أوسع، جدلاً مثل الجدل الذي أثارته رواية سامية عيسى «حليب التين».
وعموماً فإن الرواية مشوقة وتثير أسئلة مهمة، وهي نموذج للجيل الثالث من أدباء المنفى تتابع رحلة الشتات وتصور عذابات الفلسطينيين الذين ولدوا في المنافي ولا يعرفون إلى أين هم ذاهبون. إنها في هذا الجانب تقف إلى جانب رواية سامية عيسى «خلسة في كوبنهاجن».