ارتبط «حجر الورد» لديّ بذكرى خاصة حدثتْ في الأيام الأخيرة التي قضيناها في المستشفى برفقة حسين البرغوثي بعد أن أخبرنا الطبيب بصعوبة علاجه. وكان وقتها ما يزال متوهجاً بطاقته وقدرته على الحوار والمجادلة وفضول للمعرفة لم يخبُ تحت وطأة المرض.
ظلّ حضوره مدهشا حتى وهو في السرير، بذهنٍ متوقّد رغم الإنهاك الشديد نتيجة المرض والعلاج الكيماويّ. كنّا في الليلة الأخيرة متوقعين رحيله بين ساعة وأخرى، ونقضي الوقت في التدخين والصمت المتقطّع وانتظار شيء نخاف حدوثه. إلى أن بدأنا بسماع الدقّات على الشاشة الطبيّة تتسارع، فهرعنا حول سريره. اقتربتْ منه بترا وأمسكتْ بيديه وهي تبكي وتقول آخر كلماتها له. واقتربتُ منه حاملا نصّ «حجر الورد»، وبدأتُ بقراءته، كنتُ أقرأ عليه أحبَّ النّصوص إلى قلبه مع تقطّع أنفاسه الأخيرة. أقرأ دون توقّف أو انقطاع، وبصوتٍ عالٍ، وأقرأ حتى الإجهاد الذي يخالطه إحساس بفقدان وشيك. كنتُ أراه يموت، وكلماته تنهار من فمي على محياه، وهو مغمضٌ عينيه بوداعة الملائكة، وبوجهٍ شاحبٍ.
استمررتُ في القراءة كأنّها كانت الخيط الأخير الذي يربطه بالحياة، كما قال الصديق محمود أبو هشهش حينها. الأطباء والممرضون ينظرون من باب الغرفة إلى مشهد سرياليّ: “شخص يقرأ شعراً على شخص مريض يموت، يودّعه بكلمات غير القرآن”. بدونا لهم كمشعوذين. أقرأ “أتى كنبيٍّ ومضى كنبيّ من عالمٍ آخر ومن حلمٍ مختلف، علامةً بُعثتْ من قوى أعلى حتى هو لم يكن واعيا بها…”.
كنتُ أقرأ نصّه بأخطاء لغويّة فادحة من شدّة الإرهاق والتعب المتواصل والمتراكم منذ عدة أيام، وبسبب دمعتين كبيرتين التصقتا بعينيّ، لم أعد أرى الكلمات بوضوح من خلالهما، وأنا أنتقل من سطر إلى آخر، ومن صفحة إلى أخرى. وكان مفاجئا لي في تلك اللحظة أنّه لم يعبّر عن امتعاضه، أو يقطّب حاجبيه، فكنتُ بين لحظة وأخرى أنظرُ إلى وجهه متوقعّا إشارةَ غضبٍ منه كما هي عادته إذا أخطأ أحدنا في قراءة نصٍ أمامه.
بدت كأنّها محاولة أخيرة ويائسة لإعادته إلى الحياة بخطأٍ لغويّ! لكني شعرتُ للمرة الأولى أنني في مأمنٍ من نقده! وكان هذا مُريحاً ومُحزناً بشكلٍ قاسٍ في تلك اللحظة. وقرأتُ حتى لم أعد أشعر بصوتي، لم أعد أشعر بالكلمات، ولا من حولي، إلى أن توقّفتْ دقّات الشاشة!
ثراء اللغة
أوّل ما يشدّ الانتباه في «حجر الورد» هو اللغة التي يوظّفها النصّ. فهي تأخذ من الشعر كثافة العبارة، وثراء التشبيهات والاستعارات وغرابتها وعمقها. وتأخذ منه أيضا تعرّجاته اللغويّة وقفزاته البعيدة، كقوله “وكأنّه لم يكن يعي حدوده، كنهر يفيض” وقوله “ومحيطات أخرى ظلّت فيه خارج العبارة”. وتأخذ من النثر تدفّق السرد وانفلاته، وحريّة الوصف والتوالد المستمر. فالنص في النهاية مزيج من كلّ هذا: ليس رواية بالمعنى الحكائي للكلمة، فيفتقد لحبكة ولبناء نامٍ ومُرَكّب للشخصيّات، وليس قصيدة لأنّه في الأساس يروي قصّة تتفاعل فيها شخصيّات عدّة.
وتبلغ هذه اللغة ذروتها بما تحتشد به من هواجس وأفكار فلسفيّة ومآثر أدبيّة وقصص ميثولوجيّه متعددّة المشارب. جانحةً أحياناً إلى لهجة نبويّة في القول، مدفوعة بهاجس رؤيويّ يطمح إلى إعادة تعريف الأشياء، كقوله “الصوت سوط” و”الذاكرة متحفٌ ميتٌ” إلخ. وهذا النزوع الرؤيوي يأخذ شرعيّته الفكريّة والفنيّة من سلطة “المعلم”، الذي جاء كنبيٍ ومضى كنبيّ، صاحب القول ورأس الحكمة المُفترض.
بالإضافة إلى ذلك، يتخلّل السرد اقتباسات قرآنيّة وأدبيّة من النفري إلى ابن عربي والشعر العربي القديم. اقتباسات تصل غالباً إلى حدّ التقمّص، فهي ليست إضافات على النصّ بل جزء من بنيته. كوصفه لقدوم “المعلّم” بأنّه جاء من كهفٍ بعد أنّ نام فيه سبعة قرون. فالنص هنا لم يقتبس هذا القول القرآني فقط، بل اقتبس القصّة أيضا. لذا فهو يتجاوز فكرة الاقتباس إلى حالة التقمّص الكامل لهذه القصّة القرآنيّة وإدماجها في النصّ بحيث تصبح جزءاً من السيرة الشخصيّة لهذا “المعلّم” الذي يذهب إلى السوق بعملة قديمة ولا يتعرّف عليها أحد. كل هذه المعارف والرؤى التي تتقاطع في النص تجعل منه كما يقول حسين البرغوثي نفسه “سمفونيّة من الأصوات وأصداء التاريخ”. وهذا ما يجعل من لغة «حجر الورد» مشحونة بالإشارات، متعدّدة المستويات، مدهشة بجمالياتها، وعصيّة على التلخيص. ويقول حسين البرغوثي عن ذلك في حوار:
“كنتُ في «حجر الورد» أريدُ جملاً تشعّ بالإيحاءات، وكنتُ أسأل نفسي كيف أربطها، أنت – كقارئ – تربطها بالإيقاع الآخر. هذه مشكلتكَ أنت. فالجمل قابلة للربط. لا يوجد منطق بمعنى سبب ونتيجة لكي يربط هذه الجملة بتلك، أو بين فقرة وأخرى، أو أين بداية ونهاية عبارة وأخرى أو صوت وآخر”.
التاريخ كمسرح مفتوح
يبدو التاريخ أمام هذا “المعلم” أو “النبيّ” مسرحاً مفتوحاً، يتنقّل بين أزمانه وحُقبِه كأنّه يصعد الدرج من طابق إلى آخر، أو كمن ينعطف من شارع إلى آخر يليه. نجده في مقهى للعب النرد في تدمر القديمة، ثم نجده في قصر في أصفهان، ثم في بيت في طنجة وقبل هذا كان في كهف ونام سبعة قرون إلخ. يتنقل بين الحقب الزمنيّة برشاقة وتلقائيّة، ويندمج في حيوات شخصيّات عادية بسيطة وميثولوجيّة قديمة. ولأنّ كلّ نص أدبيّ يحمل في ثناياه ما يعلن عن هويته الفنيّة، فإننا نستشهد هنا بهذا المقطع الذي يشكل مفتاحاً مزدوجاً لبناء هذا النص ولشخصيّة “المعلّم” نفسه:
“وأدركتُ لاحقاً أنه يرى العالم بطريقة مختلفة، فيرى العالم متزامناً، ما حدث قبل عشرة آلاف سنة، ربما في زاغروس، موجود في ذاكرته كغرزة تطريز بقرب غرزة أخرى هي ما يحدث عندنا الآن في أصفهان، فالأزمنة متجاورة وليست متتابعة”. ويضيف السارد قائلاً: “ولذا تكلّم عن حياته التالية، وعن أين كان في حياته السابقة، وبدا كعالم ينهض من أنقاض عالم”.
فهو يعيش الأزمنة كلها دفعة واحدة، الماضي متاح، والحياة السابقة، والماضي الموغل في القدم أيضاً، كلها في مستوى واحد، متجاورة، وهي مكان صالح للعيش والمغامرة، ومساحة لاكتشاف الذات، والتفاعل، وهي كلها في النهاية أجزاء من السيرة الكلية لشخصيّة “المعلم”، وللسارد أيضاً، الشخصيّة الموازية له في النص.
ويتحرّك السرد بشكل تقوده معرفة الكاتب الواسعة العميقة بالحضارات القديمة، وتاريخ الثقافات والأدب والفن، وجغرافيا المدن وحتى طرق القوافل القديمة. وهي في الأساس معرفة ذهنيّة تتدفق في شبكة السرد. لذا يبدو أنّ هناك حاجة عميقة في أجزاء من هذا النص للإبهار، إبهار القارئ، وإحداث الدهشة من كثافة المعرفة. ويبدو هذا مشروعاً وله ما يبرّره في أجزاء من النص، وغير مبرّر في أجزاء أخرى منه، كتوظيفه لفيلم «ذهب مع الريح» في النص، “فسكارليت” إحدى الشخصيّات الرئيسيّة في هذا الفيلم الشهير، الذي صدر في نهاية الثلاثينيّات من القرن العشرين، تخرج من الفيلم وتصبح زوجة السارد. لكن ما لذي تضيفه شخصيّة مثل “سكارليت” إلى هذا النصّ؟ هذا الفيلم المُنتج على الطريقة الهوليووديّة، رغم شهرته الكبيرة، عُرف بتكريسه للكثير من الكليشهيّات عن العبيد والأفارقة. شخصّية “سكارليت” في الفيلم لا تحمّل رمزاً، يضيفُ معنىً خاصاً إلى النص، غير أنها جزء من فيلم ناجح، ومن هنا يأتي هذا الانبهار ربما الذي يجعل حسين يوظّفه في النصّ.
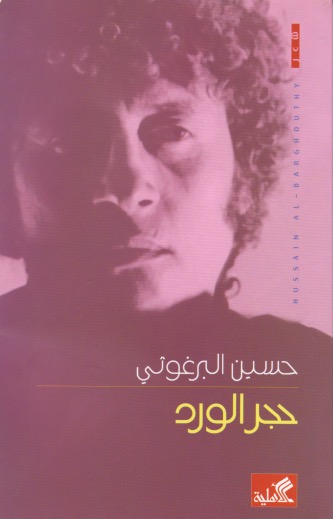
تقليديّة في نص ما بعد حداثي
العلاقة التي تحكم السارد كمريد بمعلمّه “النبيّ” علاقة تقليديّة رتيبة، تنمّ عن فوقيّة وتمنح المعلّم السلطة والمعرفة الكليّة وكأنّه مصدر الحقيقة والدهشة الدائمة. الحوار بين الشخصيتين ليس متكافئاً، فالسارد كشخصيّة تلميذ مأخوذ بالمعلّم الذي يناديه بكلمة “عبد”. وإن كانت هذه العلاقة تستمدّ منطقها من الموروث الصوفيّ الذي يتداخل في النصّ، ولها ما يبرّرها على هذا المستوى، إلا إنها تنمّ عن علاقة تراثيّة لا تنسجم مع نص حرّ كـ «حجر الورد» يُكسّر قواعد الزمن، وبنيته، ويغيّب حدود الأمكنة، ويملك حريّة السفر بين الثقافات والأساطير. فنحن هنا أمام نص ما بعد حداثي يختار بناءً فنيّاً متحرّراً من قيود النوع، والتجنيس الأدبيّ، وقد بدا متحرّراً من أيّ قيد فنيّ أو شكليّ أو موضوعيّ. ولهذا فإن هذه العلاقة التقليدية تُفقد النص شيئاً من بريقه، وتوهجه وجسارته.
وإن كان هذا مثلباً بالمعنى الفنيّ، فهناك أيضاً تناقض نجده أحياناً على مستوى السرد. فيقول السارد واصفاً معلّمه “تعاليمه كانت بلا فائدة” (ص.3)، ثم يناقض ذلك لاحقا بقوله “فلم نعد بعده مثلما كنّا عليه من قبل” (ص.5). ويقول في مكان آخر “كان كشفقٍ، ولم يهتمّ أحد” (ص.4). ثم يناقض هذا “كنا نلتفّ عليه كزنزانة، فينبسط كبحر وينسرح” (ص.7). ويقول أيضا “وكان واضحاً، ووضوحه يخيفنا” (ص.12). ثم يناقض هذا بالقول لاحقاً “لكنّه كان أبعد مما يجب، لا ذاك ولا هذا، غامضا، وراء اللغة” (ص.14).
هل قصد المؤلّف هذا التناقض وما الغاية منه؟ فليس في النص ما يشير إلى أيّ تحوّل في شخصيّة “المعلم”، أو في شخصيّة السارد نفسه الذي يطلق الصفات، وبالتالي تغيّرهما من حالة إلى أخرى. بل تبدو شخصيّة “المعلم” ثابتة، من بداية النص إلى آخره، وهذا الثبات هو ما يمنحها القدرة على إسداء الوصايا وتقرير حقائق الأشياء. لذا فإنّ التناقض هنا من الصعب تبريره، والبحث له عن مخرج فنيّ. حتى لو “كانت اللغة في «حجر الورد» ليست للإيصال، ولا هي واسطة بين الذات والواقع” كما يقول حسين، فإنّ هذا التناقض يستنزف النص، ويربك القارئ، ويحدث خللاً في فاعليّة الوصف. فلا معنى لهذا التناقض الذي لا يعكس تحوّلاً في الشخصيّة الموصوفة، أو يعبّر عن تغيّر في وجهة نظر السارد.
«حجر الورد» (٢٠٠٢، وصدر بطبعة جديدة عن الدار الأهلية في عمّان، ٢٠١٧) عمل تجريبيّ مدهش في جوانب منه، لا سيّما على مستوى اللغة، لكنه يبدو مرتبكاً على مستوى البناء الكليّ للعمل، حيث يبدو تقليديّاً في جانب، وما بعد حداثي في جانب آخر. لكنه يبقى نصّاً ثريّاً بعوالمه، يفتح آفاقاً جديدة، بجرأته، وعمق المعرفة التي تشعّ منه. و«حجر الورد» هو اسم لحجر من أكثر القطع الأثريّة شهرة في العالم، ويسمى la pierre de la rose، حجر كبير من الجرانيت مع نقوش باللغتين المصريّة واليونانيّة، وقد كان حاسما لفكّ الرموز الهيروغليفيّة المصريّة من قِبل الباحثين. هل اختار حسين هذه التسمية من هذا الحجر؟ على كلّ حال، فهما يتقاطعان في الروح والهويّة.






