هذه المادة هي ملخّص مقدمة كتاب The Arab and Jewish Questions: Geographies of Engagement in Palestine and Beyond الصادر مؤخرا (2020) عن دار نشر جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الامريكية، والذي حرّره كلّ من الباحِثَين بشير بشير وليلى فرسخ. الترجمة تمت بدعم من: The Bruno Kreisky Forum for International Dialogue- Vienna- Austria. قامَت ريم غنايم بترجمة المادّة وتنفيذ صياغة تحريريّة لها.
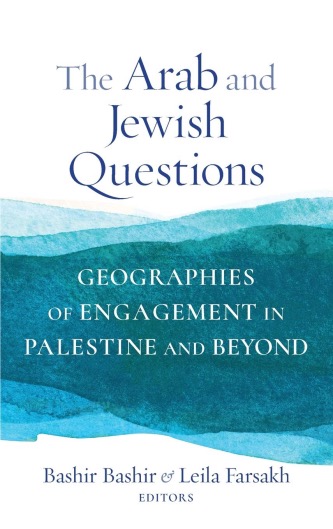
توضيح الهامش وتحديد المَتن المُلتَبَس
لم يسبق أن توقّفت أية دراسة حتى وقتنا الراهن عند نقاط التقاطع بين تعزّز ظاهرة رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في الغرب، والإخفاق في حل النزاع العربي الإسرائيلي، والدلالات السياسية التي حَملتها الانتفاضات العربية الأخيرة. كما ولم يسبق أن قام الباحثون برَصد نقاط التّماس بين هذه المسائل بثلاث مسائل أخرى تبدو ظاهريًا كما لو كانت منفصلة عن بعضها، إلَّا أنّها متشابكة متداخلة في جوهرها لا يمكن فهم سياقاتها دون إدراك نقاط التّماس بينها، وهي مسألة إسرائيل – فلسطين، والمسألة العربية – الإسلامية، والمسألة اليهودية. يمكن القول بشأن هذه المسائل إنّها تتجاوز فكرة التّشابك لتصبح منتمية كليًا إلى نفس التاريخ الذي يواصل إشعال التوترات في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. من هنا، فإنَّ إعادة النظر في الاشتباكات العربية المعاصرة مع مسألة الحقوق السياسية اليهودية، في ضوء معاداة السامية والصهيونية الأوروبية، إلى جانب استكشاف وتوضيح الاشتباكات اليهودية مع المسألة العربية، وتحديدًا كيفية تعامل الأصوات اليهودية الصهيونية وغير الصهيونية مع الوجود الفلسطيني والحقوق السياسية في فلسطين التاريخية، أضحت ضرورية لنا لفهم الراهن السياسي والمستقبل المُلتَبس.
تأثرت السياسات الشرق أوسطية والأوروبية على امتداد العقدين المُنصرمين بثلاثة تطورات مصيرية تستدعي مساءلة المفاهيم السائدة حول القومية والمواطنة وإنهاء الاستعمار. أولًا، “مسألة فلسطين” المحورية، التي لم تزل عالقة حتّى اللحظة، والتي خلق الاستعمار العدواني والمتواصل عليها حقائق لا رجعة منها تلقي بظلال الشكّ على جدوى التقسيم وإمكانية “حل الدولتين”. وكذلك، فقد عمّق استعمار فلسطين الاشتباكات/التداخلات بين الحياة الإسرائيلية والحياة الفلسطينية، جاعلاً من مسألة حقوق العرب واليهود الراهنة والمستقبلية متلازمة مُدمَجة لا مجالَ للفصل بينها.
ثانيًا، أشارت الانتفاضات العربية التي اندلعت في عدد من دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في العام 2011 إلى تراجع الأيديولوجيات الوحدوية/الإدماجية الكبرى التي سادت سلطتها عقودًا من الزّمن في التاريخ العربي الحديث، مثل العروبة والبعثية والإسلاموية، الأمر الذي أفضى إلى التشكيك في الهوية الجمعية الشاملة التي يعيشُ المواطنون في كنفها وتحت سقفها. كما وساهمت الحركات الثائرة على الأنظمة الاستبدادية في إبراز وتثوير الأسس العرقية والثقافية المتنوعة للمجتمعات التي عاشت هذه الحركات بين ظهرانيها ونشأت منها وفيها، وهو التنوع الذي يطالب به الثوّار والذي قمعته أنظمتهم الاستبدادية بواسطة البطش واضطهاد العديد من الأقليات، مثل الأكراد والأيزيديين واليهود-العرب والكلدانيّين والبربر.
ثالثًا، أصبح الإسلام والمسلمون الدّوال (signifiers) الداخلية الجديدة التي تجسّد الآخر، لا سيما في الغرب، طارحةً تحديات جدية للمفاهيم الرّاهنة للمواطنة والديمقراطية في الغرب.
يَرتبط صعود مفاهيم المواطنة الأوروبية ورهاب الإسلام بذكريات “الماضي” الاستعماري الأوروبي المكبوتة، وكذلك بعولمة الاقتصاد السياسي الليبرالي الجديد، وأفول دولة الرفاه الاجتماعيّ. إلا أنّها تعكس ارتباطًا مفاهيميًا وتاريخيًا وطيدًا بين كراهية اليهود ورهاب الإسلام في أوروبا، وهو ارتباط لم يتم استقراؤه بالشكل الكافي حتّى الوقت الراهن(١). ذهب العديد من الباحثين إلى دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه التطورات، إذ يناقش جلبير أشقر، على سبيل المثال، الجذور العميقة للانتفاضات العربية التي تكمن أساسًا في الخصائص الاقتصادية المحدّدة التي تميز هذه المجتمعات، وليس في التفسيرات السياسية أو الثقافية التبسيطية(٢).

أما شولتو بيرنز فيؤكّد على أن رهاب الإسلام في أوروبا يتم تطبيعه من قبل المثقفين الذين يصورون الإسلام والمسلمين على أنهم عناصر أجنبية دخيلة على أوروبا(٣). في الوقت نفسه، تعارض فرجينيا تيلي تقسيم الأراضي (territorial partition) باعتباره أفضل سبيل للاستجابة لمطالب مشروعَين عرقيّين وطنيّين متنافسين لتقرير المصير، وتدعو عوض ذلك إلى نماذج سيادية تقوم على توحيد سياسي لا استعماري يستند إلى الحقوق الفردية(٤).
تقدّم هذه الرؤى تحليلًا نقديًا ضروريًا يتجاوز الخطابات السائدة حول الانتفاضات العربية، ورهاب الإسلام الأوروبي، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنّها تغفل عن الروابط الأساسية بين هذه التطورات، التي تبدو كما لو أنّها منفصلة في كياناتها ودلالاتها ومواقعها الجغرافية. يمهّد هذا الرّبط التاريخيّ والسياسيّ والهوّياتي بلا شكّ الطريق لفهم أعمق للصراعات التي تواصل تكوين وتثوير التاريخ والثقافات والسياسات في الشرق الأوسط وأوروبا وما وراءهما. من هنا، فإنّ رسم الخرائط الجغرافية المتشابكة لما يربط بين هذه المسائل، وكشف روايات وسياقات تاريخيّة تمّ طمسُها، تهميشها أو إهمالها، سيقدّم، في رأينا، مستقبلًا أكثر وضوحًا يتجاوز حدود الخطابات القومية التقليدية والروايات التاريخية المهيمنة والمنفصلة.
المسألة اليهودية والتشابك العربي مع “الآخر”: السّياقات، والدلالات، والإسقاطات

انشغلت “المسألة اليهودية” بتعريف الحقوق السياسية لمَن اعتُبروا أقلية في البلدان التي باشرت في مشاريع بناء أممها الإقصائية، حتى وإن لجأت هذه المشاريع أحيانًا إلى الأيديولوجيات السياسية التي وعدت بالتحرير وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين. بتعبير أدق، فقد تحوّل الوجود اليهودي في أوروبا إلى “قضية”، وذلك نتيجة هيمنة المسيحية كسمة مميزة للتكوين الاجتماعي والثقافي والسياسي لأوروبا، وللقومية باعتبارها تعريفًا لهوية سياسية حديثة. تعاملت قوى القومية والمسيحية الأوروبية مع اليهود على أنهم “الآخر” المطلق، وبالتالي لزَم التعامل معهم من منطلق الشكّ والرّيبة وبصفتهم دخلاء. بالنسبة للمسيحيّين في أوروبا، فقد كان اليهود في حاجة إلى التحوّل للديانة المسيحية، أما بالنسبة للجمهوريّين الوطنيّين، فقد كان على اليهود حصر تدينهم في حيّزهم الخاص والتشبّه بالمواطنين الآخرين في الحيّز العام. ومن المفارقات أن نكتشف أن نجاح خطاب التحرّر اليهودي في أوروبا، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في تبني قيم المواطنة المتساوية والاندماج بالمجتمعات الأوروبية، قد أفضى إلى نشوء نمط جديد من معاداة السامية. ووفق هذا اللون الجديد من معاداة السامية اتهم اليهود على أنهم مسؤولين عن الحداثة وانعكاساتها (مثل نشوء المجتمع الصناعي والتمدّن) والخيانة السياسية أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى في وسط أوروبا على وجه الخصوص(٥). أما بالنسبة لمعادي السامية، فقد ظلّ اليهود شعبًا شرقيًا(٦). في نهاية المطاف، أدت المغالاة في معاداة السامية ومعاداة البلشفية في أوساط أقصى اليمين إلى التطهير العرقي والإبادة (المحرقة) أثناء الحرب العالمية الثانية(٧). جزئيًا، اقترن “ارتحال” المسألة اليهودية إلى الشرق الأوسط، وإلى فلسطين تحديدًا، بفشل القوميات الأوروبية في استيعاب الوجود اليهودي، إلى جانب مصالحها الاستعمارية في الإمبراطورية العثمانية(٨).
حدثَ التشابك العربيّ المبكر مع “المسألة اليهودية” بشكل رئيس عبر الاستعمار الأوروبي والنوايا الصهيونية لاستعمار فلسطين التاريخية. وقد نظر العرب والفلسطينيون منذ بدايات مواجهاتهم مع الحركة الصهيونية إلى الصهيونية كحركة دخيلة واستعمارية سعت إلى نزع السمة العربية عن فلسطين(٩). تواصلَت عملية التمييز بين اليهود المحليّين الفلسطينيّين، الذين كان يُنظر إليهم عمومًا على أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته السياسية، واليهود الصهاينة الأوروبيّين، الذين اعتُبروا مستعمرين في الخطاب الفكري والسياسي العربي والفلسطيني بعد حرب 1948 وحتى نهاية السبعينيات. عرّف البرنامج الذي دعت إليه فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوائل السبعينيات من القرن المنصرم، والداعي إلى إقامة دولة ديمقراطية غير طائفية للمسلمين والمسيحيّين واليهود في فلسطين، الهوية الفلسطينية على أنها تشمل اليهود الفلسطينيّين(١٠). ومع تبنّي منظمة التحرير الفلسطينية لبرنامج النقاط العشر في العام 1974 فقط، تمّ نزع الطابع الفلسطيني والعربي عن اليهود الفلسطينيّين. يومئ هذا التحول، من برنامج الدولة الواحدة إلى القبول الفعلي للتقسيم كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بانزلاق من القومية الفلسطينية الشاملة والمدنية إلى حد كبير إلى القومية الفلسطينية الأثنية(١١). أفضى هذا الخطاب القومي الاثني الذي أقصى اليهود الفلسطينيّين من الهوية الفلسطينية، على نحو مناقض، إلى إعادة إنتاج خطاب صهيوني أصرّ على إلغاء التمييز بين اليهود والصهاينة(١٢). كان المفكرون العرب والفلسطينيون، في ذلك الوقت، باستثناء ثلّة منهم، نذكر منهم إدوارد سعيد على سبيل المثال لا الحصر، بالكاد اشتبكوا مع تعقيدات “المسألة اليهودية” ومعاداة السامية والمحرقة ومركزيتها في الهوية اليهودية المعاصرة والخطاب السياسي(١٣). للتأكيد، فقد سعى عددٌ من المفكرين الفلسطينيّين وغيرهم من المثقفين العرب إلى دراسة تداعيات المحرقة في أي نقاش حول الحقوق اليهودية في فلسطين(١٤).
يحدّد جلبير أشقر في كتابه “العرب والمحرقة النازيّة”(١٥) الاستجابات والمواقف العربية المختلفة تجاه النازية والمحرقة واليهود، مستكشفًا السياقات التاريخية والأيديولوجية والفكرية لهذه الاستجابات بالإضافة إلى تنوّعها. ويتقصّى عُمر كامل مواقف المثقفين العرب إزاء أراء المثقفين الأوروبيّين -من أمثال أرنولد توينبي وجان بول سارتر،(١٦) وماكسيم رودنسون- استنادًا إلى مواقفهم من مسألة حقوق اليهود في فلسطين وانعكاساتها على الصراع العربي الإسرائيلي. وبحسب كامل، فإن المثقفين العرب استاءوا من عدم دعم هؤلاء المثقفين الأوروبيّين للفلسطينيّين. يوضح كامل، من خلال فحصه لكتابات هؤلاء المثقفين العرب، كيف أدّى تركيزهم على الاستعمار الفرنسي والبريطاني، وكذلك على الصهيونية وإسرائيل، إلى تهميش، بل وحتى عزل، أي نقاش عربي جاد حول المحرقة(١٧). في الوقت نفسه، وجد الكتّاب الفلسطينيون والعرب في الأدب فضاءً خصبًا لتفكيك تداعيات المحرقة على الحقوق السياسية الفلسطينية واليهودية في فلسطين (منهم، على سبيل المثال، غسان كنفاني، وإلياس خوري، وسوزان أبو الهوى، وربعي المدهون، وأكرم مسلم)(١٨). جمع غسان كنفاني -أحد أبرز المفكرين الفلسطينيّين في عصره وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- في روايته القصيرة “عائد إلى حيفا” (1969)، في تداخل قدريّ مأساوي بين عائلة من الناجين من المحرقة وعائلة من اللاجئين الفلسطينيّين. على الرغم من أن الرواية تنتهي إلى طريق مسدود مع إعادة تأكيد ضرورة الحرب، إلَّا أنها تمنح صوتًا بشريًا للمستعمِر والمستعمَر في الوقت الذي تُبرز فيه التشابك بين حياة الطرفين. أخيرًا، توقّف إدوارد سعيد في عدد من أعماله، لا سيما “مسألة فلسطين” (1980) و”فرويد وغير الأوروبيّين” (2003)، عند التشابك المأساوي للمسألة اليهودية والمحرقة مع قضية فلسطين والنكبة(١٩).
واقع القومية العربية وظلّ اليهوديّ-العربيّ
أثار الاضطراب السياسي الذي أطلقته الانتفاضات العربية في العام 2011 اهتمامًا متجددًا بمسألة حماية الحقوق السياسية الفردية والجماعية في نظام حكم ديمقراطي قائم على المساواة والاحتواء في القرن الحادي والعشرين. كما وفّر فرصة فريدة لإعادة النظر في المسألة اليهودية، خاصة من قبل جيل الشباب من الكتاب والمفكرين الذين شكّكوا في العقيدة الوحدوية/الإدماجية للقومية العربية. أظهر هؤلاء الكتاب اهتمامًا متجدّدًا في دور “اليهود العرب” في الثقافة العربية. بينما ظهر اليهود العرب، في الماضي، بوصفهم مجرّد أشخاص في الروايات العربية التي كتبها يهود عرب يعيشون في إسرائيل (مثل سامي ميخائيل وآخرين)، فقد ظهر اليهود العرب مؤخرًا في كثير من الإنتاجات الثقافية العربية الرّائجة، لا سيما في الروايات والأفلام(٢٠). تُظهر الأعمال، التي تم إنتاجها، تحديدًا بعد العام 2003، اهتمامًا متزايدًا في تاريخ الجاليات العربية اليهودية من مختلف البلدان العربية(٢١). تسلّط هذه الأعمال الضوء على اليهود بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في العراق واليمن والمغرب وسوريا ومصر والجزائر وليبيا وتونس(٢٢). وبينما كان لكل من هذه المجتمعات اليهودية سماتها، وتاريخها المحدّد، ضمن سياقاتها الخاصة، فإنَّ الغالبية العظمى منها قد غادرت أو نزحت من العالم العربي خلال خمسينيات القرن المنصرم. منذ ذلك الحين وحتى أواخر التسعينيات، تم إقصاء هذا المُكوِّن المتجذّر والعميق في المجتمع العربي وتهميشه، بل ومُحيَ أحيانًا من التأريخ الرسمي والذاكرة والرواية الوطنية للعديد من البلدان العربية.
يعتبر هذا الاهتمام الأدبي المتجدّد، وغير المنسّق، بشخصية اليهوديّ العربيّ، نتاج تأمُّل استبطانيّ في معنى الهُوية الوطنية بعد حرب العراق والحرب الباردة(٢٣). على سبيل المثال، أعاد العديد من المفكرين العراقيّين النظر في خطاب الدولة الوطني والتاريخي، والذي سيطر على العراق البعثيّ لعقود من الزمن، ومزج بين الوطنية والأفكار الاشتراكية، والهُوية القومية العربية. ولكن، أثبتَ هذا الخطاب خواءه بعد انهيار النظام الوطني المركزي في العام 2003. وهكذا كرّست الجهود الأدبية للابتعاد عن الخطاب البعثي الوحدوي/الإدماجي للهُوية المنسجمة والمتناغمة، من خلال لفت الانتباه إلى تنوّع العراق وتعقيده.
إنَّ مفهوم اليهودي العربي ليس جديدًا بالطبع(٢٤). يبرز العمل الرائد والمؤثر لأستاذة الدراسات الثقافية إيلا شوحط منذ الثمانينيات، بوصفها أوّل صوت يهودي معاصر يعيد تأكيد مركزية الهوية العربية داخل الهوية اليهودية، موضّحةً كذلك الاشتباكات بين قضية فلسطين ومسألة اليهودي العربي(٢٥)، وتستكشف شوحط بشكل نقديّ التطورات التاريخية (الحداثة الاستعمارية وارتباطاتها الخطابية في أشكال التخيلات الاستشراقية ونظريات المعرفة الأوروبية) التي شقّت وفصلت بين “العرب” و”اليهود”، مما يُحيلها إلى فئات متعارضة. أصبح هذا الانقسام الاستشراقي أكثر حدّةً ووضوحًا مع ظهور الصهيونية وترجمة فكرتها إلى واقع سياسي في فلسطين، مما أدى إلى تجريد الفلسطينيّين من ممتلكاتهم، وتشتيتهم في أرجاء الدول العربية، وما يصاحب ذلك من تهجير لليهود العرب إلى إسرائيل بشكل أساسيّ. وفقًا لهذا الانقسام والانفصال الاستشراقي، أصبح “اليهودي العربي”، وهو رمز ما بعد التقسيم، “تناقضًا وجوديًا ظاهرًا، وتدميرًا معرفيًا” يقوّض ويشكّك في الروايات والهُويات التّمييزية، ويفتح آفاقًا وإمكانياتٍ جديدةً(٢٦).
في الواقع، نادرًا ما نلحظ حضورًا اجتماعيًا وديموغرافيًا لليهود العرب في العالم العربيّ اليوم، على الرغم من أنه لا تزال غالبية المجتمعات العربية متنوعة، ثقافيًا وعرقيًا، حيث إن الأكراد والأرمن والأيزيديّين والأمازيغ، من ضمن مجموعات أخرى، هم جزء لا يتجزأ من المنطقة، وقد شكّل التنوّع تحدّيات بالغة لنماذجَ جامدة وإقصائية من القومية العربية. وهكذا، في حين يلعب اليهودي العربي دورًا هامًا في مهمة معالجة مسألة التنوع الثقافي والعرقي، فإن تحليلنا لا يدّعي أو يسعى إلى تحويل اليهودي العربي بصفته الرمز النهائي والوحيد لحقوق الإنسان والمواطنة الشاملة في العالم العربي. لا تزال المجموعات المهمشة الأخرى، في هذه المجتمعات العربية، تشكّل مكونات هامّة في تكوين الدول العربية، لكن حقوقها ومشاركتها السياسية تقابَل بالطّمس والقمع، إن لم تكن تتعرّض للاعتداء أيضًا. بالتالي، فإنَّ إحياء مفهوم اليهودي العربيّ يمكن أن يُشكّل كذلك وسيلةً لكشف التاريخ المدفون ودفع النقاش حول المساواة والحقوق السياسية إلى ما وراء خطاب القومية وسياسات الأقلية.
الصّهيونية وتشابكها مع القضية العربية: عنف التغييب والاعتراف الهشّ
عرّف بعض الباحثين “المسألة العربية” على أنها “العلاقات بين اليهود والعرب في البلاد”(٢٧)، بالنسبة لآخرين(٢٨)، فقد نشأت “المسألة العربية” عن حقيقة أن السكان العرب، من المسلمين والمسيحيّين، الذين سكنوا وشكّلوا الأغلبية في فلسطين منذ مئات السنين، لم يرحبوا بالمستوطنين الصهاينة الجدد، الذين ادّعوا أنهم عائدون إلى موطن أجدادهم. اعتمد النهج الصهيوني السائد إما على تجاهل الوجود العربي الأصلانيّ، والتقليل من ارتباطه بالأرض ومقاومته الشديدة لمساعيهم الاستعمارية، أو التأكيد على أن التنمية الاقتصادية التي كانت ستحقّقها الصهيونية، ستعود بالفائدة على السكان الأصلانيّين(٢٩).
بحسب نيل كابلان، يمكن تحديد ثلاثة مواقف رئيسية حول “المسألة العربية” كانت حاضرة خلال الفترة ما بين 1917–1925(٣٠). أولًا، رأت أقلية نشطة بأنها مسألة رئيسية شكّلت تحديًا خطيرًا لمرتكز الصهيونية الأخلاقي. وهكذا، فقد سعوا إلى التكيّف مع المعارضة العربية، ودعوا إلى السعي لتحقيق السلام والتسوية معها. ثانيًا، لم يولِ قطاع كبير من الييشوف الصهيوني أهمية كبيرة لها واعتبروها عقبة صعبة ينبغي التعامل معها بحذر. ثالثًا، اعتبرها الجزء الأكبر تحديًا خطيرًا يتطلّب تصميم وتطوير إجراءات مضادّة فعّالة للردّ على التّهديدات العربية، الدّيموغرافية والسياسية والنفسية منها. ومع ذلك، فقد ظل الخطاب الأخلاقي الصهيوني السائد قائمًا على الاستبطان، مما يعني أنه نادرًا ما يتمّ التعامل، أخلاقيًا، مع العربي باعتباره “الآخر المُعتبَر”، أي ذاك الذي ينظر إليه الكثيرون بوصفه خارجًا عن “نطاق الإقناع المعياري”(٣١).
يجادل بعض النقاد(٣٢) بأن الاتجاه العام عند الصهاينة أصحاب التأثير هو الالتزام بتصريح غولدا مئير المنشور على نطاق واسع، القائل إنه “لم يكن هناك ما يسمى بالفلسطينيّين”. وظلّ هذا الرأي بوصفه إحدى تعويذات الصهيونية، التي تبنّاها التيار الرئيسي للقادة الصهاينة من ديفيد بن غوريون إلى يتسحاق شامير، ومن حاييم وايزمان إلى نفتالي بينيت. لم يكن شاغلهم الرئيسي هو الواقع في فلسطين، ولكن كيفية استخدام الانتماء اليهودي التاريخي مع الأرض، لإنشاء دولة يهودية من شأنها أن تحل مشكلة أوروبا مع اليهودية. بينما كان هرتزل يعلم أن فلسطين مأهولة بالعرب، نظر إلى هؤلاء العرب الأصلانيّين على أنهم بدائيون ومتخلفون، مؤكّدًا أن الصهيونية ستعود عليهم -كأفراد وليس كجماعة- بالازدهار والحداثة. في المقابل، أشار إسحاق إبشتاين إلى عدم تعامل الصهيونية مع وجود عرب فلسطين على أنه “مسألة خفية”، معتبرًا أن هذه المسألة أعمق من أي مسألة أخرى، واعتبر الوجود العربي في فلسطين، فضلًا عن ثقافتهم وهُويتهم الوطنية، تحديًا خطيرًا للتطلعات الصهيونية يتطلب انخراطًا جادًا، ويتطلب الوصول إلى تسوية تاريخية مع السكان العرب الأصلانيّين(٣٣). لم يشك إبشتاين يومًا في شرعية المطالب التاريخية الصهيونية في فلسطين، لكنه أصرّ على أن نجاح الصهيونية في فلسطين، يعتمد على كسب رضا العرب وتقاسم الأرض معهم، وليس تجاهل حقوقهم الوطنية الجماعية. مع ذلك، كحال بقية الصهاينة، فقد كان يعتقد أن الصهاينة هم حاملو الحضارة الغربية، وأن العرب سيرحّبون بمكاسب التحديث التي سيحقّقها الصهاينة لفلسطين. في حين أنه لم يدافع عن دولة ثنائية القومية، فقد دعا إلى دولة صهيونية تكاملية، يعيش فيها مجتمع عربي قوي ويزدهر مع الصهاينة، بدلًا من الانفصال عنهم(٣٤).
من ناحية ثانية، أصر الصهاينة التصحيحيون، وتحديدًا زئيف جابوتنسكي، على أن محاولات الصهاينة العماليّين، أو الاشتراكيّين، لمعالجة المسألة العربية، كانت إما محاولات ساذجة (شراء الموافقة والولاء العرب بالمال)، أو انتحارية. توقع جابوتنسكي أن العرب الأصلانيّين، مثل كل الشعوب الأصلانية، سوف يقاومون المستوطنين الاستعماريّين لأطول فترة ممكنة. وبالتالي خلُص إلى أن الطريقة الأنسب للتعامل مع العرب هي إقامة “جدار حديدي” من القوة العسكرية الصهيونية القادرة على كسر المقاومة العربية(٣٥). وقد رفض آخرون، أمثال سيمون راويدوفيتش ويزهار سيملانسكي، هذا النهج، وقالوا إن “القضية الفلسطينية ليست قضية عربية، بل هي قضية يهودية بالكامل”(٣٦)، وأكدوا على أنه لا يمكن فصل المطالب اليهودية عن حقوق الفلسطينيّين وتطلعاتهم. “بريت شالوم” و”إيحود”، المنظمتان الصهيونيتان اللتان تأسّستا في العشرينيات وأوائل الأربعينيات من القرن الماضي، دفعتا الأمر إلى أبعد من ذلك، للتوصل إلى اتفاق مع القادة العرب على أساس حل ثنائي القومية في فلسطين(٣٧). وقد تم تحييدهما مع إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948، ومع هيمنة عقلية الجدار الحديدي في السياسة الإسرائيلية منذ ذلك الحين.
بعد قيام دولة إسرائيل، سعت الصهيونية، وخاصة بين عامي 1948 و1967، إلى تصفية القضية العربية بوسائل مختلفة، بما في ذلك النفي والإنكار والتهميش والقمع الكولونيالي. بعد حرب 1967 وصعود منظمة التحرير الفلسطينية، أصبحت السياسة الإسرائيلية مهمومةً بتوسيع قبضتها الاستعمارية على الأرض الفلسطينية، بينما جعلت من قضية فلسطين مشكلةَ لاجئين عرب، يتم حلّها مع الدول العربية المجاورة، وليس مع الفلسطينيّين، في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242. أثبتت الانتفاضة الأولى محدودية هذا النّهج، ومهّدت الطريق لعملية أوسلو للسلام، التي قدمت أول اعتراف إسرائيلي رسمي بالفلسطينيّين ومطالبهم السياسية. خلال هذه الفترة، تعاملت إسرائيل مع الفلسطينيّين بأسلوب إدارة الصراع، بدلًا من محاولة التّوصل إلى مصالحة تاريخية. في الوقت نفسه، في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، كشف المؤرخون وعلماء الاجتماع النقديون الإسرائيليون عن تقييم نقدي للاشتباكات الصهيونية والإسرائيلية مع القضية العربية. بناءً على مصادر أرشيفية إسرائيلية، تحدى “المؤرخون الجدد” في إسرائيل التأريخَ الإسرائيليّ المهيمن والمُتعارف عليه من خلال الإشارة إلى الدور النّشط والرئيسي الذي لعبته إسرائيل في طرد الفلسطينيّين في العام 1948(٣٨). في حين أن هذه المراجعات النقدية قد حصلت على اعتراف عام وأكاديمي، إلا أنها ظلت هامشية في تأثيرها على السياسة الإسرائيلية. تحولت الاتجاهات السياسية السائدة والصهيونية واقعيًا، في العقدين الماضيين، نحو اليمين، وأعادت استحضار وتعزيز التأريخ الإسرائيلي التقليدي. وفقًا لإحداثيات هذا التأريخ، فإن الفلسطينيّين غير مرئيّين إلى حدّ كبير، وحقوقهم السياسية متنازَعٌ عليها(٣٩).
أوروبا ومسألة “الآخر” اليهودي والمسلم
تتجذّر العمليات المعقدة لتقسيم العرب واليهود، وفك الارتباط بين القضية اليهودية والقضية العربية/الإسلامية، بعمق في الفكر السياسي الغربي السائد. ربما يمكن العثور على ترسيمٍ واضحٍ لعمليات فك الارتباط هذا في استخدام مصطلح “الحضارة اليهودية-المسيحية”، حيث لم يتم استخدام هذا المصطلح العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بمفهوم التفوّق السياسي والثقافي والمعرفي لأوروبا وحسب، بل ولقمع أو إعادة صياغة ماضي أوروبا الاستعماري داخليًا (أي الهولوكوست) وخارجيًا (الإمبريالية) وأيضًا، مع إسباغ الشرعية على حربها ضد الإسلام. وغالبًا ما ترتبط “الحضارة اليهودية-المسيحية” بالتقدم والحرية والديمقراطية والقيم الغربية الليبرالية. يعرض هذا المصطلح التاريخ الفكريّ للغرب، ويؤكد على تفوّقه الحضاري، مقارنة بالحضارات الأخرى، لا سيما الإسلام(٤٠). مع ذلك، يقلّل استدعاء هذا البناء الأيديولوجي الاستطرادي [أو الخطابيّ] من أهمية سيرورة ما بعد الهولوكوست المتمثلة في إعادة دمج اليهود بوصفهم أوروبيّين، بعد أن تمّ تصويرهم بالماضي على أنهم ساميون يستحقون الإقصاء أو الإبادة(٤١).
علاوة على ذلك، تتجاهل “الحضارة اليهودية-المسيحية” مكانة ودور الحضارة الإسلامية، التي كانت حاضرة ومزدهرة في شبه الجزيرة الأيبيرية والعالم العربيّ وبلاد فارس والإمبراطورية العثمانية، منذ القرن التاسع حتى القرن التاسع عشر.
أدى الاحتلال المسيحي لإسبانيا والبرتغال إلى اعتناق الدين القسري، وطرد اليهود والمسلمين؛ إذ تم منح عشرات الآلاف من اليهود حق اللجوء في شمال إفريقيا المسلمة والإمبراطورية العثمانية(٤٢). وحتى الحرب العالمية الأولى -وبالأخصّ، منذ إعلان بلفور- لم يحدث أن تضرّرت العلاقات بين العرب المسلمين والمسيحيّين واليهود العرب بشكل خطير ولم تبلغ هذا المبلغ من العداوة والخصومة.
من خلال قراءته الحفرية النقدية العميقة للنصوص الغربية الكلاسيكية، يتتبّع الباحث جيل النجار التقاطعات الحميمة، وإن كانت مخفية، بين المسألة اليهودية والمسألة العربية الإسلامية، ويكشف عنها بوصفها سؤالًا واحدًا ينتمي إلى تاريخ معقّدٍ واحد(٤٣). يقدم النجار منظورًا فلسفيًّا أوسع لفهم العداء المتكون، لكن غير المرئي، بين اليهود والعرب، وكراهية اليهود والإسلام في الغرب المسيحي(٤٤). وقد تغلغلت هذه الانقسامات والعداوات، كذلك، في الفكر السياسي والتاريخ اليهودي والعربي، وهيمنت عليهما.
نحو إعادة التّفكير واجتراحِ حلّ
إعادة النظر في المسائل اليهودية والعربية هو أمرٌ ضروريّ وملحّ، نظرًا للأزمة التي تواجهها القومية الفلسطينية واليهودية والعربية والأوروبية اليوم. لقد أدى تشرذم المجتمع الفلسطيني بين مواطنين إسرائيليّين ولاجئين مشتّتين في الشرق الأوسط والخارج، وفلسطينيّين محاصرين في غزة، وقلائل يعيشون مع حقوق سياسية محدودة في الضفة الغربية، إلى تقويض قيمة مشروع الدولة القومية الفلسطينية، مما يفرضُ إعادة التفكير في الطرق التي يمكن من خلالها حماية الحقوق السياسية، خارج إطار تقسيم الأراضي والسيادة العرقية والدول القومية الحصرية(٤٥). لقد جعلَ إعلان خطة الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التفكير بهذه الأمور أكثر ضرورة(٤٦). كما أنّ تكثيف الخطاب العنصري الشوفيني في إسرائيل أضحى يشكّل تهديدًا لفكرة الصهيونية كمشروع ديمقراطي شرعيّ، حتى في نظر بعض أتباع هذه الفكرة(٤٧). وقد أدى تكثيف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي العدواني إلى إبقاء القضية الفلسطينية حية، سواء داخل المجتمعات العربية والإسلامية أو الدولية، على الرغم من المساعي الصهيونية لإضعافها وتفتيتها.
إن استمرار المسألة العربية اليوم وإلحاحها، لم يُضعف من ثقل المسألة اليهودية وضرورة الانخراط فيها. وبالنسبة للصهيونية، فإنّه رغم بقائها مشروعًا استعماريًا استيطانيًا، أوجدت أيضًا مجتمعًا ثقافيًا وسياسيًا إسرائيليًا نابضًا بالحياة داخل فلسطين، يمنح المعنى والحقوق السياسية لأكثر من ستة ملايين يهودي والعديد من اليهود على مستوى العالم(٤٨).
هذه حقيقة ينبغي على القومية الفلسطينية والعربية أن تتصدّى لها، ولو من باب الحصول على إجابة لمفهوم حقوق اليهود، سواء داخل حدود هويتهم القومية أو خارجها. علاوة على ذلك، فإن العنف، والطائفية اللذين اندلعا خلال العقدين الماضيَين في العديد من دول الشرق الأوسط، كشفا عن ضرورة التعامل والتعاطي الجاد مع التنوع الثقافيّ والاثنيّ الداخلي، سواء حمَل هذا الآخر هويةً مسيحيّة أو يهوديةً أو كرديةً أو كلدانيةً أو بربريّة. وهكذا، على سبيل المثال، تصبح معالجة تاريخ اليهود العرب، وسيلة مهمة للخوض في هذا النقاش. في نفس الوقت، فإن تعزّز رهاب الإسلام وكراهية اليهود في الغرب، يستدعي الماضي الاستعماريّ لأوروبا، ويبرز الحاجة إلى الشروع بنزع الاستعمار، إذا كان لأوروبا أن تخلق ديمقراطيات شاملة وقائمة على المساواة حقًا.
تتطلّب عمليّة كشف ورصد هذه التشابكات والاشتباكات بين مسائل مركزية وسياقات تاريخية وسياسية تبدو، للوهلة الأولى، منفصلة لا علاقة بينها، مزيدًا من البحث والتقصّي والنّقد. وهذه التأملات التي نقدّمها للقارئ ما هي إلا دعوة أوليّة للانخراط في مسار بحثي مناهض للاستعمار ويقوم على ضرورة تبنّي فكرة التّشابك بين ثلاث مسائل ظلّ التعاطي معها رهينة استقلالها وانفصالها عن بعضها، حتى هذه اللحظة الرّاهنة. من هنا نأمل أن تشجع هذه المادة الموجزة الباحثاتِ والباحثين على دراسة الروابط بين هذه المسائل المركزية الشائكة التي ما زالت تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة الواقع والمستقبل السياسي والثقافي في فلسطين، الشرق الأوسط، أوروبا ومناطق أخرى في العالم.
الهوامش






