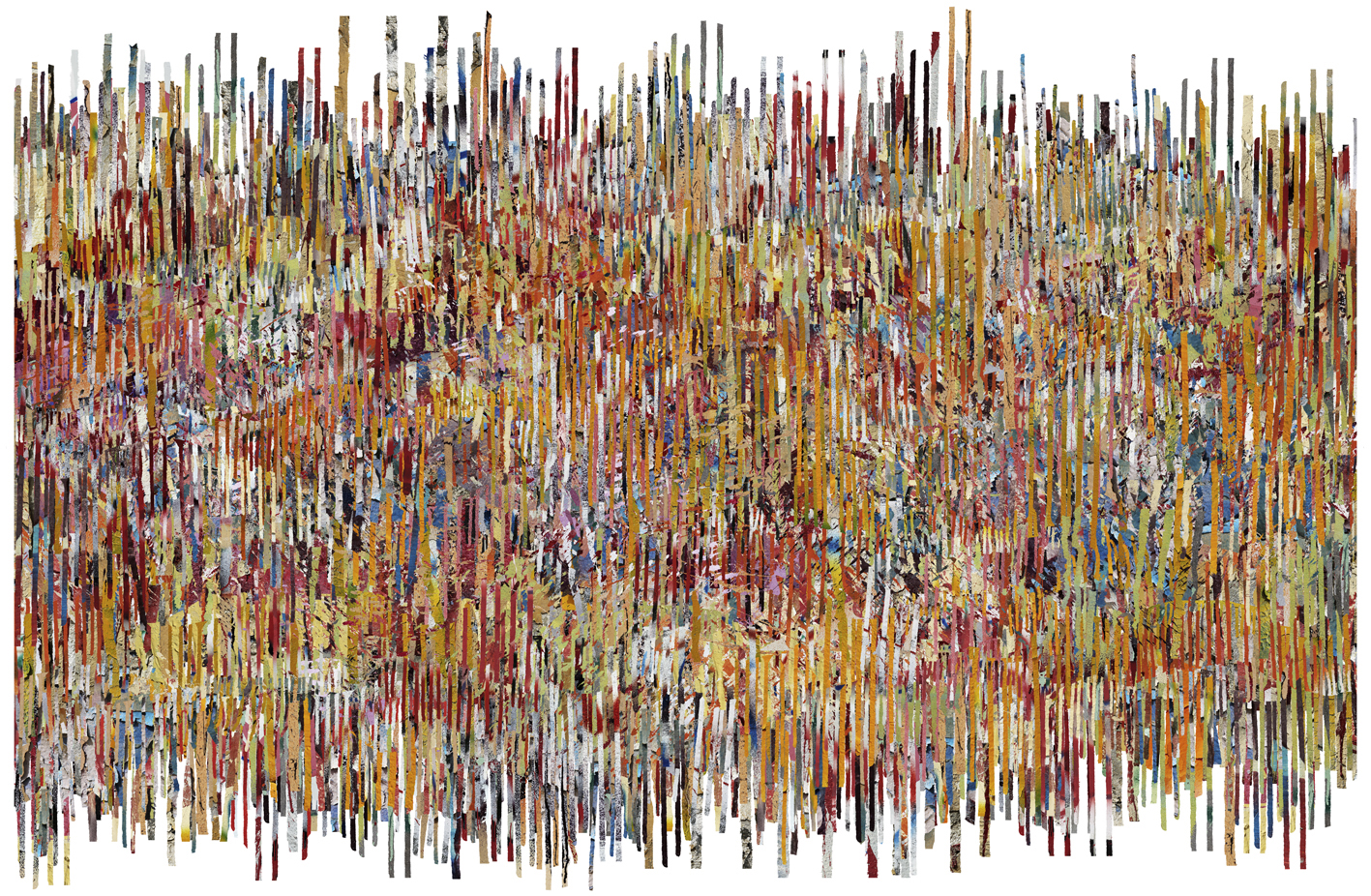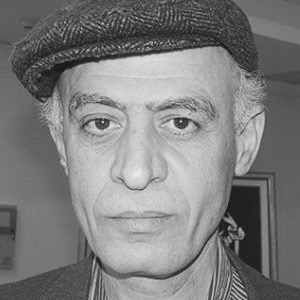في الفترة الأخيرة قرأت رواية خيال علمي ومجموعة قصصية لكاتبة نابلسية وكتبت عن الرواية في زاويتي في جريدة الأيام الفلسطينية، وخربشت بضع ملاحظات على القصص القصيرة. بعضها راق للكاتبة وبعضها لم يرق.
اهتمامي بالكاتبة فجر تساؤلات عديدة منها ما يتعلق بي ومنها ما يتعلق بالقراء الذين عقب أحدهم على جزء مما كتبت بالتالي: “نيالها هذه الكاتبة فقد حظيت باهتمام الناقد عادل الاسطة“، وحجة الكاتب الذي أرسل لي روايته وديوان شعر أيضاً أنني لا ألتفت إلى الأصوات الجديدة، وربما كان محقاً.
بعد 42 عاماً من تجربتي الكتابية اقتنعت أكثر وأكثر بضرورة أن يخلق كل جيل معه نقاده. واقتنعت أكثر بأن على الناقد ألا يتحول إلى عارض كتب، لأنه سيخسر الكثير ولن يكرس مشروعاً نقدياً ولن يتعمق في ظواهر أدبية أو قضايا نقدية، وفوق هذا لن يتابع أصواتاً بعينها لها مشروعها الأدبي وهي الأجدر بأن تتابع. والسؤال هو: لماذا هي الأجدر بأن تتابع؟
ربما احتاج الناقد إلى دراسة إحصائية للأدباء والأديبات الذين أصدروا عملاً أدبياً أو عملين فقط ثم انقطعوا عن الكتابة، ولم يضف ما كتبوه إلى الحركة الأدبية شيئاً يذكر أو ذا بال، ربما احتاج الناقد إلى دراسة إحصائية كهذه ليجيب على تساؤلات من يعاتبه لأنه لا يحفل بالأصوات الأدبية الجديدة ولأنه يؤثر أن يتابع أدباء لهم مشروعهم الأدبي.
تحفل مكتبتي بأعمال شعرية وقصصية وروائية لكتاب كثر انقطعوا عن الكتابة بعد عملهم الأول أو الثاني ولم تشكل كتابتهم أية قيمة أدبية فنية. إنها كتابات أقرب إلى الكتابات الانفعالية العفوية التي تقول تجاربهم بلغة بسيطة جداً وأحياناً ضعيفة، هذا إذا كانت أصلاً، كما تبدو في نصوصهم، لغتهم البكر الخالية من قلم الآخرين.
تعيدني الكتابة السابقة إلى كتاب فاروق وادي «ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية»، 1985، وما كتبه فيه عن الروائي إميل حبيبي. كان فاروق وادي درس رواية «المتشائل» وتساءل إن كان يمكن أن يُكرَس الكاتب روائياً من خلال عمل واحد فقط، وذهب إلى أن هذا غير ممكن إلا في حالة كاتب كتب رواية مثل رواية «المتشائل». والسؤال هو: كم كاتب من كتابنا أصدر عملاً أدبياً أول وكان مكتملاً؟
سأجيب من خلال تجربتي حتى لا يغضب الكتّاب.
لو هيئ لي الآن أن أنظر في مجموعتي القصصية الأولى «فصول في توقيع الاتفاقية»، 1979، فهل سأرضى عنها؟ وأوافق على نشرها؟
أغلب الظن أنني سأتخلى عنها كما تخلى محمود درويش عن ديوانه الأول «عصافير بلا أجنحة»، 1960، وكثير من قصائده التي ظهرت في ديوانه الثاني «أوراق الزيتون».
ثمة قيمة واحدة لكثير من الأعمال الأولى هي القيمة التاريخية وأما القيمة الأدبية الفنية فهي شبه معدومة إلا في حالات نادرة حيث تظل الأفضل لكتّابها، كما هو حال الشاعر الفرنسي رامبو والشاعر العراقي مظفر النواب.
هل نقصّر حقاً بحق الأصوات الجديدة؟
ربما ما ذكرته سابقاً يغيب عن ذهنها وما يغيب عن ذهنها أكثر هو أنها ليست ذات مشروع أدبي أصلاً. مثلاً، إن كتّاباً كثراً حتى ممن أصدروا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة نصوص أو دواوين، لا يتساءلون: أين نحن من مسيرة أدبنا المحلي أو الوطني أو العربي، ولا أريد أن أقول: والأدب العالمي فيبدو قولي ضرباً من الشطط والمبالغة والإسراف في التفاؤل.
إن أصواتاً أدبية جديدة كثيرة تبدو منقطعة انقطاعاً تاماً عن مسيرة أدبها الوطني، وانقطاع شبه كلي عن ذلك الأدب لا يجعلها تتساءل عما يمكن أن تضيفه وعما يمكن أن يشكل إثراء للقارئ وللأدب الوطني على الأقل.
ربما قلة من أدبائنا هم من فعلوا هذا، وهم عموماً من واصلوا الكتابة ومن كان لهم مشروعهم الأدبي، عدا مشروعهم السياسي والاجتماعي.
اهتمامي بالكاتبة النابلسية فجر لدي أسئلة أخرى عديدة ليس أقلها ظاهرة الكاتبات النابلسيات. هناك ظاهرة الكتابة في سن متأخرة وظاهرة كتابة المرأة بعد تجربة شخصية، بل وأكثر: كتابة المرأة المقيمة في الوطن والمرأة المقيمة في المنفى، ولعلني أقارب هذا في أسابيع قادمة.