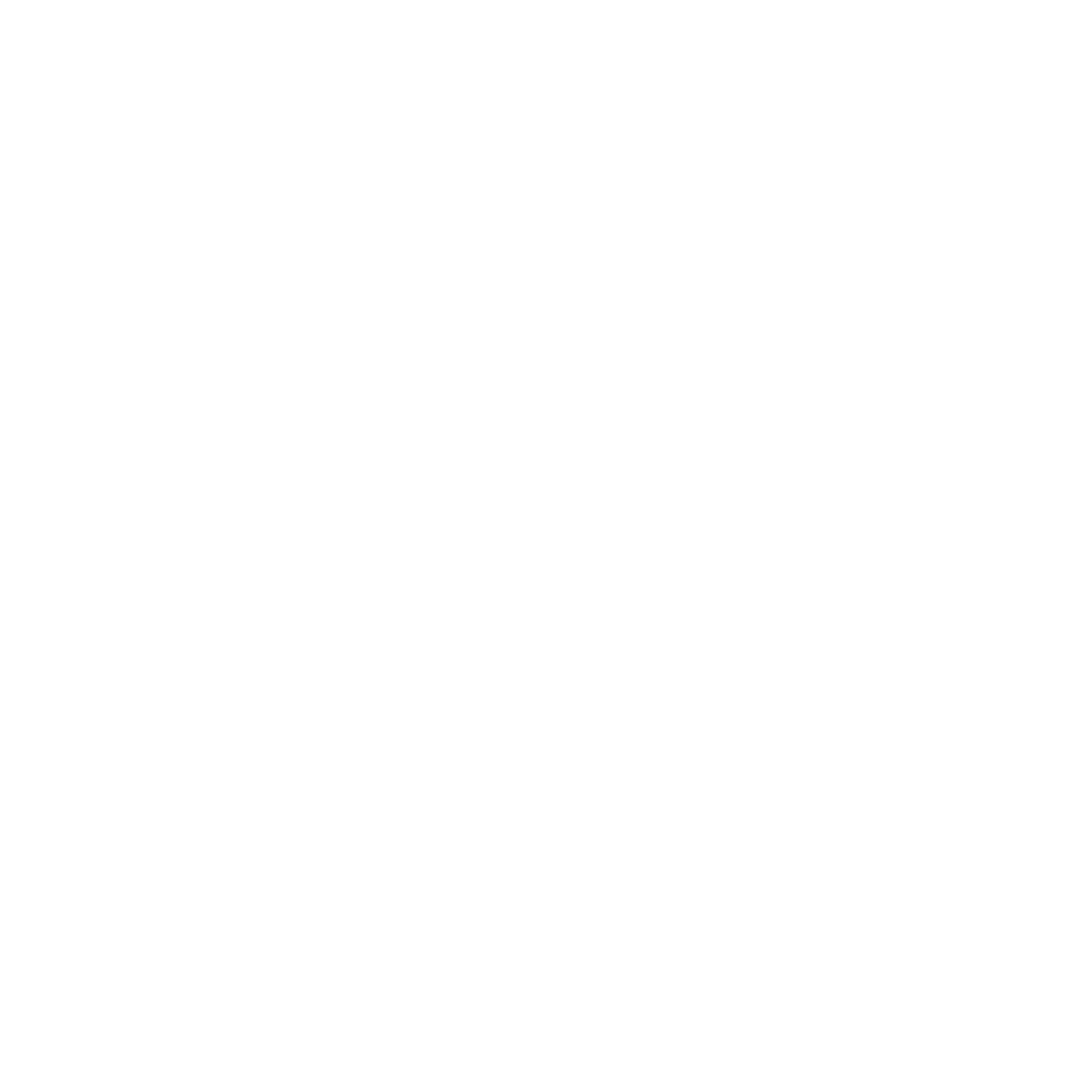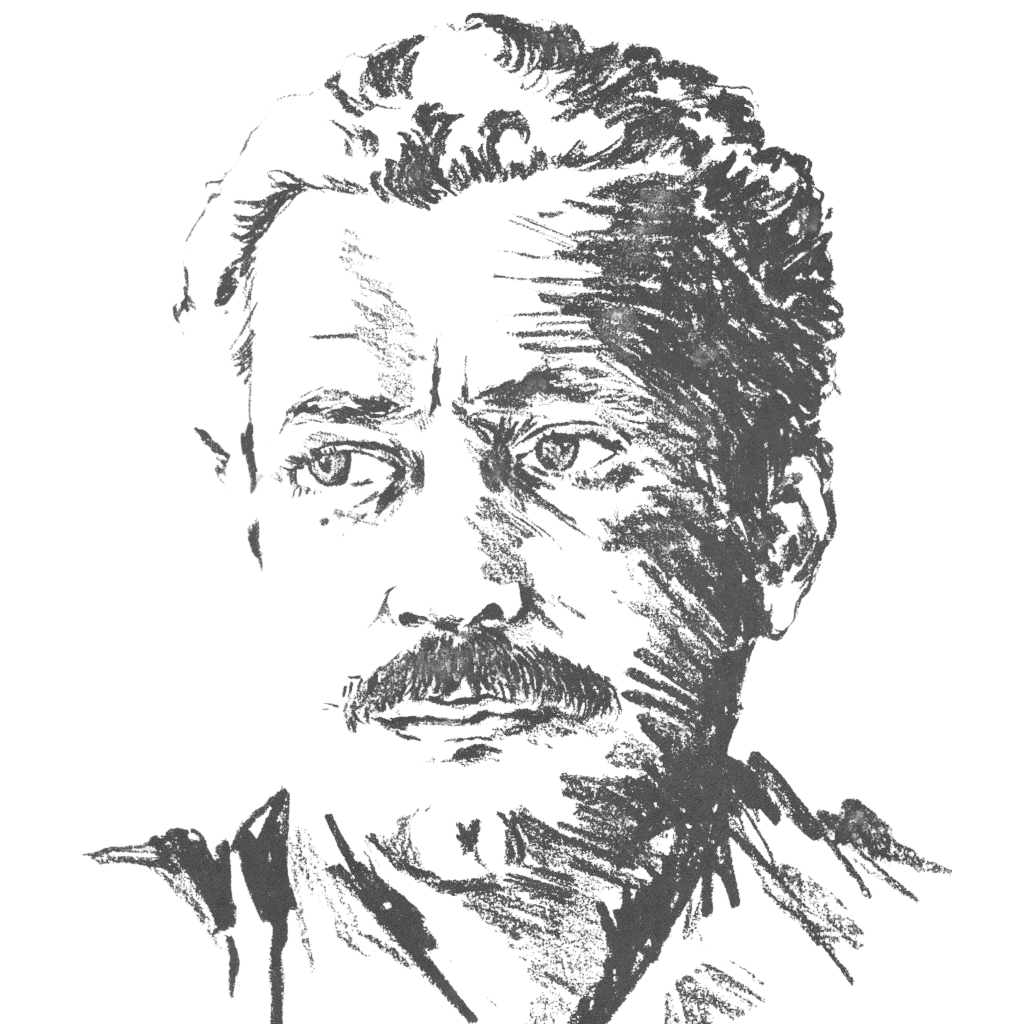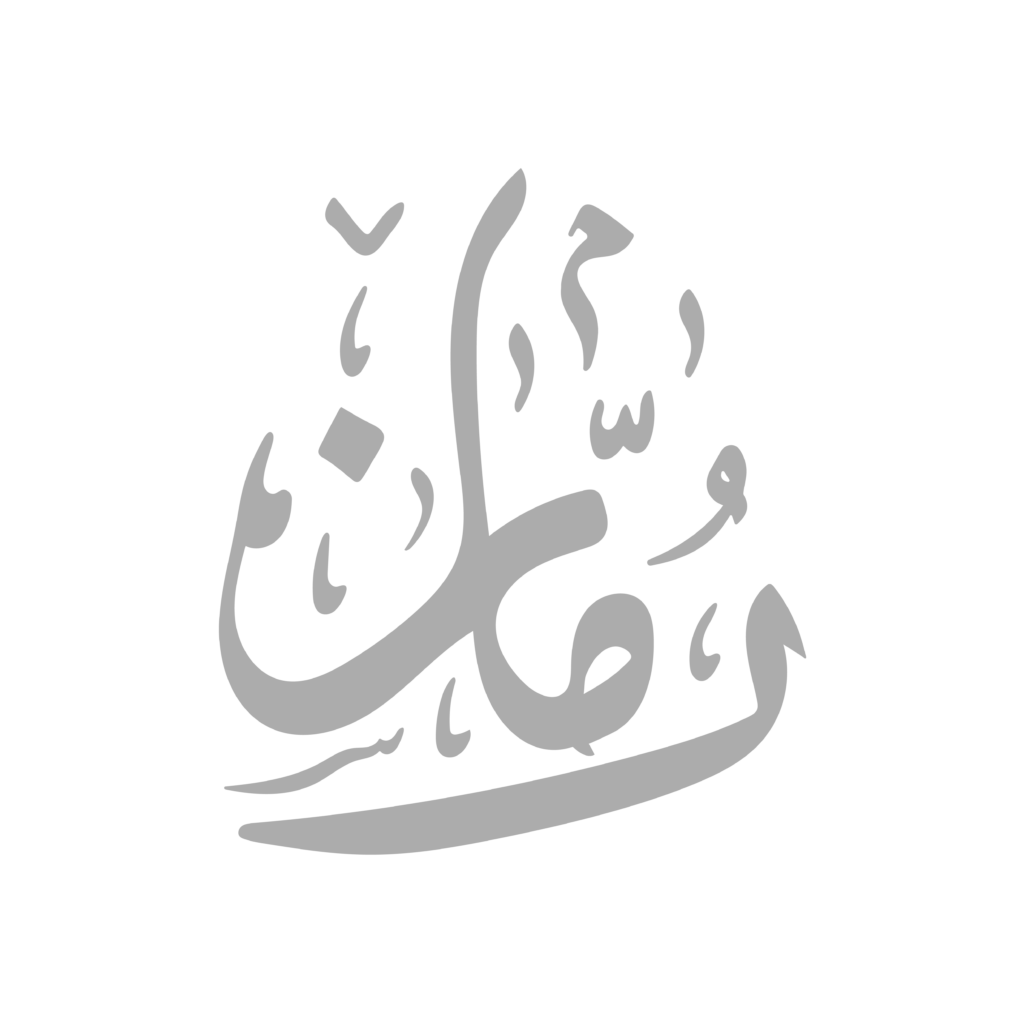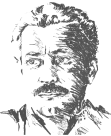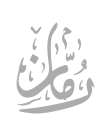رحّبت الكاتبة الإيرلندية، سالي روني، بالقرار الصادر عن المحكمة العليا البريطانية الذي قضى بأنّ حظر حركة "Palestine Action" كمجموعة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة كان "غير قانوني وغير متناسب"، معتبرة الحكم انتصاراً للحريات المدنية وحرية التعبير في بريطانيا.
كما انتقدت روني تفسير المحكمة لمفهوم "العنف"، مشيرة إلى أن الإضرار بالممتلكات لا يُعد عنفاً إذا لم يصب كائنات حيّة، مؤكدة أن نشاطات المجموعة تندرج ضمن تقليد العصيان المدني، كما فعلت حركات حقوق المرأة والحركات البيئية. وأوضحت أنها تخطط لاستخدام عائدات أعمالها لدعم بالستاين أكشن، مشيرة إلى أنها اضطرت سابقاً لإلغاء زيارة إلى المملكة المتحدة لتلقّي جائزة خشية التعرض للاعتقال، وأن استمرار الحظر كان يهدد إمكانية نشر كتبها في البلاد.
في تعليقها على الحكم قالت روني إنها "مبتهجة ومحفّزة" لأنّ المحكمة وجّهت رسالة واضحة بشأن أهمية حماية الحريات الأساسية، مشدّدةً على أنّ قرار الحظر كان تدخّلاً خطيراً في الحقوق الأساسية، خصوصاً حرية التعبير وحرية التجمّع السياسي. ويبقى القرار القضائي وتداعياته محور نقاش واسع في الأوساط القانونية والسياسية البريطانية حول حدود استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، ومكانها في حالات الاحتجاج المدني السلبي، وهو ما تؤكّده تصريحات روني التي ترى في هذا الحكم إعادة توازن بين حقوق الأفراد وقيود الدولة على حرية التعبير.
الروائية سالي روني ستتبرع لحركة "فلسطين أكشن" والحكومة البريطانية تحذرها
ورغم الحكم، ما زال الحظر سارياً مؤقتاً بينما تستعدّ الحكومة للطعن في قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف. وفي أواخر 2025 أعلنت روني أنها تخطّط لاستخدام عوائد أعمالها لدعم الحركة وأنها ألغت زيارة مقرّرة إلى بريطانيا لما كان يمكن أن يعرّضها لخطر الاعتقال بسبب دعمها لـ"Palestine Action" في ظلّ الحظر. وأوضحت حينها أنّ استمرار الحظر قد يقود إلى انسحاب كتبها من السوق البريطانية ويشكّل انتهاكاً خطيراً للحقوق الفنية والسياسية.
رمان / وكالات