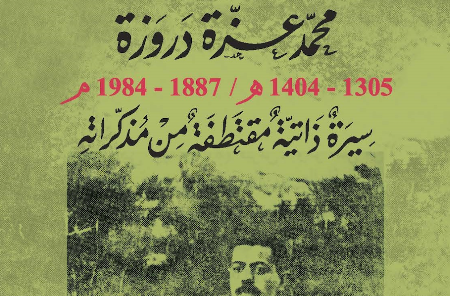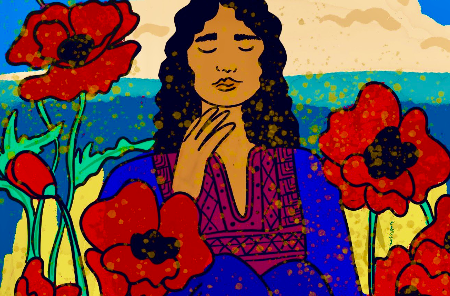المخرج اللبناني زياد دويري
أمرٌ آخر في الفيلم كان يُلزم عدم إدراجه ضمن العروض وليس أقلّ فداحة من التجربة التطبيعية لمُخرجه، وهو هنا في موضوع النقاش عينه، فالفيلم هو وجهة النّظر الكتائبيّة في الحرب اللبنانية، وذلك في العلاقة مع الفلسطينيين في لبنان ممثلين هنا بالدور الذي أدّاه الفلسطيني الباشا ونال عنه جائزته! هذا جوّ الفيلم وخطابه والخط السياسي لمخرجه وطبعاً جمهوره، ما الذي يعنيه إذن ما كتبه النّاقد إبراهيم العريس في ”الحياة" (15/09/2017) بأنها "جائزة كان من العيب ألا يُحتفل بها في بيروت لدى حضور ممثل الدور الفلسطيني كامل الباشا عرض الفيلم في العاصمة اللبنانية!“؟
وليس الموضوع شائكاً كما يبدو، لا في بيروت حين أُثير قبل شهر ولا هذه الأيام في رام الله، وهو ليس في الأخيرة امتداداً له في الأولى.
هناك، في بيروت، لم يكن الموضوع فلسطينياً، بل كان كأي مسألة ثقافية/سياسية خاضعاً لاستقطاب لبناني مشوّه بالأساس يحكمه الموقف من النظام السوري، وعلى أساسه تتفرّع المواقف وتتطرّف في مسائل عديدة كان أحدها زياد دويري وفيلمه «قضية ٢٣». لم تكن المسألة فلسطينية بالمرّة، بل محلية جداً، ”معركة أهليّة“ استُحضرت/استُخدمت فيها فلسطين، كالعادة.
في رام الله، المسألة المثارة متعلّقة بالفيلم ومُخرجه، ولا اعتبارات خارجية واصطفافات تتجاوز موضوع الفيلم، وهو ما يمكن أن يجعل النقاشَ مفيداً. نحاول في ”رمّان“ فتح هذا النّقاش إنّما بمبدأين لا نساوم عليهما: أولاً رفضنا للتطبيع، وثانياً رفضنا للمنع.
أسوأ ما حصل هنا هو تأرجح النّقاش بين التطبيع والمنع، بين الدفاع عن فيلم لمخرجه نهجٌ تطبيعي وبين الدفاع عن منع عمل فني من الوصول إلى الناس، ومن الجهتين لمسنا نبرة وصائيّة أبوية وأحياناً تخوينيّة، ما جعل كامل الباشا -الفلسطيني الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا عن دوره في الفيلم- يصرّح بمقاطعة حملة المقاطعة، وهذه مسألة كارثيّة إن بدأت تتسلل إلى عقولنا، مسألة تتحمّل ”حركة المقاطعة“ نفسها قسماً من المسؤولية عنها (بعد مسؤولية المتلفّظ بها) للأسلوب الذي تحاول السيطرة فيه على المجتمع، وزادُها في ذلك هو الإنجاز العظيم (حقاً) الذي حققته حملات المقاطعة في كل العالم، وآخر صدى لها كان قبل أيام حين طالب البريطاني كين لوتش بتحويل عائدات فيلمه الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان، «أنا، دانييل بلايك»، في الصالات الإسرائيلية، إلى حملات المقاطعة.
على ”حركة المقاطعة“ أن تكون مسؤولة عن كل كلمة تصدر عنها، وأن تعرف كيف توجّه نشطاءها وهم شباب متحمّسون مغالون ومزعجون أحياناً. مسؤولية الحركة تنبع من كونها، كنشاط عام وليس كمنظّمة، الفعل الأقوى الذي يواجه به الفلسطينيون وأصدقاؤهم في العالم الاحتلالَ الإسرائيلي ومؤسساته والشركات العالمية الداعمة له. من هنا نقول أن المسؤولية الأكبر تقع على هذه الحركة، على أن لا تجد في نفسها وصياً على الشعب، قاضياً أو شرطياً ينفّر الأهالي منه (كما هو حال نشطاء المقاطعة في لبنان). ولا يحقّ لهذه الحركة ولا لغيرها الدعوة لمنع أي عمل فنّي أو أدبي. ولتدعُ كما تشاء إلى مقاطعة عمل ما أو لتُعلم الجمهور بما قد يجهله، ويبقى القرار للمجتمع، للناس، لا لتنظيم أو حركة وبالتأكيد لا لجهة أمنية أو حكومية أو بلديّة.
لكن المشكلة بالأساس كانت في مكان آخر، كانت لدى المسؤولين في مهرجان «أيام السينما» الذي تنظّمه مؤسسة ”فيلم لاب-فلسطين“، كانت بالأساس اختيار الفيلم، بل واختياره ليكون فيلم الختام كنوع من التكريم، ولا يمكن لمبرمجي الفيلم أن لا يكونوا قد اطّلعوا على الضّجة التي أحدثها الفيلم في لبنان الشهر الماضي، وما أُثير عن الفعل التطبيعي لمخرجه في فيلمه السابق (صَوّر جزءاً منه في تل أبيب وأقام فيها). وإن ادّعى أحد المنظّمين ذلك، فإن بيان ”حركة المقاطعة“ الذي صدر أمس الأول يشير بوضوح إلى أن الحركة أطلعت في جلسات مطوّلة إدارة المهرجان على إشكالية عرض الفيلم. إذن، كان اختيار الفيلم عن وعي بل وإصرار، فكان أن عُرض وكان أن جرت ضغوط فمَنعت عرضه بلديّةُ رام الله… كنّا في بؤس واحد وصرنا في بؤسيْن.
صار أن أُدرج الفيلم، وكفيلم ختامي للمهرجان، حاولت قبله "حركة المقاطعة" ”إفهام“ المنظّمين بأنّ لمُخرج الفيلم تجربة تطبيعية سابقة، عرف الأخيرون ذلك ولم يكترثوا. من هنا كان لا بد أن ينتقل النّقاش لا إلى منعه بقوّة التحريض، فكما أنّ مناهضة التطبيع مسألة مبدئيّة فإنّ مناهضة المنع كذلك مسألة مبدئيّة، لكلّ عمل فنّي الحق في الوصول إلى متلقّيه، فكان لا بد أن ينتقل النّقاش إلى محاسبة المسؤولين عن عرضه لتهاونهم في مسألة هي في أوج صراعنا مع الاحتلال اليوم: المقاطعة/التطبيع.
أمرٌ آخر في الفيلم كان يُلزم عدم إدراجه ضمن العروض وليس أقلّ فداحة من التجربة التطبيعية لمُخرجه، وهو هنا في موضوع النقاش عينه، فالفيلم هو وجهة النّظر الكتائبيّة في الحرب اللبنانية، وذلك في العلاقة مع الفلسطينيين في لبنان ممثلين هنا بالدور الذي أدّاه الفلسطيني الباشا ونال عنه جائزته! هذا جوّ الفيلم وخطابه والخط السياسي لمخرجه وطبعاً جمهوره، ما الذي يعنيه إذن ما كتبه النّاقد إبراهيم العريس في ”الحياة" (15/09/2017) بأنها "جائزة كان من العيب ألا يُحتفل بها في بيروت لدى حضور ممثل الدور الفلسطيني كامل الباشا عرض الفيلم في العاصمة اللبنانية!“؟
كيف يمكن لمهرجان فلسطيني أن يكرّم فيلماً جعل من خطاب مجرم الحرب بشير الجميّل (صبرا وشاتيلا) خطاباً وطنياً "يحب لبنان" آتٍ كالنّقيض ”للفلسطيني الأجنبي مرتكب مجزرة الدامور"! هذه مسألة لا تقلّ خطورة عن الإشكاليات التطبيعية لمخرج الفيلم، هذا حديث عن الفيلم ذاته وليس عن الفيلم السابق لمخرجه، وهو دعاية كره تجاه الفلسطينيين في لبنان. كيف لا يكترث أحد هناك، في رام الله، لهذا الجانب من الفيلم ويكون الحديث كلّه عن التطبيع! وهو فيلم أشارت أكثر من قراءة له إلى سذاجة التصنيف فيه بين الخيّر والشرير، تصنيف يكون فيه الفلسطيني هو مرتكب المجازر. أليس لدى تاريخ وحاضر فلسطينيي لبنان البائسيْن أي اعتبار لدى أهلنا في رام الله؟! هذا تعليق للمخرجة اللبنانية إليان الراهب («ليالٍ بلا نوم» و«ميّل يا غزيّل») أنقله عن الفيسبوك (بإذنها)، قد يلخّص الكثير من الكلام عن الفيلم:
"مش مشكلة أن الفيلم منحاز، المشكلة أن قبل مجزرة الدامور بكم يوم صارت مجزرة الكارنتينا وقبلها بأشهر مجزرة السبت الأسود ومذكور فظاعتها بكتاب «أنا الضحية والجلاد أنا»، وبعد الدامور حدثت مجزرة تل الزعتر وطبعاً بعدها بسنين مجزرة صبرا وشاتيلا وحصار المخيمات. لو انذكروا هُول من قِبل محامية الشخص الفلسطيني كان الفيلم بيّن أقوى وأن كل البلد مسؤول، وأن الشخصيتين مظلومتين تجاه السياسيين الوسخين. للأسف، ما عرفنا عن الشخص الفلسطيني أشياء إلا بمرحلة الـ ٤٨ وبمرحلة أيلول الأسود، وكأن من الـ ٧٣ (يوم قصف الجيش اللبناني مخيمات فلسطينية) ليوم أحداث الدامور لا وجود لمجازر ضد الفلسطينيين بلبنان."
الفيلم دعاية كره تجاه الفلسطينيين، نعم، هذا ما يتوجّب أخذه بعين الاعتبار في رام الله قبل التاريخ التطبيعي لمخرجه، هذا وذاك ما يتوجّب محاسبة المسؤولين عن إدراج الفيلم، عليه. أمّا ”حركة المقاطعة“ فكلّي أمل ألا يكرّهوا الناس بهم لغلاظة خطابهم، وأن يُدركوا أنّهم ليسوا أوصياء على الفلسطينيين، ولن يكونوا.
هناك، في بيروت، لم يكن الموضوع فلسطينياً، بل كان كأي مسألة ثقافية/سياسية خاضعاً لاستقطاب لبناني مشوّه بالأساس يحكمه الموقف من النظام السوري، وعلى أساسه تتفرّع المواقف وتتطرّف في مسائل عديدة كان أحدها زياد دويري وفيلمه «قضية ٢٣». لم تكن المسألة فلسطينية بالمرّة، بل محلية جداً، ”معركة أهليّة“ استُحضرت/استُخدمت فيها فلسطين، كالعادة.
في رام الله، المسألة المثارة متعلّقة بالفيلم ومُخرجه، ولا اعتبارات خارجية واصطفافات تتجاوز موضوع الفيلم، وهو ما يمكن أن يجعل النقاشَ مفيداً. نحاول في ”رمّان“ فتح هذا النّقاش إنّما بمبدأين لا نساوم عليهما: أولاً رفضنا للتطبيع، وثانياً رفضنا للمنع.
أسوأ ما حصل هنا هو تأرجح النّقاش بين التطبيع والمنع، بين الدفاع عن فيلم لمخرجه نهجٌ تطبيعي وبين الدفاع عن منع عمل فني من الوصول إلى الناس، ومن الجهتين لمسنا نبرة وصائيّة أبوية وأحياناً تخوينيّة، ما جعل كامل الباشا -الفلسطيني الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا عن دوره في الفيلم- يصرّح بمقاطعة حملة المقاطعة، وهذه مسألة كارثيّة إن بدأت تتسلل إلى عقولنا، مسألة تتحمّل ”حركة المقاطعة“ نفسها قسماً من المسؤولية عنها (بعد مسؤولية المتلفّظ بها) للأسلوب الذي تحاول السيطرة فيه على المجتمع، وزادُها في ذلك هو الإنجاز العظيم (حقاً) الذي حققته حملات المقاطعة في كل العالم، وآخر صدى لها كان قبل أيام حين طالب البريطاني كين لوتش بتحويل عائدات فيلمه الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان، «أنا، دانييل بلايك»، في الصالات الإسرائيلية، إلى حملات المقاطعة.
على ”حركة المقاطعة“ أن تكون مسؤولة عن كل كلمة تصدر عنها، وأن تعرف كيف توجّه نشطاءها وهم شباب متحمّسون مغالون ومزعجون أحياناً. مسؤولية الحركة تنبع من كونها، كنشاط عام وليس كمنظّمة، الفعل الأقوى الذي يواجه به الفلسطينيون وأصدقاؤهم في العالم الاحتلالَ الإسرائيلي ومؤسساته والشركات العالمية الداعمة له. من هنا نقول أن المسؤولية الأكبر تقع على هذه الحركة، على أن لا تجد في نفسها وصياً على الشعب، قاضياً أو شرطياً ينفّر الأهالي منه (كما هو حال نشطاء المقاطعة في لبنان). ولا يحقّ لهذه الحركة ولا لغيرها الدعوة لمنع أي عمل فنّي أو أدبي. ولتدعُ كما تشاء إلى مقاطعة عمل ما أو لتُعلم الجمهور بما قد يجهله، ويبقى القرار للمجتمع، للناس، لا لتنظيم أو حركة وبالتأكيد لا لجهة أمنية أو حكومية أو بلديّة.
لكن المشكلة بالأساس كانت في مكان آخر، كانت لدى المسؤولين في مهرجان «أيام السينما» الذي تنظّمه مؤسسة ”فيلم لاب-فلسطين“، كانت بالأساس اختيار الفيلم، بل واختياره ليكون فيلم الختام كنوع من التكريم، ولا يمكن لمبرمجي الفيلم أن لا يكونوا قد اطّلعوا على الضّجة التي أحدثها الفيلم في لبنان الشهر الماضي، وما أُثير عن الفعل التطبيعي لمخرجه في فيلمه السابق (صَوّر جزءاً منه في تل أبيب وأقام فيها). وإن ادّعى أحد المنظّمين ذلك، فإن بيان ”حركة المقاطعة“ الذي صدر أمس الأول يشير بوضوح إلى أن الحركة أطلعت في جلسات مطوّلة إدارة المهرجان على إشكالية عرض الفيلم. إذن، كان اختيار الفيلم عن وعي بل وإصرار، فكان أن عُرض وكان أن جرت ضغوط فمَنعت عرضه بلديّةُ رام الله… كنّا في بؤس واحد وصرنا في بؤسيْن.
صار أن أُدرج الفيلم، وكفيلم ختامي للمهرجان، حاولت قبله "حركة المقاطعة" ”إفهام“ المنظّمين بأنّ لمُخرج الفيلم تجربة تطبيعية سابقة، عرف الأخيرون ذلك ولم يكترثوا. من هنا كان لا بد أن ينتقل النّقاش لا إلى منعه بقوّة التحريض، فكما أنّ مناهضة التطبيع مسألة مبدئيّة فإنّ مناهضة المنع كذلك مسألة مبدئيّة، لكلّ عمل فنّي الحق في الوصول إلى متلقّيه، فكان لا بد أن ينتقل النّقاش إلى محاسبة المسؤولين عن عرضه لتهاونهم في مسألة هي في أوج صراعنا مع الاحتلال اليوم: المقاطعة/التطبيع.
أمرٌ آخر في الفيلم كان يُلزم عدم إدراجه ضمن العروض وليس أقلّ فداحة من التجربة التطبيعية لمُخرجه، وهو هنا في موضوع النقاش عينه، فالفيلم هو وجهة النّظر الكتائبيّة في الحرب اللبنانية، وذلك في العلاقة مع الفلسطينيين في لبنان ممثلين هنا بالدور الذي أدّاه الفلسطيني الباشا ونال عنه جائزته! هذا جوّ الفيلم وخطابه والخط السياسي لمخرجه وطبعاً جمهوره، ما الذي يعنيه إذن ما كتبه النّاقد إبراهيم العريس في ”الحياة" (15/09/2017) بأنها "جائزة كان من العيب ألا يُحتفل بها في بيروت لدى حضور ممثل الدور الفلسطيني كامل الباشا عرض الفيلم في العاصمة اللبنانية!“؟
كيف يمكن لمهرجان فلسطيني أن يكرّم فيلماً جعل من خطاب مجرم الحرب بشير الجميّل (صبرا وشاتيلا) خطاباً وطنياً "يحب لبنان" آتٍ كالنّقيض ”للفلسطيني الأجنبي مرتكب مجزرة الدامور"! هذه مسألة لا تقلّ خطورة عن الإشكاليات التطبيعية لمخرج الفيلم، هذا حديث عن الفيلم ذاته وليس عن الفيلم السابق لمخرجه، وهو دعاية كره تجاه الفلسطينيين في لبنان. كيف لا يكترث أحد هناك، في رام الله، لهذا الجانب من الفيلم ويكون الحديث كلّه عن التطبيع! وهو فيلم أشارت أكثر من قراءة له إلى سذاجة التصنيف فيه بين الخيّر والشرير، تصنيف يكون فيه الفلسطيني هو مرتكب المجازر. أليس لدى تاريخ وحاضر فلسطينيي لبنان البائسيْن أي اعتبار لدى أهلنا في رام الله؟! هذا تعليق للمخرجة اللبنانية إليان الراهب («ليالٍ بلا نوم» و«ميّل يا غزيّل») أنقله عن الفيسبوك (بإذنها)، قد يلخّص الكثير من الكلام عن الفيلم:
"مش مشكلة أن الفيلم منحاز، المشكلة أن قبل مجزرة الدامور بكم يوم صارت مجزرة الكارنتينا وقبلها بأشهر مجزرة السبت الأسود ومذكور فظاعتها بكتاب «أنا الضحية والجلاد أنا»، وبعد الدامور حدثت مجزرة تل الزعتر وطبعاً بعدها بسنين مجزرة صبرا وشاتيلا وحصار المخيمات. لو انذكروا هُول من قِبل محامية الشخص الفلسطيني كان الفيلم بيّن أقوى وأن كل البلد مسؤول، وأن الشخصيتين مظلومتين تجاه السياسيين الوسخين. للأسف، ما عرفنا عن الشخص الفلسطيني أشياء إلا بمرحلة الـ ٤٨ وبمرحلة أيلول الأسود، وكأن من الـ ٧٣ (يوم قصف الجيش اللبناني مخيمات فلسطينية) ليوم أحداث الدامور لا وجود لمجازر ضد الفلسطينيين بلبنان."
الفيلم دعاية كره تجاه الفلسطينيين، نعم، هذا ما يتوجّب أخذه بعين الاعتبار في رام الله قبل التاريخ التطبيعي لمخرجه، هذا وذاك ما يتوجّب محاسبة المسؤولين عن إدراج الفيلم، عليه. أمّا ”حركة المقاطعة“ فكلّي أمل ألا يكرّهوا الناس بهم لغلاظة خطابهم، وأن يُدركوا أنّهم ليسوا أوصياء على الفلسطينيين، ولن يكونوا.