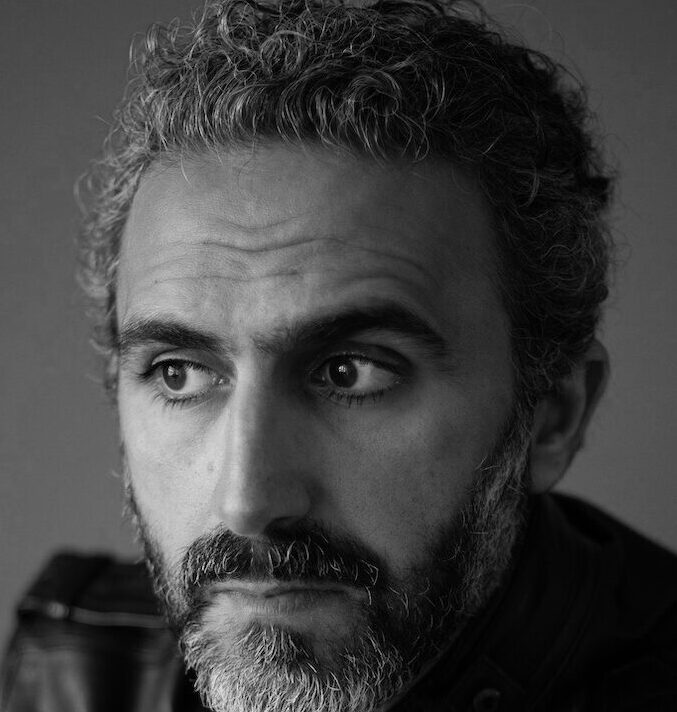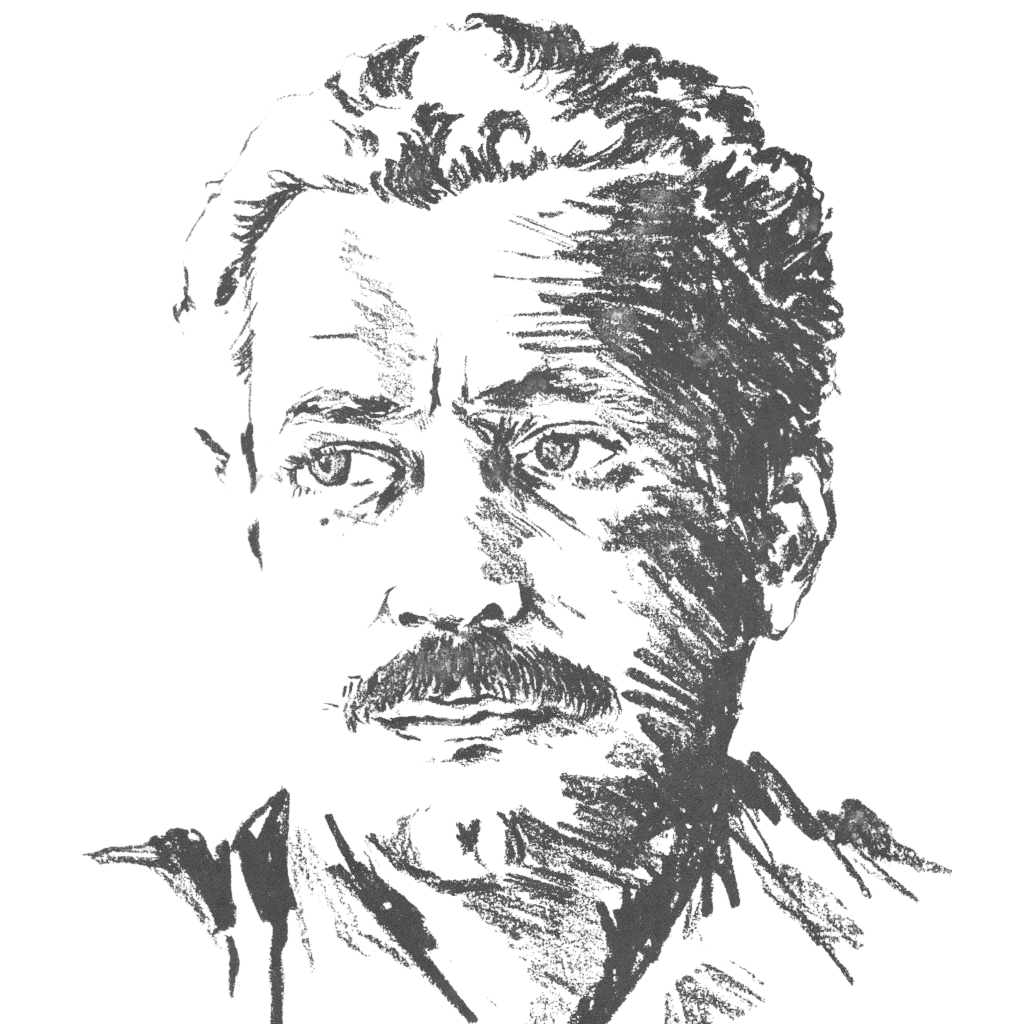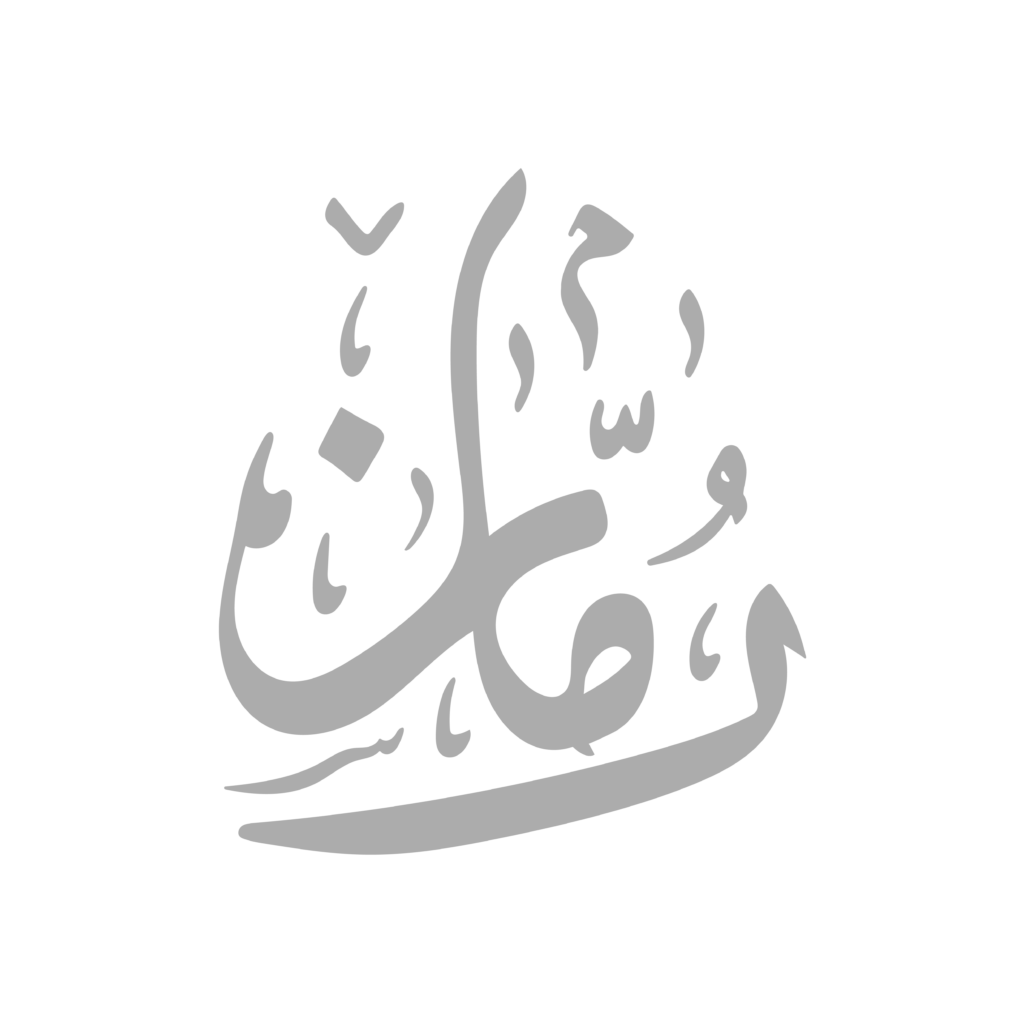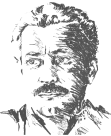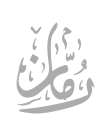فيلم التشادي محمد صالح هارون، جوهرة تركها المهرجان إلى آخره أيامه. فيلم شِعريّ، بما في هذه الكلمة من سحر، بما فيها من مجازات هي هنا بصرية، كما هي نصّية.
يحكي الفيلم عن فتاة، تشتكي باكراً لوالدها شعورَها أنها مختلفة. لاحقاً سيطاردها رجال قائلين إنها أجنبية، مهاجرة، مع غموض يلفّ القرية الصحراوية حول أصلها، حول ما يُظنّ أن أمها ماتت يوم ولادتها، وحول أبيها الذي لجأ إلى هذه القرية وهو شاب إثر حادثة قتل.
الفيلم عمل واقعي سحري إفريقي، فيه واقعية يحيطها السحر، الخيال الجامح، في القصة والشخصيات كما في المكان وهو قرية رملية في صحراء صخرية، تلفها الأشجار والقنوات المائية، كأنها القرية سراب، مكان خرافي. نحن هنا أقرب إلى واحة متخيَّلة في سياق يحمل من السحر بقدر، أو ربما أكبر من، ما يحمل من الواقعية.
وهذا كله يشي بحقيقة أن للفيلم تصويراً خلاباً، لقطات ثابتة وأخرى متحركة، تأسر المتفرج من دون أن تخلع عنه القصة. والفيلم مقل في الكلام، يحمل ما يكفي منه وحسب. الصورة أساس هنا، الموسيقى كذلك، بتناغم بين إيقاعات إفريقية وموسيقى الجاز. البيئة المسلمة المتعايشة مع تحرر فردي للنساء، الشخصية الرئيسية تحديداً، ومدموجة بإرث محلي من حكايات الموتى والأشباح، في مجتمع أبوي وقبائلي. هنا، تتحدى الفتاة المتجمع وأفراده وتحقق، في فيلم هو الأكثر نسوية ضمن المسابقة، إرادتها، بعد تحقيق لرغباتها مع حبيبها.
هو فيلم شعري، بمجازاته، هو كذلك فيلم نسويّ، من دون إقحام، فالفتاة فيه ترفض قمعاً ممارَساً أو محتملاً، ترفض إملاءات، ترفض الرفضَ حيالها بوصفها غريبة ومختلفة. وتحمل، أخيراً، امرأةً سنعرف أخيراً من تكون، إلى قبرها لدفنها. بعد تمنّع القرية بحجة أن المرأة ساحرة، تجلب الشؤم.
الفيلم في كل ذلك شبيه بآخر مواز له في جمالياته وإن اختلف في سياقاته، هو "تمبكتو" للموريتاني عبد الرحمن سيساكو. جماليات الصحراء الإفريقية، ببطولات نسائية وإرادات نسوية. هنا، في الفيلمين، الصحراء حالة جمالية.
"سمسوم، ليلة النجوم" (Soumsoum, the Night of the Stars) هادئ، في حواراته كما في مونتاجه، هادى في وتيرة الحركة فيه، حركة الشخصيات وحركة الصور. كثير من لقطاته تأملية، الجماليات فيه متكاملة، الصحراء المتخيَّلة فيه حالةٌ جمالية. جماليات جعلت للسحر فيه مكاناً طبيعياً.
السحر هنا، كما كان في أسلوب الفيلم كان في سياقه. السحر هنا، كما هي الصحراء، لا واحة تماماً، بل سراب، كالمجاز الشعري، سراب من ذلك الواقعي السحري، سراب كأنه حقيقة. سراب لحالة حقيقية.